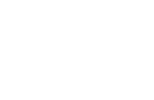قد ظهر لک من اللمعة السابقة انّ الإنسان الکامل بمنزلة الأب للموجودات الإمکانیّة، و هی صادرةٌ عنه بلاواسطةٍ أو بواسطةٍ ـ کماقال الصادق علیه السلام: «نحن صنائع اللّه و
الناس بعد صنائع لنا»(1) ـ. فمجموع العالم بمنزلة الأبناء له، و للأب رعایة أبنائه و تربیتها حتّى یبلغها إلى غایة کمالها الممکن لها، فهو المربّی للأبناء العالَمیّة بالأسماء الإلهیّة الّتی أودعتها الحضرة الأحدیّة فیه و علّمتها إیّاه و رکّبتها فی فطرته. و هو الواسطة فی وصول الفیض من الحقّ إلى الخلق؛ و هو الّذی نور التجلّی منه یفیض على ما یناسبه من العالم، فانّ کلّ حقیقةٍ حقیقةٌ من حقائق ذاته و کلّ صفةٍ کمالیّةٍ صفةٌ من صفاته ـ لمرتبة جمعیّته و خلافته على الکلّ الجامعة بین البدایة و النهایة و أحکامها و أحکام الجمع و التفرقة و الوحدة و الکثرة و الحقّیّة و الخلقیّة و القید و الإطلاق عن حضورٍ من غیر غیبةٍ و یقینٍ بلاریبةٍ ـ. فعلى الخلیفة رعایة رعایاه و على الأب تربیة أبنائه على الوجه الأنسب الألیق بهم لئلّا یهمل کلّ قابلٍ عمّا یستعدّه و کلّ مستحقٍّ عمّا یستحقّه؛ و فیه یتفاضل الخلائق بعضهم على بعضٍ، فلذا انعقد – علیه السلام ـ هذا الدعاء للأبناء؛ و قال ـ صلوات اللّه و سلامه علیه ـ :
اللَّهُمَّ وَ مُنَّ عَلَیَّ بِبَقَاءِ وُلْدِی، وَ بِإِصْلاَحِهِمْ لِی و بِإِمْتَاعِی بِهِمْ.
«منّ»: فعل أمرٍ مِن مَنّ یمُنّ ـ کمدّ یمدّ ـ: إذا أنعم؛ یقال: منّ علیه بکذا منّاً: أنعم علیه.
و «البقاء» یطلق تارةً على استمرار الوجود أزلاً أبداً ـ فهو مختصٌّ باللّه سبحانه، لأنّه عین البقاء ـ، و تارةً على طول الوجود، و هو المراد هنا.
و «وَلَد» ـ على وزن فرس ـ للمفرد و الجمع، و فی نسخة ابن ادریس: «وُلْدِی» ـ على وزن حکمی ـ للجمع خاصّةً، أی: منّ علیّ بطول عمرهم.
و «باصلاحهم» أی: إبعادهم عن الفساد لانتفاعی. و ذلک لایکون إلّا بتوفیق العباد
للصواب و السداد، لأنّ الربّ ینتفع بتربیة مربوبه. و قال الفاضل الشارح: «و فیه تلمیحٌ إلى قوله ـ تعالى ـ: (وَ أَصْلِحْ لِی فِی ذُرِّیَّتِی)(2)»(3)
<قیل: «هو دعاءٌ باصلاح ذرّیّته لبرّه و طاعته ـ لقوله: «لی»ـ»؛
و قیل: «انّه دعاءٌ باصلاحهم لطاعة اللّه ـ عزّ و جلّ ـ».
قال أمین الإسلام: «و هو الأشبه، لأنّ طاعتهم من برّه»(4)؛
و عن الزجّاج: «أی: اجعل ذرّیّتی صالحین»(5)؛
و قال سهل بن عبداللّه: «معناه: اجعلهم لی خلف صدقٍ و لک عبید حقٍّ».
و هذه المعانی کلّها محتملةٌ فی عبارة الدعاء. و قال الزمخشریّ: «فان قلت: ما معنى(6)
قوله: (وَ أَصْلِحْ لِی فِی ذُرِّیَّتِی)؟
قلت: معناه: أن یجعل ذرّیّته موقعاً للصلاح و مظنّةً له، کأنّه قال: هب لی الصلاح فی ذرّیّتی و أوقعه فیهم»(7)؛ انتهى.
و قیل: «هو على تضمین «اصلح» معنى «بارک»>(8)
<و «بامتاعی بهم»: إمّا مأخوذٌ من: أمتعت بالشیء بمعنى: تمتّعت به و انتفعت به ـ و المتاع: کلّ ماینتفع به ـ، فالباء للتعدیة؛ و إمّا من «الامتاع» المتعدّی بمعنى التعمیر ـ کما فی قوله تعالى: (یُمَتِّعْکُمْ مَتَاعاً حَسَناً)(9)، أی: یعمّرکم ـ، و الباء حینئذٍ للمصاحبة. حکى المطرّزی فی المغرب(10) عن بعضهم جعل الإمتاع متعدّیاً و المتاع مصدراً، أو انّه مصدر أمتعته إمتاعاً و متاعاً. ثمّ قال: «قلت: و الظاهر أنّه مصدرٌ من متع ـ کالسلام من سلم ـ».
ثمّ لایبعد على أخذ «الإمتاع» متعدّیاً جعله هیهنا بمعنى التعمیر، و «الباء» ـ فی: «بهم» ـ بمعنى: مع، أی: و بتعمیری معهم ـ کالتمتیع ـ>(11)؛ و منه فی التنزیل الکریم: (وَ یُمَتِّعُکُمْ مَتَاعاً حَسَناً)، أی: یعمّرکم و یعیشکم فی أمنٍ و دعةٍ فی عیشةٍ راضیةٍ إلى أجلٍ مسمىً؛ و کذلک فی قوله ـ سبحانه ـ: (قُلْ لَنْ یَنفَعَکُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوتِ أَو الْقَتلِ وَ إِذاً لاَتُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِیلاً)(12)، أی: لاتعمّرون و لاتبقون فی الدنیا إلّا إلى آجالکم.
إِلَهِی امْدُدْ لِی فِی أَعْمَارِهِمْ، وَ زِدْ لِی فِی آجَالِهِمْ، وَ رَبِّ لِی صَغِیرَهُمْ، وَ قَوِّ لِی ضَعِیفَهُمْ، وَ أَصِحَّ لِی أَبْدَانَهُمْ وَ أَدْیَانَهُمْ وَ أَخْلاَقَهُمْ، وَ عَافِهِمْ فِی أَنْفُسِهِمْ وَ فِی جَوَارِحِهِمْ وَ فِی کُلِّ مَا عُنِیتُ بِهِ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَ أَدْرِرْ لِی وَ عَلَى یَدِی أَرْزَاقَهُمْ. وَ اجْعَلْهُمْ أَبْرَاراً أَتْقِیَاءَ بُصَرَاءَ سَامِعِینَ مُطِیعِینَ لَکَ، وَ لاَِوْلِیَائِکَ مُحِبِّینَ مُنَاصِحِینَ، وَ لِجَمِیعِ أَعْدَائِکَ مُعَانِدِینَ وَ مُبْغِضِینَ، آمِینَ.
«امْدُد لی فی أعمارهم» أی: طوّل أعمارهم و أمهلهم فیها؛ <قال الفارابیّ فی دیوان الأدب: «مدّ اللّه فی عمره أی: أمهل له و طوّل له»(13)
و «الأعمار»: جمع عُمْر ـ بالضمّ، و بضمّتین، و بالفتح و السکون ـ، و هو الحیاة. و قیل: «مدّة بقاء الحیاة»؛ و قد مرّ تحقیقه(14)
و «الآجال»: جمع أَجَل ـ بالتحریک ـ، و هو مدّة العمر>(15) و إن قصر عمره. و قیل:
«هذا عطف تفسیرٍ للأوّل، و الفرق بینهما انّ فی الفقرة الأولى استدعاء طول عمرهم مطلقاً و
فی هذا طول عمرهم لانتفاعه بهم، حیث قیّد بقوله: لی».
و الظاهر انّه تأسیسٌ لاتأکیدٌ(16) و المراد بـ «المدّ فی الأعمار»: البرکة فیها بالتوفیق للطاعات و العبادات.
قوله – علیه السلام ـ: «و ربِّ لی صغیرهم»: أمرٌ من التربیة، یقال: ربّاه یربّیه: أوصله إلى کماله تدریجاً.
و «قوّ لی ضعیفهم»: أمرٌ من التقویة.
و «الصحّة» فی الأصل للبدن، ثمّ استعیرت للأفعال و المعانی ـ کما مرّ ـ.
و «عافهم» أی: ادفع عنهم الشرور الکائنة «فی أنفسهم و جوارحهم».
و عافهم «فی کلّ ما عُنیت به من أمرهم» بصیغة المجهول المتکلّم، و فی نسخة ابن ادریس بالخطاب(17)؛ یعنی: عافهم فی کلّ ما اهتممت به من أمرهم و شأنهم، من قولهم: هذا الأمر لایعنینی أی: لایشغلنی و لایهمّنی، و منه الحدیث: «من حسن إسلام المرء ترکه ما لایعنیه»(18) أی: ما لایهمّه؛ یقال: عنیت بحاجتک أی: اهتممت بها(19)
و «أدرر لی» بفکّ الإدغام من باب الإفعال، و من باب ضرب؛ أی: کثّر و وفّر لی، یقال: درّ اللبن و غیره درّاً: کثر و زاد، و أدر اللّه الرزق إدراراً: کثّره و وسّعه. و قال الشیخ البهائی ـ رحمه اللّه ـ فی المفتاح: «المراد بالرزق الدار: الّذی یتجدّد شیئاً فشیئاً، من قولهم: درّ اللبن: إذا زاد و کثر جریانه من الضرع»(20)؛ و بالوصل من قولهم: الریح تدر السحاب و تستدرّه أی:
تستجلبه.
و «اللام» للملک و الانتفاع. و قال بعضهم: «و فی تقییده السؤال بقوله – علیه السلام ـ: «لی» فی جمیع الفقرات ما یدلّ على أن الدعاء له و لهم، و على تمام الحنوّ و الشفقة، و على انّ الدعاء له – علیه السلام ـ أبلغ فی الدعاء و أقرب إلى الإجابة، و على أنّ کلّ واحدٍ ممّا سأل یکون على الوجه الکامل»(21)؛ انتهى.
و «على یدی» بصیغة الإفراد، أی: بواسطتی. و فی نسخة الشهید ـ رحمه اللّه ـ بصیغة التثنیة.
و «أرزاقهم»: مفعولٌ لـ«أدرر».
<و «الأبرار»: جمع بارّ، أو: برّ ـ کأصحاب: جمع صاحب، أو أرباب: جمع ربّ ـ. یقال: برّ الرجل یبرّ برّاً ـ مثل: علم یعلم علماً ـ فهو بَرٌّ ـ بالفتح ـ و بارٌّ. و هو خلاف الفاجر؛
و قیل: «هو الصادق»؛
و قیل: «هو کثیر البرّ، أی: الخیر و الاتّساع فی الإحسان».
و «الأتقیاء»: جمع تقیّ، و هو المطیع المتجنّب عن المعاصی.
و «البصراء»: جمع بصیر>(22) ـ کالخطباء جمع خطیب ـ ؛ أی: اجعلهم أصحاب
الادراکات القلبیّة، لأنّ البصیرة إدراکٌ لابالعین.
و «سامعین» أی: مصغین إصغاء الطاعة؛ یقال: فلانٌ سامعٌ مطیعٌ أی: سامعٌ لما یؤمر به ـ کائناً ما کان ـ سمع طاعةٍ و قبولٍ ـ و منه قوله تعالى: (وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اسْمَعُوا)(23) ـ، أی: مذعنین منقادین لحکمک.
و «لأولیائک» متعلّقٌ بـ «محبّین».
<و «مناصحین» أی: خالصین غیر غائبین. و الجملة عطفٌ على ثانی مفعولی «اجعل»؛
أی: و اجعلهم محبّین مناصحین لأولیائک. و إنّما فصّل بین العاطف و المعطوف لأنّ الفصل بالظرف کلافصلٍ؛ و قس علیه قوله – علیه السلام ـ «و لجمیع أعدائک معاندین». یقال: أبغضه أی: قلاه و ترکه. و فی نسخةٍ وقع «معادّین» بدلاً عن «معاندین».
و «آمین» بالقصر فی لغة الحجاز؛ و المدع اشباعٌ، بدلیل انّه لاتوجد فی العربیّة کلمةٌ على فاعیل. و معناه: أللّهمّ استجب دعائی>(24)، و لااعتبار بنسخة «قالین» بدلاً منه؛ و قد تقدّم الکلام علیه.
اللَّهُمَّ اشْدُدْ بِهِمْ عَضُدِی، وَ أَقِمْ بِهِمْ أَوَدِی، وَ کَثِّرْ بِهِمْ عَدَدِی، وَ زَیِّنْ بِهِمْ مَحْضَرِی، وَ أَحْیِ بِهِمْ ذِکْرِی، وَ اکْفِنِی بِهِمْ فِی غَیْبَتِی، وَ أَعِنِّی بِهِمْ عَلَى حَاجَتِی، وَ اجْعَلْهُمْ لِی مُحِبِّینَ، وَ عَلَیَّ حَدِبِینَ مُقْبِلِینَ مُسْتَقِیمِینَ لِی، مُطِیعِینَ غَیْرَ عَاصِینَ وَ لاَعَاقِّینَ وَ لاَمُخَالِفِینَ وَ لاَخَاطِئِینَ. وَ أَعِنِّی عَلَى تَرْبِیَتِهِمْ وَ تَأْدِیبِهِمْ، وَ بِرِّهِمْ، وَ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ مَعَهُمْ أَوْلاَداً ذُکُوراً، وَ اجْعَلْ ذَلِکَ خَیْراً لِی، وَ اجْعَلْهُمْ لِی عَوْناً عَلَى مَا سَأَلْتُکَ.
«الشدّ»: التقویة.
و «العضد»: ما بین المرفق إلى الکتف. و «شدّ العضد» عبارةٌ عن تقویته بسببهم.
و «الأَوَد» ـ بفتحتین ـ: العوج؛ یقال: أَوَد ـ کفرح ـ: أعوج. <و هو هنا مستعارٌ لاختلال الحال و خروجها عن حدّ الاستقامة، أی: و اصلح بهم اختلال حالی. و الظاهر انّ طلبه لذلک - علیه السلام ـ إنّما هو على تقدیر وقوعه، فکأنّه قال: إن وقع فی شیءٍ من أحوالی أوَدٌ و اعوجاجٌ فأقمه بهم؛ و قد علمت انّه لایلزم من صدق الشرطیّة صدق کلّ واحدٍ من جزءیها، فلایلزم من صدق کلامه - علیه السلام ـ وقوع الإعوجاج حتّى یحتاج
إلى إقامته بهم. و الروایة فی أکثر النسخ: «و أقم به أَوَدی» بإفراد الضمیر(25)، و هو باعتبار إرجاعه إلى «الشدّ» المفهوم من قوله: «اشدد» ـ نحو قوله تعالى: (اعْدِلُوا هُوَ أَقرَبُ)(26)
قیل: «أو إلى «العضد» و لو على وجه الاستخدام».
و «العدد»: الکمّیّة المتألّفة من الوحدات>(27)
و «زیّن بهم محضری» أی: اجعلهم مزیّنین لمحلّ حضوری و مجلسی. و هذا دعاءٌ لبرّهم و صلاحهم، لأنّ الخلف الصالح سببٌ لزینة محضر الوالدین.
و «أحیاه»: جعله حیّاً.
و المراد بـ «الذِکر» هنا: الصیت و الذکر الجمیل فی الناس، أی: اجعلنی بسببهم من المذکورین بعد وفاتی بالذکر الجمیل.
و «اکفنی بهم فی غیبتی» <أی: اجعلهم قائمین مقامی فی غیبتی.
و «أعانه» على أمرٍ: ساعده علیه.
و «حدِبین» ـ بکسر الدال ـ: مشفقین متعطّفین؛ یقال: حدِب علیه حدباً ـ من باب تعب ـ: تعطّف علیه، فهو حَدِبٌ ـ على وزن کتفٌ ـ.
و «الإقبال» هنا کنایةٌ عن الاعتناء و الإکرام، لأنّ من اعتنى بأحدٍ و أکرمه التفت إلیه و أقبل علیه بوجهه.
و «مستقیمین» أی: مستوین>(28) لامعوجین، و ذلک یحصل بملکة العدالة للأخلاق
الفاضلة.
و «غیر عاصین»: إمّا نعتٌ مؤکّدٌ لمعنى قوله: «مطیعین»، أو حالٌ مؤکّدةٌ من الضمیر فی «مطیعین».
و «لا» مزیدةٌ لتأکید ما أفادة «غیر» من معنى النفی، کأنّة قیل: مطیعین غیر عاصین فی کلّ ما أمرتهم و لاعاقّین فیما یجب علیهم من أداء حقوق الوالدین، و لامخالفین بأن یفعلوا خلاف مرضاتی؛
«و لاخاطئین» بأن یتعمّدوا الذنب فی ترک أداء حقوقی. فی الأساس: «أخطا فی المسألة و فی الرأی، و خطىء خطأً عظیماً: إذا تعمّد الذنب»(29)
و «هب لی من لدنک معهم» کلا الجارّین و الظرف متعلّقٌ بـ «هب»، فاللام صلةٌ له.
و «من» لابتداء الغایة مجازاً.
و «مع» لزمان الاجتماع. و یجوز أن یکون من متعلّقةً بمحذوفٍ هو حالٌ من المفعول ـ أی: کائنین من لدنک ـ، کما یجوز أن یکون الظرف من قولهم «معهم» کذلک ـ أی: حالکونهم معهم ـ.
و فی قوله: «من لدنک» تنبیهٌ على أن هذا المقصود لایکون و لایحصل إلّا من عنده ـ تعالى ـ.
و «الذَکَر» ـ بالتحریک ـ: خلاف الأنثى، و الجمع: ذکور و ذکران. و لایجوز جمعه بالواو و النون، لأنّ ذلک مختصٌّ بالعلم العاقل و الوصف الّذی یجمع مؤنّثه بالألف و التاء، و ما شذّ عن ذلک فمسموعٌ لایقاس علیه.
و «اجعل ذلک خیراً لی» فیه إشارةٌ على وجه التلویح إلى قوله ـ تعالى ـ: (أَ یَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَ بَنِینَ – نُسَارِعُ لَهُمْ فِی الْخَیرَاتِ بَلْ لاَیَشْعُرُونَ)(30)، أی: أ یحسبون انّ الّذی نمدّهم به من المال و البنین نسارع به لهم فیما فیه خیرهم؟، کلّا! لانفعل ذلک!، بل هم لایشعرون بانّ ذلک الإمداد استدراجٌ لهم و استجرارٌ لهم إلى زیادة الإثم، فهو شرٌّ لهم؛ فسأل – علیه السلام ـ أن تکون هبة ما سأله ـ من الأولاد ـ خیراً له حتّى لایکون داخلاً
فی مضمون هذه الآیة و نحوها؛ هکذا ذکره الفاضل الشارح(31)
أقول: فی هذا إشارةٌ إلى أنّ الذکر خیرٌ من الأنثى ـ کما قال تعالى: (وَ لَیسَ الذَّکَرُ کَالاُنثَى)(32) ـ، و ذلک لفاعلیّته و کونه علّةً لمثله. و لهذا روی: «إنّ البنین نعماء لابدّ بازائها الشکر و البنات نقماتٌ، و أبوالبنات مأجورٌ بهنّ!»(33)
قوله – علیه السلام ـ: «و اجعلهم لی عوناً على ما سألتک» أی: على النحو الّذی سألتک إیّاه فی الأولاد. و فی بعض النسخ: «عوناً لی على ما سألتک إیّاه فی الأولاد»؛ و فی بعض النسخ: «عوناً لی ما سألتک». فیجوز تعلّق «على» بقوله: «عوناً»، فیکون ما سأل – علیه السلام ـ سؤالاً تقدّم منه لاذکر له هنا؛ و یجوز أن یتعلّق بمحذوفٍ هو صفةٌ لقوله: «عوناً»، أی: کائناً على النحو الّذی سألتک فی الأولاد من کفایة أموری و شدّ عضدی و إقامة أَوَدی بهم،…إلى غیر ذلک بما سبق سؤاله.
وَ أَعِذْنِی وَ ذُرِّیَّتِی مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ، فَإِنَّکَ خَلَقْتَنَا وَ أَمَرْتَنَا وَ نَهَیْتَنَا وَ رَغَّبْتَنَا فِی ثَوَابِ مَا أَمَرْتَنَا وَ رَهَّبْتَنَا عِقَابَهُ، وَ جَعَلْتَ لَنَا عَدُوّاً یَکِیدُنَا، سَلَّطْتَهُ مِنَّا عَلَى مَا لَمْ تُسَلِّطْنَا عَلَیْهِ مِنْهُ، أَسْکَنْتَهُ صُدُورَنَا، وَ أَجْرَیْتَهُ مَجَارِیَ دِمَائِنَا، لاَیَغْفُلُ إِنْ غَفَلْنَا، وَ لاَیَنْسَى إِنْ نَسِینَا، یُوْمِنُنَا عِقَابَکَ، وَ یُخَوِّفُنَا بِغَیْرِکَ. إِنْ هَمَمْنَا بِفَاحِشَةٍ شَجَّعَنَا عَلَیْهَا، وَ إِنْ هَمَمْنَا بِعَمَلٍ صَالِحٍ ثَبَّطَنَا عَنْهُ، یَتَعَرَّضُ لَنَا بِالشَّهَوَاتِ، وَ یَنْصِبُ لَنَا بِالشُّبُهَاتِ، إِنْ وَعَدَنَا کَذَبَنَا، وَ إِنْ مَنَّانَا أَخْلَفَنَا، وَ إِلاَّ تَصْرِفْ عَنَّا کَیْدَهُ یُضِلَّنَا، وَ إِلاَّ تَقِنَا خَبَالَهُ یَسْتَزِلَّنَا. اللَّهُمَّ فَاقْهَرْ سُلْطَانَهُ عَنَّا بِسُلْطَانِکَ حَتَّى تَحْبِسَهُ عَنَّا بِکَثْرَةِ الدُّعَاءِ لَکَ فَنُصْبِحَ مِنْ کَیْدِهِ فِی الْمَعْصُومِینَ بِکَ.
<«اعذنی» أی: اجرنی. «و ذرّیّتی» عطفٌ على الضمیر.
و «الفاء» من قوله – علیه السلام ـ: «فإنّک» سببیّةٌ تدلّ على سببیّة مابعدها لما قبلها.
و عائد الموصول ـ من قوله: «ما أمرتنا» ـ محذوفٌ، أی: ما أمرتنا به، کقوله تعالى: (فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ)(34) أی: به ـ.
و الضمیر من «عقابه» عائدٌ إلى «ما أمرتنا» باعتبار ترکه کما انّ «الثواب» باعتبار فعله. و أعرض عن ذکر المنهیّ للاختصار، حیث انّ النهی داخلٌ فیه ـ لأنّه أمرنا بترکه ـ. و یجوز ارجاعه إلى ما دلّ علیه سیاق الکلام؛ أی: عقاب مانهیتنا عنه.
و «جعلت» إمّا بمعنى: خلقت، فیکون متعدّیاً إلى واحدٍ، و الجارّ و المجرور متعلّقٌ به، أو بمحذفٍ وقع حالاً ممّا بعده ـ لکونه نکرةً ـ ؛ و إمّا بمعنى: صیّرت، فیکون متعدّیاً إلى مفعولین أوّلهما «عدوّاً» و ثانیهما الظرف المتقدّم، قدّم على الأوّل مسارعةً إلى بیان العداوة. و هو متعلّقٌ بمحذوفٍ، أی: عدوّاً کائناً له ـ فانّ خبر صار فی الحقیقة هو الکون المقدّر العامل فی الظرف ـ.
و جملة «یکیدنا» فی محلّ نصبٍ صفةٌ لـ «عدوٍّ»>(35)
و «سلّطه» على الشیء تسلیطاً: مکّنه منه. و الجملة إمّا استینافٌ؛ و إمّا صفةٌ ثانیةٌ لـ «عدوٍّ». و لایمنعه عدم حرف العطف بین الجملتین، فانّ الصفة تتعدّد بغیر عاطفٍ و إن کانت جملةً ـ کما فی نحو: (الرَّحمَنُ – عَلَّمَ الْقُرآنَ – خَلَقَ الاِنسَانَ – عَلَّمَهُ الْبَیَانَ)(36) ـ، نصّ علیه صاحب المغنی(37) و المعنى: جعلت للشیطان سلطاناً علینا و لم تجعلنا مسلّطین علیه.
و قوله – علیه السلام ـ: «أسکنته صدورنا ـ… إلى آخره ـ»: جملةٌ مستأنفةٌ بیانیّةٌ لتسلّطه، کأنّه سئل: کیف سلّطته منکم على ما لم أسلّطکم علیه منه؟
فقال: أسکنته صدورنا. و یؤیّده تصدیره بـ «الواو» فی نسخة الکفعمیّ و فی بعض النسخ الصحیحة.
<قیل: «انّه تمثیلٌ لایصال وساوسه إلى القلوب برفقٍ، لا أنّه یخلص إلى الصدور بنفسه»(38)، و اختاره أمین الإسلام الطبرسیّ(39)>(40)
<و قیل: «المراد بـ «الصدور» هنا: القلوب تسمیةً للحال باسم محلّه مجازاً؛ کما روی عن النبیّ ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ: «إنّ الشیطان واضعٌ خطمه على قلب ابن آدم، فإذا ذکر اللّه خنس و إن نسی التقم قلبه»(41)؛
و عنه ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ: «إنّ الشیطان لیخطم على قلب ابن آدم، له خرطومٌ کخرطوم الکلب، إذا ذکر العبد اللّه ـ عزّ و جلّ ـ خنس ـ أی: رجع على عقبیه ـ، و إذا غقل عن ذکر اللّه ـ تعالى ـ وسوس»(42)؛ انتهى.
أقول: استشهاده بالحدیثین على کون المراد بـ «الصدور»: القلوب، فاسدٌ، لأنّ الخطم من کلّ طائرٍ منقاره و من کلّ دابّةٍ مقدّم أنفها و فمها.
و قیل: «إنّما قال ـ سبحانه ـ (الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ)(43) و لمیقل: «فی
قلوبهم»، لأنّ الشیطان لاتسلّط له على قلب المؤمن «الّذی هو بین اصبعین من أصابع الرحمن»(44)
قال المحقّقون: «لیس للشیطان على القلب سبیلٌ، و إنّما الشیطان یجیء إلى الصدر الّذی هو حصن القلب فیثبت فیه هموم الدنیا و الحرص على الزخارف، فیضیق القلب حینئذٍ و لایجد للطاعة لذّةً و لا للإیمان حلاوةً و لا على الإسلام طلاوةً، فاذا طرد العدوّ بذکر اللّه و الإعراض عمّا لایعنیه حصل الأمن و انشرح القلب و تیسّر له القیام بالعبودیّة».
و الحقّ انّه یجوز أن یراد بـ «الصدر»: محلّ القلب باعتبار کونه موضع تعلّق النفس الناطقة بالحیوانیّة، و لذا ینسب إلیه الشرح و الضیق. و یجوز أن یراد به القلب الّذی هو المضغة الصنوبریّة المودعة فی التجویف الأیسر من الصدر باعتبار انّه محلّ اللطیفة الربّانیّة النورانیّة العالمة الّتی هی مهبط الأنوار الإلهیّة، و بها یکون الإنسان إنساناً. فهی حقیقة الإنسان، و بها یستعدّ لامتثال الأحکام، و بها صلاح البدن و فساده. و یعبّر عنها بالنفس الناطقة تارةً ـ: (وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا)(45) ـ، و بالروح أخرى ـ (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی
((46)
و قد یعبّر عنها بالعقل باعتبار تجرّدها و نسبتها إلى عالم القدس، إذ هی بهذا الاعتبار تعقل نفسها و تحبسها عمّا یقتضیه تعلّقها بالبدن من الشرور و المفاسد المانعة لها من الرجوع إلى عالمها القدسیّ. و هی جوهرٌ مجرّدٌ عن المادّة فی ذاتها دون فعلها فی الأبدان بالتصرّف و التدبیر.
قال بعضهم: «إنّما عظّم الشارع أمر القلب لصدور الأفعال الإختیاریّة عنه و عمّا یقوم به من العلوم؛ و رتّب الأمر على المضغة و المراد بها العقل الّذی هو النفس الناطقة المتعلّقة بها،
فذلک من إطلاق اسم المحلّ على الحال»؛ انتهى. هکذا نقل الشارح الفاضل(47) عن المحقّقین.
أقول: إطلاق القلب على النفس الناطقة شائعٌ عند الحکماء و أرباب الحقیقة. و تسمیتها بالقلب لتقلّبها بین عالم العقول المجرّدة المحضة و عالم النفوس المادّیّة المنطبعة و تقلّبها فی وجوهها الخمسة ـ الّتی إلى العوالم الکلّیّة الخمسة ـ ؛ فان لکلّ قلبٍ وجوهاً خمسة:
وجهٌ إلى الحضرة الأحدیّة بلاواسطةٍ؛
و وجهٌ إلى الأرواح المقدّسة ـ و هی العقول المجرّدة ـ، و من هذا الوجه یأخذ من ربّه مایقتضیه استعداده بالواسطة؛
و وجهٌ یختصّ بعالم المثال و یتحظّی منه بمقدار نسبته من مقام الجمع و بحسب اعتدال مزاجه و اخلاقه و انتظام أحواله فی تصرّفاته و حضوره و معرفته؛
و وجهٌ یلی عالم الشهادة، و یختصّ بالاسم الظاهر و الآخر؛
و وجهٌ جامعٌ یختصّ بأحدیّة الجمع، و هی الّتی تلیها مرتبة الهویّة المعنویّة بالأوّلیّة و الظهور و البطون و الجمع بین هذه النعوت الأربعة.
و لکلّ وجهٍ مظهرٌ من الأناسی. و الّذی هو صورة قلب الجمع و الوجود نبیّنا ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ، فانّ مقامه نقطة وسط الدائرة الوجودیّة، فوجوه قلبه الخمسة تواجه کلّ عالمٍ و حضرةٍ و مرتبةٍ، و تضبط أحکام الجمع و تظهر بأوصافها کلّها بالوجه الجامع ـ المنبّه علیه آنفاً ـ. و کأنّه عن هذه الوجوه الخمسة عبّر بالأرواح الخمسة فی الحدیث الّذی رواه فی الکافی(48) عن أمیرالمؤمنین – علیه السلام ـ حیث قال – علیه السلام ـ: «انّ للأنبیاء ـ و هم السابقون ـ خمسة أرواح:
روح القدس؛
و روح الإیمان؛
و روح القوّة؛
و روح الشهوة؛
و روح البدن»؛
قال: «فبروح القدس بعثوا أنبیاء و بها علموا الأشیاء؛
و بروح الإیمان عبدوا اللّه و لم یشرکوا به شیئاً؛
و بروح القوّة جاهدوا عدوّهم و عالجوا معاشهم؛
و بروح الشهوة أصابوا لذیذ الطعام و نکحوا الحلال من شباب النساء؛
و بروح البدن دبّوا و درجوا».
ثمّ قال: «و للمؤمنین ـ و هم أصحاب الیمین الأربعة الأخیرة؛ و للکفّار ـ و هم أصحاب الشمال ـ الثلاثة الأخیرة، کما للدوابّ». و فی لفظ هذا معناه.
فظهر ممّا ذکر انّ النفس الناطقة ـ الّتی هی القلب ـ واسطةٌ بین المجرّدات المحضة و المادّیّات الصرفة؛ فبهذا الاعتبار لها وجهان:
وجهٌ إلى المجرّد؛ و وجهٌ إلى المادّیّ؛
فبالأوّل یتنوّر بنور الروح ـ و تسمّى بـ: القلب ـ، و هو الباعث للخیر و المطرق لالهام الملک؛
و بالثانی تظلم بظلمتها و تتّصف بصفاتها ـ و تسمّى بـ: الصدر ـ، و هو الباعث على الشرّ و المطرق لوسوسة الشیطان ـ کما قال خالق الإنس و الجانّ: (الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ)(43) ـ. فالصدر محلّ وسوسة الشیطان.
ثمّ انّه کما یتقلّب الحقّ ـ سبحانه ـ فی شؤونه کذلک القلب یتقلّب حسب تقلّبه فی
الخواطر و الصفات و الأحوال؛ و لذلک ـ أی: لتقلّب القلب فی الخواطر ـ قال ـ سبحانه ـ : (إِنَّ فِی ذَلِکَ) ـ أی: القرآن ـ (لَذِکْرَى لِمَنْ کَانَ لَهُ قَلْبٌ)(49) یتقلّب فی أنواع الصور و الصفات، ولم یقل: «العقل» لأنّ العقل یتقیّد بالاعتقادات الجزئیّة فیحصر الأمر الإلهیّ الّذی لاینحصر فیما یدرکه؛ بخلاف القلب، فانّه ـ لکونه مجلىً لتجلّیّاتٍ مختلفةٍ من الإلهیّة و الربوبیّة و تقلّبه فی صورها ـ یتذکّر ما نسیه ممّا کان یجده قبل ظهوره فی هذه النشأة العنصریّة و یجد ما أضاعه ـ کما قال علیه السلام: «الحکمة ضالّة المؤمن»(50) ـ ؛ فافهم!.
اعلم! أنّ بین القلب و القبول و القابلیّة مناسبةً معنویّةً و لفظیّةً؛ أمّا المعنویّة فلأنّ له قابلیّة قبول صور جمیع التجلّیّات؛ و أمّا اللفظیّة فلأنّه لولا قبلیّة بعض حروف القلب و القابل و قلبه لکان هو هو. و قلب الشیء لغةً: أن یجعل أوّله آخره أو ظاهره باطنه(51) جمعاً و فرادىً، و إذا قلبت لفظة القلب فانّ القبول و القابلیّة من تقالیبه.
قوله – علیه السلام ـ: «و أجریته مجاری دمائنا».
<«المجاری»: جمع مجرى. و هو إمّا مصدرٌ میمیٌّ ـ فیکون نصبها على المصدریة ـ؛ أو اسم مکانٍ ـ فیکون نصبها على الظرفیّة ـ. فانّه یجری مجاری دمائنا و له التصرّف فینا کیف یشاء!، و فی الحدیث من طرق العامّة: «إنّ الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم»(52)>(53)؛
و فی الکافی(54) عن أبی عبداللّه أو أبی جعفرٍ – علیهما السلام ـ قال: «إنّ آدم – علیه السلام ـ قال: یا ربّ! سلطّت علیّ الشیطان و أجریته منّی مجرى الدم!، فاجعل لی شیئاً، فقال: یا آدم! جعلت لک انّ من همّ من ولدک بسیّئةٍ لم تکتب علیه، فان عملها کتبت له سیّئةٌ؛ و من همّ منهم بحسنةٍ فان لم یعملها کتبت له حسنةٌ، فان هو عملها کتبت له عشراً!
قال: یا ربّ زدنی!
قال: جعلت لک انّ من عمل منهم سیّئةً ثمّ استغفر له غفرت له!
قال: یا ربّ زدنی!
قال: جعلت لهم التوبة و(55) بسطت لهم التوبة حتّى تبلغ النفس هذه!
قال: یا ربّ حسبی!».
قوله: «و لایغفل إن غفلنا و لاینسی إن نسینا».
«غفَل» یغفُل ـ من باب نصر ینصر ـ فهو غافلٌ. و الغفلة عبارةٌ عن عدم التفطّن للشیءـ سواءٌ بقیت صورته أو معناه فی الخیال أو الذکر بالکلّیّة أو لا، و لذلک یحتاج الناسی إلى تجشّم کسبٍ جدیدٍ و کلفةٍ فی تحصیله ثانیاً ـ. أی: إن غفلنا عن ذبّ الشیطان و دفعه عنّا لایغفل هو عن إظلالنا أصلا؛ و إن نسیناه لاینسانا هو. فالمفاعیل الأربعة محذوفةٌ، و الجزاء مقدّمٌ على الظرف فی الفقرتین الأخیرتین.
قوله – علیه السلام ـ: «یؤمننا عقابک» أی: یجعلنا مأمونین من عذابک.
«و یخوّفنابغیرک» و اللّه أحقّ بأن یخشى، <فمنهم من یخوّفه قهر الأوثان و غضبها فی ترک عبادتها و یأمرهم بالإخلاص فیها؛
و منهم من یخوّفه بأس الأعداء فیثبطه عن الجهاد فی سبیل اللّه؛
و منهم من یخوّفه الفقر فیمنعه من الصدقات و إیتاء الزکاة؛… إلى غیر ذلک.
قال بعضهم: «إن قیل: کیف یؤمننا و یخوّفننا و نحن لانشاهده و لانسمع کلامه؟!
قلنا: ذلک عبارةٌ عن وسوسةٍ بالأمان و الخوف ـ کما تقول: نفسی تخوّفنی بکذا ـ ؛ و هو ظاهرٌ.
قوله: «إن هممنا بفاحشةٍ شجّعنا علیها».
«هممت» بالشیء همّاً ـ من باب قتل ـ: إذا أردته و لم تفعله.
قیل: «الفاحشة: الذنب القبیح»؛
و قیل: «کلّ سوءٍ جاوز حدّه فهو فاحشٌ».
و «شجّعه» على الأمر تشجیعاً: جرّأه و أقدمه علیه. و أصله فی الحرب، یقال: شجُع – بالضمّ ـ شجاعةً: إذا قوى قلبه و استهان بالحروب جرأةً و إقداماً؛ أی: یشدّ قلبنا على تلک الفاحشة بأن یحسن قبحها و یزیّن سوءها فی أعیننا و یرغّبنا فیها .
و «ثبّطه» تثبیطاً: قعد به عن الأمر> ، أی: جعلنا مستبطئین متقاعدین.
و «یتعرّض» أی: یتصدّی لنا بالشهوات، أی: ما تشتهی إلیها أنفسنا، لأنّ الشهوة اشتیاق النفس إلى الملائم.
و «الباء» إمّا للصلة؛ أو للملابسة على حذف مضافٍ ـ أی: متلبّساً بتهییج الشهوات ـ ؛ أو للاستعانة ـ نحو: کتبت بالقلم ـ.
و «ینصب» من: نصبت الشیء ـ من باب ضرب ـ: إذا أقمته، فیکون «الباء» زائدةً؛ أی: یقیم «بالشبهات». و أمّا من: نصبت له رأیاً: إذا أشرت علیه به؛ فیکون «الباء» صلةً لـ «ینصب» بتضمینه معنى: یشیر ـ أی: یشیر علیها بالشبهات ـ ؛ أو <«الباء» للظرفیّة و مفعول «ینصب» محذوفٌ ـ أی: ینصب لنا حبائله فی میادین الشبهات ـ. و یجوز أن یضمن
ینصب معنى: یتحرّف>(40)؛ <و یحتمل أن یکون ینصب لازماً ـ من نصب له بمعنى: عاداه،
کما مرّ ـ، فیکون «الباء» للملابسة ـ أی: یعادینا متلبّساً بایقاع الشبهات ـ. و هی کلّ باطلٍ أخذه الوهم بصورة الحقّ و شبّهه به، و لذلک سمّی «شبهةً»>(56)
قوله: «إن وعدنا کذبنا» بتخفیف الذال المعجمة؛ أی: إن وعدنا وعدنا المواعید الکاذبة الباطلة – کالاتّکال على رحمة اللّه من غیر سابقة إحسانٍ، و تأخیر التوبة بطول الأمل، و الاعتماد بشفاعة الشافعین من غیر عملٍ، إلى غیر ذلک ـ ؛ و فیه إشارةٌ إلى قوله ـ تعالى ـ : (وَ شَارِکْهُمْ فِی الاَْموَالِ وَ الاَْولاَدِ وَ عِدْهُمْ وَ مَا یَعِدُهُمُ الشَّیطَانُ إِلاَّ غُرُوراً)(57)
و «إن منّانا» أی: زیّن لنا الأمانی و الآمال؛ یقال: تمنّیت الشیء و منیت غیری إیّاه: إذا جعلته یرجوه و یتمنّاه، أی: إن وعدنا على الأمانیّ «أخلفنا» ـ أی: لم ینجز لنا و عمل على خلاف أمنیّتنا ـ.
قوله – علیه السلام ـ: «و إلّا تصرف عنّا کیده» شرطٌ، لأنّ أصله: إن لا. قال فی المغنی: «قد تقترن «إن» الشرطیّة بـ «لا» النافیّة فیظنّ من لامعرفة له انّها «إلّا» الاستثنائیّة ـ نحو: (وَ إِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّی کَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیْهِنَّ)(58) ـ. و لقد(59) بلغنی انّ بعض من یدّعی الفضل سأل فی (إِلاَّ تَفعَلُوهُ)(60)؟ فقال: ما هذا الاستثناء؟ أ متّصلٌ هو أم منقطعٌ؟»(61)؛ انتهى. أی: و إن لم تصرف عنّا کیده.
«یضلَّنا» ـ بفتح اللام على الروایة المشهورة ـ: جوابٌ للشرط. و أصله: یضللنا ـ بالجزم ـ، فأدغمت اللام الأولى فی الثانیة ـ کراهة اجتماع المثلین ـ و حرّکت الثانیة ـ لالتقاء الساکنین ـ ففتحت ـ لأنّه أخفّ الحرکات ـ مع ثقل التضعیف. و فی بعض النسخ: «یضلُّنا» ـ
بضمّ اللام المشدّدة ـ، و هو خلاف الظاهر.
و کلّ ما قلنا فی: «و إلّا تصرف ـ… إلى آخره ـ» جارٍ فی قوله – علیه السلام ـ: «و إلّا تقنا خباله یستزلّنا»، أی: و إن لم تقنا فساده أو عناده یوقعنا فی الزلّة و العثرة.
قال الفاضل الشارح: «و ثبت فی بعض النسخ «یضلُّنا» و «یستزلُّنا» ـ بضمّ اللام المشدّدة ـ، و هو کقوله ـ تعالى ـ: (وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا لاَیَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئاً)(62) ـ بضمّ الراء المشدّدة فی القراءة المشهورة(63) ـ.
و اختلفوا فی تخریجه؛ فقیل: «هو على حذف الفاء، أی: فلایضرّکم»(64)؛
و قیل: «على حذف الجواب، و جعل الفعل المرفوع دلیلاً علیه منویّاً تقدیمه على الشرط؛ و التقدیر: لایضرّکم کیدهم إن تصبروا»(65)
و ردّ المحقّقون کلا القولین بأنّ حذف الفاء مختصٌّ بالشعر، و الجواب لایحذف فی السعة إلّا إذا کان فعل الشرط ماضیاً، و أمّا إذا کان مضارعاً فحذفه ضرورةً لایجوز إلّا فی الشعر. و تخریج القراءة المتواترة على شیءٍ لایجوز إلّا فی الشعر غیر صوابٍ.
و قال بعضهم: «هو مجزومٌ و الضمّة اتّباعٌ ـ کالضمّة فی قولک: «لم یسدْ و لم یردْ»، و استصوبه ابن هشامٍ؛
و قال قومٌ: «انّه مجزومٌ، لکنّه لما اضطرّ إلى تحریکه حرّک بحرکته الإعرابیّة المستحقّ لها فی الأصل».
إذا عرفت ذلک فتخریج الروایة المذکورة فی عبارة الدعاء على الوجهین الأوّلین غیر صوابٍ، لأنّه – علیه السلام ـ أفصح الخلق فی زمانه و تخریج کلامه على شیءٍ مختصٍّ بالضرورة لاوجه له.
و أمّا الوجه الثالث فلایتمشّی هنا، فتعیّن حملها على الوجه الرابع.
و وقع فی بعض التعالیق على الصحیفة الشریفة انّ الجواب محذوفٌ، و قوله: «یضلّنا» و «یستزلّنا» جملتان مفسّرتان له، و الحذف لیذهب الوهم کلّ مذهبٍ؛ و التقدیر: و إن لاتصرف عنّا کیده تصبنا داهیةٌ کبیرةٌ ـ و هو انّه یضلّنا على کلّ حالٍ و لانجد عنه محیصاً ـ. قال: «و هذه القاعدة ـ أعنی: حذف الجواب ـ لدلالة الکلام علیه طریقةٌ مسلوکةٌ للبلاغة، و فی التنزیل الکریم منها: (وَ لَولاَ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَ نِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ)(66)… الآیة ؛ و منها:
(فَلَولاَ إِنْ کُنتُمْ غَیرَ مَدِینِینَ – تَرجِعُونَهَا اِنْ کُنتُمْ صَادِقِینَ)(67) ـ»؛ انتهى.
و هو کلامٌ عجیبٌ یدلّ على قصور قائله فی علم العربیّة جدّاً!؛ أمّا أوّلاً فدعوى الحذف فی مثل ذلک مردودةٌ بنصّ سیبویه و غیره من أئمّة العربیّة من انّه لایحذف جواب الشرط الجازم إلّا و فعل الشرط ماضٍ ـ کما تقدّم ـ، فکیف یجعل ذلک داخلاً فی قاعدة حذف الجواب الّتی هی طریقةٌ مسلوکةٌ للبلاغة؟!
و أمّا ثانیاً: فانّ هذا التقدیر الّذی قدّره جواباً لایدلّ علیه دلیلٌ و لاقرینة، إذ لایستدعیه الکلام؛ بل الجواب هو قوله: «یضلّنا و یستزلّنا» قطعاً لتوقّف مضمونها على حصول الشرط. و من ارتکب دعوى الحذف فانّما ارتکبها من حیث الصناعة النحویّة لیعطی القواعد حقّها و إن لم یکن المعنى متوقّفاً علیه؛ و قد علمت ما فیه؛
و أمّا ثالثاً: فقد صرّحوا بأنّ شرط الدلیل اللفظیّ أن یکون طبق المحذوف لفظاً و معنىً ـ نحو: زیداً أضربه ـ، أو معنىً إن تعذّر اللفظ ـ نحو: زیداً مررت به، أی: جاوزت ـ، و ماقدّره من الجواب أعمّ ممّا زعم انّه دلیلٌ لفظیٌّ علیه، فیکف یکون مدلولاً له؟. و اللّه یقول الحقّ و
هو یهدی السبیل»(68)؛ انتهى کلام الشارح الفاضل.
أقول: مراده من بعض التعالیق هو تعلیق السیّد السند الداماد(69) ـرحمه اللّه ـ، و ما أورده علیه بعضها واردٌ.
قوله – علیه السلام ـ: «أللّهمّ فاقهر سلطانه عنّا بسلطانک» أی: اکسر غلبته و شوکته عنّا بسلطانک و غلبتک على کلّ شیءٍ. تصدیر هذه الجملة بالنداء للمبالغة فی التضرّع و الابتهال.
قوله – علیه السلام ـ: «حتّى تحبسه عنّا بکثرة الدعاء».
«الباء» للاستعانة؛ أو السببیّة، أی: بسبب کثرة الدعاء و التضرّع إلیک فی دفع کیده و شرّه بجعله محبوساً مدفوعاً ممنوعاً عنّا.
<قوله - علیه السلام ـ: «فنصبحَ» بالنون منصوبٌ معطوفٌ على قوله: «تحبسه».
و «فاؤه» للتعقیب و السببیّة، لأنّ السبب التامّ یستعقب مسبّبه من غیر تراخٍ. و «نصبح» بمعنى: نصیر ذا صباحٍ.
و قوله – علیه السلام ـ: «فی المعصومین بک» أی: کائنین فی جملة المحفوظین بسببک؛ أو: باستعانتک؛ أو: حال کوننا فی جملة الّذین حفظتهم؛ أو: مندرجین فی سلک أرباب العصمة. و هی ـ کما قاله الحکماء ـ: ملکةٌ تمنع الفجور و المعصیة>(70)؛
و قیل: «هی ملکة اجتناب المعاصی مع التمکّن منها»؛
و قیل: «هی فیضٌ إلهیٌّ یقوی به العبد على تحرّی الخیر و تجنّب الشرّ».
اللَّهُمَّ أَعْطِنِی کُلَّ سُوْلِی، وَ اقْضِ لِی حَوَائِجِی، وَ لاَتَمْنَعْنِی الاْجَابَةَ وَ قَدْ ضَمِنْتَهَا لِی، وَ لاَتَحْجُبْ دُعَائِی عَنْکَ وَ قَدْ أَمَرْتَنِی بِهِ، وَ امْنُنْ عَلَیَّ بِکُلِّ
مَا یُصْلِحُنِی فِی دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی مَا ذَکَرْتُ مِنْهُ وَ مَا نَسِیتُ، أَوْ أَظْهَرْتُ أَوْ أَخْفَیْتُ أَوْ أَعْلَنْتُ أَوْ أَسْرَرْتُ. وَ اجْعَلْنِی فِی جَمِیعِ ذَلِکَ مِنَ الْمُصْلِحِینَ بِسُوَالِی إِیَّاکَ، الْمُنْجِحِینَ بِالطَّلَبِ إِلَیْکَ غَیْرِ الْمَمْنُوعِینَ بِالتَّوَکُّلِ عَلَیْکَ. الْمُعَوَّدِینَ بِالتَّعَوُّذِ بِکَ، الرَّابِحِینَ فِی التِّجَارَةِ عَلَیْکَ، الْمجَارِینَ بِعِزِّکَ، الْمُوسَعِ عَلَیْهِمُ الرِّزْقُ الْحَلاَلُ مِنْ فَضْلِکَ، الْوَاسِعِ بِجُودِکَ وَ کَرَمِکَ، الْمُعَزِّینَ مِنَ الذُّلِّ بِکَ، وَ الْمُجَارِینَ مِنَ الظُّلْمِ بِعَدْلِکَ، وَ الْمُعَافَیْنَ مِنَ الْبَلاَءِ بِرَحْمَتِکَ، وَ الْمُغْنَیْنَ مِنَ الْفَقْرِ بِغِنَاکَ، وَ الْمَعْصُومِینَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ الزَّلَلِ وَ الْخَطَاءِ بِتَقْوَاکَ، وَ الْمُوَفَّقِینَ لِلْخَیْرِ وَ الرُّشْدِ وَ الصَّوَابِ بِطَاعَتِکَ، وَ الُمحَالِ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الذُّنُوبِ بِقُدْرَتِکَ، التَّارِکِینَ لِکُلِّ مَعْصِیَتِکَ، السَّاکِنِینَ فِی جِوَارِکَ.
«سؤلی» أی: مسؤولی؛ قال الزمخشریّ فی الأساس: «أصبیت منه سؤلی: طلبتی، فُعلٌ بمعنى مفعولٍ، کعُرف و نُکر»(71)؛ انتهى.
و «اقض لی» أی: انجز لی.
«حوائجی» بالهمز ـ کما هو الأصل ـ ؛ و الیاء نسخةٌ. و فیه شاهدٌ على جمع «حاجة» على «حوائج»، خلافاً لمن أنکر ذلک.
و «قد ضمنتها» أی: کفّلت الإجابة لی ـ کما فی قوله تعالى: (أُدْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ)(72)-(73) ـ، و وعدک واجب الوفاء کالضمان.
و «حجَبَه» حجْباً ـ من باب قتل ـ: منعه من الدخول. و «حجب الدعاء» عنه تمثیلٌ لعدم قبوله.
و «قد أمرتنی به» أی: بالدعاء بقولک: (أدْعُونِی…).
و «الواو» من قوله: «و قد» فی الموضعین للحال.
و لمّا سئل – علیه السلام ـ ما سأل استشعر بأنّ حوائج العبد کثیرةٌ لایحصیها البیان، فاستدرک بقوله: «و امنن علیّ ـ… إلى آخره ـ»، فسأل – علیه السلام ـ منه ـ تعالى ـ کلّ ما یعلم انّه یصلحه فی دنیاه و آخرته ـ سواءٌ ذکره فی دعائه أو نسیه، أظهره أو أخفاه، أعلنه أو أسرّه ـ.
<و «أو» فی کلّ ذلک للتنویع. و لایکاد اللغویّ یفرّق بین «الإظهار» و «الإعلان» و «الإخفاء» و «الاسرار»؛ إلّا انّ قول المفسّرین فی قوله ـ تعالى ـ: (یَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفَى)(74) :
أی: ما أسررته إلى غیرک و شیئاً أخفى من ذلک، و هو ما اخترته ببالک من غیر أن تتفوّه به أصلا؛
یرشد إلى الفرق>(75)، فلایبعد أن یکون قوله – علیه السلام ـ: «أو أظهرت أو
أخفیت»ـ أی: ما أظهرته على لسانی و تفوّهت به، أو ما أخفیته مخطراً له ببالک من غیر أن تفوّه به أصلا؛ أو ما أعلنته و ذکرته للناس علانیّةً أو أسررته إلى غیرى فی خفاءٍ ـ موافقاً لما ذکره المفسّرون.
و قیل: «سواءٌ کان هذا فی ذکرٍ منّی أو نسیت، و سواءٌ کان أظهرته أو أخفیته، هذا فی أعمال الجوارح؛ و سواءٌ کان أعلنته أو أسررته، هذا فی أعمال القلب. و إعلانها عبارةٌ عن القول بها ظاهراً. مثلاً الإعتقاد بالواحدانیّة من غیر أن نتکلّم به هو السرّ، و مع التکلّم به فی مثل قول: «لا إله إلّا اللّه» هو الإعلان».
قوله: «و اجعلنی فی جمیع ذلک من المصلحین بسؤالی إیّاک».
الجارّ و المجرور إمّا متعلّقٌ بمحذوفٍ هو حالٌ من مفعول «اجعلنی» ـ و التقدیر: و اجعلنی کائناً فی جمیع ذلک من المصلحین ـ ؛ و إمّا متعلّقٌ بـ «مصلحین» ـ و التقدیر: و اجعلنی من المصلحین فی جمیع ذلک ـ. و التقدیم للاعتناء بالمقدّم ـ کما مرّ مراراًـ.
و «ذلک» إشارةٌ إلى المذکور من المسؤولات. و استعمال «ذلک» مع قرب العهد بالمشار إلیه للإیذان بعلوّ شأنه و فضله.
و «من المصلحین» فی محلّ النصب على أنّه المفعول الثانی لـ «اجعلنی».
و قوله: «بسؤالی» متعلّقٌ بقوله: «و اجعلنلی» لا بـ «المصلحین»، إلّا أن یقال: التقدیر: اجعلنی کأحدهم مصلحاً بسؤالی إیّاک أن یکون نیّتی و مطلوبی من سؤالی إیّاک الاصلاح.
و «الباء» للسببیّة؛ أو للالة.
<و «المنجحین»: جمع منجح، اسم فاعلٍ من انجح الرجل: إذا أصاب طلبته و قضیت له حاجته؛ و فی القاموس: «النَجاح ـ بالفتح ـ و النُجح ـ بالضمّ ـ: الظفر بالشیء»(76)>(75) <و قد ضمّن معنى «الاشتیاق» و نحوه فعدّی بـ «إلى»>(40)؛ أی: الّذین ظفروا لحاجتهم بالطلب إلیک ـ أی: بسبب طلبهم حاجتهم منک ـ مفوّضاً قضاؤها إلیک. و یمکن أن یکون قوله: «بالطلب» متعلّقاً بقوله: «و اجعلنی»، على مثال قوله: «بسؤالی».
قوله: «غیر الممنوعین بالتوکّل علیک».
«غیرِ» ـ بکسر الراءـ: صفةٌ للـ «مصلحین» و «المنجحین»، و إنّما وقعت صفةً لمعرفةٍ ـ و الأصل فیها أن تکون صفةً لنکرةٍ ـ لأحد الوجهین:
جعل الموصوف مجرى النکرة، لأنّ المراد بـ «المصلحین» و «المنجحین» طائفةٌ لا بأعیانهم، فیکون بمعنى النکرة ـ إذ اللام فیه للجنس و المعرّف الجنسیّ فی المعنى کالنکرة و إن کان فی اللفظ کالمعرفة ـ، و ذلک انّ المقصود به الحقیقة من حیث الوجود فی ضمن الأفراد، و تدلّ القرینة على أنّ المراد به البعض ـ نحو: ادخل السوق و اشتر اللحم ـ، فیصیر فی المعنى کالنکرة، فیجوز حینئذٍ أن یعامل معاملة النکرة فیوصف بالنکرة؛ أو جعل الصفة مجرى المعرفة، لأنّ کلمة «غیر» إذا اضیفت إلى شیءٍ له ضدٌّ واحدٌ یصیر
معرفةً ـ کما فی (غَیْرِ الْمَغضُوبِ عَلَیهِمْ)، حیث جعل صفةً للّذین (انْعَمتَ عَلَیهِمْ)(77)،
لکون «غیر» مضافاً إلى ما له ضدٌّ واحدٌ، فانّ للمغضوب علیه ضدّاً واحداً هو المنعم علیه. فیکون متعیّناً معروفاً عندک تعریف الحرکة بغیر السکون، فاذا قلت: علیک بالحرکة غیر السکون وصفت المعرفة بالمعرفة، بل وصفت الشیء بنفسه، لأنّها عینه، فکأنّک کرّرت الحرکة تأکیداً ـ.
و یحتمل أن یکون «غیر الممنوعین» بدلاً من «المصلحین» و «المنجحین»، لا نعتاً له.
و فی نسخة ابن ادریس: «غیرَ» ـ بالنصب(78) ـ، فهو إمّا على الحال؛ أو على القطع بتقدیر: أعنی.
و «الباء» من قوله: «بالتوکّل» للسببیّة، أی: المصلحین و المفلحین الّذین هم غیر الممنوعین عن وصول رحمتک الشاملة الّتی وسعت کلّ شیءٍ، أو عن أمنیّاتهم و مبتغیاتهم بسبب التوکّل على جنابک؛ <أو بمعنى: «من» ـ على ما نصّ علیه الجوهریّ(79) و غیره(80)، و منه قوله سبحانه: (یَشرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ)(81) ـ، أو بمعنى: «فی»>(82)
و «المعوّدین» بالدال المهملة على النسخ المشهورة، و هو اسم مفعولٍ من عوّدته کذا أی: صیّرته له عادةً؛ و فی نسخة الشهید ـ رحمه اللّه ـ بالذال المعجمة(83)، من عوّذة: إذا عصمه من کلّ سوءٍ. و «الباء» على الروایة المشهورة للتعدیّة، و على الروایة الثانیة للملابسة و الاستعانة، أی: المتعاذین و المعصومین بالتعوّذ بک ـ أی: بالعصمة إلیک ـ، و هذا مؤیّدٌ
للنسخة الثانیة.
«الرابحین فی التجارة علیک».
«ربح» فلانٌ فی تجارته رِبْحاً و رَبَحاً ـ من باب علم و تعب ـ: أصاب الربح، و هو الفضل و الزیادة على رأس المال.
و «التجارة»: صناعة التاجر، و هی التصدّی للبیع و الشراء لتحصیل الربح؛ و قد یراد بها ما یتأجّر فیه من الأمتعة و نحوها ـ على تسمیة المفعول باسم المصدر ـ.
و «علیک»: ظرفٌ لغو متعلّقٌ بـ «الرابحین»، شبّه الثواب من اللّه بالطاعة منه بالربح على شخصٍ فی التجارة.
و قال بعضهم: «استعار لفظ التجارة لأعمالهم الصالحة، و وجه الشبه کونهم متعوّضین بمتاع الدنیا و بحرکاتهم فی العبادة متاع الآخرة. و رشّح بلفظ «الرابحین» لأفضلیّة متاع الآخرة»(84)؛
و قال الفاضل الشارح: «هذا استعارةٌ تمثیلیّةٌ»(85)؛
و لایخفى تمحّله!.
و «على» فی «علیک» إمّا بمعنى: إلى؛ أو بمعنى: من، أی: الرابحین منک. و یجوز أن یکون الظرف حالاً ـ أی: حالکونهم واردین علیک ـ، و یجوز أن یضمن التجارة معنى التذلّل و نحوه.
قوله – علیه السلام ـ: «و المجارین بعزّک» على صیغة جمع المفعول بکسر الراء المهملة،
من أجاره فهذا مجارٌ: إذا أدخله فی جواره و أمانه. أی: المأمومین الداخلین فی جوارک و أمانک. و یروى بفتحها، من: جاراه مجاراةً فهذا مجارٌ و ذلک مجاریٌ: إذا جرى معه و ماشاه مماشاةً عنایةً و اهتماماً برفقه.
و قیل: «بکسر الراء المهملة اسم فاعلٍ، أی: الّذین آووا إلى جوار عزّک و جلالک».
و «الموسع» یروى بتشدید السین و تخفیفها، و کلاهما بمعنىً؛ یقال: أوسع اللّه علیه رزقه و وسّعه ـ بالألف و التشدید ـ أی: بسطه و کثّره. و هو فی اللغة: ماینتفع به(86)، فیشمل الحلال و الحرام، و لذلک قیّده بـ «الحلال». و قیل: «الموسع على وزن الموجب: اسم فاعلٍ، و على وزن المفرح: اسم مفعولٍ من باب التفعیل».
و «الرزق» قد تقدّم الکلام علیه مستوفاً.
و «من» فی قوله – علیه السلام ـ: «من فضلک» لابتداء الغایة مجازاً؛ فالظرف إمّا لغوٌ متعلّقٌ بـ «موسع»، أو مستقرٌّ متعلّقٌ بمحذوفٍ وقع حالاً من «الرزق الحلال».
و قوله – علیه السلام ـ: «المُعَزّین من الذلّ بک» ـ بصیغة اسم المفعول، من باب الإفعال ـ من: أعزّه اعزازاً: أکرمه.
<و «من» بمعنى: عن، لما فی الإعزاز من معنى التنزیه عمّا ینافیه، و یحتمل أن تکون للبدل، أی: بدل الذلّ.
و «الباء» فی «بک» للاستعانة، أو السببیّة.
و «المجارِین من الظلم بعدلک» بکسر الراء المهملة، جمع مجار ـ اسم مفعولٍ ـ ؛ أی: الّذین أمنتهم من ظلم الظالمین.
و فی نسخة ابن ادریس: المجازین ـ بفتح الزاء المعجمة، جمع: مجازی، اسم مفعولٍ من جازاه مجازاةً بمعنى: کافأه ـ. عن الشهید ـ رحمه اللّه ـ: «المجازین بالمعجمة على صیغتی المفعول و الفاعل معاً، أی: الّذین یجازیهم على ما أصابهم من الظلم و ینتصف لهم من ظالمیهم عدلک؛ أو: الّذین لایجازون من اعتدى علیهم و ظلمهم إلّا بعدلک»(87)؛ انتهى.
و فی هذا المعنى قول أمیرالمؤمنین – علیه السلام ـ فی صفة المؤمن: «إن بغی علیه صبر
حتّى یکون اللّه الّذی ینتصر له»(88)، أی: إن أُظلم لم ینتقم هو لنفسه من ظالمه، بل یکلّ أمره إلى عدل اللّه ـ سبحانه ـ لینتصر له(89) منه>.
و «المعافَین من البلاء برحمتک»: بفتح الفاء ـ کالمصطفَین ـ، و أصله: معافیین، و هو اسم مفعولٍ من باب المفاعلة؛ أی: مخلصین محفوظین من البلاء بسبب رحمتک؛ أو: حال کونهم متلبّسین بها.
و «المغنَین من الفقر بغناک» اسم مفعولٍ من باب الإفعال.
و «المعصومین» أی: المحفوظین.
و «بتقواک» من: التقوى، أو من: الوقایة.
<و «الرَشَد» ـ بالضمّ و السکون، و بفتحتین ـ: الرشاد و الهدى و الاستقامة. و قال الواحدیّ: «الرشد: اصابة الخیر، و هو نقیض الغیّ»(90)؛ و قال الراغب: «الرشد: عنایةٌ إلهیّةٌ تعین الإنسان عند توجّهه فی أموره فتقوّیه على ما فیه صلاحه و تفتّره عمّا فیه فساده. و أکثر مایکون ذلک من الباطن، نحو قوله ـ تعالى ـ : (وَ لَقَدْ آتَیْنَا إِبرَاهِیمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَ کُنَّا بِهِ عَالِمِینَ)(91) و کثیراً مّا یکون ذلک بتقویة العزم أو بفسخه»(92)>(93)
و «الُمحال» ـ بضمّ المیم ـ: اسم مفعولٍ من حال یحول؛ و منه قوله ـ تعالى ـ: (وَ حِیلَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ مَایَشْتَهُونَ)(94) و فی نسخة ابن ادریس: «المحول» ـ على وزن مقول ـ. و هو
الموافق للمشهور الّذی علیه التنزیل، قال ـ سبحانه ـ: (وَ آعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرءِ وَ قَلْبِهِ)(95) أی: الّذین حیل بینهم و بین الذنوب بقدرتک. و أمّا أحال فلم ینصّ علیه أحدٌ من أهل اللغة، إلّا انّ الروایة المشهورة وردت هنا بلفظ: «المحال بینهم»، و لامعنى له إلّا أن یکون بمعنى المحول.
قوله – علیه السلام ـ: «التارکین لکلّ معصیتک»، قال الشهاب الفیّومی فی المصباح: «ترکت المنزل ترکاً: رحلت عنه؛ و ترکت الرجل: فارقته. ثمّ استعیر للاسقاط فی المعانی، فقیل: ترک حقّه: إذا أسقطه؛ و ترک رکعةً من الصلاة: لمیأت بها، فانّه اسقاطٌ لما ثبت شرعاً؛ و ترکت البحر ساکناً: لم أغیّره عن حاله»(96)؛ انتهى.
و قیل: «الترک: الکفّ عن الفعل المبتدء فی محلّ القدرة علیه»، فقوله – علیه السلام ـ : «التارکین لکلّ معصیتک» لایجوز أن یکون بمعنى: الکافّین عنها بعد ارتکابها و المفارقین لها بعد مواصلتها ـ کما یقتضیه معنى الترک ـ، إذ لایتصوّر ارتکاب أحدٍ کلّ معصیةٍ، بل معناه غیر الفاعلین لشیءٍ من المعاصی. و هذا المعنى للترک شائعٌ فی الاستعمال أیضاً.
فان قلت: قد تقرّر فی علم البیان انّ «کلّاً» إذا وقعت فی حیّز النفی موجّهاً إلى الشمول خاصّةً أفاد بمفهومه الثبوت لبعض الأفراد ـ کقولک: لم آخذ کلّ الدراهم ـ، فیلزم على هذا أن یکون معنى «التارکین لکلّ معصیتک»: التارکین لمجموعها مع ارتکابهم لبعض أفرادها، کما انّ قولک: لمآخذ کلّ الدراهم یفید ثبوت الأخذ لبعضها. و هذا المعنى غیر مرادٍ هنا قطعاً!، بل المراد ترک کلّ فردٍ من المعصیة؛
قلت: الحقّ انّ هذا الحکم أکثریٌّ لا کلّیٌّ، کما نصّ علیه التفتازانیّ فی شرح التلخیص، قال: «لأنّا نجده حیث لایصلح أن یتعلّق الفعل ببعضٍ ـ کقوله تعالى: (وَ اللَّهُ لاَیُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ)(97)، (وَ اللَّهُ لاَیُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِیمٍ)(98)، (وَ لاَتُطِعْ کُلَّ حَلاَّفٍ مَهِینٍ)(99) ـ»(100)
و أجاب بعضهم بأنّ دلالة المفهوم انّما یعوّل علیها عند عدم المعارض، و هو هنا موجودٌـ إذ دلّ الدلیل على تحریم الاختیال والفخر و الکفر و الحلف – ؛ و هذا الجواب صالحٌ هنا أیضاً، إذ الدلیل أوجب ترک کلّ فردٍ من المعصیة، فلایعوّل على دلالة المفهوم؛ هکذا ذکره الفاضل الشارح(101)
قوله – علیه السلام ـ: «الساکنین فی جوارک».
«سکن» فی الدار سکناً: حلّ بها، و الاسم: السکن.
<و «جاوره» مجاورةً و جواراً ـ من باب قاتل ـ و الاسم: الجُوار ـ بالفتح و الضمّ ـ، و قال الفارابیّ فی دیوان الأدب فی باب فِعال ـ بالکسر ـ: «هو الجِوار لغةٌ فی الجُوار، و الکسر أفصح»(102)؛ و فی باب فَعال ـ بالفتح ـ: «هو الجَوار»(103) و بالحرکات الثلاث وردت الروایة فی الدعاء>(104) قال الفاضل الشارح: «و السکن فی جوار اللّه ـ تعالى ـ تمثیلٌ للسلامة من کلّ آفةٍ و نیل الکرامة بکلّ خیرٍ، مثّل صورة من وقاه اللّه ـ سبحانه ـ و سلّمه من کلّ مخوفٍ و شمله بفضله و عنایته بصورة من سکن فی جوار ملکٍ عظیمٍ و سیّدٍ کریمٍ، فهو یقیه و یحفظه من کلّ سوءٍ و شرٍّ رعایةً لسکناه فی جواره، و یغشاه بکلّ خیرٍ و برٍّ و کرامةٍ لحلوله فی کنفه»(5)؛ انتهى.
أقول: «قد سبق انّ من أعظم الذنوب و المعصیة ذنب الوجود ـ کما قیل:
وُجُودُکَ ذَنبٌ لاَیُقَاسُ بِهِ ذَنبُ(105)
فالمراد بقوله – علیه السلام ـ: «التارکین لکلّ معصیتک»: هم التارکین الفانین من الوجود الباقین ببقاء مفیض الخیر و الجود.
و هو المقصود من قوله – علیه السلام ـ: «الساکنین فی جوارک»، لأنّ بحسب ترک الکثرة و الغیریّة تحصل القرب من الحضرة الأحدیّة، فمن فنى عن نفسه حصل له الصلاحیّة للسکنى فی جواره ـ کما لایخفى على من له بصیرةٌ فی معرفة ربّه ـ.
اللَّهُمَّ أَعْطِنَا جَمِیعَ ذَلِکَ بِتَوْفِیقِکَ وَ رَحْمَتِکَ، وَ أَعِذْنَا مِنْ عَذَابِ السَّعِیرِ، وَ أَعْطِ جَمِیعَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُوْمِنِینَ وَ الْمُوْمِنَاتِ مِثْلَ الَّذِی سَأَلْتُکَ لِنَفْسِی وَ لِوَلَدِی فِی عَاجِلِ الدُّنْیَا وَ آجِلِ الاْخِرَةِ، إِنَّکَ قَرِیبٌ مُجِیبٌ سَمِیعٌ عَلِیمٌ عَفُوٌّ غَفُورٌ رَؤُوفٌ رَحِیمٌ. وَ آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً، وَ فِی الاْخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.
قال الفاضل الشارح: «جمع بین «التوفیق» و «الرحمة»، لأنّ بعض المسؤول المشارإلیه بذلک متسبّبٌ عن التوفیق، و بعضه عن محض الرحمة – کما هو الظاهر ـ»(106)؛ انتهى.
أقول: هذا فاسدٌ!، لأنّه لافرق فی مرتبة الفیض المقدّس بین التوفیق و الرحمة، و قد سبق انّ جمیع الکمالات و النعم فائضٌ على الممکنات بلطفه و انعامه و رحمته، لأنّ ذوات الممکنات و وجود الکمالات و التمکّن من الانتفاع بها و القوى و الآلآت الّتی بها یحصل الانتفاع کلّها فائضةٌ من جوده و رحمته.
و کما عرفت سابقاً انّ الصراطات کثیرةٌ ـ و مع کثرتها یرجع إلى صراطین:
صراط الوجود؛
و صراط الإیمان و التوحید؛
و صراط الوجود یعمّ کلّ موجودٍ حتّى الکافر، و صراط الإیمان یختصّ بأهل التوحید ـ کذلک الرحمات کثیرةٌ و مع کثرتها یرجع إلى رحمتین:
رحمة عامّة تعمّ کلّ موجودٍ ـ حتّى الغضب و الکافر ـ ؛
و رحمة خاصّة بأهل التوحید. بل الصراط و الرحمة و الوجود واحدٌ فی الحقیقة عند أهل البصیرة.
و لمّا کان – علیه السلام ـ إماماً لأهل التوحید و قدوةً فی الترک و التجرید و أباً و مربّیاً لهذا العالم النضید سأل لعامّة أهل التوحید من المسلمین و المسلمات إلى آخرهم مثل ما سأل لنفسه و لولده؛ و فی الخبر: «من حقّ المسلم على المسلم أن یحبّ له ما یحبّ لنفسه و یکره له ما یکره لنفسه»(107)؛
و فی آخر: «یحبّ المرء المسلم لأخیه ما یجبّ لأعزّ أهله و یکره المرء المسلم لأخیه مایکره لأعزّ أهله»(108)
و تقدیم «الاسلام» على «الإیمان» لتقدّمه فی ترتیب الوجود، و قد تقدّم الکلام علیهما مستوفىً.
و قوله – علیه السلام ـ: «إنّک قریبٌ مجیبٌ» تعلیلٌ لاستدعاء الإجابة؛ و تحقیق ذلک یحتاج إلى تمهید مقدّمةٍ هی:
انّ الوجود البحت الخالص الحقّ البسیط المنزّه عن الماهیّة و الترکیب هو اللّه ـ سبحانه ـ، و العدم البحت لاذات له و لاماهیّة و لا أثر و لاتمیّز، بل هو لاشیءٌ محضٌ؛ و
الوجود المشوب بالعدم ماسوى اللّه. و هی المخلوقات ذوات الماهیّات ـ فانّ کلّ ممکنٍ فهو زوجٌ ترکیبیٌّ ترکّب ذاته من وجودٍ له من اللّه هو منشؤ تذوّته و تحقیق حقیقته، و من عدمٍ له من نفسه تمیّز بذلک الوجود و تخصّص به بحسب قابلیّته له، و انّ المعلول یجب أن یکون مناسباً للعلّة. و قد تحقّق کون الواجب ـ تعالى ـ عین الوجود و الموجود بنفس ذاته بذاته ـ ؛ فالفائض عنه یجب أن یکون وجود الأشیاء لا ماهیّاتها الکلّیّة ـ لفقد المناسبة ـ. و کما انّ الماهیّة لیست مجعولةً ـ بمعنى انّ الجاعل لمیجعل الماهیّة ماهیّةً ـ فکذلک الوجود لیس مجعولاً، بمعنى انّ الجاعل لم یجعل الوجود وجودآ، بل الوجود وجودٌ أزلاً و أبداً و الماهیّة ماهیّةٌ أزلاً و أبداً و غیر موجودةٍ و لامعدومةٍ أزلاً و أبداً، و إنّما تأثیر الفاعل فی خصوصیّة الوجود و تعیّنه لاغیر.
و انّ نسبة ذاته ـ سبحانه ـ و أسماؤه الحسنى إلى ماسواه یمتنع أن یختلف بالمعیّة و اللامعیّة و الافاضة و اللاافاضة، و إلّا فیکون بالفعل مع بعضٍ و بالقوّة مع آخرین، فیترکّب ذاته من جهتی فعلٍ و قوّةٍ، و تتغیّر صفاته حسب تغیّر المتجدّدات المتعاقبات ـ تعالى عن ذلک!ـ. بل نسبة ذاته الّتی هی فعلیّة صرفةٌ و غناءٌ محضٌ من جمیع الوجوه و إن کان من الحوادث الزمانیّة نسبةٌ واحدةٌ إیجابیّةٌ و معیّةٌ قیومیّةٌ ثابتةٌ غیر زمانیّةٍ و لامتغیّرةٍ أصلا، و الکلّ عنده واجباتٌ و بغنائه بقدر استعداداتها مستغنیاتٌ کلٌّ فی وقته و محلّه على حسب طاقته. و إنّما إمکانها و فقرها بالقیاس إلى ذواتها و قوابل ذواتها. فالمکان و المکانیّات بأسرها بالنسبة إلیه ـ سبحانه ـ کنقطةٍ واحدةٍ فی معیّة الوجود؛ (وَ السَّمَاوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِهِ)(109) و الزمان و الزمانیّات بآزالها و آبادها کان واحدآ عنه فی ذلک؛ «جفّ القلم بما هو
کائنٌ»(110) ما من نسمةٍ کائنةٍ إلى یوم القیامة إلّا و هی کائنةٌ و الموجودات کلّها ـ شهودیّاتها و
غیبیّاتها ـ کوجودٍ واحدٍ فی الفیضان عنه ـ تعالى ـ ؛ (مَا خَلَقَکُمْ وَ لاَبَعَثَکُمْ إِلاَّ کَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ)(111)، و إنّما المتقدّم و المتجدّد و المتصرّم و الحضور و الغیبة فی هذه کلّها بقیاس بعضها إلى بعضٍ فی مدارک المحبوسین فی مطمورة الزمان المسجونین فی سجن المکان لا غیر، و إن کان هذا ممّا یستغربه الأوهام!.
و أمّا قوله ـ عزّ و جلّ ـ: (کُلَّ یَومٍ هُوَ فِی شَأْنٍ)(112) فهو کما قال بعض العلماء: «انّها شؤونٌ یبدیها لاشؤونٌ یبتدیها!».
قال بعض أهل المعرفة: «اعلم! أنّ إمداد الحقّ و تجلّیّاته واصلٌ إلى العالم فی کلّ نفسٍ، و فی التحقیق الأتمّ لیس إلّا تجلٍّ واحدٍ یظهر له بحسب القوالب و مراتبها و استعداداتها تعیّناتٌ، فیلحقه لذلک التعدّد و النعوت المختلفة الأسماء و الصفات، لا أنّ الأمر فی نفسه متعدّدٌ و وروده طارٍ متجدّدٍ؛ و إنّما التقدّم و التأخّر و غیرهما من أحوال الممکنات ممّا توهّم التجدّد و الطریان و التقیّد و التغیّر و نحو ذلک کالحال فی التعدّد، و إلّا فالأمر أجلّ من أن ینحصر فی إطلاقٍ أو تقییدٍ أو اسمٍ أو صفةٍ أو نقصانٍ أو مزیدٍ. و هذا التجلّیّ الأحدیّ المشارإلیه لیس غیر النور الوجودیّ، و لایصل من الحقّ إلى الممکنات بعد الاتّصاف بالوجود و قبله غیر ذلک، و ماسواه فانّما هو أحکام الممکنات و آثارها متّصلٌ من بعضها بالبعض حال الظهور بالتجلّیّ الوجودیّ الوحدانیّ المذکور.
و لمّا لم یکن الوجود ذاتیّاً لما سوى الحقّ ـ بل مستفادّاً من تجلّیّه ـ افتقر العالم فی بقائه إلى الإمداد الوجودیّ الأحدیّ فی الآنات من دون فطرةٍ و لا انقطاعٍ، إذ لو انقطع الإمداد المذکور طرفة عینٍ لفنى العالم دفعةً واحدةً. فانّ الحکم العدمیّ لازمٌ للممکن و الوجود عارضٌ له من موجده»(113)
و قال: «و لمّا کان هذا الخلق من جنس ما کان أوّلاً التبس على المحجوبین، و لم یشعروا بالتجدّد و ذهاب ما کان حاصلاً بالفناء فی الحقّ، لأنّ کلّ تجلٍّ یعطی خلقاً جدیداً و یفنی فی الوجود الحقیقیّ ماکان حاصلاً».
و یظهر هذا المعنى فی النار المشتعلة من الدهن و الفتیلة، فانّه فی کلّ آنٍ یدخل منها شیءٌ فی تلک الناریّة و یتّصف بالصفة النوریّة ثمّ تذهب تلک الصورة بصیرورته هواءً؛ هکذا شأن العالم بأسره، فانّه یستمدّ دائماً من الخزائن الإلهیّة مفیضاً منها و یرجع إلیها. فمن هذا سهل علیک أن تتیقّن انّ وجود العالم عن الباری لیس کوجود البِناء عن البَنّاء، و لا کوجود الکتابة عن الکاتب، بل کوجود الکلام عن المتکلّم ـ إن سکت بطل الکلام! ـ، بل کوجود ضوء الشمس فی الجوّ المظلم الذات ما دامت الشمس طالعةً ـ فان غابت الشمس بطل الضوء من الجوّ ـ ؛ لکن شمس الوجود یمتنع علیه العدم لذاته.
و کما انّ الکلام لیس جزء المتکلّم ـ بل فعله و عمله بعد ما لم یکن ـ و کذا النور الّذی فی الجوّ لیس بجزء الشمس ـ بل هو فیضٌ منها ـ فهکذا الحکم فی وجود العالم عن الباریّ ـ جلّ ثناؤه ـ لیس بجزءٍ من ذاته، بل فضلٌ و فیضٌ یتفضّل به و یفیض، إلّا انّ الشمس لم تقدر أن تمنع نورها و فیضها ـ لأنّها مطبوعةٌ على ذلک ـ بخلافه ـ سبحانه ـ، فانّه مختارٌ فی أفعاله بنحوٍ من الإختیار أجلّ و أرفع عمّا یتصوّره العوامّ و أشدّ و أقوى من اختیار مثل المتکلّم القادر على الکلام، إن شاء تکلّم و إن شاء سکت. فهو ـ سبحانه ـ إن شاء أفاض وجوده و فضله و أظهر حکمته، و إن شاء أمسک، و لو أمسک طرفة عینٍ عن الإفاضة و التوجّه لتهافت السماوات و بادت الأفلاک و تساقطت الکواکب و عدمت الأرکان و هلکت الخلائق و دثر العالم و فنى دفعةً واحدةً بلازمانٍ! ـ کماقال عزّ و جلّ: (إِنَّ اللَّهَ یُمسِکُ السَّمَاوَاتِ وَ الاَرْضَ أَنْ تَزُولاَ وَ لَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَکَهُمَا مِن أَحَدٍ مِن بَعدِهِ)(114)؛ و قیل فی الفارسیّة:
به محض التفاتى زنده دارد آفرینش را++
اگر نازى کند از هم فرو ریزند قالبها
و لاتستبعد خروج الکلام عن المرام، فانّ الکلام یجرّ الکلام!.
فثبت ممّا ذکر انّه لایخرج عن احاطته وجودٌ و لا عن قیّومیّته و معیّته شیءٌ، إذ لوخرج عنه وجودٌ و عن قیّومیّته و معیّته شیءٌ لم یکن محیطاً به ـ لتناهی وجوده و قیّومیّته و معیّته دون ذلک الوجود و الشیء، تعالى عن ذلک علوّاً کبیراً! ـ. لأنّه الوجود البحت الغیر المتناهی، بل «لو أنّکم دلّیتم بحبلٍ إلى الأرض السفلى لهبطت على اللّه!»(115)، و: (فَأیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِیمٌ)(116)، (أَلاَ إِنَّهُمْ فِی مِرْیَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلاَ إِنَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ مُحِیطٌ)(117)، (وَ هُوَ مَعَکُمْ أَینَ مَا کُنْتُمْ)(118)، (وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیهِ مِنْ حَبْلِ الوَرِیدِ)(119)
فإذا تمهّد هذه المقدّمة فنقول: مقصوده – علیه السلام ـ من قوله: «إنّک قریبٌ» هذا القرب المذکور و المعیّة المذکورة؛
و من قوله – علیه السلام ـ: «مجیبٌ»: الاجابة لدعاء الموجودات الإمکانیّة بلسانهم الاستعدادیّة الفطریّة على الطریقة المذکورة.
فإذا علمت ماذکرناه لک فی هذا المقام فلاتصغ إلى ما ذکره بعض الأعلام ـ و تابعه الفاضل الشارح(120) ـ من: «أنّ وصفه ـ تعالى ـ بالقریب تمثیلٌ لکمال علمه بأفعال عباده و أقوالهم و اطّلاعه على أحوالهم بحال من قرب مکانه.
و «المجیب»: هو الّذی یقبل دعاء الداعین بالاجابة و سؤال السائلین بالاسعاف و ضرورة المضطرّین بالکفایة؛ و فیه تلمیحٌ إلى قوله ـ تعالى ـ: (وَ إِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ)(121)
فانّه تحقیقٌ ظاهریٌ!؛ فالأحرى أن تفسّر الآیة بما ذکرناه.
فتأمّل فیما ذکر، و احفظه و اتقنه، فانّه من لباب المعرفة و مخّ الحکمة عزیزٌ جدّاً!.
و قوله – علیه السلام ـ : «سمیعٌ علیمٌ».
«السمیع»: هو العالم بالمسموعات؛ و قیل: «هو الّذی لایعزب عن ادراکه مسموعٌ و إن خفی».
و «العلیم»: هو العالم بجمیع الأشیاء قبل حدوثها و بعد ظهورها على أتمّ مایکون، و العلوم کلّها من عنده و عطیّته؛ و قیل: «هو الّذی کمل علمه و کماله بأن یحیط بکلّ شیءٍ ـ ظاهره و باطنه ـ مشاهدةً و کشفاً على أتمّ مایمکن بحیث لایتصوّر فوقه، و لایکون مستفادّاً من المعلوم، بل المعلوم یکون مستفادّاً منه. و یفارق علم العبد علمه ـ سبحانه ـ فی المراتب الثلاث».
و لمّا کانت الفعیل من ابنیة المبالغة فـ «السمیع» و «العلیم» أبلغ من السامع و العالم.
1) لم أعثر علیه منسوباً إلى سادس ائمّتنا المعصومین ـ علیهم السلام ـ. و فی کتابٍ من مولاناأمیرالمؤمنین – علیه السلام ـ إلى معاویة: «فانّا صنائع ربّنا و الناس بعد صنائع لنا»، راجع:«نهج البلاغة» الکتاب 28 ص 385، و انظر: «شرح ابن أبی الحدید» علیه ج 15 ص 192،«الإحتجاج» ج 1 ص 196، «بحار الأنوار» ج 33 ص 57.
2) کریمة 15 الأحقاف.
3) راجع: «ریاض السالکین» ج 4 ص 98.
4) راجع: «مجمع البیان» ج 9 ص 144.
5) راجع: نفس المصدر.
6) المصدر: + «فی» فی.
7) راجع: «تفسیر الکشّاف» ج 3 ص 521.
8) قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 98.
9) کریمة 3 هود.
10) لم أعثر على العبارة فیه، و لم یذکر المطرّزی فی «المغرّب» باب المیم مع التاء، راجع: المصدر ص422 القائمة 2.
11) قارن: «شرح الصحیفة» ص 252 مع تغییرٍ یسیر، و انظر: «نور الأنوار» ص 140.
12) کریمة 16 الأحزاب.
13) قال: «و مدّه اللّه فی غیّه أی: أمهله و طوّل له»، راجع: «دیوان الأدب» ج 3 ص 120القائمة 2.
14) المصدر: ـ و قد مرّ تحقیقه.
15) قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 99.
16) خلافاً للمحدّث الجزائریّ حیث قال: «الظاهر انّه تأکیدٌ لما قبله»، راجع: «نور الأنوار»ص 140.
17) کما حکاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 253.
18) راجع: «وسائل الشیعة» ج 12 ص 195 الحدیث 16069، «بحار الأنوار» ج 1 ص 150،«أعلام الدین» ص 148، «شرح نهج البلاغة» ج 10 ص 138.
19) القطعة هی تحریر کلام محقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 253.
20) راجع: «مفتاح الفلاح» ص 60.
21) کما حکاه العلّامة المدنیّ، راجع: «ریاض السالکین» ج 4 ص 101.
22) قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 102.
23) کریمة 108 المائدة.
24) قارن: نفس المصدر أیضاً ص 103.
25) و حکى المحقّق الداماد جمع الضمیر فی نسختی الشهید و الکفعمیّ، راجع: «شرح الصحیفة»ص 254.
26) کریمة 8 المائدة.
27) قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 104.
28) قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 106.
29) راجع: «أساس البلاغة» ص 167 القائمة 2.
30) کریمتان 56 / 55 المؤمنون.
31) راجع: «ریاض السالکین» ج 4 ص 108.
32) کریمة 36 آل عمران.
33) لم أعثر علیه فی مصادرنا الروائیّة.
34) کریمة 94 الحجر.
35) قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 109، مع تغییرٍ یسیر.
36) کریمات 4 / 1 الرحمن.
37) قال: «و الّذی یظهر انّ الصفة تتعدّد بغیر عاطفٍ و إن کانت جملةً»، راجع: «مغنی اللبیب» ج2 ص 504.
38) هکذا العبارة فی النسختین، و انظر: التعلیقة الآتیة.
39) قال: «و قیل: «انّ معنى قوله: (یُوَسوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ): یلقی الشغل فی قلوبهم بوسواسه، و المراد انّ له رفقاء به یوصل الوسواس إلى الصدر»؛ و هو أقرب من خلوصه بنفسه إلى صدره»؛ راجع: «مجمع البیان» ج 10 ص 498.
40) قارن: «نور الأنوار» ص 141.
41) راجع: «إتحاف السادة المتّقین» ج 7 ص 269، «مجمع الزوائد» ج 7 ص 149، «کنز العمّال»الحدیث 1782، «تفسیر القرطبیّ» ج 20 ص 262.
42) لم أعثر علیه.
43) کریمة 5 الناس.
44) إشارةٌ إلى قول النبیّ ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ: «قلب المؤمن بین إصبعین من أصابع الرحمن»، راجع: «بحار الأنوار» ج 67 ص 39، «عوالی اللئالی» ج 1 ص 68 الحدیث 69.
45) کریمة 7 الشمس.
46) کریمة 85 الإسراء.
47) راجع: «ریاض السالکین» ج 4 ص 112.
48) راجع: «الکافی» ج 2 ص 286 الحدیث 16 مع تغییرٍ و زیادةٍ و حذفٍ، و انظر: «بحار الأنوار»ج 6 ص 250، «بصائر الدرجات» ص 447 الحدیث 5، «تحف العقول» ص 188.
49) کریمة 37 ق.
50) راجع: «الکافی» ج 8 ص 167 الحدیث 186، «بحار الأنوار» ج 75 ص 309، «الأمالی» ـ للطوسیّ ـ ص 625 الحدیث 1290، «تحف العقول» ص 392.
51) کما قال الفیروزآبادیّ: «قلبه یقلبه: حوّله عن وجهه»، راجع: «القاموس المحیط» ص 130القائمة 2.
52) راجع: «بحار الأنوار» ج 60 ص 268، «جامع الأخبار» ص 180، «شرح نهج البلاغة» ج 6ص 268، و انظر: «عوالی اللئالی» ج 4 ص 113 الحدیث 175، «مستدرک الوسائل» ج 16ص 220 الحدیث 19650، «الکافی» ج 8 ص 113 الحدیث 92، و انظر أیضاً: «التعلیقات»ص 59.
53) قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 114، مع تغییرٍ یسیر.
54) راجع: «الکافی» ج 2 ص 440 الحدیث 1، و انظر أیضاً: «مستدرک الوسائل» ج 1 ص 95الحدیث 75، «بحار الأنوار» ج 6 ص 68، «الزهد» ص 75.
55) المصدر: أو قال.
56) قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 118، مع تلخیصٍ.
57) کریمة 64 الإسراء.
58) کریمة 33 یوسف.
59) مغنی اللبیب: قد.
60) کریمة 73 الأنفال.
61) راجع: «مغنی اللبیب» ج 1 ص 33.
62) کریمة 120 آل عمران.
63) أمّا سکون الراء مع ضمّ الضاد فقراءة الکسائی، انظر: «البحر المحیط» ج 3 ص 43، و أمّاسکون الراء مع کسر الضاد فهی قراءة نافع و ابن کثیر و أبوعمرو و غیرهم، انظر: نفس المصدر، «تفسیر القرطبیّ» ج 4 ص 184، «تفسیر الکشّاف» ج 1 ص 213، «التفسیرالکبیر» ج 3 ص 39، «النشر فی القراءآت العشر» ج 2 ص 242.
64) کما حکاه العلّامة المدنیّ، راجع: «ریاض السالکین» ج 4 ص 120.
65) هذا قول محقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 256.
66) کریمة 25 الفتح.
67) کریمتان 87 / 86 الواقعة.
68) راجع: «ریاض السالکین» ج 4 ص 120.
69) انظر: «شرح الصحیفة» ص 256.
70) قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 123.
71) راجع: «أساس البلاغة» ص 281 القائمة 2.
72) کریمة 60 غافر.
73) و انظر: «التعلیقات» ص 60.
74) کریمة 7 طه.
75) قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 127.
76) راجع: «القاموس المحیط» ص 235 القائمة 2.
77) کریمة 7 الفاتحة.
78) کما حکاه العلّامة المدنیّ، راجع: «ریاض السالکین» ج 4 ص 129.
79) لم أعثر علیه، و الجوهریّ حینما یذکر معانی الباء لم یأت بهذا المعنی، راجع: «صحاح اللغة» ج6 ص 2547 القائمة 1.
80) فانظر: «مغنى اللبیب» ج 1 ص 141.
81) کریمة 6 الإنسان.
82) قارن: «شرح الصحیفة» ص 257.
83) هذا الضبط منسوبٌ عند العلّامة المدنیّ إلى نسخة ابن ادریس، راجع: «ریاض السالکین» ج4 ص 129.
84) کما حکاه العلّامة المدنیّ، راجع: نفس المصدر ص 130.
85) راجع: نفس المصدر أیضاً.
86) کما نصّ علیه الفیروزآبادیّ، راجع: «القاموس المحیط» ص 816 القائمة 2.
87) کما حکاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 259.
88) راجع: «الکافی» ج 2 ص 230 الحدیث 1، «مستدرک الوسائل» ج 11 ص 183 الحدیث12678، «بحار الأنوار» ج 64 ص 367.
89) قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 134.
90) کما حکاه عنه النووی، راجع: «تهذیب الأسماء و اللغات» المجلد الأوّل من القسم الثانی ص122 القائمة 2، و فیه: «الرشد فی اللغة…».
91) کریمة 51 الأنبیاء.
92) راجع: «الذریعة إلى مکارم الشریعة» ص 101.
93) قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 138.
94) کریمة 54 سبأ.
95) کریمة 24 الأنفال.
96) راجع: «المصباح المنیر» ص 102.
97) کریمة 23 الحدید.
98) کریمة 276 البقرة.
99) کریمة 10 القلم.
100) قال سعدالدین: «و الحقّ انّ هذا الحکم أکثریٌّ لا کلّیٌّ، بدلیل قوله ـ تعالى ـ …»،راجع:«الشرح المختصر» ص 74.
101) راجع: «ریاض السالکین» ج 4 ص 139.
102) انظر: التعلیقة الآتیة.
103) اختلف النقل هنا عمّا فی المطبوع من الکتاب، فانّه قال فی باب «فِعال» ـ بالکسر الفاء ـ: «هوالجوار»، راجع: «دیوان الأدب» ج 3 ص 373 القائمة 2، و قال فی باب «فُعال» ـ بضمّ الفاء ـ :«الجُوار: لغةٌ فی الجوار، و الکسر أفصح»، راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 371 القائمة 2.
104) قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 141.
105) راجع: «وفیات الأعیان» ج 1 ص 374، «مصباح الأنس» ص 693، «الراح القراح»ص 74.
106) راجع: «ریاض السالکین» ج 4 ص 141.
107) لم أعثر علیه، و روی: «للمسلم على أخیه المسلم من المعروف ستّاً… و یحبّ له ما…»، راجع:«بحار الأنوار» ج 71 ص 225، «الأمالی» ـ للطوسیّ ـ ص 634 الحدیث 1309، «مجموعةورّام» ج 2 ص 175.
108) راجع: «الکافی» ج 2 ص 172 الحدیث 9، «وسائل الشیعة» ج 12 ص 204 الحدیث16093، «أعلام الدین» ص 440، «مستدرک الوسائل» ج 9 ص 44 الحدیث 10156.
109) کریمة 67 الزمر.
110) العبارة من المشهورات بین العرفاء و المتصوّفة، انظر: «شرح فصوص الحکم» ص 443،«تمهید القواعد» ج 1 ص 70.
111) کریمة 28 لقمان.
112) کریمة 29 الرحمن.
113) هذا قول القونویّ فی «إعجاز البیان»، و أورد الفناریّ القطعة الأولى منه فی «مصباح الأنس»ص 365.
114) کریمة 41 فاطر.
115) راجع: «بحار الأنوار» ج 55 ص 107.
116) کریمة 115 البقرة.
117) کریمة 54 فصّلت.
118) کریمة 4 الحدید.
119) کریمة 16 ق.
120) راجع: «ریاض السالکین» ج 4 ص 127.
121) کریمة 186 البقرة.