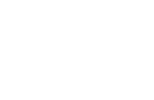بسم اللّه الرحمن الرحیم
و به نستعین
الحمد للّه المسقی للغیب المغدق بعد الجدب المحرق و المحیی للأرض بنباتها المونق بعد الموت المطبق؛ و الصلاة و السلام على نبیّه المشفق و على أهل بیته، سیّما ولیّه الّذی هو لعدوّه موبقٌ.
و بعد؛ فهذه اللمعة التاسعة عشرة من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة ـ علیه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ غیر متناهیة ـ، إملاء العبد المحتاج إلى اغداق سحاب فضله و إحسانه محمّد باقر بن السیّد محمّد ـ أحیى اللّه قلبه بسحاب عرفانه ـ.
وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ ـ عَلَیْهِ السَّلاَمُ ـ عِنْدَ الاِسْتِسْقَاءِ بَعْدَ الْجَدْبِ.
«الاستسقاء»: استفعالٌ بمعنى طلب السقی، و قد صار حقیقةً شرعیّةً على طلب الغیث بالدعاء و الاستغفار.
<و «الجدب»: هو حبس الأمطار و غور الأنهار. و العلّة فیه قاله الصادق - علیه السلام ـ: «إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل، و إذا أمسکت الزکاة هلکت الماشیة، و إذا جار الحکّام فی القضاء أمسک القطر من السماء، و إذا خفرت الذمّة نصر المشرکون على
المسلمین»(1)
و قد کان الاستسقاء مشروعاً فی جمیع الأدیان و الملل ـ بحکم قوله تعالى: (وَ إِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى)(2) ـ، و أنکره أبوحنیفة(3)؛ و هو منکرٌ.
و الظاهر انّه – علیه السلام ـ کان یدعو بهذا الدعاء عند الجدب مع صلاة الاستسقاء ـ و سایر آدابه ـ و بدونه، و هو أحد أفراد الاستسقاء>(4)
و هو أنواعٌ؛ أدناه الدعاء بلاصلاةٍ و لا خلف صلاةٍ، و أوسطه الدعاء خلف الصلاة، و أفضله الاستسقاء برکعتین و خطبتین.
و کیفیّته أن یأمر الخطیب الناس بالتوبة و ردّ المظالم و تصفیة النفس من الرذائل الخلقیّة و صوم ثلاثة أیّامٍ أوّلها یوم السبت و آخرها یوم الاثنین، هذا منصوصٌ؛ أو ثلاثة أیّامٍ أوّلها یوم الأربعاء و آخرها یوم الجمعة ـ لأنّها وقتٌ لإجابة الدعاء، حتّى رویت: «انّ العبد لیسأل الحاجة فیؤخّر قضاؤها إلى الجمعة»(5) ـ.
فإن لم یکونوا بمکّة أصحروا، و إن کانوا بها صلّوا بالمسجد الحرام.
و یستحبّ لهم الخروج حفاةً ـ و نعالهم بأیدیهم ـ فی ثیابٍ بذلةٍ متخشّعین مستغفرین. و یخرج الإمام خاشعاً متبذّلاً متنظّفاً لا متطیّباً.
و یستحبّ الخروج بذوی الزهد و الصلاح و الشیوح و الأطفال و البهائم و العجائز ـ لأنّهم مظنّة الرحمة على المذنبین ـ، لا الشواب و الفسّاق و أهل الخلاف و الکفّار ـ و لو أهل
الذمّة ـ. و یفرّق بین الأطفال و الأمّهات، و ینادی المؤذّنون بدل الأذان: الصلاة ـ ثلاثاً ـ.
و وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، فیصلّی الإمام بالناس رکعتین ـ کالعیدین ـ، یقرء فی الأولى بعد الحمد سورةً بالجهر، ثمّ یکبّر خمساً و یقنت عقب کلّ تکبیرةٍ بالاستغفار و سؤال اللّه ـ تعالى ـ طلب الغیث و توفیر المیاه و انزال الرحمة. و من المأثور فیه: «أللّهمّ اسق عبادک و إماءک و بهائمک(6)، و انشر رحمتک، و احی بلادک المیتة»(7) ثمّ یکبّر السادسة و یرکع و یسجد السجدتین، ثمّ یقوم إلى الرکعة الثانیة فیقرء بعد الحمد سورةً، ثمّ یکبّر أربعاً و یقنت عقب کلّ تکبیرةٍ ـ کما فی الأولى ـ، ثمّ یکبّر و یسجد و یتشهّد.
فإذا سلّم صعد المنبر و حوّل رداءه ـ فیجعل الّذی على یمینه على یساره، و الّذی على یساره على یمینه ـ، و یترکه محوّلاً حتّى ینزعه، و هذا للاتّباع و التفاؤل ـ.
و یخطب بخطبتین، فإذا فرغ استقبل القبلة و کبّر اللّه مأة مرّة، ثمّ یلتفت عن یمینه و یهلّل اللّه مأة مرّة، ثمّ یلتفت عن یساره و یسبّح اللّه مأة مرّة، ثمّ یستدبر القبلة و یستقبل الناس و یحمد اللّه مأة مرّة رافعاً بکلّ ذلک صوته، و الناس یتابعونه فی الأذکار دون الالتفات إلى الجهات.
فإن سقوا، و إلّا عادوا ثانیاً و ثالثاً من غیر قنوطٍ، بانین على الصوم الأوّل إن لم یفطروا بعده، و إلّا بصومٍ مستأنفٍ(8)
و یصحّ من المسافر و فی کلّ وقتٍ؛ و من الرجل وحده ـ و لو فی بیته ـ.
اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَیْثَ، وَ انْشُرْ عَلَیْنَا رَحْمَتَکَ بِغَیْثِکَ الْمُغْدِقِ مِنَ السَّحَابِ،
الْمُنْسَاقِ لِنَبَاتِ أَرْضِکَ، الْمُونِقِ فِی جَمِیعِ الاْفَاقِ.
قیل: «لم یصدّره – علیه السلام ـ بالثناء علیه ـ تعالى ـ و الصلاة على محمّدٍ و آله – علیهم السلام ـ و الاعتراف بالذنوب ـ کما هو دأبه فی طلب الحوائج ـ، و کأنّ النکتة فیه ضیق المقام، و انّه لایسع إلّا طلب الحاجة ـ سیّما و الغرض یعود إلى سائر الناس ـ»(9)
«اسقنا»: یجوز أن یقرء بالقطع، من الإسقاء؛ و بالوصل من السقی، یقال: سقاه اللّه الغیث و أسقاه؛ قال الراغب: «الإسقاء أبلغ من السقی، لأنّ الإسقاء أن تجعل له ما یسقى منه و یشرب، و السقی أن تعطیه ما یشرب»(10)؛
و قیل: «السقی، لما لا کلفة فیه، و لهذا ذکر فی شراب الجنّة ـ نحو: (سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً)(11) ـ، و الاسقاء لما فیه کلفةٌ، و لهذا ذکر فی ماء الدنیا ـ نحو: (لاََسقَینَاهُمْ مَاءً غَدَقاً)(12) -(13) -.
و «الغیث»: المطر؛ یقال: قد غاث المطر الأرض، أی: أحیاها. و یسمّى النبات الّذی ینبت به «غیثاً»، تسمیةً باسم السبب، فیقال: رعینا الغیث. و قال الجوهریّ: «و ربّما سمّی السحاب و النبات بذلک»(14)؛ و یقال أیضاً للسحاب الواقع فی أیّامه: غیثٌ، و فی غیر أیّامه: مطرٌ.
و «المغدق»: المطر الکثیر القطر، أو کبیره(15)؛ یقال: غدق المطر غدقاً ـ من باب تعب ـ و أغدق إغداقاً: کثر ماؤه و قطره.
و «السَّحاب» ـ بالفتح ـ: جمع سحابة لا مفرد، بدلیل قوله ـ تعالى ـ : (وَ یُنْشِىءُ
السَّحَابَ الثِّقَالَ)(16)، فانّه لوکان مفرداً لقیل: «الثقیل». و قد یستعمل مذکّراً ـ مثل قوله تعالى: (وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَینَ السَّمَاءِ)(17)، لأنّ الجمع الّذی بینه و بین مفرده «التاء» یستعمل تارةً مؤنّثاً و تارةً مذکّراً ـ؛ کذا فی مجمع البیان(18)
و السحاب هو الغیم، سمّی بذلک لانسحابه فی الهواء.
«المنساق لنبات» أرضها أی: المسوق لرواء نباتها، أو لانباتها؛ و «السوق»: حثّ الماشی فی السیر حتّى یقع الاسراع فیه.
<و «النَّبات» ـ بالفتح ـ: مصدر نبت البقل نبتاً و نباتاً ـ من باب قتل ـ، ثمّ قیل لما ینبت: نبتٌ و نباتٌ؛ و هو المراد هنا. و «اللام» للتعلیل، أی: لأجل انباته، أو لیسقیه>(19)
<و «المونق» ـ على وزن موجِب ـ: إمّا من الأنق ـ بالتحریک ـ بمعنى: الکلاء ـ فـ «المونق» بمعنى: المنبت المخرج له ـ ؛ أو بمعنى: الفرح و السرور، أی: سببٌ للأنق و الفرح؛ و إمّا من الأنیق بمعنى: المعجب ـ من قولهم: أنقنی حسنه أی: أعجبنی ـ>(20)، أی: لانباتها المعجب.
فقوله: «لنبات» متعلّقٌ بـ «المنساق»، و قوله: «أرضک» صفةٌ للنبات، و قوله: «فی جمیع الآفاق» متعلّقٌ بـ «أرضک».
<و «الآفاق»: جمع أُفُق ـ بضمّتین -، و هو الناحیة، أی: فی جمیع نواحی الأرض>(19)
و یحتمل أن یکون المراد: اسقنا غیث الحیاة من سماوات العقول المجرّدة إلى أراضی الجسمانیّة المادّیّة و انشر الرحمة علینا بغیث الحیاة و الفیوضات الکثیرة القطر من السحاب المنساق من النفس الرحمانیّ الظاهر من الجنّة لنبات أرضک الهیولانیّ بأنواع أشجار الصور النوعیّة الجمادیّة و النباتیّة و الحیوانیّة فی جمیع الآفاق و النواحی المادّیّة؛ و امنن علینا بایناع الثمرة،
أی: باتمام الکمالات اللائقة بکلٍّ من الأنواع الثلاثة؛ هذا فی العالم الکبیر.
و أمّا فی العالم الصغیر الإنسانیّ فنقول: اسقنا غیث الحیاة من سماوات الأرواح الأمریّة إلى أراضی الجسدانیّة العنصریّة و انشر الرحمة الواسعة علینا بغیث الحیاة الکبیرة القطر المنساق من السحاب النفس الإنسانیّ لنبات أرضک الجسدانیّ بأنواع الأشجار القوى الطبیعیّة و الحیوانیّة و الإنسانیّة فی جمیع الآفاق و النواحی الجسدانیّة.
و علیک بتطبیق سائر فقرات هذا الدعاء على هذا السیاق إن کنت من أهله!، ترکنا بیانها خوفاً للإطالة.
وَ امْنُنْ عَلَى عِبَادِکَ بِإِینَاعِ الثَّمَرَةِ، وَ أَحْیِ بِلاَدَکَ بِبُلُوغِ الزَّهَرَةِ، وَ أَشْهِدْ مَلاَئِکَتَکَ الْکِرَامَ السَّفَرَةَ؛ بِسَقْیٍ مِنْکَ نَافِعٍ، دَائِمٍ غُزْرُهُ، وَاسِعٍ دِرَرُهُ، وَابِلٍ سَرِیعٍ عَاجِلٍ.
«المنّ»: الإنعام و الاحسان.
<و «بإیناع الثمرة» أی: بتمام نضجها و بلوغها الاقتطاف>(21)؛ یقال: یَنعِت الثمار ینعاً ـ
من بابی نفع و ضرب ـ: أدرکت و نضجت، و الاسم: الیَنع ـ بضمّ الیاء و فتحها ـ. <و أینعت ـ بالألف ـ ایناعاً أکثر استعمالاً من الثلاثی.
و «الَثمَر» بفتحتین، و «الثمرة» مثله. فالأوّل مذکّرٌ و یجمع على ثمار ـ مثل: جبل و جبال ـ، و الثانی مؤنّثٌ و الجمع ثمرات ـ کقصبة و قصبات ـ. و الثمر و الثمرة: الحمل الّذی تخرجه الشجرة ـ سواءٌ أکل أم لا ـ>(19)
و «أحی بلادک ببلوغ الزهرة» عطفٌ على «اسقنا».
و «الزهْر» ـ بالتحریک و التسکین ـ: هی النَور ـ بفتح النون ـ، و واحدته: الزهرة ـ کالتمر و التمرة ـ؛
و قیل: «لایسمّى زهراً حتّى یتفتّح»(22)؛
و قیل: «حتّى یصفرّ»(23)
<و «زهرة الأرض»: نضارتها و غضارتها و حسنها و بهجتها>(24)
و «أشهِد»: أمرٌ من باب الإفعال، أی: احضر؛ من: شهد المجلس: إذا حضره ـ و منه: (مَا أَشْهَدْتَهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَ الاَرضِ)(25)، أی: أحضرتهم ـ.
و «السفرة» قد مرّ تفسیره فی اللمعة الثالثة. و المراد هنا: أهل السفارة؛ أی: احضر أهل السفارة بیننا و بینک فی إیصال المیاه إلینا. و قد مرّ فی اللمعة الثالثة ـ فی تفسیر قوله علیه السلام: «و خزّان المطر… إلى آخر الدعاء» ـ: انّه إشارةٌ إلى ملائکة ما تحت السماء ـ و هم مبادی الصور النوعیّة للأنواع الطبیعیّة العنصریّة ـ. فکلّ ملکٍ من جنس ما یدبّره و یحرّکه بإذن اللّه و أمره، فملک الریاح من باب الریاح، و ملک الأمطار من باب الأمطار، و ملک الجبال من باب الجبال -… و هکذا ـ. أو المراد من «السفرة»: الکتبة من الملائکة(26) ـ: الّذین ینسخون الکتب من اللوح المحفوظ ـ، على أنّه جمع «سافر» من السِفْر، و هو الکُتُب.
<و فائدة إشهاد الملائکة و إحضارهم توقّع مزید الرحمة و البرکة و استجابة الدعاء و قبوله، لأنّ لکلّ موجودٍ ملکٌ موکّلٌ به ـ کما عرفت(27) ـ.
و إنّما خصّ «الکرام السفرة»، لأنّهم الوسائط بین اللّه و بیننا ـ کما مرّ ـ ؛
أو لمزید تعطّفهم على المؤمنین، فقد فسّر «الکرام» من قوله ـ تعالى ـ: (بِأَیدِی سَفَرَةٍ – کِرَامٍ بَرَرَةٍ)(28) بـ: المتعطّفین على المؤمنین(29)؛>(30)
أو المراد من الکتب: هی الملائکة العلویّة ـ و هی العقول المقدّسة المؤثّرة فی تلک الملائکة السفلیّة. «کرامٌ» لشرفها و قربها من اللّه.
قوله – علیه السلام ـ: «بسقی»، قال الفاضل الشارح: «باؤه للسببیّة، و هی إمّا متعلّقةٌ بالأفعال الثلاثة الّتی قبلها ـ على طریق التنازع ـ و إعمال الأخیر منها فی المجرور و الأوّلین فی ضمیره، ثمّ حذفه، لأنّه فضلةٌ و لا لبس، و الأصل ـ: و امنن على عبادک بایناع الثمرة به و أحی بلادک ببلوغ الزهرة به ـ.
لایقال: یلزم منه تعلّق حرفی جرٍّ بمعنىً واحدٍ بفعلٍ واحدٍ من غیر إبدالٍ، و هو غیر جائزٍ؛
لأنّا نقول: حرفا الجرّ هنا لیسا(31) بمعنىً واحدٍ، بل «الباء» من قوله: «بایناع الثمرة» للتعدیة و «ایناع الثمرة» واقعٌ موقع المفعول به ـ ألاَ ترى انّ «منّ» قد یتعدّى بنفسه، فیقال: من ّعلیه کذا، کما یقال: منّ علیه بکذا؟!، قال الفیّومی فی المصباح: «منّ علیه العتق و غیره و به منّاً من باب قتل: أنعم علیه به»(32) ـ ؛ و «الباء» من قوله: «ببلوغ الزهرة» للالة ـ و تسمّى باء الاستعانة ـ ؛ و «الباء» من قوله: «بسقی» للسببیّة، فاختلف معنى الحرفین. فتعلّقهما بالأوّل کقولک: منّ اللّه على زیدٍ بخلاصه برحمته، و بالثانی کقولک: قطعت الشجرة بالسکین بقوّتی؛ و هذا ممّا لاریب فی جوازه.
و إمّا متعلّقةٌ بالمصدرین ـ أعنی: الإیناع و البلوغ ـ على جهة التنازع أیضاً، فیکون السقی سبباً لإیناع الثمرة و بلوغ الزهرة، کما قال ـ تعالى ـ: (وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الَّثمَرَاتِ رِزْقاً لَکُمْ)(33)؛ قال المفسّرون: «خروج الثمرات إنّما هو بقدرته ـ تعالى ـ و
مشیّته، و لکنّه جعل الماء سبباً فی إخراجها و مادّةً لها ـ کالنطفة فی الحیوان ـ بأن أودع فی الماء قوّةً فاعلةً و فی الأرض قوّةً منفعلةً قابلةً یتولّد من اجتماعهما أصناف الثمرات؛ أو بأن أجرى عادته بافاضة صور الثمار و کیفیّاتها المتخالفة على المادّة الممتزجة من الماء و التراب، و هو ـ سبحانه ـ قادرٌ على أن یوجد جمیع الأشیاء بلا أسبابٍ و موّادٍ کما أبدع نفوس الأسباب و الموادّ؛ و لکن له ـ عزّ و جلّ ـ فی انشائها متقلّبةً فی الأحوال و متبدّلةً فی الأطوار من بدائع حکمٍ باهرةٍ یتجدّد لأولی الأبصار عبراً و تزیدهم طمأنینةً إلى عظیم قدرته و لطیف رحمته ما لیس فی إبداعها بغتةً»(34)؛ انتهى کلامه.
قوله – علیه السلام ـ: «غُزْره» ـ <بضمّ الغین المعجمة ثمّ الزاء ثمّ الراء المهملة ـ: جمع غزیر؛ و بفتح العین ـ کما فی نسخة ابن ادریس ـ: الکثرة>(21)؛ أی: کثر مطره.
«دِرَره» ـ بکسر الدال و فتح الراء المهملتین، کعِنَب ـ أی: صبوبة، قال الجوهریّ: «للسحاب درّةٌ أی: صبٌّ، و الجمع: دررٌ»(35) و فی بعض النسخ بفتح الدال(36) بمعنى: الدفع ـ أی: بمعنى: الادرار و السیلان ـ ؛ و فی نسخةٍ: درّه(37)
<و «الوابل» و «الوبل»: المطر العظیم القطر، یقال: وَبَلت السماء وَبْلاً ـ من باب وعد ـ أی: اشتدّ مطرها؛ و کان الأصل: وبل مطر السماء، فحذف ـ للعلم به ـ، و لهذا یقال للمطر: وابلٌ>(38)
تُحْیِی بِهِ مَا قَدْ مَاتَ، وَ تَرُدُّ بِهِ مَا قَدْ فَاتَ، وَ تُخْرِجُ بِهِ مَا هُوَ آتٍ، وَ تُوَسِّعُ بِهِ فِی الاَْقْوَاتِ.
جملة «تحیی» فی محلّ جرٍّ صفةٌ «لسقى».
و «الحیاة» و «الموت» استعارتان للأرض، کما وقع فی کلام اللّه ـ تعالى ـ کثیراً ـ کقوله سبحانه: (یُحیِى الاَْرضَ بَعدَ مَوتِهَا)(39) ـ.
و «ما قد مات» أی: من النبات و نفعه.
و «ما هو آتٍ» أی: ما یمکن أن ینبته الأرض بسبب المطر.
و «الأقوات»: جمع قوت، و هو مایؤکل لیمسک الرمق؛ أی: توسّع بسبب ذلک الغیث فی قوت العباد.
سَحَاباً مُتَرَاکِماً هَنِیئاً مَرِیئاً طَبَقاً مُجَلْجَلاً، غَیْرَ مُلِثٍّ وَدْقُهُ، وَ لاَ خُلَّبٍ بَرْقُهُ.
<«سحاباً»: منصوبٌ على الحالیّة من «سقی». و صحّ کونه حالاً ـ مع جموده ـ لکونه نوعاً لصاحبه؛ و کونه عن نکرةٍ لتخصیصها بالنعوت المتقدّمة. و یجوز أن یکون مفعولاً(40)
لفعلٍ محذوفٍ، أی: نسألک ـ>(41) أو: أرسل ـ سحاباً. و یحتمل أن یکون بدل الکلّ من «الغیث»، و لهذا وصف بقوله: «متراکماً» ـ کما فی قوله تعالى: (بِالنَّاصِیَةِ – نَاصِیَةٍ کَاذِبَةٍ)(42) ـ، لأنّه إذا أبدل النکرة من المعرفة فلابدّ من الوصف.
و «المتراکم»: المجتمع الضخم.
و «الهنیء»: الطیّب اللذیذ الطعم، <من: هنُأ الطعام ـ من بابی علم و کرم ـ: ساغ و طاب و لذّ.
و «المریء» ـ مهموزاً ـ: المحمود العاقبة؛ من: مرء الطعام مراءةً ـ مثل: ضخم ضخامةً ـ>(43) و قیل: «الهنیء من الطعام: ما لا تعب فیه و لا إثم، و المریء ما لا داء
فیه»(44)
<و «الطَبَق» ـ بالتحریک ـ: العامّ الشامل الکثیر، کأنّه یطبق الأرض جمیعاً ـ و «الطیّب»: ما تستلذّه الحواسّ و النفس -.
و «مجلجلاً» أی: ذا رعدٍ، و «الجلجلة»: صوت الرعد؛ قال فی القاموس: «الجلجلة: التحریک و شدّة الصوت، و صوت الرعد(45)، و سحابٌ مجلجلٌ و غیثٌ جلجال»(46) و فی النسخ المشهورة على اسم المفعول، و فی نسخةٍ قدیمةٍ على اسم الفاعل؛ فعلى الأوّل معناه: انّ الملک یجلجله فیصوّت؛ و على الثانی معناه: المصوّت.
و «غیر ملثٍّ» أی: غیر دائمٍ و لا مقیمٍ. و أصله من: ألثّ فلانٌ بالمکان: إذا أقام و لایبرح.
و «الودق»: المطر>(43)
«و لاخلّبٍ برقه». <«الخلّب» ـ بضمّ الخاء المعجمة و تشدید اللام المفتوحة ـ: السحاب الّذی لا مطر فیه. و «البرق الخلّب»: المطمِع المخلِف.
اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَیْثاً مغِیثاً مَرِیعاً مُمْرِعاً عَرِیضاً وَاسِعاً غَزِیراً، تَرُدُّ بِهِ النَّهِیضَ، وَ تَجْبُرُ بِهِ الْمَهِیضَ.
«المغیث» هنا مفعِلٌ من الغیث، بمعنى: الکلاء و النبات مجازاً>(47)
و «غیثاً مغیثاً» أی: مطراً موجباً للغیث و النبات؛ أو: «مُغیثاً» ـ بضمّ المیم ـ من الاغاثة، أی: یکون سبباً للاستغاثة، یعنی: یقضی حوائج المحتاجین؛ أو تأکیدٌ ـ کلیلٍ ألیلٍ و ظلٍّ ظلیلٍ ـ، أی: مطراً شدیداً.
و «مریعاً» ـ بفتح المیم على صیغة فعیلٍ، من: مرع الوادی مراعةً، ککرم کرامةً ـ أی: أخصب بکثرة الکلاء؛ و بضمّ المیم ـ کما فی نسخة ابن ادریس ـ: الکثیر النماء، من أراع الطعام: إذا صارت له زیادةً فی العجز و الخبز، و أراعت الإبل: إذا کثرت أولادها؛ أی: یصیر سبباً للریع و النماء. <و یروى: «مُربعاً» ـ بضمّ المیم و الباء الموحّدة ـ، أی: مغنیاً عن الارتیاد لعمومه؛ فـ: الناس یریعون حیث کانوا أی: یقیمون و لایطلبون و یرتادون المراعی فی غیر مرابعهم ـ من أربعوا: إذا أقاموا فی المرابع.
و قال الخطائی: أی: منبتاً للربیع.
قال بعضهم: «و الأوّل هو الأعرف، لأنّ الإرباع بمعنى: انبات الربیع قلّما ذکر فی کلامهم»>(48)
و «مُمرِعاً» ـ بضمّ المیم، على صیغة الفاعل من باب الإفعال ـ بمعنى: المخصب أیضاً، من: مرُع الوادی ـ بضمّ الراء ـ مراعةً، و أمرع المکان امراعاً أی: صار ذا خصبٍ و کلاءٍ و عشبٍ.
و «عریضاً» ـ بالعین المهملة و الضاء المعجمة ـ أی: کثیراً ـ کما فی القرآن: (فَذُو دُعَاءٍ عَرِیضٍ)(49)، و فی قوله صلّى اللّه علیه و آله و سلم لعثمان فی انهزامه یوم أحد: «لقد ذهبت عریضاً یا عثمان!»(50) ـ. و فی نسخة ابن ادریس بالغین المعجمة(51)، أی: طریّاً جدیداً؛ یقال: لحمٌ غریضٌ؛ و یقال لماء المطر: غریضٌ مفروضٌ.
و «واسعاً» أی: بالغاً کلّ مکانٍ یحتاج إلى المطر.
و «غزیراً» من الغزارة بمعنى: الکثرة.
و «النهیض»: فعیلٌ بمعنى فاعلٍ، و هو صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ، أی: النبت النهیض؛ یقال:
نهض النبت ینهض أی: استوى. و قیل: «النهیض: النبات، لأنّه نهض من الأرض على ساقه»؛ أی: تردّ بذلک المطر المذکور النبات الیابس إلى الطراوة و النضارة.
و «جَبَرت» العظم جبراً ـ من باب قتل ـ: أصلحته فجبر هو؛ و جبر جبراً أیضاً و جبوراً: صلح، یستعمل لازماً و متعدّیاً.
و «المهیض»: النبات المکسور، و فی الأصل کسر العظم بعد جبره؛ یقال: هاض العظم کسره بعد الجبر و هو مهیضٌ. <شبّه النبات المنکسر ـ للقحط ـ بالعظم المکسور، فاستعار له لفظ المهیض تصریحاً بالاستعارة، و قرّنها بذکر الجبر ـ الّذی من لوازم المستعار منه ـ ترشیحاً>(52)
اعلم! أن الترشیح فی اللغة التزیین، و تربیة الأمّ ولدها باللین قلیلاً قلیلاً(53)؛
و فی الاصطلاح ینقسم إلى: ترشیح التشبیه ـ و هو: ذکر وصفٍ ملائمٍ للمشبّه به ـ؛
و: ترشیح المجاز ـ و هو: ذکر وصفٍ ملائمٍ للمعنى الحقیقیّ ـ ؛
و: ترشیح الاستعارة ـ و هو: ذکر وصفٍ ملائمٍ للمستعار منه ـ.
و تفصیل ذلک انّ الاستعارة ـ بالمعنى الّذی ذکرنا لک فی اللمعة الأولى ـ ثلاثة أقسام:لأنّها إمّا أن لم یقترن بشیءٍ یلائم المستعار له أو المستعار منه؛ أو قرّنت بمایلائم المستعار له أو المستعار منه؛
فالأوّل مطلقةٌ، لأنّها لم یقیّد بصفةٍ و لا تفریعٍ ـ نحو: عندی أسدٌ ـ ؛
و الثانی مجرّدةٌ، لخلوّها عن المبالغة ـ کقول کثیّر:
غَمرُ الرَّدَاءِ إِذَا تَبَسَّمَ ضَاحِکاً++
غَلِقَتْ بِضِحکَتِهِ رِقَابُ المَالِ(54)
أی: کثیر العطاء، استعار الرداء للعطاء ـ لأنّه یصون عرض صاحبه کما یصون الرداء ما یلقى علیه ـ ؛ ثمّ وصفه بالغمر ـ الّذی هو یلائم العطاء دون الرداء ـ تجریداً للاستعارة. و ذلک
لأنّه قد شاع وصف العطاء بالکثرة و تعارف، دون الرداء؛ و القرینة على ذلک سیاق الکلام؛ و قیل: «لفظ الغمر». و یقال: غلق الرهن فی ید المرتهن: إذا لم یقدر الراهن على انفکاکه؛ یعنی: إذا تبسّم و شرع فی الضحک غلقت رقاب أمواله فی أیدی السائلین. فحاصل المعنى: انّ السائلین یأخذون مال الممدوح من غیر علمه و یجیؤن إلى حضرته، فتبسّم و لا یأخذ منهم، فیملکونه!.
و الثالث: مرشّحةٌ، و هو: ما قرن بما یلائم المستعار، نحو: (أُولَئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ)(55)، فانّه استعار الاشتراء للاستبدال و الاختیار، ثمّ فرّع علیها مایلائم الاشتراء من الربح و التجارة.
و مثال الترشیح بالصفة قولک: جاورت الیوم بحراً ذاخرآ متلاطم الأمواج. و قد اجتمع التجرید و الترشیح فی قوله:
لَدَى أَسَدٍ شَاکِی السِّلاَحِ مُقَذِّفٌ++
لَهُ لِبَدٌ أَظْفَارُهُ لَمْ تُقَلَّمِ(56)
فـ «شاکی السلاح» تجریدٌ، لأنّه وصفٌ یلائم المستعار له ـ أعنی: الأسد الحقیقیّ ـ. و الترشیح أبلغ من الإطلاق و التجرید، و من جمع الترشیح والتجرید، لاشتماله على تحقیق المبالغة و التشبیه ـ لأنّ فی الاستعارة مبالغةً فی التشبیه ـ، فتزیینها و تربیتها بما یلائم المستعار منه تحقیقٌ لذلک و تقویةٌ له.
و ما ذکر فی الاستعارة یجری فی التشبیه و المجاز و التوریة(57)؛ فتذکّر!.
اللَّهُمَّ اسْقِنَا سَقْیاً تُسِیلُ مِنْهُ الظِّرَابَ، وَ تَمْلاُ مِنْهُ الْجِبَابَ، وَ تُفَجِّرُ بِهِ الاَنْهَارَ، وَ تُنْبِتُ بِهِ آلاَشْجَارَ، وَ تُرْخِصُ بِهِ الاَسْعَارَ فِی جَمِیعِ الاَمْصَارِ.
«سُقیاً» ـ بفتح السین و ضمّها(58) ـ: مفعولٌ مطلقٌ لـ «اسقنا».
<و «سال» الماء یسیل سیلاً ـ من باب باع ـ: جرى، و أسلته إسالةً: أجریته>(52)
و «الظراب» ـ على وزن کتاب -: هو الآکام، و هی بالفارسیّة: تلّ؛ و قیل: «هو الجبل الصغیر، أو المنبسط على الأرض»(59) و إیقاع فعل «الإسالة» على «الظراب» مجازٌ عقلیٌّ.
و «الجِباب» ـ بالکسر، جمع جُب بالضمّ ـ: البئر(60)
و «التفجیر» هو أن تفتحّ للماء طریقاً لیخرج من منبعه و یسیل جاریاً.
<و «الأنهار»: جمع نَهَر ـ بالتحریک - لغةٌ فی النَهْر - بالسکون، مثل: سبب و أسباب ـ، و بالتسکین یجمع على نُهُر ـ بضمّتین - و أنهر؛ و هو: المجرى الواسع من مجاری الماء. و إیقاع التفجیر علیها مجازٌ عقلیٌّ.
و «الأشجار»: جمع شجر، و هو ما له ساقٌ صلبٌ من النبات یقوم به – کالنخل و غیره ـ.
و «الرُخص» ـ بالضمّ ـ: ضدّ الغلاء.
و «الأسعار»: جمع سِعر ـ بالکسر ـ>(61)، و هو مایقدّر من الثمن. و «السعر» إن لم یکن للعبد فی أسبابه مدخلٌ فهو من اللّه – کما هو مذهب الإمامیّة -، لا انّ کلّ سعرٍ بأیّ وجهٍ کان – کجبر السلطان الرعیّة على سعرٍ مخصوصٍ ترقیّاً أو نزولاً ـ منسوبٌ إلى اللّه. و الأشاعرة بناءً على أصلهم من أنّه لافاعل إلّا اللّه یقولون: انّ السعر من فعل اللّه.
و اختلف المعتزلة، فقال بعضهم: «هو فعلٌ مباشرٌ من العبد، إذ لیس ذلک إلّا مواضعةً
منهم على البیع و الشراء بثمنٍ مخصوصٍ»؛ و قال آخرون: «هو متولّدٌ من فعل اللّه ـ تعالى ـ. و هو تقلیل الأجناس و تکثیر الرغبات بأسبابٍ هی من فعله»(62)
و «الأمصار»: جمع مِصر ـ بالکسر ـ، و هو البلد العظیم.
وَ تَنْعَشُ بِهِ الْبَهَائِمَ وَ الْخَلْقَ، وَ تُکْمِلُ لَنَا بِهِ طَیِّبَاتِ الرِّزْقِ، و تُنْبِتُ لَنَا بِهِ الزَّرْعَ، وَ تُدِرُّ بِهِ الضَّرْعَ، وَ تَزِیدُنَا بِهِ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِنَا.
قال فی القاموس: «نعشه: رفعه، أو: ذکره ذکراً حسناً، أو: جبر فاقته»(63)، و الأخیر أنسب(60)؛ أی: یجبر به فقر الخلائق و فاقتهم.
<و «البهائم»: جمع بهیمة، و هی کلّ ذات أربعٍ من دوابّ البرّ و البحر؛ و کلّ حیوانٍ لایمیّز فهو بهیمةٌ.
و «تکمل» من باب الإفعال و التفعیل.
و «طیّبات الرزق» قد تقدّم الکلام علیه.
و «الزرع»: ما أنبتت بالبذر، تسمیةً بالمصدر؛ و منه یقال: حصدت الزرع أی: النبات. قال بعضهم: «و لایسمّى زرعاً إلّا و هو غضٌّ طریٌّ».
و «درّ» اللبن درّاً ـ من بابی ضرب و قتل ـ: کثر؛ و أدرّه اللّه أی: کثّره.
و «الضرغ»: الثدی لکلّ ذات ظلفٍ و خفٍّ. و «ادراء الضرع» کـ «اجراء النهر» مجازٌ عقلیٌّ>(64)
و «تزیدنا به» أی: بذلک المطر قوّةً إلى قوّتنا؛ أی: القوّة الروحانیّة – الّتی هی الإطمینان ـ إلى القوّة البدنیّة؛ و هو تلمیحٌ إلى قوله ـ تعالى ـ حکایةً عن هود: (وَ یَا قَومِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیهِ یُرسِلِ السَّمَاءَ عَلَیکُمْ مِدْرَاراً وَ یَزِدْکُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِکُمْ)(65)
اللَّهُمَّ لاَتَجْعَلْ ظِلَّهُ عَلَیْنَا سَمُوماً، وَ لاَتَجْعَلْ بَرْدَهُ عَلَیْنَا حُسُوماً، وَ لاَتَجْعَلْ صَوْبَهُ عَلَیْنَا رُجُوماً، وَ لاَتَجْعَلْ مَاءَهُ عَلَیْنَا أُجَاجاً.
قال فی القاموس: «الظلّ من السحاب: ما وارى الشمس منه، أو سواده»(66)؛
و قیل: «الظلّ هو الفیء الحاصل من حاجزٍ بینک و بین الشمس مطلقاً»(67)؛
و قیل: «مخصوصٌ بما کان منه إلى الزوال، و ما بعده هو الفیء»(68)؛
و قال ابن قتیبة فی أوّل أدب الکاتب: «یذهبون – یعنی العوامّ ـ إلى أنّ الظلّ و الفیء بمعنىً، و لیس کذلک، بل الظلّ یکون غدوةً و عشیّةً و من أوّل النهار إلى آخره. و معنى الظلّ: الستر، و منه: أنا فی ظلّک، و منه: ظلّ الجنّة، و ظلّ شجرها إنّما هو سترها و نواحیها، و ظلّ اللیل: سواده، لأنّه یستر کلّ شیءٍ، و ظلّ الشمس ما سترته الشخوص من مسقطها. و أمّا الفیء فلایکون إلّا بعد الزوال و لایقال لما قبل الزوال فیءٌ، و إنّما سمّی ما بعد الزوال فیئاً لأنّه ظلٌّ فاء من جانبٍ إلى جانبٍ، و الفیء: الرجوع»(69)؛ انتهى.
و الحقّ انّ الظلّ مایحدث من الجسم الکثیف عند نور الشمس علیه، و الفیء هو الظلّ الحادث بعد الزوال، لأنّه مأخوذٌ من «فاء» بمعنى: رجع.
<و «السَموم» ـ بالفتح ـ: الریح الحارّة.
و «الحُسوم» ـ بالضمّ ـ:مصدرٌ – کالصعود و الهبوط -، یقال: حسمه حسماً و حُسوماً ـ من باب ضرب ـ یعنی(70) : قطعه؛ و منه قیل للسیف: حساماً، لأنّه قاطعٌ؛ أی: لاتجعل برده علینا قطعاً ـ أی: قاطعاً ـ>(71) أو هو بمعنى: التتابع، أی: لاتجعل برده علینا متتابعاً، فانّ البرد إذا تتابع أهلک؛ أو هو بمعنى: النحس و الشرّ(72)، یقال للّیل: الحسوم، لأنّها تحسم الخیر عن أهلها.
و «الصَوب» ـ بالفتح ـ: نزول المطر و انصبابه.
و «الرجم»: القتل، و أصله: الرمی بالحجارة. و «الرجوم» فی الدعاء یحتمل أن یکون جمعاً و مصدراً.
و «الأُجاج» ـ بالضمّ ـ: الشدید الملوحة؛ و قیل: «الشدید المرارة».
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ ارْزُقْنَا مِنْ بَرَکَاتِ السَّمَاوَاتِ وَ الاَْرْضِ، إِنَّکَ عَلَى کُلِّ شَىْءٍ قَدِیرٌ.
اختتم الدعاء بالصلاة للأمر بالابتداء و الاختتام بها فی الحدیث(73) لاستجابة الدعاء ـ
کما مرّ ذکره ؛ فتذکّر -.
و «البرکات»: جمع برَکَة – بالتحریک -، و هی الزیادة و النماء، و تطلق على مطلق الخیر.
و قوله – علیه السلام ـ: «إنّک على کلّ شیءٍ قدیرٌ» تعلیلٌ للدعاء و مزید استدعاءٍ
للإجابة.
—
هذا آخر اللمعة التاسعة عشرة من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة، إملاء المحتاج إلى رشحات رحمة الحضرة الأحدیّة محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة ـ ریّاها اللّه تعالى زروع آماله فی الدنیا و الآخرة -. و قد وفّقنی اللّه ـ تعالى ـ لاتمامها فی لیلة الأربعاء من شهر محرّم الحرام سنة إحدى و ثلاثین و مأتین و ألفٍ من الهجرة النبویّة.
1) راجع: «تهذیب الأحکام» ج 3 ص 147 الحدیث 21، «الخصال» ج 1 ص 242 الحدیث95.
2) کریمة 60 البقرة.
3) راجع: «کتاب الخلاف» ج 1 ص 685 المسألة 460، «المبسوط» ـ للسرخسی ـ ج 2 ص 76،«المجموع» ج 5 ص 100، «بدایة المجتهد» ج 1 ص 207.
4) قارن: «نور الأنوار» ص 116.
5) لم أعثر علیه. و قریبٌ منه: «انّ المؤمن لیدعو فیؤخّر اجابته إلى یوم الجمعة»، راجع: «الکافی»ج 2 ص 489 الحدیث 6، و انظر أیضاً: «من لایحضره الفقیه» ج 1 ص 422 الحدیث 1243.
6) المصدر: ـ و بهائمک.
7) راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 1 ص 527 الحدیث 1550، و انظر أیضاً: «مستدرک الوسائل» ج 6 ص 183 الحدیث 6720، «بحار الأنوار» ج 88 ص 339، «المصباح» ـ للکفعمیّ ـ ص 416.
8) هذا تحریر کلام ثانی الشهیدین، راجع: «الروضة البهیّة» ج 1 ص 690.
9) هذا قول محدّث الجزائری، راجع: «نور الأنوار» ص 116.
10) راجع: «المفردات» ص 415 القائمة 2 ـ مع تقدیمٍ و تأخیر ـ.
11) کریمة 21 الإنسان.
12) کریمة 16 الجن.
13) کما حکاه العلّامة المدنی، راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 233.
14) راجع: «صحاح اللغة» ج 1 ص 289 القائمة 1.
15) و انظر: «نور الأنوار» ص 117.
16) کریمة 12 الرعد.
17) کریمة 164 البقرة.
18) قال: «و السحاب جمع سحابة، و لذلک قال الثقال؛ و لو قیل الثقیل لجاز»، راجع: «مجمع البیان» ج 6 ص 21. فلایخفى ما فی کلام المصنّف.
19) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 234.
20) قارن: «نور الأنوار» ص 117، مع تغییرٍ یسیرٍ.
21) قارن: «نور الأنوار» ص 117.
22) هذا مختار العلّامة المدنیّ، راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 235.
23) قال الفیومیّ: «قالوا: و لایسمّى زهراً حتّى یتفتّح، و قال ابن قتیبة: حتّى یصفرّ»، راجع:«المصباح المنیر» ص 351.
24) قارن: «شرح الصحیفة» ص 195.
25) کریمة 51 الکهف.
26) لنقد هذا الاحتمال راجع: «نور الأنوار» ص 117.
27) المصدر: ـ لأنّ… عرفت.
28) کریمتان 16 / 15 عبس.
29) لم أعثر على هذا التفسیر فی کتب المفسّرین، فانظر مثلاً: «مجمع البیان» ج 10 ص 268،«التبیان» ج 10 ص 272، «تفسیر القرطبی» ج 19 ص 216.
30) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 235.
31) المصدر: لیس.
32) قال: «منّ علیه بالعتق و غیره منّاً ـ من باب قتل ـ، و امتنّ علیه به أیضاً: أنعم علیه به»،راجع: «المصباح المنیر» ص 798.
33) کریمتان 22 البقرة، 32 إبراهیم.
34) راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 236.
35) راجع: «صحاح اللغة» ج 2 ص 656 القائمة 1.
36) انظر: «شرح الصحیفة» ص 195.
37) انظر: نفس المصدر أیضاً.
38) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 238.
39) کریمات 19 / 50 الروم، 17 الحدید.
40) المصدر: منصوباً.
41) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 239.
42) کریمتان 16 / 15 العلق.
43) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 240.
44) هذا قول الهرویّ على ما حکاه عنه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 196. و انظر:«التعلیقات» ص 45، «نور الأنوار» ص 117.
45) القاموس: + و الوعید.
46) راجع: «القاموس المحیط» ص 900 القائمة 2.
47) قارن: «شرح الصحیفة» ص 196.
48) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 243.
49) کریمة 51 فصّلت.
50) «… و رجع عثمان بعد ثلاثة أیّام فقال النبیّ ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلم -: لقد ذهبت بهاعریضاً»، راجع: «نهج الحقّ» ص 249. و لم أعثر علیه بلفظه إلّا فی ما حکاه المحقّق الداماد،راجع: «شرح الصحیفة» ص 197.
51) کما حکاه المحدّث الجزائریّ، راجع: «نور الأنوار» ص 117.
52) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 244.
53) انظر: «القاموس المحیط» ص 213 القائمة 2.
54) راجع: «دیوان کثیّر عزّة» ص 112.
55) کریمة 16 البقرة.
56) البیت من معلّقة زهیر بن أبی سلمى الشهیرة، راجع: «جمهرة أشعار العرب» ص 107.
57) لجمیع ذلک راجع: «الطراز» ج 1 ص 236.
58) کذا، و قال المحدّث الجزائری: «بفتح السین مع التنوین مصدرٌ و بضمّها بلاتنوینٍ اسمه، کما فی نسخة ابن ادریس»، راجع: «نور الأنوار» ص 117.
59) کما عن الفیروزآبادیّ، راجع: «القاموس المحیط» ص 116 القائمة 1. و انظر: «التعلیقات» ص46، «نور الأنوار» ص 117.
60) و انظر: «شرح الصحیفة» ص 198.
61) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 246.
62) لجمیع ذلک راجع: «الذخیره فی علم الکلام» ص 274، «تقریب المعارف» ص 94، «أنوارالملکوت» ص 194، «إرشاد الطالبین» ص 293، «شرح القوشجی على التجرید» ص 357السطر 4.
63) قال: «نعشه اللّه – کمنعه ـ: رفعه… و فلاناً: جبره بعد فقرٍ، و المیّت: ذکره ذکراً حسناً»، راجع:«القاموس المحیط» ص 562 القائمة 1.
64) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 248.
65) کریمة 52 هود.
66) راجع: «القاموس المحیط» ص 946 القائمة 1.
67) کما حکاه العلّامة المدنیّ، راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 250.
68) هذا قول أبی الهیثم، راجع: «لسان العرب» ج 11 ص 416 القائمة 1.
69) راجع: «أدب الکاتب» ص 27.
70) المصدر: بمعنى.
71) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 250.
72) هذا هو مختار محقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 199.
73) اشارةٌ إلى قول أبی عبداللّه – علیه السلام ـ: «إذا دعا أحدکم فلیبدء بالصلاة على النبیّ ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ، فانّ الصلاة على النبیّ ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ مقبولةٌ، ولم یکن اللّه لیقبل بعض الدعاء و یردّ بعضاً»، راجع: «وسائل الشیعة» ج 7 ص 96 الحدیث8836، «الأمالی» – للطوسی ـ ص 172 الحدیث 290.