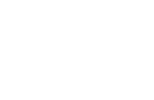اعلم! أنّه کما أردف اللّه ـ تعالى ـ توحیده باطاعة الوالدین أردف الشرک بالعقوق فی عدّة مواضع؛ و فی بعض الأخبار القدسیّة: «و عزّتی و جلالی و ارتفاع مکانی لو انّ العاقّ لوالدیه یعمل بأعمال الأنبیاء جمیعاً لم أقبلها منه!»(1)؛
و روی انّ أوّل مکتوبٍ فی اللوح المحفوظ: «إنّی أنا اللّه لا إله إلّا أنا، من رضی عنه والده فأنا عنه راضٍ و من سخط علیه والداه فأنا علیه ساخطٌ!(2)»(3)؛
و عن أبی جعفرٍ – علیه السلام ـ قال: «إنّ العبد لیکون بارّاً بوالدیه فی حیاتهما ثمّ یموتان فلایقضی عنهما دینهما(4) و لایستغفر لهما، فیکتبه اللّه عاقّاً، و انّه لیکون عاقّآ لهما فی حیاتهما غیر بارٍّ بهما فإذا ماتا قضى دینهما و استغفر لهما فیکتبه اللّه ـ عزّ و جلّ ـ بارّاً»(5)
و قد دلّت الأخبار و التجریة و الاعتبار على انّه لایردّ دعاء الوالد فی حقّ ولده، و انّ من لم یرض عنه أمّه یشتدّ علیه سکرات الموت و عذاب القبر؛ و علیک بحمل هذه الأخبار
على ماذکرناه.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، کَمَا شَرَّفْتَنَا بِهِ، وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، کَمَا أَوْجَبْتَ لَنَا الْحَقَّ عَلَى الْخَلْقِ بِسَبَبِهِ.
و على التحقیق الّذی ذکرنا ضمیر «شرّفتنا» و «لنا» یرجع إلى أئمّتنا – علیهم السلام ـ، أی: جعلتنا مشرّفین بأن صیّرتنا من المصلّین علیه بالصلاة الکافیة الوافیة بحقوق الجمع و التفصیل ـ کما مرّ تحقیق الصلاة مستوفىً فی اللمعة الثانیة ـ. و کما أوجبت لنا ـ معاشر الأئمّة ـ الحقّ الّذی أوجبه اللّه ـ سبحانه ـ على الخلق بسبب محمّدٍ ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ، فانّ جمیع الحقوق الّتی أوجبها اللّه ـ سبحانه ـ لرسوله على خلقه أوجبها لهم – علیه السلام ـ. و الشاهد على ذلک قوله ـ تعالى ـ: (أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الاَْمْرِ مِنْکُمْ)(6)
و قیل: «المراد من «الحقّ»: الموالاة، لأنّ محبّة الأئمّة واجبةٌ على الأمّة بسبب القرب إلى خاتم الرسالة حیث جعل اللّه مودّتهم أجراً للرسالة بقوله ـ سبحانه ـ: (قُلْ لاَأَسْأَلُکُمْ عَلَیهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُربَى)(7)».
و قال الفاضل الشارح: «الکاف فی الموضعین للتعلیل عند المثبتین له، و «ما» مصدریّةٌ، أی: لتشریفک إیّانا به و لإیجابک لنا الحقّ على الخلق بسببه. و منه عندهم قوله ـ تعالى ـ : (وَ اذْکُرُوهُ کَمَا هَدَاکُمْ)(8)، أی: لهدایته إیّاکم. و نفی الأکثرون ورود الکاف للتعلیل و قالوا:
هی فی ذلک و نحوه للتشبیه.
و «ما» إمّا مصدریةٌ، فالکاف و مجرورها فی محلّ نصبٍ نعتٌ لمصدرٍ محذوفٍ ـ و التقدیر فی قوله: «کما شرّفتنا به»: صلّ على محمّدٍ و آله صلاةً مماثلةً لتشریفک إیّانا به، أی: تکون
جزاءً لتشریفک إیّانا به؛ و قس علیه ما بعده و نحوه ـ ؛ و إمّا کافّةٌ لامحلّ لها من الإعراب، لأنّ الکاف لیست حینئذٍ بجارّةٍ، بل لمجرّد تشبیه مضمون الجملة بالجملة، و لذا لاتطلب فعلاً عاملاً یفضی معناه إلى مدخولها؛ نصّ علیه الرضیّ(9) قال ابن هشامٍ فی المغنی: «و فیه اخراج الکاف عمّا ثبت لها من عمل الجرّ من غیر(10) مقتضٍ»(11)؛
و هو فی محلّه. و من نفى ورود الکاف للتعلیل أجاب بأنّه من وضع الخاصّ موضع العامّ، إذ الذکر و الهدایة یشترکان فی أمرٍ ـ و هو الإحسان ـ، فهذا فی الأصل بمنزلة: و أحسن کما أحسن اللّه إلیک، و الکاف للتشبیه لا للتعلیل، فوضع الخاصّ ـ و هو الذکر ـ موضع العامّ ـ و هو الإحسان ـ ؛ و الأصل: و أحسنوا کما أحسن اللّه إلیکم؛ ثمّ عدل عن ذلک الأصل إلى خصوصیّة المطلوب ـ و هو الذکر و الهدایة ـ»(12)؛ انتهى کلامه.
و الحقّ انّ «الکاف» هنا للتشبیه لا للتعلیل ـ کما ذکرناه لک ـ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی أَهَابُهُمَا هَیْبَةَ السُّلْطَانِ الْعَسُوفِ، وَ أَبَرُّهُمَا بِرَّ الاُْمِّ الرَّؤُوفِ، وَ اجْعَلْ طَاعَتِی لِوَالِدَیَّ وَ بِرِّی بِهِمَا أَقَرَّ لِعَیْنِی مِنْ رَقْدَةِ الْوَسْنَانِ، وَ أَثْلَجَ لِصَدْرِی مِنْ شَرْبَةِ الظَّمْآنِ حَتَّى أُوثِرَ عَلَى هَوَایَ هَوَاهُمَا، وَ أُقَدِّمَ عَلَى رِضَایَ رِضَاهُمَا وَ أَسْتَکْثِرَ بِرَّهُمَا بِی وَ إِنْ قَلَّ، وَ أَسْتَقِلَّ بِرِّی بِهِمَا وَ إِنْ کَثُرَ.
«أهابُهما» ـ بصیغة متکلّم الوحدة، بضمّ الباء، و بفتحها بتقدیر حتّى ـ من: هاب الشیء یهابه: إذا خافه و إذا عظّمه و وقّره؛ کذا فی النهایة(13) و قال ابن فارس: «الهیبة: الإجلال»(14)،
فالفاعل: هائبٌ، و المفعول: مهیوبٌ، و مهیبٌ أیضاً.
و «هیبة السلطان» منصوبٌ بنزع الخافض، أی: کهیبة السلطان، أو مفعولٌ مطلقٌ.
و «العسوف»: الظلوم. و التشبیه فی مقدار الهیبة لا فی جنسها، لأنّ هیبته لسطوةٍ و قهرٍ و ظلمٍ، بخلاف هذه الهیبة، فانّها هیبة إجلالٍ و تعظیمٍ.
و «برّ» الوالدین: إحسان الطاعة إلیهما و الرفق بهما و تحرّی محابهما و توقّی مکارههما، یقال: بررت والدی أبرّه ـ من باب علم ـ أبراً و بروراً.
و «برّ الأمّ» أی: مثل برّ الأمّ المشفقة لولدها. و قال الفاضل الشارح: «و برّ الأمّ مفعولٌ مطلقٌ مبیّنٌ للنوع، إلّا انّه فی الأوّل ـ أی: هیبة السلطان ـ مضافٌ إلى مفعولٍ و فی الثانی ـ أی: برّ الأمّ ـ مضافٌ إلى الفاعل ـ أی: برّ الأمّ الرؤوف لولدها ـ»(15)؛ انتهى.
و قوله – علیه السلام ـ: «أقرّ لعینی» أفعل تفضیلٍ من القُرّ ـ بالضم ـ، و هو البرّ؛ و هو کنایةٌ عن السرور، لما تحقّق فی اللمعة الأولى من أنّ دمعة الفرح باردةٌ و دمعة الحزن حارّةٌ، و لهذا یقال فی الدعاء لزیدٍ مثلاً: أقرّ اللّه عنیه، کنایةً عن السرور، و: أسخن اللّه عینه، کنایةً عن الحزن(16) و قال المفضّل: «فی قرّة العین ثلاثة أقوالٍ:
أحدها: تبرّد دمعها، لأنّه دلیل السرور و الضحک کما انّ حرّه دلیل الغمّ و الحزن؛
و الثانی: نومها، لأنّه یکون مع فراغ الخاطر و ذهاب الحزن؛
و الثالث: حصول الرضا(17)، فلاتطمع لشیءٍ آخر.
و قد یؤخذ من القرار، أی: حصل مطلبه حتّى تقرّ عینه و لا تتحرّک و لاتنظر إلى الأطراف و الجوانب لمشاهدة المطلوب.
و «الرقدة»: النوم.
و «الوسنان»: الناعس، أو شدید النعاس؛ کما انّ العطشان شدید العطش. و لمّا کان النوم قرّة عینٍ لشدید النعاس فطلب من اللّه أن یجعل الطاعة و البرّ للوالدین أقرّ و أحسن و أطیب من النوم بالنسبة إلى حریص النوم و شدید النعاس.
و «أثلج» أی: أسرّ و أبرد؛ قال الجوهریّ: «ثلُجت نفسی ـ بضمّ اللام ـ أی: اطمأنّت(18)»(19)، و هو مأخوذٌ من الثلج، و هو بالفارسیّة: البرف.
<و «الشربة»: المرّة الواحدة من الشرب، و: من الماء: ما یشرب مرّةً.
و «الظمآن»: العطشان. و قیل: «المراد به: شدّة العطش»؛
و هو الأنسب هنا>(20) أی: اجعل طاعتی و برّی أبرد لکبدی الحرّاء من شرب الماء، لأنّ شدید العطش قرّة عینه شرب الماء.
«حتّى أوثر» أی: أختار، یقال: آثرت هذا على ذلک ـ بالمدّ ـ ایثاراً: فضّلته و رجّحته.
و «الهوى»: إرادة النفس. و یکون فی الخیر و الشرّ على الأشهر، خلافاً لمن خصّه بالشرّ.
و «استکثرت» الشیء: عدّدته کثیراً؛ و نقیضه: «استقلته» أی: عدّدته قلیلاً.
اللَّهُمَّ خَفِّضْ لَهُمَا صَوْتِی، وَ أَطِبْ لَهُمَا کَلاَمِی، وَ أَلِنْ لَهُمَا عَرِیکَتِی، وَ اعْطِفْ عَلَیْهِمَا قَلْبِی، وَ صَیِّرْنِی بِهِمَا رَفِیقاً، وَ عَلَیْهِمَا شَفِیقاً.
«خفض» الصوت: خلاف الجهر. و هو إمّا حقیقةٌ ـ لأنّ رفع الصوت بالنسبة إلى ذوی الأقدار خلاف الآداب، کما قال سبحانه: (وَ لاَتَرفَعُوا أَصْوَاتَکُمْ فَوقَ صَوتِ النَّبِیِّ)(21) ـ، و إمّا مجازٌ کنایةً عن التواضع و التذلّل بالنسبة إلیهما.
و «الطیّبات» من الکلام: أفضله و أحسنه، أی: وفّقنی لأن أطیّب لهما کلامی؛ و هذه إشارةٌ إلى قوله ـ تعالى ـ: (وَ لاَتَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ)، و قوله ـ سبحانه ـ: (وَ قُلْ لَهُمَا قَولاً کَرِیماً)(22) و عن الصادق – علیه السلام ـ فی تفسیر هذا قال: «إن ضجراک فلاتقل لهما أفٍّ، و إن ضرباک فقل لهما: غفر اللّه لکما، فذلک منک قولٌ کریمٌ». ثمّ (وَ اخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ)(23) قال: «لاتملأ عینیک من النظر إلیهما إلّا برحمةٍ و رأفةٍ. و لاترفع صوتک فوق أصواتهما و لایدک فوق أیدیهما و لاتقدّم قدّامهما»(24)
و قیل: «القول الکریم أن تقول لهما: یا أبتاه، یا أمّاه دون تسمیتهما باسمهما».
و «ألن لهما عریکتی» أی: اسلس لهما خلقی و اکسر نخوتی. و قیل: «العریکة: الطبیعة»(25)؛
و قیل: «الخلق»؛ و قیل: «النفس». و قال الزمخشریّ: «فلانٌ لیّن العریکة: إذا کان سلسلاً»(26)؛ و قد مرّ بیانه فی اللمعة العشرین.
و «اعطف» أی: اشفق علیهما «قلبی»، من: عطف علیه عطفاً: أشفق و تحنّن.
<و «الرفق»: اللطف، رفَق به یرفُق ـ من باب قتل ـ فهو رفیقٌ.
و «أشفق» علیه إشفاقاً: رقّ له و رحمه، و الاسم: الشَفَقَة ـ بالتحریک ـ. و تقدیم المجرور على المفعول فی الفقرات کلّها لإظهار الاعتناء به و إبراز الرغبة فی المؤخّر بتقدیم
أحواله>(27)، فانّ تأخیر ما حقّه التقدیم عمّا هو من أحواله المرغّبة فیه کما یورث شوق السامع إلى وروده ینبىء عن کمال رغبة المتکلّم فیه و اعتنائه بحصوله لامحالة.
اللَّهُمَّ اشْکُرْ لَهُمَا تَرْبِیَتِی، وَ أَثِبْهُمَا عَلَى تَکْرِمَتِی، وَ احْفَظْ لَهُمَا مَا حَفِظَاهُ مِنِّی فِی صِغَرِی.
أی: اجزهما حسن الجزاء علیهما لتربیتهما إیّای.
و «أثابه» یثیبه: جازاه على صنیعه و کافأه به، و الاسم: الثواب. و هو عوضٌ مستحقٌّ غیر منقطعٍ یوصل إلى مستحقّه على سبیل التعظیم و الإجلال؛ و بقید «المستحقّ» یخرج التفضّل، و بـ «التعظیم»: الأجرة، و بـ «غیر الانقطاع»: العوض.
«على تکرمتی» مصدرٌ مضافٌ إلى المفعول بمعنى: الإکرام، أی: بإکرامهما لی.
«فی صغری» بکسر الصاد: مقابل الکبر، و بفتحها بمعنى: الصغار و الهوان، و لیس بمرادٍ هنا.
اللَّهُمَّ وَ مَا مَسَّهُمَا مِنِّی مِنْ أَذىً أَوْ خَلَصَ إِلَیْهِمَا عَنِّی مِنْ مَکْرُوهٍ، أَوْ ضَاعَ قِبَلِی لَهُمَا مِنْ حَقٍّ فَاجْعَلْهُ حِطَّةً لِذُنُوبِهِمَا، وَ عُلُوّاً فِی دَرَجَاتِهِمَا، وَ زِیَادَةً فِی حَسَنَاتِهِمَا، یَا مُبَدِّلَ السَّیِّئَاتِ بِأَضْعَافِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ.
«مسّه» یمسّه ـ من باب تعب، و فی لغةٍ من باب قتل ـ: لمسه بیده؛ قال فی الکشّاف: «المسّ مستعارٌ للإصابة(28)، و منه قوله ـ تعالى ـ: (إِنْ تَمْسَسْکُمْ حَسَنَةٌ)(29)»(30)؛ و قال فی الأساس: «و من المجاز: مسّه الکبر و مسّه العذاب»(31)
و «من» الأولى: للابتداء، و الثانیة: للتبیین.
و «الأذى»: المکروه الیسیر، أی: الأذى الّذی مسّهما من جانبی.
و «خلَصَ» ـ على وزن نصر ـ هنا بمعنى: وصل؛ قال فی الأساس: «خلص إلیهم: وصل، و خلص إلیه الحزن و السرور»(32)؛ أی: المکروه الّذی وصل إلیهما من قبلی، فلایحتاج إلى القول بالتضمین بمعنى: بلغ ـ کما قیل ـ.
و قوله – علیه السلام ـ: «أو ضاع لهما قبلی من حقٍّ».
<«قِبَلی» ـ بکسر القاف و فتح الباء ـ أی: عندی؛ قال الفارابیّ فی دیوان الأدب: «یقال: لی قِبَل فلانٍ حقٌّ أی: عنده»(33)>(34)، أی: صار ضائعاً بوسیلتی حقّهما الواجب علیّ أو على غیری.
و «الفاء» من قوله: «فاجعله» لربط شبه الجواب بشبه الشرط.
و «حطّة» أی: محواً، من: حطّه الشیء یحطّه: إذا نزله و ألقاه. قال ابن الأثیر فی النهایة: «فیه: من ابتلاه(35) ببلاءٍ فی جسده فهو له حطّةٌ، أی: تحطّ عنه خطایاه و ذنوبه؛ و هی فعلةٌ من حطّ الشیء یحطّه»(36) أی: اجعله سبباً لامحاء ذنوبهما و علوّاً ـ… إلى آخره ـ.
و هذا بناءً على ما تقدّم من ابتلاء المؤمنین فی هذه الدار بالبلایا و المحن، إمّا حطّةً لأوزارهم أو رفعةً لمقدارهم أو زیادةً فی حسناتهم، و لذلک ختمه بقوله – علیه السلام ـ : «یا مبدّل السیّئات بأضعافها من الحسنات». و قد تقدّم القول فی هذه الفقرة فی وجه اعتراف أهل العصمة بالذنوب و الخطیئة بما لامزید علیه؛ فلیرجع إلیه.
اللَّهُمَّ وَ مَا تَعَدَّیَا عَلَیَّ فِیهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ أَسْرَفَا عَلَیَّ فِیهِ مِنْ فِعْلٍ أَوْ ضَیَّعَاهُ
لِی مِنْ حَقٍّ، أَوْ قَصَّرَا بِی عَنْهُ مِنْ وَاجِبٍ، فَقَدْ وَهَبْتُهُ لَهُمَا، وَ جُدْتُ بِهِ عَلَیْهِمَا، وَ رَغِبْتُ إِلَیْکَ فِی وَضْعِ تَبِعَتِهِ عَنْهُمَا، فَإِنِّی لاَأَتَّهِمُهُمَا عَلَى نَفْسِی، وَ لاَأَسْتَبْطِئُهُمَا فِی بِرِّی، وَ لاَأَکْرَهُ مَا تَوَلَّیَاهُ مِنْ أَمْرِی.
«و ما تعدّیا» أی: تجاوزا عن الحدّ الواجب، من: عدا علیه و تعدّى و اعتدّ: ظلمه و تجاوز الحدّ.
و ضمیر «فیه» و «ضیّعاه» و «عنه» راجعٌ إلى «ما».
و «قصّرا بی عنه» أی: لم یبلغا لی إلیه و لم یحصلا لی، من: قصّر به عن الشیء تقصیراً: لم یبلغ به إلیه.
«فقد وهبته لهما». دخول «الفاء» على الخبر لتضمّنه معنى الشرط.
و «جدت» من: الجود.
و «رغبت» إلى اللّه: تضرّعت إلیه و سألته.
و «تَبِعَة» ـ على وزن کلمة ـ: ما تطلبه من ظلامةٍ و نحوها.
و «الفاء» من قوله: «فانّی لاأتّهمهما» للسببیّة بمعنى: اللام، فهی للدلالة على سببیّة مابعدها لما قبلها؛ أی: لأنّی لاأعتقد الریبة بهما فی نفسی، من: اتّهمته فی قوله: شککت فی صدقه. و اصله: اوتهمت ـ لأنّه من الوهم ـ، قلبت الواو یاءً لسکونها و انکسار ماقبلها، ثمّ أبدلت منها التاء فأدغمت فی تاء الافتعال.
و «لاأستبطئهما» أی: لاأعتقد بطوءهما فی برّی، من: استبطأته: اعتقدته و رأیته بطیئاً. و هو استفعالٌ من البُطؤ ـ بالضمّ، مهموز الآخر ـ، و هو نقیض السرعة.
و قوله: «و لا أکره ما تولّیاه من أمری»، یقال: تولّى الأمر تولیةً: صار علیه والیاً؛ أی: ما فعلاه و تصدّیا به فی حقّی لیس مکروهاً لی، بل کلّ ما فعلاه مرضیٌّ حسنٌ عندی.
یَا رَبِّ فَهُمَا أَوْجَبُ حَقّاً عَلَیَّ، وَ أَقْدَمُ إِحْسَاناً إِلَیَّ، وَ أَعْظَمُ مِنَّةً لَدَیَّ مِنْ أَنْ أُقَاصَّهُمَا بِعَدْلٍ، أَوْ أُجَازِیَهُمَا عَلَى مِثْلٍ، أَیْنَ إِذاً یَا إِلَهِی طُولُ شُغْلِهِمَا
بِتَرْبِیَتِی؟! وَ أَیْنَ شِدَّةُ تَعَبِهِمَا فِی حِرَاسَتِی؟! وَ أَیْنَ إِقْتَارُهُمَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا لِلتَّوْسِعَةِ عَلَیَّ؟! هَیْهَاتَ! مَا یَسْتَوْفِیَانِ مِنِّی حَقَّهُمَا، وَ لاَأُدْرِکُ مَا یَجِبُ عَلَیَّ لَهُمَا، وَ لاَأَنَا بِقَاضٍ وَظِیفَةَ خِدْمَتِهِمَا، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعِنِّی یَا خَیْرَ مَنِ اسْتُعِینَ بِهِ، وَ وَفِّقْنِی یَا أَهْدَى مَنْ رُغِبَ إِلَیْهِ، وَ لاَتَجْعَلْنِی فِی أَهْلِ الْعُقُوقِ لِلاْبَاءِ وَ الاُمَّهَاتِ. یَوْمَ تُجْزَى کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ وَ هُمْ لاَیُظْلَمُونَ.
و «الفاء» من قوله: «فهما أوجب حقّاً ـ… إلى آخره ـ» سببیّةٌ إذ کان مابعدها سبباً لما قبلها، فهی لتعلیل جعله عدم اتّهامهما على نفسه و استبطاءهما فی برّه و کراهیّته لما تولّیاه من أمره سبباً لتجاوزی عن مؤاحذتهما، لأنّهما أوجب حقّاً علیَّ ـ … إلى آخره ـ.
و «أوجب» أی: ألزم و أثبت، من: وجب الشیء: إذا لزم و ثبت.
و «حقّاً» منصوبٌ على التمییز؛ و قس علیه قوله: «أقدم إحساناً و أعظم منّةً».
و «من» فی قوله: «من أن أقاصّهما» لیست صلةً لأفعل، بل متعلّقةٌ بالبعد المفهوم من التفضیل، لعدم صحّة قصد التفضیل و المشارکة للمفضّل علیه تحقیقاً أو تقدیراً، بل اسم التفضیل هنا مخرجٌ عن معناه التفضیلیّ إلى التجاوز و البعد الّذی یلزمه، فانّ التفضیل یستلزم بعد المفضّل عن المفضّل علیه. فکأنّه قیل: هما بعیدان من جهة الحقّ من مقاصّتی لهما؛ أو المعنى: هما أبعد الناس حقّاً من مقاصّتی لهما ـ على تضمین أفعل معنى أبعد ـ ؛ هکذا ذکره الشارح الفاضل(37)
و هو کماترى!.
و «الفاء» تفریعیّةٌ، و الأفعل بمعناه.
و «من أقاصّهما» متعلّقٌ بـ «أوجب»، و «من» تفضیلیّةٌ.
و «قاصصته» مقاصّةً ـ من باب فعل ـ: فعلت به مثل مافعل؛ و الاسم: القصاص؛ و
یجب ادغام الفعل و المصدر و اسم الفاعل، یقال: قاصّه مقاصّةً کما یقال: سارّه مسارّةً و حاجّه محاجّةً. و المعنى: انّ والدیّ أوجب حقّاً من أن أحسب اساءتهما فی مقابلة إحسانهما لدیّ. فقوله – علیه السلام ـ: «أن أقاصّهما» مفضّلٌ علیه لکلّ واحدٍ من الفقرات الثلاث على سبیل التنازع.
«أو أجازیهما على مثلٍ».
«أو» للتنویع؛ و «على مثلٍ» متعلّقةٌ بمحذوفٍ صفةٌ لمصدرٍ مؤکّدٍ محذوفٍ، أی: أکافیهما مکافاةً کائنةً على مثلٍ ـ أی: مماثلةً ـ لفعلهما من الإساءة، إذ المجازاة إنّما تکون على نفس الفعل لا على مثل الفعل. و الفرق بین «المقاصّة» و «المجازاة» تکون بمقابلته من غیر جنسه ـ کمقابلة الشتم بالضرب ـ. فکان مفادّ کلٍّ من الفقرتین غیر الأخرى.
و قیل: «معنى هذا الفقرة: أکافیهما بمثل ما فعلا بی من الخیر و الشرّ؛ و أمّا المقاصّة فهو مخصوصٌ بمجازاة الشرّ. فان قیل: إذا کافأهما بمثل ما فعلا به من الخیر و الشرّ فقد أنصفهما و أدّى حقّهما، فکیف یقول: «فأین إذاً شدّة تعبهما»؟
قلت: المراد انّ شرّهم و ضرّرهم اضمحلّ فی الخیر الکثیر، و لیس فی طاقتی مکافاة ما بقی من خیرهما مجّاناً، و انّه أکثر و أعظم من ذلک»؛ انتهى.
أقول: اختصاص المقاصّة بمجازات الشرّ خلاف العرف و اللغة. و هذا السؤال و الجواب أیضاً لیسا بشیءٍ!.
و قیل: «یعنی إذا أجازیهما بالتقصیر الّذی صدر عنهما فی حقّی بأن أقصّر أیضاً فی حقّهما، فأین تذهب إذاً المدّة الطویلة الّتی کانا یشتغلان فیهما بتربیتی؟؛ یعنی: یبقى مشقّتهما فی حفظی و تضیّقهما على أنفسهما للتوسعة ـ بأن لم یأکلا حتّى آکل و لم یلبسا حتّى ألبس ـ بلامکافاةٍ أصلا، لأنّه إن لم أستوف حقّی منهما یصیر حقّی معادلاً لحقّهما؛ بل یبقى من قبلی فی حقّهما التقصیر المحض و من قبلهما فی حقّی البرّ و الإحسان الخالص»؛ انتهى.
هذا ما ذکروه.
و على التحقیق الّذی ذکرناه لک فی ابتداء الدعاء معنى هذه الفقرة: انّ مجازاة حقّهما أو بما
یساویه و یماثله غیر مقدورةٍ، لأنّ مساواة المعلول و مماثلته للعلّة من جمیع الجهات و الحیثیّات محالٌ ألبتّة، فما فی مرتبة المعلول معلولٌ و ما فی مرتبة العلّة علّةٌ بالبدیهة؛ فتبصّر تفهم!.
قوله – علیه السلام ـ: «أین إذاً ـ… إلى آخره ـ».
«أین» اسم استفهامٍ عن المکان. و لیس الاستفهام به على حقیقةٍ، بل المراد به استعظامه لحقّهما، أو اعتذاره باحسانهما إلیه.
<و «إذاً» عند الجمهور حرفٌ بسیطٌ؛ و «النون» فیها أصلٌ ـ کنون لمن و عن ـ. و هی حرف جوابٍ و جزاءٍ. و قال الزرکشیّ فی البرهان: «ذکر المتأخّرون(38) انّ إذا مرکّبةٌ من «إذ»ـ الّتی هی ظرف زمانٍ ماضٍ ـ و من جملةٍ بعدها تحقیقاً أو تقدیراً، لکن حذفت الجملة تخفیفاً(39) و أبدل منها التنوین ـ کما فی قولهم: حینئذٍ ـ. و لیست هذه الناصبة للمضارع، لأنّ تلک تختصّ به و لذا عملت فیه، و هذه لاتختصّ به بل تدخل على الماضی ـ نحو: (إِذاً لاَتَیْنَاهُمْ)(40)، (إِذاً لاَمْسَکْتُمْ)(41)، (إِذاً لاَذَقْنَاکَ ((42) ـ ؛ و على الاسم ـ نحو: (إِنَّکُمْ إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّبِینَ)(43) ـ. قال: و هذا المعنى لم یذکره النحاة، لکنّه قیاس ما قالوه فی إذاً»(44)؛ انتهى.
قال بعض المحقّقین: «و عدم ذکر النحاة لهذا المعنى هو الوجه، لأنّ «إذاً» هذه هی الناصبة للمضارع جزماً. و القول بأنّ تلک تختصّ بالمضارع ممنوعٌ، فقد صرّح النحویّون بعدم الاختصاص؛ قال فی التصریح: «حکى سیبویه عن بعض العرب الغاء إذن من عمل النصب
فی المضارع(45) مع استیفاء شروط العمل. و هو القیاس، لأنّها لاتختصّ(46)»(47)؛ انتهى. و قال الزجّاج و الفارسیّ: «الناصب أن مضمرةً بعدها لا هی، لأنّها غیر مختصّةٍ إذ تدخل على الجمل الابتدائیّة ـ نحو: إذاً عبداللّه یأتیک ـ، و تلیها الأسماء مبنیّةً على غیر الفعل».
و «إذاً» فی جمیع نسخ الصحیفة بالألف، إلّا ما شذّ؛ و هو الموافق لرسمها فی المصاحف.
و اختلف النحویّون فی ذلک، فجزم ابن مالکٍ فی التسهیل بأنّها تکتب بالألف مراعاةً للوقف علیها ـ لأنّها تبدل فی الوقف ألفاً تشبیهاً لها بتنوین المنصوب ـ ؛ و عزّاه ابن هشامٍ فی المغنی للجمهور؛ و قال أبوحیّان فی شرح التسهیل: «و ذهب المازنیّ و الأکثرون إلى انّها تکتب بالنون»؛ و اختلف النقل عن الفرّاء، فقال الرضیّ(48) و ابن هشامٍ: «قال الفرّاء: إن
أعملت کتبت بالألف و إلّا کتبت بالنون، للفرق بینهما و بین إذا الزمانیه؛ و أمّا إذا أعملت فالعمل یمیّزها عنها»(49)؛ و قال أبوحیّان: «فصّل الفرّاء فقال: إن ألغیت کتبت بالألف لضعفها،
و إن أعملت کتبت بالنون لقوّتها»؛ و حکی عن أبی العبّاس المبرّد انّه کان یقول: أشتهی أن أکوی ید من یکتب «إذن» بالألف! و أنا لواقفٌ علیها؛ و کذا وقف الفرّاء.
و قوله مردودٌ برسم الصحابة بالألف على حسب الوقف. و یخشی علیه عاقبة ما قال!، و لایعذّب بالنار إلّا خالقها!»؛ انتهى>(50)
و قوله – علیه السلام ـ: «فی حراستی» أی: حفظی و صونی عن الآفات.
و «فی» إمّا ظرفیّةٌ مجازیّةٌ؛ أو سببیّةٌ، أی: لأجل حراستی.
و قوله – علیه السلام ـ: «اقتارهما» مصدرٌ بمعنى: الفقر و التضییق فی المعاش؛ و قد مرّ غیر مرّةٍ. و فی روایة ابن ادریس: «افتهارهما»، و هو مصدرٌ بمعنى: القهر.
<و «هیهات»: اسم فعلٍ بمعنى: بعد. و قیل: «فی هیهات زیادة البعد و إن کان یفسّر ببُعدٍ»(51)
و قال الرضیّ: «کلّ ما هو بمعنى الخبر من أسماء الأفعال ففیه معنى التعجّب، فمعنى هیهات أی: ما أبعده، و شتّان أی: ما أشدّ الافتراق، و سرعان و بطآن أی: ما أسرعه و ما أبطأه»(52)
و فی «تاء» هیهات الحرکات الثلاث، فالفتح نظراً إلى أصله حین کان مفعولاً مطلقاً ـ لأنّ أصله المصدر ـ، و الکسر لالتقاء الساکنین ـ لأنّ أصل البناء السکون ـ، و الضمّ للتنبیه بقوّة الحرکة على قوّة معنى البعد فیه ـ إذ معناه ما أبعده، کما ذکرناه ـ». کذا یستفادّ من کلام الرضی.
و المستعمل من هذه اللغات استعمالاً غالباً الفتح بلاتنوینٍ؛ و فیها لغاتٌ أخر أوصلها فی القاموس إلى إحدى و خمسین لغة(53)>(54)
قال الفاضل الشارح: «و فاعل هیهات فی عبارة الدعاء ضمیرٌ مستترٌ عائدٌ إلى الوفاء بحقّ الوالدین ـ الّذی أفهمه قوله بعده: «ما یستوفیان منّی حقّهما» ـ، کما فی قوله ـ تعالى ـ : (هَیهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ)(55) انّ فاعله ضمیرٌ عائدٌ إلى التصدیق؛ أو الصحّة؛ أو الوقوع؛ أو الاخراج، المفهوم من قوله ـ تعالى ـ قبله: (أَ یَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ إِذَا مِتُّمْ وَ کُنتُمْ تُرَاباً وَ عِظَاماً أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ
((56)
فان قلت: ما قیل فی الآیة لامحذور فیه، لأنّه کالاضمار بعد الذکر، و أمّا ماذکرته فی الدعاء فهو کالاضمار قبل الذکر، و هو محذورٌ!
قلت: هو کقولهم فی باب التنازع ـ فی نحو: ضربنی و أکرمت زیداً ـ: انّ فاعل ضربنی
مضمرٌ قبل الذکر، لأنّه قد جاء بعده ما یفسّره على الجملة و إن لم یجىء لمحض التفسیر کما جاء فی نحو: ربّه رجلاً، فلااستبعاد فیما ذکرناه(57)
و على هذا فلک فی عبارة الدعاء دعوى حذف فاعل «هیهات» و قیام الجملة بعده مقامه؛ و هو ظاهرٌ.
و من الغریب ما توهّمه بعض المترجمین من جواز کون «ما» من قوله – علیه السلام ـ : «ما یستوفیان» مصدریّةً و هی و مسبوکها فاعل «هیهات»، و التقدیر: هیهات استیفاؤهما منّی حقّهما؛ مع أنّ قوله: «و لا أدرک ما یجب علیّ لهما» لایبقى معه مجالٌ لهذا التوهّم(58)، لأنّ «لا» معیّنةٌ لکون «ما» نافیةً، إذ لاتقترن «واو» العطف بـ «لا» إلّا إذا سبقت بنفیٍ»(59)؛ انتهى.
أقول: لایخفى تمحّل ما ذکره!، و الحقّ مع بعض المترجمین و الغرابة مردودةٌ علیه!.
و على التحقیق الّذی ذکرناه «البُعد» هنا محمولٌ على التعذّر، أی: لایمکن أن یستوفیا منّی حقّهما ـ للعلّة الّتی ذکرناها فی عدم القدرة على المجازات ـ.
قوله – علیه السلام ـ: «و لا أنا بقاضٍ» أی: مؤدٍّ.
و «باؤه» زائدةٌ، و هی فی الخبر غیر الموجب مقیسةٌ و لاتحتاج إلى متعلّقٍ للزیادة. و فی نسخةٍ «ما» بدل «لا».
و «الوظیفة»: ما یقدّر من عملٍ أو رزقٍ و نحو ذلک، أی: لا أقدر قضاء ما وظّفته علیَّ من خدمتهما. و قال فی القاموس: «الوظیفة: الشرط(60)»(61)؛ فالمعنى: و ما أنا بمؤدٍّ شرط خدمتهما.
و «الفاء» من قوله – علیه السلام ـ: «فصلّ على محمّدٍ و آله» فصیحةٌ، أی: إذا کان الأمر على ما ذکر فصلّ على محمّدٍ.
و «أعنّی» لما ذکرنا فی أوّل الدعاء. و حذف المستعان علیه و الموفّق له إمّا لتعیّنهما؛ أو
لإرادة التعمیم مع الاختصار.
و «من استُعِین به» بصیغة ماضی المجهول، و کذا «من رُغب إلیه».
و «فی» من قوله: «فی أهل العقوق» إمّا ظرفیّةٌ ـ کما مرّ غیر مرّةٍ ـ، أی: فی زمرة أهل العقوق؛ أو بمعنى: مع، أی: معهم ـ کما فی قوله تعالى: (فَادْخُلِی فِی عِبَادِی)(62)، أی: مع عبادی ـ.
و «الأمّهات»: جمع أمّ. قیل: «أصلها: أمّهة، و لهذا جمعت على أمّهات»؛
و أجیب بزیادة الهاء، و انّ الأصل أمّات ـ قال ابن جنّیٍّ: «دعوى الزیاة أسهل من دعوى الحذف»(63) ـ ؛
<و قیل: «کلٌّ من أمٍّ و أمّهةٍ لغةٌ برأسها، و الأمّات جمع أمّ و الأمّهات جمع أمّهة. و لاحاجة إلى دعوى زیادةٍ و لاحذفٍ. و کثر فی الناس أمّهات و فی غیر الناس أمّات، للفرق».
و «یوم تجزی ـ… إلى آخره ـ» متعلّقٌ بـ «لاتجعلنی»، و هو اقتباسٌ من قوله ـ تعالى ـ : (وَ لِتُجْزَى کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ وَ هُمْ لاَیُظْلَمُونَ)(64)؛ و التغییر الیسیر لایضرّ فی الاقتباس ـ
و قد سبق تحقیقه بما لامزید علیه فی اللمعة الأولى ـ.
و «یوم» منصوبٌ على الظرفیّة لـ «تجعلنی»، و الجملة فی محلّ جرٍ باضافة «یوم» إلیها.
و «بما کسبت» متعلّقٌ بـ «تجزى».
و «ما» إمّا موصولةٌ ـ أی: بالّذی کسبته ـ ؛ و إمّا مصدریّةٌ ـ أی: بکسبها ـ.
و «هم لایظلمون» فی محلّ نصبٍ على الحال من «کلٍّ»، لأنّها فی معنى الجمع. و جمع الضمیر لأنّه أنسب بحال الکسب، أی: لایظلمون بنقص ما یستحقّونه من الثواب و لابزیادة
ما یستحقّونه من العقاب>(65)
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ذُرِّیَّتِهِ، وَ اخْصُصْ أَبَوَیَّ بِأَفْضَلِ مَا خَصَصْتَ بِهِ آبَاءَ عِبَادِکَ الْمُوْمِنِینَ وَ أُمَّهَاتِهِمْ، یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.
«الآل» قیل: «أصله: أهل، بدلیل التصغیر فیقال: أهیل»؛
و قیل: «أصله: أوْل، تحرّکت الواو و انفتح ما قبلها فقلبت ألفاً ـ مثل: قال ـ»(66)
و «الذریّة» قد تقدّم الکلام علیها فی اللمعة الرابعة. و عطفها على الأولى من قبیل عطف الخاصّ على العامّ، لأنّ ذرّیة الرجل: نسله و آله و ذوا قرابته؛ فکلّ ذرّیةٍ آلٌ دون العکس.
و «اخصص» أمرٌ.
و «ما» إمّا موصولةٌ؛ أو موصوفةٌ.
و «المؤمنین» صفةٌ لـ «عبادک»، أی: خصّص أبویّ بأفضل الفضل و الثواب الّذی خصصت به؛ أو: بأفضل شیءٍ خصصت به عبادک المؤمنین.
اللَّهُمَّ لاَتُنْسِنِی ذِکْرَهُمَا فِی أَدْبَارِ صَلَوَاتِی، وَ فِی إِناً مِنْ آنَاءِ لَیْلِی، وَ فِی کُلِّ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ نَهَارِی.
«الأدبار»: جمع دبر ـ بالضمّ و بفتحتین ـ، و هو من کلّ شیءٍ عقبه؛ أی: فی أعقاب صلاتی، لأنّها محلّ إجابة الدعاء ـ کما سبق فی مبدء اللمعة الأولى ـ. و قد سبق فی مبدء الدعاء الثانی انّ المصلّی بالصلاة الحقیقیّة صارت أعضاؤه کلّها ألسنةً یدعوبها، فإذا دعا بکلّیّته أجابه مولاه ـ لقوله: (أُدْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ)(67) ـ، فلذا ورد: «انّ الدعاء فی أعقاب
الصلوات لایردّ»(68)
و المراد من «آناء لیلی»: ساعةٌ من ساعاته؛ قال الجوهریّ: «آناء اللیل: ساعاته»(69)
و «الساعة»: جزءٌ مّا غیر مقدّرٍ من أجزاء اللیل و النهار. و فی عرف أهل التنجیم تطلق على جزءٍ من أربعةٍ و عشرین جزءً من یومٍ بلیلته، فعلى هذا التعبیر بـ «الآن» لتغییر العبارة. و یجوز أن یکون المراد من «الآن» جزءٌ من أجزاء الزمان، و ذلک لأنّ تمام اللیل محلّ استجابة الدعاء.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اغْفِرْ لِی بِدُعَائِی لَهُمَا، وَ اغْفِرْ لَهُمَا بِبِرِّهِمَا بِی مَغْفِرَةً حَتْماً، وَ ارْضَ عَنْهُمَا بِشَفَاعَتِی لَهُمَا رِضىً عَزْماً، وَ بَلِّغْهُمَا بِالْکَرَامَةِ مَوَاطِنَ السَّلاَمَةِ.
«الباء» للسببیّة، أی: بسبب دعائی لهما و بسبب برّهما بی.
و «حتم» اللّه حتماً: أوجبه جزماً، أی: مغفرةً لازمةً واجبةً بحیث لایتخلّف عنها.
و «رضىً» بالقصر و التنوین.
و «عزماً» أی: معزوماً، من عزم اللّه أی: أراد و قصد و قطع و فرض؛ أی: مجزوماً لاشبهة فی تحقّقه و ثبوته.
و «الباء» من قوله: «بالکرامة» للملابسة، أی: متلبّسین بالکرامة؛ أو للسببیّة، أی: بسبب إکرامک لهما أو إکرامهما بکرامتهما علیّ.
و «المواطن»: جمع موطن بمعنى: الوطن، و هو مکان الولادة الجسمیّة أو المعنویّة. و المراد بـ «مواطن السلامة»: مواطن الأمن و العافیة؛ و هی المرتبة الإلهیّة على تحقیقنا، و الجنّة على
الظاهر لسلامتها عن الظلمة الإمکانیّة، أو عن المکارة الدنیویّة.
اللَّهُمَّ وَ إِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتُکَ لَهُمَا فَشَفِّعْهُمَا فِیَّ، وَ إِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتُکَ لِی فَشَفِّعْنِی فِیهِمَا حَتَّى نَجْتَمِعَ بِرَأْفَتِکَ فِی دَارِ کَرَامَتِکَ وَ مَحَلِّ مَغْفِرَتِکَ وَ رَحْمَتِکَ، إِنَّکَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ وَ الْمَنِّ الْقَدِیمِ، وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ.
و «شفّعهما» و «شفّعنی» کلاهما أمرٌ من باب التفعیل؛ یقال: شفّعه تشفیعاً.
قیل: «شفاعته هی السؤال فی التجاوز عن الآثام و المعاصی»(70)؛ و المعنى: انّه إن کانت مغفرتهما سابقةً لمغفرتی فاجعلهما شفیعین لی، و إن کنت مغفوراً قبلهما اجعلنی شفیعاً لهما.
<و «حتّى» بمعنى: کی التعلیلیّة، أی: کی نجتمع.
و «الرأفة»: أشدّ الرحمة.
و «الکرامة»: التعظیم و الإجلال. و المراد بـ «دار الکرامة»: الجنّة، لاکرام اللّه ـ تعالى ـ أهلها بأنواع الکرامة؛ و کذا المراد بـ «محلّ المغفرة و الرحمة»، فانّ المؤمن و إن صرف عمره فی الطاعة لایدخل الجنّة إلّا بالمغفرة و الرحمة!.
و قوله: «إنّک ذوالفضل العظیم» تعلیلٌ لما قبله>(71)
و المراد بـ «المنّ القدیم»: النعمة القدیمة، إشارةً إلى أنّ منّه أزلیّةٌ.
و قوله – علیه السلام ـ: «و أنت أرحم الراحمین»: جملةٌ تذییلیّةٌ إشارةً إلى أنّ الرحمة کما شملها أوّلاً من غیر سابقة استحقاقٍ شملها آخراً أیضاً بمجرّد الفضل و الرحمة.
—
هذا آخر اللمعة الرابعة و العشرین من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة
السجّادیّة، و قد وفّقنی اللّه ـ تعالى ـ لاتمامها فی لیلة الثلثاء لأربعٍ خلون من شهر ربیع الأوّل سنة إحدى و ثلاثین و مأتین بعد الألف من الهجرة النبویّة.
1) لم أعثر علیه.
2) المصدر: ـ و من سخط علیه… ساخطٌ.
3) راجع: «مستدرک الوسائل» ج 15 ص 176 الحدیث 17919، و لم أعثر علیه فی غیره.
4) المصدر: دیونهما.
5) راجع: «الکافی» ج 2 ص 163 الحدیث 21، «وسائل الشیعة» ج 21 ص 506 الحدیث27708، «بحار الأنوار» ج 71 ص 59، «الزهد» ص 33 الحدیث 87.
6) کریمة 59 النساء.
7) کریمة 23 الشورى.
8) کریمة 198 البقرة.
9) راجع: «شرح الرضی على الکافیة» ج 4 ص 338.
10) المغنی: الجرّ بغیر.
11) راجع: «مغنی اللبیب» ج 1 ص 234.
12) هکذا فی النسختین، و لکن فی المطبوع من المصدر لم توجد هذه الفقرة الأخیرة ـ أی: من قوله:و من نفى ورود… إلى قوله: الهدایة ـ، انظر: «ریاض السالکین» ج 4 ص 54.
13) قال ابن الأثیر: «یقال: هاب الشیء یهابه: إذا خافه و إذا وقّره و عظّمه»، راجع: «النهایة» ج 5ص 285.
14) راجع: «مجمل اللغة» ج 4 ص 458.
15) راجع: «ریاض السالکین» ج 4 ص 58، مع إضافة بعض الألفاظ.
16) و انظر: «شرح الصحیفة» ص 247.
17) إلى هنا قول المفضّل کما حکاه الرازی بعد أن حکى قول الزجّاج فی هذه اللفظة أیضاً، راجع:«التفسیر الکبیر» ج 24 ص 115.
18) قال: ثلَجت نفسی… إذا اطمأنّت.
19) راجع: «صحاح اللغة» ج 1 ص 302 القائمة 1.
20) قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 60.
21) کریمة 2 الحجرات.
22) کریمة 23 الإسراء.
23) کریمة 24 الإسراء.
24) راجع: «الکافی» ج 2 ص 157 الحدیث 1، «من لایحضره الفقیه» ج 4 ص 407 الحدیث5883، «وسائل الشیعة» ج 21 ص 487 الحدیث 27663، «مستدرک الوسائل» ج 15 ص197 الحدیث 17996، «تفسیر العیّاشی» ج 2 ص 285 الحدیث 39، و انظر: «نور الأنوار»ص 139.
25) کما عن الجوهریّ، راجع: «صحاح اللغة» ج 4 ص 1599 القائمة 1.
26) راجع: «أساس البلاغة» ص 417 القائمة 1.
27) قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 62.
28) الکشّاف: مستعارٌ لمعنى الإصابة.
29) کریمة 120 آل عمران.
30) راجع: «تفسیر الکشّاف» ج 1 ص 459.
31) راجع: «أساس البلاغة» ص 595 القائمة 2.
32) راجع: نفس المصدر ص 172 القائمة 1.
33) راجع: «دیوان الأدب» ج 1 ص 265 القائمة 2.
34) قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 67.
35) المصدر: + اللّه.
36) راجع: «النهایة» ج 1 ص 402.
37) راجع: «ریاض السالکین» ج 4 ص 71.
38) کذا فی النسختین، و لکن فی «البرهان» هذا القول منسوبٌ إلى بعض المتأخّرین کمعنىً منمعانی «إذن»، قال: «و ذکر بعض المتأخّرین لها معنىً ثالثاً و هی…»، راجع: التعلیقة الآتیة.
39) فی النسختین: تحقیقاً.
40) کریمة 67 النساء.
41) کریمة 100 الإسراء.
42) کریمة 75 الإسراء.
43) کریمة 42 الشعراء.
44) راجع: «البرهان فی علوم القرآن» ج 4 ص 187، مع اختلافٍ.
45) التصریح: ـ من عمل… المضارع.
46) التصریح: لأنّها غیر مختصّةٍ.
47) راجع: «التصریح على التوضیح» ج 2 ص 235.
48) راجع: «شرح الرضی على الکافیة» ج 4 ص 46.
49) راجع: «مغنی اللبیب» ج 1 ص 31.
50) قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 75 مع تلخیصٍ، وانظر أیضاً: «الحدائق الندیّة» ص 416.
51) هذا قول الواحدیّ على ما حکاه عنه العلّامة المدنیّ، انظر: التعلیقة السالفة.
52) لم أعثر علیه، نعم! قال: «و من أسماء الأفعال الّتی بمعنى الخبر هیهات … و منها شتّان بمعنى:افترق مع تعجّبٍ»، راجع: «شرح الرضی على الکافیة» ج 3 ص 102، 103.
53) لم أعثر علیه فی «القاموس المحیط».
54) قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 75.
55) کریمة 36 المؤمنون.
56) کریمة 35 المؤمنون.
57) هیهنا حذف المصنّف قطعةً من المصدر.
58) المصدر: لهذا التوهّم مجالٌ.
59) راجع: نفس المصدر ص 81.
60) قال: الوظیف…، و کسفینة:… الشرط.
61) راجع: «القاموس المحیط» ص 794 القائمة 1.
62) کریمة 29 الفجر.
63) کما حکاه عنه الفیّومی، راجع: «المصباح المنیر» ص 31.
64) کریمة 22 الجاثیة.
65) قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 83.
66) و انظر: «تاج العروس» ج 14 ص 34 القائمة 1.
67) کریمة 60 غافر.
68) لم أعثر علیه، و انظر: «مستدرک الوسائل» ج 5 ص 274 الحدیث 5851، «بحار الأنوار» ج90 ص 384.
69) قارن: «صحاح اللغة» ج 6 ص 2273 القائمة 2.
70) هذا قول علّامة المدنیّ، راجع: «ریاض السالکین» ج 4 ص 89.
71) قارن: نفس المصدر.