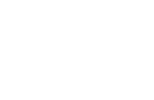قد ظهر لک الفرق بین الغیبة و البهتان، فان کان فی غیبته کان کذباً و غیبةً، و إن کان بحضوره کان کذباً و أذیّةً؛ و إثمه أشدّ من الغیبة؛ قال اللّه ـ تعالى ـ: (وَ مَنْ یَکْسِبْ خَطِیئَةً أَو إِثْماً ثُمَّ یرم بِهِ بَرِیئاً فَقَد احْتَمَلَ بُهتَاناً وَ إِثْماً مُبِیناً)(1)، و قال النبیّ ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ: «من بهت مؤمناً أو مؤمنةً أو قال فیه ما لیس فیه أقامه اللّه على تلٍّ من نارٍ حتّى یخرج ممّا قاله فیه»(2)
و «الذکر» قد سبق تحقیقه. و قال الفاضل الشارح: «ذِکر الشیء ـ بالکسر ـ: اجراؤه على اللسان؛ و قال الواحدیّ: معنى الذکر: حضور المعنى فی النفس.
ثمّ یکون تارةً بالقلب، و تارةً بالقول؛ و لیس شرطه أن یکون بعد نسیانٍ.
و المراد بـ «حسن الذکر»: الثناء على الإنسان فی غیبته و وصفه بما یسرّه ـ من تعدید محاسنه ـ.
«الحسنة»: من الصفات الجاریة مجرى الأسماء، و هی کلّ ما یتعلّق به المدح فی العاجل و الثواب فی الآجل؛ و ضدّها: السیّئة»(3)
و «أغظى» الرجل عینه إغضاءً: قارب بین جفنیها، ثمّ استعمل فی الحلم؛ أی: أحلم و أعفو.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ حَلِّنِی بِحِلْیَةِ الصَّالِحِینَ، وَ أَلْبِسْنِی زِینَةَ الْمُتَّقِینَ، فِی بَسْطِ الْعَدْلِ، وَ کَظْمِ الغَیْظِ، وَ إِطْفَاءِ النَّائِرَةِ، وَ ضَمِّ أَهْلِ الْفُرْقَةِ، وَ إِصْلاَحِ ذَاتِ الْبَیْنِ، وَ إِفْشَاءِ الْعَارِفَةِ، وَ سَتْرِ الْعَائِبَةِ، وَ لِینِ الْعَرِیکَةِ، وَ خَفْضِ الْجَنَاحِ، وَ حُسْنِ السِّیرَةِ، وَ سُکُونِ الرِّیحِ، وَ طِیبِ الْمخَالَقَةِ، وَ السَّبْقِ إِلَى الْفَضِیلَةِ.
و «حلِّنی»: أمرٌ من التحلیة، یقال: حلّیت المرأة تحلیةً: ألبتسها الحلیّ، و: السیف: جعلت له حلیةً.
و «الحِلیة» ـ بالکسر ـ: ما یتزیّن به من مصنوع المعدنیّات و الحجارة؛ و تعدیته بـ «الباء» لتضمینه معنى التزیین استعارةً مکنیّةً و تخییلیّةً. و أیضاً الحِلیة ـ بالکسرـ: الخلقة و الصفة؛ و حلیة الرجل: صفته؛ فالمعنى: زیّنی بزینة الصالحین، أو بصفتهم.
و «المتّقین»: جمع متّقی، اسم فاعلٍ من باب الإفعال من الوقایة؛ و هی: فرط الصیانة. و
«التقوى» فی عرف الشرع هی: اجتناب ما حرّم اللّه و أداء ما فرض اللّه؛ قال الصادق – علیه السلام ـ: «هی أن لایفقدک اللّه حیث أمرک و لایراک حیث نهاک»(4)؛ و قد تقدّم الکلام فیها فی اللعمة الرابعة.
و «فی» من قوله – علیه السلام ـ: «فی بسط العدل» للمصاحبة ـ نحو:(ادْخُلُوا فِی أُمَمٍ)(5)، أی: معهم ـ متعلّقٌ بـ «حلِّنی» و «ألبسنی» على سبیل التنازع؛ أی: حلّنی بحلیتهم ـ
أو: ألبسنی زینتهم ـ مع توفیقی لبسط العدل.
و «البسط»: النشر، یقال: بسَطَ الثوب بسْطاً ـ من باب قتل ـ: نشره.
و «العدل» قد مرّ معناه.
«کظم» غیظه کظماً ـ من باب ضرب ـ: إذا أمسک على ما فی نفسه منه و لم یظهره لابقولٍ و لابفعلٍ، و یقال بالفارسیّة: «فرو بردن خشم». و أصله من: کظم القربة: إذا ملأها و شدّ فاها. و هو من کمال الحلم، قال ـ تعالى ـ: (وَ الْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَ الْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ)(6) و الأخبار فی الحثّ علیه أکثر من أن تحصى؛ و لذا یلقّب إمامنا و مولانا موسى بن جعفر – علیه السلام ـ بـ «الکاظم».
قوله – علیه السلام ـ: «و اطفاء النائرة».
<«الاطفاء»: اخماد النار، یقال: طفأت النار تطفأ ـ بالهمز، من باب تعب ـ طفوءً ـ على وزن فعولٍ ـ خمدت؛ و منه: أطفأت الفتنة: إذا سکّنتها ـ على الاستعارة ـ.
و «النائرة»: العداوة و الشحناء، و هی مشتقّةٌ من النار؛ یقال: بینهم نائرةٌ أی: عداوةٌ و بغضاءٌ>(7)؛ و المراد ذهاب الفتنة من بین الناس. و قیل: «نارت الفتنة تنوّراً: إذا وقعت و انتشرت، فهی نائرةٌ».
و «ضمّ أهل الفُرقة» أی: صلحهم و وصلهم؛ یقال: ضممته ضمّاً فانظمّ: جمعته جمعاً فانجمع.
<و «الفُرقة» ـ بالضمّ ـ: اسمٌ من افترق القوم: إذا انفصل بعضهم عن بعضٍ بالأبدان. و قد تستعمل فی تفرّق القلوب، و هو المراد هنا>(8) <و هو من أعظم الطاعات و أفخم العبادات، حتّى أنّه قال الصادق - علیه السلام ـ: «المصلح لیس بکاذبٍ»(9) و ما بعد هذه الفقرة کالتأکید لها>(10)
قوله – علیه السلام ـ: «و اصلاح ذات البین».
«البَین» ـ بالفتح ـ: من الأضداد، یطلق على الوصل و على الفرقة. و قولهم: لإصلاح ذات البین أی: لإصلاح الفساد بین القوم.
و «ذات»: مؤنّث «ذا» بمعنى: الصاحب. و إنّما أنّثوا الذات لأنّ بعض الأشیاء قد یوضع له اسمٌ مؤنّثٌ و لبعضها اسمٌ مذکّرٌ؛ قالوا: دارٌ و حائطٌ، فأنّثوا الدار و ذکّروا الحائط؛ هکذا قال الأخفش فی قوله ـ تعالى ـ: (وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَینِکُمْ)(11) -(12)
و «العارفة»: المعروف، و هو الخیر و الاحسان.
و المراد بـ «افشائها» و اظهارها: حدیثها ـ کما قال سبحانه: (وَ أَمَّا بِنِعمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثٌ)(13) ـ، و کذا إذا کانت العارفة من غیره ـ سبحانه، کما ورد فی الأحادیث ـ.
و «العائبة»: مصدرٌ بمعنى العیب ـ کالعافیة و العارفة ـ. و المراد: ستر معایب المؤمنین ـ کما انّ الأولى نشر محاسنهم ـ.
<و «العریکة»: الطبیعة، و هی الخلق و السجیّة؛ یقال: فلانٌ لیّن العریکة: إذا کان سلساً مطاوعاً منقاداً منکسر النخوة. و فی صفته ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ: «أصدق الناس لهجةً و ألینهم عریکةً»(14)>(15)
و «خفض الجناح» عبارةٌ عن کمال التواضع و التطأطأ. و أصله ـ کما قال صاحب الکشّاف ـ: انّ(16) الطائر إذا أراد أن ینحطّ للوقوع کسر جناحه و خفظه، و إذا أراد أن ینهض للطیران رفع جناحه؛ فجعل خفض جناحه(17) مثلاً للتواضع(18) و لین الجانب»(19)؛ انتهى. و منه قوله ـ تعالى ـ: (وَ اخْفَضْ جَنَاحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ)(20)
و قیل: «الطائر إذا أراد ضمّ فرخه إلیه للتربیة خفض له جناحیه؛ فلهذا صار خفض الجناح کنایةً عن حسن التدبیر»(21)
و «السیرة»: الطریقة؛ یقال: سار الوالی فی الرعیّة سیرةً حسنةً أو قبیحةً: أی: طریقةً حسنةً أو قبیحةً.
<و «سکون الریح»: کنایةٌ عن الحلم و الوقار>(22)، لأنّ الحلیم ساکنٌ ریح غضبه و
طیشه، فاستعیر لفظ «الریح» للطیش و العجلة بجامع سرعة الحرکة. <و کثیراً مّا یستعمل سکون الریح فی الذمّ مراداً بالریح الدولة و الغلبة؛ و منه قوله ـ تعالى ـ: (وَ تَذْهَبَ ر
یحُکُم)(23)، أی: دولتکم و صولتکم. استعیرت الریح للدولة من حیث إنّها فی تمشّی أمرها و نفاذها مشبّهةٌ بها(24) فی هبوبها و جریانها؛ تقول العرب: هبّت ریح فلانٍ: إذا دالت له الدولة و نفذ أمره؛ و علیه قول الشاعر:
إِذَا هَبَّتْ رِیَاحُکَ فَاغْتَنِمهَا++
فَعُقبَى کُلِّ خَافِقَةٍ سُکُونُ
وَ لاَتَبخَلْ إِذَا أَیسَرتَ یَوماً++
فَمَا تدْرِی السُّکُونَ مَتَى یَکُونُ>(25)
<قوله - علیه السلام ـ: «و طیب المخالقة» بالخاء المعجمة و القاف: حسن التخلّق فی المعاشرة، و بالحاء المهملة و الفاء: حسن المؤاخاة؛ و فی الحدیث: «حالف رسول اللّه ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ بین المهاجرین و الأنصار»(26) أی: آخى بینهم(27)>(28)
قوله – علیه السلام ـ: «و السبق إلى الفضیلة».
«السبق»: التقدّم، قال الفیّومی: «و قد یکون للسابق لاحقٌ ـ کالسابق من الخیل ـ، و قد لایکون ـ کمن أحرز قصبة السبق، فانه سابقٌ إلیها و منفردٌ بها و لایکون له لاحقٌ»(29)؛ انتهى.
و الفضل و «الفضیلة»: خلاف النقص و النقیصة، و هی من الصفات الکمالیّة و الفضائل النفسانیّة.
و فی هذه الفقرات إشارةٌ إلى أنّ النفس الناطقة الإنسانیّة مادامت واقفةً مع النفس الأمّارة و مراداتها و استولب علیها بصفاتها جذبتها إلى الجهة السفلیّة و صیّرت مطالبها جزئیّةً ممّا یناسب مصالحها، فلذا إذا طلب کلّ شخصٍ ما یمنعه منه الآخر یقع العداوة
والبغضاء و تستولی القوّة الغضبیّة الطالبة للجاه و الکرامة و القهر و الغلبة و الریاسة و السلطنة، و یقع الاستکبار و الإباء و الأنفة و الاستنکاف، و یؤدّی إلى التقاطع و التهاجر و التحارب و التشاجر. و کلّما بعدت عن الجهة السفلیّة بالتوجّه إلى الجهة العلویّة و التنویر بأنوار الوحدة الذاتیّة و الصفاتیّة و الأفعالیّة ارتفعت عن مقام النفس الأمّارة و اتّصلت بروح القدس و صارت مطلبها کلّیّةً بلاتمانعٍ و لاتنافسٍ فیها ـ لامکان حصولها لهذا بدون حرمان الآخر ـ، و مال إلى من یجانسها فی الصفاء بالمحبة الذاتیّة، فانّ المحبّة ظلّ الوحدة و الألفة ظلّ المحبّة و العدالة ظلّ الألفة؛ فکلّما کانت أقرب إلى الوحدة کانت قوّة المحبّة فیه أشدّ و أقوى. فالمؤمنون بحسب قوّة إیمانهم تحصل الألفة بینهم؛ فتبصّر تفهم!.
وَ إِیثَارِ التَّفَضُّلِ، وَ تَرْکِ التَّعْیِیرِ، وَ الاِفْضَالِ عَلَى غَیْرِ الْمُسْتَحِقِّ، وَ الْقَوْلِ بِالْحَقِّ وَ إِنْ عَزَّ، وَ اسْتِقْلاَلِ الْخَیْرِ وَ إِنْ کَثُرَ مِنْ قَوْلِی وَ فِعْلِی، وَ اسْتِکْثَارِ الشَّرِّ وَ إِنْ قَلَّ مِنْ قَوْلِی وَ فِعْلِی، وَ أَکْمِلْ ذَلِکَ لِی بِدَوَامِ الطَّاعَةِ، وَ لُزُومِ الْجَمَاعَةِ، وَ رَفْضِ أَهْلِ الْبِدَعِ، وَ مُسْتَعْمِلِ الرَّأْیِ الْمخْتَرَعِ
«الإیثار»: الاختیار.
و «التفضّل»: الإحسان، أی: اختیار الإحسان. و قیل: «إیثار التفضّل یحتمل معانٍ:
أحدها: انّ التفضّل بمعنى الفضل و الفضیلة، فیکون کالتأکید لسابقه؛
و ثانیها: أن یکون بمعنى ما تفضّل اللّه به من الرزق الحلال المقسوم؛ یعنى: آثر طلبه على طلب الحرام؛
و ثالثها: انّ المراد به التفضّل على الناس بما أساؤوا إلیَّ و ترک مقاسّتهم و مؤاخذتهم؛
و رابعها: انّ المراد به ما فضل عن القوت»(30)
و «التعییر» ـ بالعین المهملة و الیاء التحتانیّة، <تفعیلٌ من العار ـ: و هو کلّ شیءٍ یلزم
منه عیبٌ؛ یقال: عیّرته کذا و عیّرته به: إذا نسبته إلى عارٍ فیه، یتعدّی بنفسه و بالباء. و أنکر صاحب القاموس تعدیته بالباء(31)>(32)، و تبعه السیّد السند الداماد؛ فقال: «و العامّة تقول:عیّره بکذا، و هو خطأٌ»(33) <و انکارهما لیس بشیء!، فقد ورد فی الحدیث الصحیح تعدیته بالیاء، روی ثقة الإسلام فی الکافی(34) بسندٍ صحیحٍ عن أبی عبداللّه - علیه السلام ـ قال:
«قال رسول اللّه ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ: من عیّر مؤمناً بذنبً لم یمت حتّى یرکبه»؛
و قال الصادق – علیه السلام ـ: «من عیّر مؤمناً عیّره اللّه فی الدنیا و الآخرة(35)»(36)؛ و فیه شاهدٌ على ذمّ التعییر المسؤول ترکه فی الدعاء.
قال العلماء: «لاینبغی تعییر مؤمنٍ بشیءٍ و لوکان معصیته ـ سیّما على رؤوس الخلائق ـ». و لاینافی وجوب الأمر و النهی عن المنکر، لأنّ المطلوب منهما أن یکونا على سبیل النصح؛ إلّا إذا علم أنّه لاینفعه فینبغی التشدید علیه ـ على النحو المقرّر ـ.
و فی نسخةٍ «التقتیر» بدل: «التعییر» ـ من: قتر فی نفقة عیاله أو على نفسه أی: ضیّق، و هو ضدّ الاسراف.
قوله – علیه السلام ـ: «و الإفضال على غیر المستحقّ» عطفٌ على «التعییر»>(32)، و هو قرینةٌ على أنّ ما فی بعض النسخ ـ من «التقتیر»(37) ـ أصحّ، إذ المعنى: ترک التقتیر فی الإنفاق، و هو البخل؛ و ترک الإفضال على من لایستحقّه، و هو الإسراف. و فی الصحیح
عن أبی عبداللّه – علیه السلام ـ: «إذا أردت أن تعلم أ شقیٌّ الرجل أم سعیدٌ فانظر سیبه و معروفه إلى من یصنعه، فان کان یصنعه إلى من هو أهله فاعلم انّه إلى خیرٍ، و إن کان یصنعه إلى غیر أهله فاعلم أنّه لیس له عند اللّه خیرٌ»(38) و من کلام الحکماء: «آفة الجود الخطأ
بالمواضع»؛ قال الشاعر:
لَقَدْ ظَلَمَ الْمَعرُوفَ مَانِعُ أَهلِهِ++
وَ أَظْلَمُ مِنهُ مُخطِىءٌ لِمَوَاضِعِهْ
وَ مِن سَفَهٍ أَنَّ الفَتَى یُبذِلُ النَدَى++
وَ یَجهَلُ فِی الاَقوَامِ أَهلَ صَنَائِعِهْ
قوله – علیه السلام ـ: «و القول بالحقّ و إن عزّ».
«القول»: الکلام.
و «الحقّ»: خلاف الباطل.
و «عزّ» إمّا ماضی یعَزّ ـ بفتح العین ـ بمعنى: شقّ و اشتدّ ـ کقول الشاعر:
عَزِیزٌ عَلَیَّ أَن تُرَى بِی کَآبَةٌ++
فَیُشمت عَارٌ أَو یُسَاءُ حَبِیبُ
و إمّا ماضی یعِزّ ـ بکسر العین ـ بمعنى: قلّ حتّى لایکاد یوجد.
و «إن» وصلیّةٌ.
و قوله – علیه السلام ـ: «و استقلال الخیر» أی: عدّه قلیلاً و إن کثر.
و «استکبار الشرّ» أی: عدّه کثیراً و إن قلّ.
و «من» فی: «من قولی و فعلی»، فی الأوّل بیانٌ للخیر، و فی الثانی للشرّ.
و فی هاتین الفقرتین تنبیهٌ على مقام العبودیّة المبنیّة على اندکاک جبل الأنّیّة و الخروج عن مرتبة النفسیّة ـ کما لایخفى على ذوی البصیرة ـ.
و قیل: «إشارةٌ إلى الخروج عن العجب»(39)؛
و هو لازمٌ من لوازم الخروج عن المرتبة النفسیّة.
قال الفاضل الشارح: «و اعلم! أنّ الواقع فی أکثر النسخ ذکر «القول» و «الفعل» معاً فی بیان الخیر و الاقتصار على «الفعل» فی بیان الشرّ. فوجّهه بعضهم بما نصّه: «یقال: فلانٌ قال خیراً و فعل خیراً، و هذا شائعٌ؛ و قد یقال: قال شرّاً، و قولهم: فعل شرّاً قلیلٌ. فلعلّه – علیه السلام ـ ذکر استکثار الشرّ من الفعل لأنّ المقام مقام استکثار القلیل، و إذا حصل استکثار القلیل من القلیل ـ الّذی هو الفعل ـ فما هو کثیرٌ بالنسبة إلیه بطریقٍ أولى. و یحتمل انّه – علیه السلام ـ ذکر القول و الفعل معاً فی الخیر لتمام رغبته فیه و ارادته بجمیع أفراده، بخلاف الشرّ»؛ انتهى.
أقول: لایخفى ما فی الوجه الأوّل من الضعف؛
أمّا أوّلاً: فلأنّ دعواه(40): «إنّ قولهم: فعل شرّاً قلیلٌ» ممنوعٌ، بل قولهم: فعل خیراً و فعل شرّاً سیّان فی الشیوع و کثرة الاستعمال؛ و کفى شاهداً قول أمیرالمؤمنین – علیه السلام ـ : فی نهج البلاغة(41): «فاعل الخیر خیرٌ منه و فاعل الشرّ شرٌّ منه»؛ و فی الخبر: «إنّ للّه ملکاً ینادی: یا فاعل الخیر بشّروا! یا فاعل الشرّ اقصروا!»(42)؛
و أمّا ثانیاً: فلأنّ الکثرة و القلّة فی الدعاء انّما هی(43) بالنسبة إلى الوقوع، و ما دعاه من القلّة إنّما هو بالنسبة إلى التلفّظ؛ و أین أحدهما من الآخر؟!.
و أمّا الوجه الثانی فقد یعارض بأنّ الاهتمام بتوقّی الشرّ أولى من الاهتمام بطلب الخیر ـ خصوصاً و هو فی مقام السؤال لاستقلال الخیر منه ـ.
ثمّ الشرّ من القول أولى بالذکر، لتوهّم أکثر الناس أنّه لایضرّ، کما فی حدیث معاذ بن
جبل حیث قال له رسول اللّه ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ: «کفّ علیک(44) هذا ـ و أشار إلى لسانه -،
قلت: یا رسول اللّه! و إنّا لمؤاخذون بما نتکلّم به؟!
قال: ثکلتک أمّک یا معاذ! و هل یکبّ الناس على وجوههم ـ أو قال: على مناخرهم ـ إلّا حصائد ألسنتهم؟!»(45)
و الأولى أن یوجّه ذلک بوجهین:
أحدهما: التنبیه على أنّه یجب ان یعدّ القول من الفعل و یحسب(46) دخوله فی العمل، کما روی عن أبی عبداللّه – علیه السلام ـ قال: «قال رسول اللّه ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ: من رءا موضع کلامه من عمله قلّ کلامه إلّا فیما یعنیه»(47)
و آثر التنبیه على ذلک فی جانب الشرّ لمزید الاهتمام ببیانه فیه ـ حثّاً على التوقّی منه، کما وقع فی الحدیثین المذکورین ـ ؛
و الثانی: انّه لمّا کان القول أعظم کیفیّةً و أکثر کمّیّةً من الفعل لبلوغه ما لایبلغ الفعل و لعمومه من کلّ وجهٍ ـ لأنّ آلته الّتی هی اللسان لها تصرّفٌ فی کلّ موجودٍ و موهومٍ و معدومٍ، و له یدٌ فی العقلیّات و الخیالیّات و المسموعات و المبصرات و المذوقات و الملموسات ـ، بخلاف الفعل ـ فانّ کلّ جارحةٍ سوى اللسان تتعلّق بفعلٍ مخصوصٍ، فهو أقلٌّ من القول ـ ذکر – علیه السلام ـ الفعل دون القول؛ لأنّ من استکثر القلیل فاستکثاره للکثیر أولى.
و یناسب هذا المعنى ما رواه ثقة الإسلام فی الکافی(48) عن أبی عبداللّه – علیه السلام ـ قال: «قال رسول اللّه ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ: یعذّب اللّه اللسان بعذابٍ لایعذّب به شیئاً من الجوارح، فیقول أی ربّ! عذّبتنی بعذابٍ لم تعذّب به شیئاً!
فیقال له: خرجت منک کلمةٌ فبلغت مشارق الأرض و مغاربها، فسفک بها الدم الحرام و انتهب بها الفرج الحرام؛ و عزّتی(49) لأعذّبنّک بعدابٍ لا أعذّب به شیئاً!».
و روى(50) أیضاً بسندٍ نقیٍّ عن صاحب الدعاء ـ: علیّ بن الحسین، صلوات اللّه علیهما ـ قال: «إنّ لسان ابن آدم یشرف على جمیع جوارحه کلّ صباحٍ فیقول: کیف أصبحتم؟
فیقولون: بخیرٍ إن ترکتنا!؛ و یقولون: اللّه اللّه فینا! و یناشدونه؛ و یقولون: انّما نثاب و نعاقب بک»؛ و اللّه أعلم!.
و من غریب ما وقع لأبی یوسف یعقوب المعروف بابن السکّیت ـ و کان من أکابر علماء العربیّة و عظماء الشیعة، و هو من أصحاب الجواد الهادی علیه السلام ـ انّه قال فی التحذیر من عثرات اللسان:
یُصَابُ الْفَتَى مِن عَثْرَةٍ بِلِسَانِهِ++
وَ لَیسَ یُصَابُ الْمَرءُ مِن عَثْرَةِ الرِّجلِ
وَ عَثرَتُهُ فِی الْقَولِ تُذهِبُ رَأْسَهُ++
وَ عَثرَتُهُ فِی الْرِجلِ تبرأ عَنْ مهلِ
فاتّفق انّ المتوکّل العباسیّ ألزمه تأدیب ولدیه ـ: المعتزّ و المؤیّد ـ ؛ فقال له یوماً: أیّ أحبّ إلیک أبنای هذان أم الحسن و الحسین؟
فقال: و اللّه انّ قنبر خادم علیٍّ خیرٌ منک و من ابنیک!
فقال المتوکّل لأتراکه: سلّوا لسانه من قفاه!!. ففعلوا!، فمات ـ رحمه اللّه ـ، و ذلک لخمسٍ خلون من رجب سنة أربعٍ و أربعین و مأتین(51)»(52)؛ انتهى کلامه ـ رحمه اللّه ـ.
أقول: ما أورده على الموجّه واردٌ، و لکن ما ذکره من الوجهین مردودٌ؛
أمّا الأوّل منه: فلأنّ عدّ القول من الفعل و حساب دخوله فی العمل مشترکٌ بین الخیر و الشرّ ـ کما هو المستفادّ من الخبر ـ، فلایکون علّةً لترک القول فی الشرّ؛
و أمّا الثانی: فلأنّه لانسلّم أوّلاً عموم القول و أعظمیّته من الفعل من حیث هما قولٌ و فعلٌ، بل الأمر بالعکس؛ لأنّ کلّ قولٍ فعلٌ و لاعکس. و لا من حیث المورد أیضاً، لأنّ مورد القول خاصٌّ و مورد الفعل عامٌّ. و على فرض التسلم فیرد علیه ما أورده على الوجه الثانی من قول الموجّه.
و ما ذکره من الأخبار لاتدلّ على مدّعاه، بل تدلّ على ترأس اللسان على سائر الجوارح.
و قد ألهمنی اللّه ـ تعالى ـ توجیهه بوجهٍ لایرد علیه شیءٌ؛ و هو: انّ الخیر یرجع إلى الوجود و الشرّ إلى العدم ـ کما عرفت فیما سبق من الکلام ـ، فشرّ القول أو الفعل أو هما معاً یرجع إلى الأعدام، و الأعدام بما هی أعدامٌ لاتمایز بینها، فإذا اکتفى بذکر أحد هذه الشرور الثلاثة کفى، فذکر الفعل دون القول لأجل هذا.
و بما ذکرنا أیضاً رفع التنافی بین ما فی النسخ المشهورة و بعض النسخ، لأنّه إن اعتبر المضاف إلیها فی هذه الثلاثة یجب ذکرهما کما فی النسخ المشهورة؛ فتدبّر تفهم!.
قوله – علیه السلام ـ: «و أکمل ذلک لی بدوام الطاعة».
«و أکمل» عطفٌ على «ألبسنی»؛ و هو من: کمَل الشیء کمولاً ـ من باب قعد ـ، و الاسم: الکمال. و یتعدّی بالهمزة و التضعیف، فیقال: أکملته و کمّلته.
و «ذلک» إشارةٌ إلى المذکورة من الأخلاق المسؤولة.
و «الدوام»: الاستمرار.
و «الطاعة»: الانقیاد.
قوله: «و لزوم الجماعة» عطفٌ على «دوام الطاعة»، و المراد: التزام صلاة الجماعة، أو الکون مع الجماعة ـ أی: المؤمنین ـ فی التدیّن بدینهم. و قد یفسّر فی الحدیث بأهل الخیر و إن قلّوا(53) -(54)
قوله: «و رفض أهل البدع».
«الرفض»: الترک.
و «البدع»: جمع البدعة، و هی ما استحدث بعد الشریعة.
قوله – علیه السلام ـ: «و مستعمل الرأی المخترع».
«الرأی المخترع»: هو البدعة، و «مستعمله»: أهلها.
<و «الرأی» لغةً: العقل و التدبیر و الاعتقاد، و عرفاً یطلق تارةً على القیاس ـ و هو مساواة فرعٍ الأصل فی علّة حکمه. قال صاحب القاموس: «و أصحاب الرأی أصحاب القیاس، لأنّهم یقولون برأیهم فیما لم یجدوا فیه حدیثاً أو أثراً»(55) ـ ؛ و تارةً على استحسان العقل و إن عارض النصّ و خالفه ـ کما هو شأن مخالفینا حیث فسّروا القرآن و أوّلوا الحدیث على وفق رأیهم و هوائهم(56) ـ. و فسّر أبوحنیفة الرأی بـ: «أنّه دلیلٌ ینقدح فی نفس المجتهد و ربّما قصرت عنه عبارته»(57)
حکى الزمخشریّ فی ربیع الأبرار قال: «قال یوسف بن أسباط: ردّ أبوحنیفة على النبیّ ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ أربعمأة حدیث أو أکثر!.
قیل: مثل ماذا؟
قال: قال رسول اللّه ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ: للفرس سهمان، و قال أبوحنیفة: لاأجعل سهم بهیمةٍ أکثر من سهم المؤمن!؛
و أشعر رسول اللّه ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ و أصحابه البدن، و قال أبوحنیفة: الاشعار مثلةٌ!؛
و قال رسول اللّه ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ: البیعان بالخیار ما لم یتفرّقا، و قال أبوحنیفة: إذا وجب البیع فلاخیار!؛
و کان – علیه السلام ـ یقرع بین نسائه إذا أراد سفراً، و قال أبوحنیفة: القرعة قمارٌ!»(58)؛
انتهى.
و «المخترَع»: اسم مفعولٍ من: اخترع الدلیل أو الحکم و ما أشبهه أی: ارتجله و ابتکره و لم یسبق إلیه؛ و هذا القول مخترعٌ أی: مفتعَل لا أصل له. و هو هنا نعتٌ جیء به لافادة الذمّ ـ کالشیطان الرجیم ـ، لاقصداً لتوضیحٍ، إذ الرأی فی الأحکام الشرعیّة لایکون إلّا مخترعاً>(59)؛ فحینئذٍ یکون تعییراً لأهل البدع. و لفظ «مستعمل» فی بعض النسخ بالیاء،
فیکون جمعاً سقط نونه بالإضافة. و المعنى: و رفض جماعةٍ عملوا بالرأی و القیاس دون الکتاب و السنّة ـ کما هو طریقة أهل السنّة ـ.
و بالجملة الکتاب و السنّة مشحونتان بذمّ أهل الرأی و البدعة، قال اللّه ـ تعالى ـ: (یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ)(60)، و قال: (لاَتَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ
مُبِینٌ – إِنَّمَا یَأْمُرُکُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحشَاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَتَعلَمُونَ)(61)، و قال: (یَا دَاوُدُ إنَّا جَعَلنَاکَ خَلِیفَةً فِی الاَرْضِ فَاحْکُمْ بَینَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لاَتَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیلِ آللَّهِ)(62)؛ قال أمیرالمؤمنین – علیه السلام ـ: «یا معشر شیعتنا المنتحلین ولایتنا(63) !
إیّاکم و أصحاب الرأی، فانّهم أعداء السنن، تفلّتت منهم الأحادیث أن یحفظوها و أعیتهم السنّة أن یعوها، فاتّخذوا عباد اللّه حولاً و ماله دولاً؛ فذلّت لهم الرقاب و أطاعهم الخلق أشباه الکلاب!. و نازعوا الحقّ و(64) أهله، و تمثّلوا بالأئمّة الصادقین و هم من الجهّال(65) الکفّار الملاعین، فسئلوا عمّا لایعلمون فأنفوا أن یعترفوا بأنّهم لایعلمون، فعارضوا بآرائهم و ضلّوا فأضلّوا!(66) أما لو کان الدین بالقیاس لکان باطن الرجلین أولى بالمسح من ظاهرهما»(67)
و فی الکافی(68) : إنّ الصادق – علیه السلام ـ قال: «إیّاک و خصلتین ففیهما هلک من هلک!، إیّاک أن تفتی الناس برأیک أو تدین بما لاتعلم»؛
و عن الباقر – علیه السلام ـ انّه سئل عن حقّ اللّه ـ تعالى ـ على العباد؟
قال: «ان یقولوا ما یعلمون و یقفوا عند ما لایعلمون»(69)؛
و عنه – علیه السلام ـ فی الفقیه(70) عن أمیرالمؤمنین – علیه السلام ـ فی وصیّته لإبنه
محمّد بن الحنفیّة: «یا بنیّ! لاتقل ما لاتعلم، بل لاتقل کلّ ماتعلم!»؛
و فی العیون(71) عنه عن النبیّ ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ: «من أفتى الناس بغیر علمٍ لعنته ملائکة السماوات و الأرض»؛
و عن الباقر: «من أفتى الناس برأیه فقد دان اللّه بما لایعلم، و من دان اللّه بما لایعلم فقد ضاد اللّه حیث أحلّ و حرّم فیما لایعلم»(72)؛
و عن الصادق – علیه السلام ـ انّه قیل له: ترد علینا أشیاء لانعرفها فی کتابٍ و لا سنّةٍ، فننظر فیها؟
قال: «لا!، أمّا انّک لو أصبت لم تؤجر، و إن أخطأت کذبت على اللّه!»(73) و الأخبار فی هذا المعنى عنهم أکثر من أن تحصى.
اعلم أیّها الطالب للحقیقة! أنّ أصحاب الجدل و المناظرة و من یطلب المناقشة اخترعوا من نفوسهم فی الدیانات و الشرائع أشیاء کثیرة بآرائهم الفاسدة و عقولهم الناقصة الکاسدة لم یأت بها الرسول ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ و لاأمر بها و قالوا لعوام الناس: هذه سنّة الرسول!، و قد ضلّوا بذلک عن کتاب ربّهم و سنّة نبیّهم. و استکبروا عن أهل الذکر الّذین بیّنهم و قد أمروا أن یسألوهم عمّا أشکل علیهم ـ و هم أهل بیت النبوّة المنصوبین لنجاة الأمّة ـ. فظنّوا ـ لسخافة عقولهم ـ أنّ اللّه ـ سبحانه ـ ترک أمر الشریعة و فرائض الدیانات ناقصةً حتّى یحتاجوا إلى أن یتمّوها بآرائهم الفاسدة و قیاساتهم الکاذبة و
اجتهاداتهم الباطلة. و انّما فعلوا ذلک طلباً للریاسة و حبّاً لوقوع المخالفة و المنازعة بین الأمّة، فهم یهدمون الشریعة، و یوهّمون الناس و من لایعلم انّهم ینصرونها!. و ما هذه إلّا لبقاء ریاستهم و تقویة سلطنتهم! ـ کما هو دأب أهل الملل الّذین من قبلهم ـ.
فهم بأفعالهم هذه کانوا أسباباً فی نسخ الشریعة و تجدیدها فی کلٍّ من الأزمنة إلى أن یتمّ ما وعد اللّه بقوله: (إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْکُمْ وَ یَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ – وَ مَا ذَلِکَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِیزٍ)(74)، (وَ لَقَدْ کَتَبنَا فِی الْزَّبُورِ مِنْ بَعدِ الْذِّکْرِ أَنَّ الاَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ)(75)
فعلیک ـ أیّها الأخ الطالب للشریعة! ـ بمتابعة أهل بیت النبوّة، فانّهم أهل العلم و الذکر، المنصوبون لنجاة الأمّة.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِکَ عَلَیَّ إِذَا کَبِرْتُ، وَ أَقْوَى قُوَّتِکَ فِیَّ إِذَا نَصِبْتُ، وَ لاَتَبْتَلِیَنِّی بِالْکَسَلِ عَنْ عِبَادَتِکَ، وَ لاَالْعَمَى عَنْ سَبِیلِکَ، وَ لاَ بِالتَّعَرُّضِ لِخِلاَفِ مَحَبَّتِکَ، وَ لاَ مُجَامَعَةِ مَنْ تَفَرَّقَ عَنْکَ، وَ لاَمُفَارَقَةِ مَنِ اجْتَمَعَ إِلَیْکَ.
<«الجعل» بمعنى: التصییر المتعدّی إلى مفعولین، و هما هنا منصوبان بعده ـ «أوسع» و «علیَّ» ـ ؛ و هو متعلّقٌ بمحذوفٍ ـ أی: کائناً علیَّ ـ، لأنّ مفعولی التصییر فی الأصل مبتدءٌ و خبرٌ، و الظرف إذا وقع خبراً لایکون إلّا مستقرّاً.
و «إذا» ظرفٌ للفعل متضمّنٌ معنى الشرط، و ما قبلها هو الجواب فی المعنى ـ کما فی قولک: أکرمنی إذا جئتک ـ>(76)
«کبِرت» ـ بکسر الباء ـ: الکبر فی السنّ، أی: إذا صرت شیخاً کبیراً؛ و أمّا کبُرت ـ بالضمّ ـ فهو من العظم، یقال: رجلٌ کبیرٌ و کبارٌ أی: عظیمٌ؛ و کُبّار ـ بالتشدید ـ للمبالغة.
و «القوّة»: خلاف الضعف، و إضافته إلى اللّه من قبیل اضافة «نبیّک» و «عبدک» و «خلقک».
و «نصِبت» ـ بالکسر ـ: التعب. و إنّما سأل – علیه السلام ـ جعل أوسع الرزق علیه وقت الکبر لیستغنی عن تکلّف تحصیله و مشقّة تدبیره فی الوقت المقتضی لضعف البنیة عن کثیر الحرکة؛ و کذا سأل جعل أقوى القوّة فیه وقت الإعیاء.
و المراد من «الرزق»: الرزق المعنویّ؛ و من «الکبَر»: الکبر فی المعارف الربوبیّة؛ و من «القوّة»: القوّة الروحانیّة.
<و «لاتبتلینّی» یروى بالجزم و النون المؤکّدة على الأشهر.
و «الکَسَل» ـ بالتحریک ـ قال فی القاموس: «: التثاقل عن الشیء و الفتور فیه»(77) قال
بعض العارفین: «الکسل عن العبادة من صفات الجاهل المحبوس فی سجن الطبیعة البشریّة و المغلول بأغلال لواحق القوّة الشهویّة و المصفود بصفاد عوارض القوى البدنیّة، فهو ثقیلٌ لاتحرّکه ریح النشاط إلى الدرجة العلیا و لاتعرج به أریحیّة العبادة عن المرتبة الدنیا».
قوله – علیه السلام ـ: «و لا العمى عن سبیلک». المراد بـ «العمى» هنا: الضلالة>(78)؛ و فی نسخةٍ «و لا بالعمى»، و هذا أظهر.
و «السبیل»: الطریق المستقیم الموصل إلى مقام الحقّ و الهدى الناجی سالکه من التردّی فی مهاوی الردى. و قیل: «المراد بالسبیل: الدین».
و «التعرّض» للشیء: التصدّی و الطلب له؛ أی: لاتجعلنی مبتلىً بالالتفات و التوجّه إلى خلاف محبّتک و مرضاتک.
<و «المجامعة»: مصدر جامعه على الأمر أی: اجتمع معه و ساعده.
و «تفرّق» الناس عن فلانٍ: أعرضوا عنه و ترکوه>(79)؛ أی: و لامجامعة من تفرّق عنک
بالعصیان و الانفصال، و لامفارقة من اجتمع إلیک بالطاعة و الاتّصال.
اعلم! أنّ الانفصال و الاتّصال من أعظم المقامات عند العرفاء؛ قال الشیخ عبداللّه الأنصاریّ: «باب الاتّصال: «قال اللّه ـ عزّ و جلّ ـ: (ثُمَّ دَنَى فَتَدَلَّى – فَکَانَ قَابَ قَوسَینِ أَو أَدنَى)(80) أیأس العقول فقطع البحث بقوله: (أَو أَدنَى).
و للاتّصال ثلاث درجاتٍ(81): اتّصال الاعتصام، ثمّ اتّصال الشهود، ثمّ اتّصال الوجود.
فاتّصال الاعتصام بتصحیح القصد، ثمّ تصفیة الإرادة بتحقیق(82) الحال؛
و(83) الثانیة: اتّصال الشهود، و هو الخلاص من الاعتدال و الغنى عن الاستدلال بسقوط(84) شتات الأسرار؛
و(83) الثالثة: اتّصال الوجود، و هذا الاتّصال لایدرک منه نعتٌ و لامقدارٌ، إلّا اسمٌ معارٌ و
لمحٌ إلیه مشارٌ»(85)
و قال أیضاً: «باب الانفصال. قال اللّه ـ عزّ و جلّ ـ: (وَ یُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ)(86)، لیس فی المقامات شیءٌ من التفاوت ما فی الانفصال.
و وجوهه(87): أحدها: انفصالٌ هو شرط الاتّصال، و هو الانفصال عن الکونین بانفصال نظرک إلیهما و انفصالٌ توقّفک علیهما و انفصال مبالاتک بهما؛
و الثانی: انفصالٌ عن رؤیة الانفصال الّذی ذکرناه؛ و هو أن لایتّزنا فی شهود التحقیق شیئاً یوصل بالانفصال منهما إلى شیءٍ؛
و الثالث: انفصالٌ عن اتّصالٍ(88)، و هو انفصالٌ عن شهود مزاحمة الاتّصال عین السبق،
فانّ الانفصال و الاتّصال على عظم تفاوتهما فی الاسم و الرسم سیّان فی العلّة(89)»(90)
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی أَصُولُ بِکَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَ أَسْأَلُکَ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَ أَتَضَرَّعُ إِلَیْکَ عِنْدَ الْمَسْکَنَةِ، وَ لاَتَفْتِنِّی بِالاِسْتِعَانَةِ بِغَیْرِکَ إِذَا اضْطُرِرْتُ، وَ لاَبِالْخُضُوعِ لِسُوَالِ غَیْرِکَ إِذَا افْتَقَرْتُ، وَ لاَبِالتَّضَرُّعِ إِلَى مَنْ دُونَکَ إِذَا رَهِبْتُ، فَأَسْتَحِقَّ بِذَلِکَ خِذْلاَنَکَ وَ مَنْعَکَ وَ إِعْرَاضَکَ، یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.
«الصولة»: الحملة و الوثبة(91)، أی: اجعلنی صائلاً بحولک و قوّتک على عدوّی عند الضرورة.
و «الفتنة»: هی الامتحان؛ یقال: فتَنَه فُتوناً ـ من باب ضرب ـ: امتحنه. <و قال بعضهم: «الفتنة هی الضلال عن الحقّ بمحبّة أمرٍ من الأمور الباطلة و الاشتغال به عمّا هو الواجب من سلوک سبیل اللّه؛ و على هذا فمعنى: «لاتفتنّی»: لاتظلّنی ـ کما قالوا: «ربّنا لاتظلمنا» ـ»>(92)
و المعنى: لاتجعلنی مفتوناً مبتلىً بطلب الاعانة عن غیرک إذا اضطُرِرتُ ـ بصیغة المجهول، أی: صرت ملجاً ـ، لأنّ «من استعان بغیر اللّه فقد ذلّ».
و «التضرّع»: الابتهال.
و «المسکنة»: الذلّ و الحاجة.
و «الخضوع» من التطاطؤ و التواضع.
و «الرهب» ـ کالرعب ـ: الخوف.
«فاستحقّ». «الفاء» للسببیّة، و الفعل منصوبٌ بعدها بأن مضمرةً لوقوعه بعد النهی
الصریح ـ نحو: (لاَتَطْغَوا فِیهِ فَیَحِلَّ عَلَیکُمْ غَضَبِی)(93) ـ ؛ هکذا قال الشارح الفاضل(94)
و هو کما ترى!.
و الأولى انّ «الفاء» فصیحةٌ جزاءٌ للشرط المحذوف، یعنی: إذا خضعت إلى من هو دونک فاستحقّ بسبب ذلک الخذلان؛ أی: ترک نصرتک و اعانتک. و قد تقدّم الکلام فی هذا المعنى مبسوطاً فی اللمعة الثالثة عشرة.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَا یُلْقِی الشَّیْطَانُ فِی رُوعِی مِنَ التَّمَنِّی وَ التَّظَنِّی وَ الْحَسَدِ ذِکْراً لِعَظَمَتِکَ، وَ تَفَکُّراً فِی قُدْرَتِکَ، وَ تَدْبِیراً عَلَى عَدُوِّکَ.
«الرُوع» ـ على وزن جوع ـ: القلب ـ کما وقع فی الحدیث: «إنّ الروح القدس نفث فی روعی أن لایموت أحدٌ(95) حتّى یستکمل رزقه»(96) ـ. و یطلق على الذهن و العقل.
و «من التمنّی» بیانٌ لـ «ما یلقی». و هو یطلق على معانٍ:
تشهّی حصول الأمر المرغوب فیه؛
و حدیث النفس بمایکون و بما لایکون؛
و التکذیب ـ من: منى یمنی: إذا قدّر، لأنّ الکاذب یقدّر الحدیث فی نفسه ثمّ یقوله ـ(97)
و «التظنّی» أصله: التظنّن، و هو تفعّلٌ من الظنّ، فقلب النون الأخیرة یاءً بمعنى: استعمال الظنّ(98)؛ و منه قولهم: «لیس الأمر بالتظنّی و لابالتمنّی».
و «الحسد»: هو تمنّی زوال نعمة المحسود إلى الحاسد.
و «الذکر»: حضور المعنى فی النفس؛ و قد مرّ الکلام علیه فی اللمعة الحادیة عشرة.
و «العظمة» هی منصرفةٌ إلى عظم الشأن و جلالة القدر و ارتفاع المکانة، فکما لایمکن الاحاطة بکنه وجوده و حقیقته – تعالى ـ لایمکن الاحاطة بعظمته و جلالته، و إن لم یکن لکافّة الممکنات فی حدّ أنفسها شیءٌ منها إلّا أنّه یمکن أن یوصف شیءٌ بتلک المفهومات فیما أعطاه ربّه بقدر ظرفیّة وجوده. و قد عرفت تفاوت الأشیاء فی تحمّل تلک الصفات و مظاهرها – کغیرها من الصفات و الأسماء ـ. و الکامل جمع کلّها بما فی حوصلة الإمکان حتّى یصلح للخلافة الکبرى و النعمة العظمى إلى أن یصل فی القرب إلى مکانة (قَابَ قَوسَینِ أَو أَدْنَى)(99)
و إن هو إلّا من عظمة خالقه بما أودع فیه من عجائب تکوینه، ثمّ وصیّه الّذی هو فی کلّ مقامٍ و مرتبةٍ کنفسه، و بعده عترته الطاهرة حتّى یصل الأمر إلى صاحب الأمر ـ علیهم الصلاة و السلام من الخالق الأکبر ـ.
و «التفکّر» فی اللغة: إعمال النظر فی الشیء(100)؛ و فی الاصطلاح عبارةٌ عن السیر الباطنیّ من المبادی الآفاقیّة و الأنفسیّة إلى الغایة الحقیقیّة ـ أعنی: ما لمبدعها من الحکمة و القدرة و العظمة ـ.
و قال الشیخ العارف عبداللّه الأنصاری: «التفکّر تلمّس البصیرة لاستدراک البغیّة» ـ أی: تفتیش العقل لاستدراک المطلوب ـ ؛
و قال: «و هو على ثلاثة أنواعٍ(101) :
فکرةٌ فی عین التوحید، فهی اقتحام بحر الجحود، و لاینجى منه إلّا بالاعتصام بضیاء الکشف و التمسّک بالعلم الظاهر»؛
ـ مقصوده: انّ الفکرة فی عین التوحید تبعّد العبد عن التوحید الصحیح، لأنّه لایکون إلّا بعد فناء الفکر و المتفکّر جمیعاً. فالفکرة علامة الجحود و لاینجى منه إلّا بالاعتصام بضیاء الکشف، لا بالفکرة و التمسّک بالعلم الظاهر؛ یعنی: أن لایقرّ للّه بالواحدانیّة تقلیداً من غیر فکرٍ و تصدیقاً و إیماناً تقلیدیّاً، و هو توحید العوامّ ـ.
ثمّ قال: «و أمّا الفکرة فی لطائف الصنعة فهو ماءٌ یسقی زرع الحکمة» ـ و هو التفکّر فی الآیات الآفاقیّة و الأنفسیّة الّذی ذکرناه ـ ؛ ثمّ قال: «و أمّا الفکرة فی معانی الأعمال و الأحوال فهی تسهّل طریق الحقیقة»؛
ـ مراده: انّ الفکرة فی معانی الأفعال ملاحظة العبد أنّ الأعمال الصالحة هی من منن اللّه تعالى، و أنّها منه لا من العبد؛ فینبّه على توحید الأفعال، و هو أوّل مقامات الوصول. فقد صحّ «أنّ الفکرة فی معانی الأعمال تسهّل طریق الحقیقة» ـ.
ثمّ قال: «و إنّما یتخلّص من الفکرة فی عین التوحید بثلاثة أشیاء:
بمعرفة عجز العقل؛ و بالإیاس من الوقوف على الغایة؛ و بالاعتصام بحبل التعظیم».
ـ یقول رحمه اللّه: إنّما یتخلّص من الفکرة فی عین التوحید ثلاثة أشیاء:
الأوّل: إنّ من اطّلعه اللّه تعالى على عجز العقل عن ادراک التوحید فقد تخلّص من الفکرة؛
و الثانی: إنّ من انقطع طمعه عن ادراک غایةٍ یتحصّل بها التوحید فقد تخلّص من الفکرة؛
و الثالث: إنّ من عرف العجز و یئس من الغایة اعتصم بحبل التعظیم و العظمة، أی: عظّم اللّه تعالى عن أن یدرکه عقلٌ، فتخلّص عن الفکرة ـ ثمّ قال: «إنّما تدرک(102) الصنعة بثلاثة أشیاء:
بحسن النظر فی مبادی المنن؛ و بالاجابة لدواعی الإشارات؛ و بالخلاص من رقّ اتیان(103)
الشهوات»؛
ـ یقول رحمه اللّه: إنّ ادراک لطائف الصنعة بحسن النظر فی مبادی المنن، و هی المواهب. و ذلک بأن ینظر العبد فیما قبل التکوین، فیرى أنّ المخلوقات قبل خلقها ما کانت تستحقّ على اللّه تعالى أن یخلقها و لا أن یخرجها إلى الوجود و لا أن یرزقها و لا أن یوصل إلیها هذه النعم الظاهرة و الباطنة. ثمّ انّ تبارک و تعالى فعل ذلک منّةً منه و تفضّلاً ابتداءً، فهذا هو النظر فی مبادى المنن، و هو أحد مایدرک به لطائف الصنعة؛
و الثانی ممّا یدرک به لطائف الصنعة: الإجابة لدواعی الإشارات، و هو یترتّب على الأوّل. یعنی: إذا نظر فی مبادی المنن فأدرک لطائف الصنعة رءاها إشاراتٍ دالّاتٍ على وجوب حقّ اللّه على عباده، و تلک الإشارات دائماً یدعوا إلى طاعة ربّها تبارک و تعالى و تقواه؛ قال اللّه تعالى: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرقَاناً)(104)، أی: نوراً تفرّقون به بین الحقّ و الباطل. فاذن باجابة دواعی الإشارات یحصل الفرقان، و بالفرقان یقوّی ادراک ما غاب عن لطائف الصنعة؛
و الثالث ممّا یدرک به لطائف الصنعة: الخلاص من رقّ اتیان الشهوات، الّتی زیّنت للناس حتّى صار حرّاً أمکنه ادراک لطائف صنعة اللّه ـ.
ثمّ قال: «و إنّما یوقف بالفکرة على مراتب الأعمال و الأحوال بثلاثة أشیاء: باستصحاب العلم» ـ لأنّ العمل لایعرف إلّا بالعلم؛ و معرفة الأحوال هی بـ «اتّهام المرسومات» ـ و المرسومات هی الکثرة، و ذلک لایکون إلّا بأنوار الوحدانیّة؛ و إمّا – «معرفة مواقع الغیر»(105)؛
فهی معانی الواردات الّتی تغیّر حال الشخص فتنقّله من حالٍ إلى حالٍ أعلى من الأوّل حتّى یرفع الکثرة من البین. فمن عرف مواقع الاعتبار وقف بالفکرة على مراتب الأحوال».
ثمّ اعلم! أنّ التفکّر هو مفتاح الأسرار و مشکاة الأنوار و شبکة المعارف و مصدر
العوارف و منبع الحقائق و أصل الدقائق و جناح النفس للطیران من حضیض النقصان إلى أوج العرفان، و لذلک وقع الأمر به فی الأحادیث و القرآن؛ قال اللّه ـ تعالى، خالق الإنس و الجان ـ: (أَ وَ لَمْ یَنْظُرُوا فِی مَلَکُوتِ السَّمَاوَاتِ وَ الاَرْضِ وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ)(106)، (أَ وَ لَمْ یَتَفَکَّرُوا فِی أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الاَرضَ وَ مَا بَینَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ)(107)، (الَّذِینَ
یَذکُرُونَ اللَّهَ قِیَاماً وَ قُعُوداً وَ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَکَّرُونَ فِی خَلقِ السَّمَاوَاتِ وَ الاَرضِ)(108)،
و عن النبیّ ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ: «التفکّر(109) حیاة القلب البصیر»(110)؛
و عنه ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ: «تفکّر ساعةٍ خیرٌ من عبادة سنةٍ»(111)
و لاینال منزلة التفکّر إلّا من خصّه اللّه بنور المعرفة و التوحید، و فی روایةٍ: «تفکّر ساعةٍ خیرٌ من عبادة سبعین سنة»(112)؛
و عن أمیرالمؤمنین – علیه السلام ـ: «التفکّر یدعو إلى البرّ و العمل به»(113)؛
و عن الصادق – علیه السلام ـ: «أفضل العبادة إدمان التفکّر فی اللّه و(114) قدرته»(115)؛
و عنه – علیه السلام ـ: «الفکر مرآت الحسنات و کفّارة السیّئات و ضیاء القلوب و فسحةٌ للخلق و اصابةٌ فی صلاح المعاد و اطّلاعٌ على العواقب و استزادةٌ فی العلم، و هی
خصلةٌ لایعبد اللّه بمثلها»(116)؛
و عن الرضا – علیه السلام ـ: «لیس العبادة کثرة الصلاة و(64) الصوم، و إنّما العبادة التفکّر فی أمر اللّه – عزّ و جلّ ـ»(117)؛ إلى غیر ذلک ممّا ورد فی هذا الباب.
ثمّ انّه لایجوز التفکّر فی ذاته ـ تعالى ـ، بل بعض من صفاته أیضاً، لأنّه أجلّ من أن یدرک بطوامح العقول و الأحلام أو یحیط به غوامض الظنون و الأوهام، فالنظر فیه ـ تعالى ـ یوجب التحیّر؛ قال خیر الأنام ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ: «تفکّروا فی آلاء اللّه و لاتفکّروا فی اللّه، فانّکم لنتقدروا قدره»(118)؛
و عن أبی جعفر – علیه السلام ـ: «إیّاکم و التفکّر فی اللّه، و لکن إذا أردتم أن تنظروا فی عظمته فانظروا إلى عظیم خلقه»(119)
<و حکى ذوالنون المصریّ قال: «سمعت شخصاً قائماً وسط البحر و هو یقول: سیّدی! سیّدی! أنا خلف بحور الجزائر و أنت الملک الفرد بلاحاجبٍ و لازائرٍ، من ذا الّذی أنس بک فاستوحش؟ أم من ذا الّذی نظر إلى آیات قدرتک فلم یدهش؟ أما فی نصبک السماء ذات الطریق و رفعک الفلک فوق رؤوس الخلائق و اجرائک الماء بلاسائقٍ و إرسالک الریح بلاعائقٍ ما یدلّ على فردانیّتک؟!؛ أمّا السماوات فتدلّ على منعتک، و أمّا الفلک فیدلّ على صنعتک، و أمّا الریاح فنشر من نسیم برکاتک، و أمّا الرعود فتصوت بعظیم آیاتک، و أمّا الأرض فتدلّ على عظیم حکمتک، و أمّا الأنهار فتنفجر بعذوبة کلمتک، و أمّا الأشجار
فتخبر بجمیل صنائعک، و أمّا الشمس فتدلّ على بدائعک»>(120) و بالجملة کلّ شیءٍ من عالم الإمکان شواهدٌ عدلٌ على وحدانیّته و کمال قدرته و حکمته و عظمته؛
وَ فِی کُلِّ شَیْءٍ لَهُ آیَةٌ++
تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ(121)
مشتملٌ على عجائب صنع اللّه بحیث تحیّر فیه العالم الخبیر و المتفکّر البصیر. کیف! و لو أنّ إنساناً أوتی علم الأوّلین و الآخرین و لازال باقیاً ببقاء السماوات و الأرضین و تفکّر فی عجائب صنع ربّ العالمین لایقدر على الإحاطة بعشرٍ من أعشارها، بل قذف قطرةٍ من بحارها!!، (قُلْ لَو کَانَ الْبَحرُ مِدَاداً لِکَلِمَاتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحرُ قَبلَ أَنْ تَنْفَدَ کَلِمَاتُ رَبِّی وَ لَو جِئْنَا بِمِثلِهِ مَدَداً)(122)».
ثمّ أحسن مایمکن مجالاً للتفکّر فی عجائب صنعه هی النسخة الجامعة لجمیع عوالم الإمکان الّتی جعلها اللّه ـ تعالى ـ حجّةً على خلقه و کتاباً کتبه بیده و هیکلاً بناه بحکمته؛ و قال وصیّ خاتم الأنبیاء و ابن عمّه:
أَ تَزعَمُ(123) أَنَّکَ جِرمٌ صَغِیر++
وَ فِیکَ انْطَوَى الْعَالَمُ الاَکْبَرُ(124)
ثمّ انّ هذا النوع من التفکّر إنّما هو تفکّر العلماء الصالحین؛ و أمّا الصدّیقون من الأنبیاء و الأولیاء فشأنهم أجلّ و أرفع من ذلک ـ لاستقراقهم فی محبّة اللّه و أنسه، و فنائهم فی جلاله و عظمته ـ، ففکرهم لیس إلّا الاستغراق فی بحار أنوار جماله و الاحتراق من نیران وصاله.
قوله – علیه السلام ـ: «و تدبیراً على عدوّک».
<«التدبیر»: النظر فی عاقبة الأمر، یقال: دبّرت الأمر تدبیراً: نظرت إلى ما تؤول إلیه عاقبته، مأخوذٌ من الدبر ـ و هو الآخر من کلّ شیءٍ ـ، لأنّه نظرٌ فی دبر الأمر. و هو قریبٌ من التفکّر، لأنّ «التفکّر» تصرّف القلب بالنظر فی الدلیل، و «التدبیر» تصرّفه بالنظر فی
العواقب. و تعدیته بـ «على» للاشعار بأنّ التدبیر مستعلٍ علیه لازمٌ له لزوم الراکب لمرکوبه ـ کقولهم: هذا لک وهذا علیک ـ>(125) ؛ و المعنى: اجعل بدل ما یلقى الشیطان فی قلبی ذکراً لعظمتک و تفکّراً فی قدرتک و تدبیراً على عدوّک.
وَ مَا أَجْرَى عَلَى لِسَانِی مِنْ لَفْظَةِ فُحْشٍ أَوْ هُجْرٍ أَوْ شَتْمِ عِرْضٍ أَوْ شَهَادَةِ بَاطِلٍ أَوِ اغْتِیَابِ مُوْمِنٍ غَائِبٍ أَوْ سَبِّ حَاضِرٍ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ نُطْقاً بِالْحَمْدِ لَکَ، وَ إِغْرَاقاً فِی الثَّنَاءِ عَلَیْکَ، وَ ذَهَاباً فِی تَمْجِیدِکَ، وَ شُکْراً لِنِعْمَتِکَ، وَ اعْتِرَافاً بِإِحْسَانِکَ، وَ إِحْصَاءً لِمِنَنِکَ.
«و ما أجرى» أی: أجراه الشیطان على لسانی. و فی نسخةٍ: «جرى» ـ بدون الألف ـ.
و «الفُحش» ـ بالضمّ ـ: السیّىء و الردیّ من القول؛ و قیل: «الفحش و الفحشاء: ما ینفرّ عنه الطبع السلیم و یستقبحه العقل المستقیم ـ قولاً کان أو فعلاًـ»(126)
<و «الهَجر» بالضمّ: الفحش؛ و بالفتح: الهذیان>(127)
و «الشتم»: السبّ؛ <و قیل: «الشتم: وصف الرجل بما فیه إزراءٌ و نقصٌ، سیّما فیما یتعلّق بالنسب»(128)
و «عِرض» الرجل ـ بالکسر ـ: حسَبه؛ و قال ابنقتیبة: «عرض الرجل: نفسه(129)،
لاغیر»(130)؛ و قیل: «هو ما یفتخر به من حسَبٍ أو شرفٍ»(131) و قد یراد به الآباء و الأجداد.
و «الشهادة»: الإخبار بما قد شوهد ـ أی: عن عیانٍ ـ ؛ و هی اسمٌ من المشاهدة، و هی الاطّلاع على الشیء عیاناً>(132)
و «الباطل»: خلاف الحقّ.
قوله – علیه السلام ـ: «أو سبّ حاضرٍّ».
«السبّ» بمعنى: القطع، لأنّ السابّ یقطع المسبوب و ما أشبه ذلک المذکورات ـ من النمیمة و السعایة و الاستهزاء و التهمة، و غیر ذلک ممّا هو مبائنٌ لمکارم الأخلاق و حسن الشیم ـ.
«نطقاً بالحمد لک» أی: اجعل ذلک نطقاً بالحمد لک.
«و إغراقاً فی الثناء علیک». یقال: أغرق فی الشیء إغراقاً أی: بالغ فیه و أطنب؛ و الإغراق فی القول هو المبالغة و الإطناب فیه.
و «الثنآء» ـ بالمدّ ـ قیل: «هو وصف الشیء بمدحٍ أو ذمٍّ»؛ و قیل: «خاصٌّ بالمدح»(133)؛ و التحقیق ما ذکرناه فی اللمعة الأولى.
و «المنّة»: النعمة.
قال الفاضل الشارح: «و المراد بـ «احصائها»: حفظها عن الکفر فیها و الاعتداد بها صوناً لها عن إهمال شکرها و عدم الالتفات إلیها، و إلّا فنعمة اللّه لاتحصى، کما قال ـ سبحانه ـ: (وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ آللَّهِ لاَتُحصُوهَا)(134)»(135)؛ انتهى.
أقول: صرف اللفظ من معناه اللغویّ من غیر داعٍ و موجبٍ قبیحٌ، لأنّ عدم الاعصاء بالنسبة إلى غیره – علیه السلام ـ، و أمّا هو – علیه السلام ـ فهو الإنسان الکامل الّذی أحاط بکلّ النعم و المنن؛ لأنّ مرتبتة فوق العقول و الملائکة المجرّدة ـ کما مرّ غیر مرّةٍ ـ.
و قال أیضاً: «الجعل المطلوب ـ أعنی: نقل الأسباب المذکورة الّتی ألقاها الشیطان فی
روعه و أجراها على لسانه إلى الحسنات المطلوبة ـ إمّا بمحوها بالتوبة و اثبات الحسنات مکانها، أو بتبدیل ملکاتها و دواعیها فی النفس بملکات الحسنات المذکورة بأن یزیل الأولى و یأتی بالثانیة، أو بأن یثبت له بدل عقاب کلٍّ منها ثواب الحسنة المقابلة لها. و بکلٍّ فسّر(136) قوله ـ تعالى ـ: (فَأُولَئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ)(137)»(138)
أقول: تفسیر الآیة بهذه الوجوه الثلاثة لادخل له بهذه الفصول من الأدعیة!. و العجب من هذا الفاضل مع غوصه فی بحر الفضیلة غفل عن مرتبة العصمة و عدم صدور الذنب و الخطیئة حتّى یحتاج فی محوها بالتوبة!؛ و کیف تکون له الملکات الذمیمة حتّى یحتاج إلى تبدیلها بملکاتٍ حسنةٍ!! ـ أعاذنا اللّه تعالى من الذلل و الغفلة ـ. و المعنى: انّ الشیطان على فرض إمکانه الإلقاء فی روعی أو الإجراء على لسانی الأمور المذکورة على مقتضى طبیعته الخبیثة و سجیّته الخسیسة لزمه زمانٌ و مدّةٌ، فاجلعه ذکراً لعظمتک و نطقاً بالحمد لک ـ… إلى آخره ـ و أمّا تفسیر الآیتین و تبدیل السیّئات بالحسنة فقد أشبعنا الکلام فیه فی آخر اللمعة الثانیة؛ فلیرجع إلیه.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لاَأُظْلَمَنَّ وَ أَنْتَ مُطِیقٌ لِلدَّفْعِ عَنِّی، وَ لاَأَظْلِمَنَّ وَ أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى الْقَبْضِ مِنِّی، وَ لاَأَضِلَّنَّ وَ قَدْ أَمْکَنَتْکَ هِدَایَتِی، وَ لاَأَفْتَقِرَنَّ وَ مِنْ عِنْدِکَ وُسْعِی، وَ لاَأَطْغَیَنَّ وَ مِنْ عِنْدِکَ وُجْدِی.
«و لا أُظلَمَنَّ» قیل: «فعل النهی المؤکّد بالنون الثقیلة، أی: لیکن عدم مظلومیّتی حالکونک مطیقاً للدفع عنّی؛ أو «لا» للنفی، و المعنى: أسألک أن لاأظلم،أی: سأل – علیه السلام ـ أن لایظلمه أحدٌ و الحال انّه ـ تعالى ـ یقدر على أن یدفع عنه ظلم الظالمین؛
فلایلیق بجنابه أن لایدفع عنه».
و قال الفاضل الشارح: «لا طلبیّةٌ للدعاء؛ و «أُظلَم» مبنیٌّ للمفعول مجزومٌ بها مؤکّدٌ بالنون الثقیلة مسندٌ إلى ضمیر المتکلّم؛ و قس على ذلک البواقی. إلّا انّ الفعل فیها مبنیٌّ للفاعل. و الجزم بـ «لا» الطلبیّة لفعل المتکلّم ثابتٌ فی الفصیح و إن صرّح النحویّون بقلّته و ندوره»(139)
أقول: لاداعی إلى ما ذکره هنا حتّى یحتاج إلى شواهد!، و الجمل الّتی بعد هذه الأفعال کلّها أحوالٌ؛ و المعنى: و لا أکوننّ مظلوماً و الحال انّک مطیقٌ لدفع الظلم عنّی.
و قیل: «لا نافیةٌ فی جمیع هذه الفقرات، و الغرض الإخبار تحدّثاً بالنعمة»؛
و هو بعیدٌ!.
و «لا أَظلِمنَّ» بصیغة المعلوم.
<و «على القبض منّی» أی: قبض الظلم الصادر منّی و کفّی عنه.
و قیل: «بتضمینه معنى القصاص و نحوه»؛
و قیل: «انّ «من» بمعنى «على» ـ مثلها فی: (وَ نَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَومِ)(140) ـ. و حقیقته المنع»>(127)؛
و قیل: «منّی ظرفٌ مستقرٌّ متعلّقٌ بمحذوفٍ حالٌ من «القبض»، أی: کائناً منّی»(141)
و «لا أظلَنَّ»: من الظلال.
و «أمکنه» الأمر إمکاناً: سهّل و تیسّر.
و «الهدایة»: خلاف الظلالة.
و «الفقر»: خلاف الغنى، یقال: فَقِر یفقَر ـ من باب تعب یتعب ـ: إذا قلّ ماله، و أفقره
فافتقر. <و فی نسخةٍ(142) : «و لا أُقتُرِنَّ» بدل: «افتقرنّ» من الاقتار ـ بصیغة المجهول ـ، و هو: التضییق فی الرزق>(143)
و «الوُسع» ـ بالضمّ ـ: الجدة و الغنى.
و «الطغیان»: اسمٌ من طغى یطغی ـ من باب تعب ـ و من: طغى طغواً ـ من باب قال ـ بمعنى: مجاوزة الحدّ و الاسراف فی المعاصی، فکلّ مجاوز حدّه فی العصیان طاغٍ. و فی نسخة الشهید(144) ـ رحمه اللّه ـ بدل «أطغَیَنَّ»: أَضیقنّ ـ بفتح الهمزة ـ من: ضاق الرجل: إذا بخل أی: لاأبخلنّ؛ و بضمّها: لایذهبنّ مالی، من أضاق الرجل أی: ذهب ماله.
و «الوُجد» ـ بالضمّ، و یفتح و یکسر ـ: الغناء و الثروة؛ و المعنى: انّ الغناء و السعة لمّا کان فی الأکثر سبباً للطغیان و الفتنة ـ کما قال تعالى: (إِنَّ الاِنسَانَ لَیَطْغَى – أنْ رَءَاهُ اسْتَغْنَى)(145) ـ فکأنّه – علیه السلام ـ قال: لاتدعنی أطغینّ بالاستغناء؛ أو المعنى: انّ الطغیان و التکبّر لایحسن إلّا إذا کان من سعة الإنسان و غناه لنفسه، و أمّا نحن فلایحسن منّا، لأنّ وسعنا منه ـ تعالى ـ لاغیر؛ أو نقول: معنى هذا الفصل من الدعاء من قوله – علیه السلام ـ «و لاأظلمنّ… إلى اخره»: انّ هذه المتقابلات لمن یکون مبتلىً بالنفس و لم یصل إلى مرتبة الرضا و التسلیم و اندکاک جبل الأنّیّة، فلاتجعلنی مثلهم مبتلىً بهذه المتقابلات؛ فتدبّر تفهم!.
اللَّهُمَّ إِلَى مَغْفِرَتِکَ وَفَدْتُ، وَ إِلَى عَفْوِکَ قَصَدْتُ، وَ إِلَى تَجَاوُزِکَ اشْتَقْتُ، وَ بِفَضْلِکَ وَثِقْتُ، وَ لَیْسَ عِنْدِی مَا یُوجِبُ لِی مَغْفِرَتَکَ، وَ لاَ فِی عَمَلِی مَا أَسْتَحِقُّ بِهِ عَفْوَکَ، وَ مَا لِی بَعْدَ أَنْ حَکَمْتُ عَلَى نَفْسِی إِلاَّ فَضْلُکَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ تَفَضَّلْ عَلَیَّ.
<تقدیم الظرف فی الفقرات الأربع للتخصیص.
و «الوفود»: القدوم و الورود؛ یقال: وفد إلیه و علیه وفداً و وفادةً و وفوداً ـ من باب وعد ـ: قدم و ورد. و غلب استعماله لزیارة الملوک و الأمراء و الورود علیهم>(146)؛ و المعنى:
إلى مغفرتک وردت و قدمت لا إلى غیرها. و قس على ذلک ما بعدها.
و «القصد»: طلب الشیء بعینه.
و «التجاوز»: العفو و الصفح؛ و قد تقدّم.
و «الشوق»: میل النفس إلى الشیء؛ و قیل: «هو اهتیاج النفس إلى لقاء المحبوب، یقال: اشتاقه و اشتاق إلیه بمعنىً»(147)
و «الفضل»: الاحسان بلاعلّةٍ.
و «الوثوق»: الاعتماد.
<«و لیس عندی ـ... إلى آخره ـ»، «الواو» للحال، و الجملة فی محلّ النصب؛ أی: و الحال انّه لیس عندی ما یوجب مغفرتک من الأعمال الصالحة؛ و یحتمل أن یکون «الواو» للاستیناف و الجملة لامحلّ لها من الإعراب.
و «وجب» الحقّ یجب وجوباً أی: ثبت و لزم، و أوجبه أی: ألزمه و أثبته.
و «المغفرة»: هی أن یستر القادر القبیح ممّن هو تحت قدرته، حتّى أن العبد إذا ستر عیب سیّده – مخافة عقابه ـ لایقال: غفر له>(148)
«بعد أن حکمت» یعنی: بعد حکمی لک على نفسی و إقراری بعدم ما یوجب لی مغفرتک و ما استحقّ به عفوک؛ فـ «أن» مصدریّةٌ. و لم یذکر المحکوم به لدلالة الکلام السابق علیه. و الاستثناء مفرّغٌ محذوفٌ و «بعد» الإبدال من ذلک المحذوف؛ و التقدیر: و ما لی شیءٌ أعتمد و
أتّکل إلیه إلّا فضلک؛ لأنّه – علیه السلام ـ لایعتمد على عمله ـ لما مرّ ـ، و لما ورد فی الحدیث القدسیّ: «لایتّکلنّ العاملون على أعمالهم و إن حسنت، و لاییأسنّ المذنبون من مغفرتی لذنوبهم و إن کثرت، لکن برحمتی فلیثقوا و بفضلی فلیرجوا و إلى حسن نظری فلیطمئنّوا»(149)
و «الفاء» من قوله – علیه السلام ـ: «فصلّ» فصیحةٌ، أی: إذا لم یکن لی اعتمادٌ و اتّکالٌ على شیءٍ إلّا فضلک فصلّ على محمّدٍ و آله و تفضّل علیَّ.
اللَّهُمَّ وَ أَنْطِقْنِی بِالْهُدَى، وَ أَلْهِمْنِی التَّقْوَى، وَ وَفِّقْنِی لِلَّتِی هِیَ أَزْکَى، وَ اسْتَعْمِلْنِی بِمَا هُوَ أَرْضَى. اللَّهُمَّ اسْلُکْ بِیَ الطَّرِیقَةَ الْمُثْلَى، وَ اجْعَلْنِی عَلَى مِلَّتِکَ أَمُوتُ وَ أَحْیَا.
«الهدى» قد مرّ معناه؛ و کذا «التقوى»، و «الإلهام»، و «التوفیق».
و «للّتی هى أزکى» أی: الحالة أو الخصلة أو السیرة أو الملکة من العقائد الحقّة و الأعمال الحسنة.
و «المُثلى» ـ على وزن فُعلى ـ: تأنیث الأمثل ـ کـ: القصوى تأنیث الأقصى ـ، أی: الطریقة الفضلى، <یقال: مثل مثالةً فهو مثیلٌ ـ ککرم کرامةً فهو کریم ـ ؛ أی: فضَل فضْلاً ـ من باب قتل ـ فهو فاضلٌ؛ و فسّر قوله ـ تعالى ـ: (وَ یَذْهَبَا بِطَرِیقَتِکُمُ الْمُثْلَى)(150) أی: بمذهبکم الّذی أفضل المذاهب(151)؛ و منه: «أشدّ الناس بلاءً الأنبیاء(152) ثمّ الأمثل فالأمثل»(153) ـ
أی: الأشرف فالأشرف ـ. و المراد بـ «الطریقة المثلى» قیل: «هی الإقتصاد، و هو التوسّط
بین طرفی الإفراط و التفریط. و هذه الطریقة الموصلة إلیه ـ تعالى ـ تطابقت على الهدایة إلیها ألسنة الرسل و الأولیاء»؛
و قیل: «هی السیرة المختصّة بالسالکین إلى اللّه ـ تعالى ـ من(154) قطع المنازل و الترقّی فی
المقامات»>(155)
أقول: تحقیق المقام یقتضی بسطاً من الکلام؛ اعلم! أنّ الطرق إلى اللّه بعدد أنفاس الخلائق، فلکلّ خلقٍ طریقٌ خاصٌّ إلى موجده و بارئه، و هو طریق الوجود ـ لأنّ الممکن زوجٌ ترکیبیٌّ من الوجود و المهیّة، و جهة ربطه إلى العلّة هی جهة وجوده ـ کما هو مقرّرٌ فی محلّه ـ. و هو الطریق إلى الحقّ المعبّر عنه بالصراط، فانّ الصراطات کثیرةٌ و مع کثرتها ترجع إلى صراطین: صراط الوجود؛ و صراط الإیمان و التوحید. فصراط الوجود یعمّ کلّ موجودٍ، و صراط الإیمان یختصّ بأهل التوحید، فلاقدم للمشرک له، و لکن له قدمٌ على صراط الوجود.
قال صدر الحکماء و المحقّقین: «الصراط: طریق الحقّ. اعلم! أنّ لکلّ شیءٍ حرکةً جبلّیّةً و توجّهاً غریزیاً إلى اللّه ـ سبحانه ـ، و هذا المعنى مشاهدٌ ـ لمن انکشف النقاب عن بصیرته ـ فی أکثر الموجودات، و خصوصاً فی الإنسان لسعة دائرة وجوده و عظیم قوسه الصعودیّ و للإنسان مع تلک الحرکة الکمالیّة الجبلّیّة حرکةٌ إرادیّةٌ دینیّةٌ، (وَ إِنَّکَ لَتَهدِی إِلَى صِرَاطٍ مُستَقِیمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِی لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الاَرضِ)، فالاستقامة علیه و التثبّت فیه هو الّذی أراده اللّه من عباده و أرسل رسوله إلیهم و أنزل الکتب علیهم لأجله. و باقی الصراط لیس شیءٌ منها هذا الصراط المختصّ بأهل الکمال، بل کلّ واحدٍ منها یؤدّی سلوکه إلى صفةٍ من صفاته ـ تعالى ـ و اسمٍ من أسمائه غیر اسم «اللّه» ـ کما حقّقه العرفاء و دلّ علیه الحدیث المشهور(156) ـ ؛ (قُلْ هَذِهِ سَبِیلِی أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِیرَةٍ
أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی)(157)
و الاستقامة علیه هی المراد بقوله ـ تعالى ـ: (فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرتَ وَ مَنْ تَابَ مَعَکَ وَ لاَتَطْغَوا)(158) و الانحراف عنه یوجب السقوط عن الفطرة و الهویّ إلى جهنم ـ الّتی قیل لها: (هَلِ امْتَلاَتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِیدٍ)(159)
و هذا الصراط – المدعوّ فی قوله تعالى: (اهْدِنَا الصِّرَاطَ آلْمُستَقِیمِ)(160) ـ أدقّ من الشعر و أحدّ من السیف، لأنّ کمال الإنسان فی سلوکه إلى الحقّ منوطٌ باستعمال قوّتیه:
أمّا العلمیّة فبحسب إصابة التعیّن فی الأنظار الدقیقة الّتی هی أدقّ من الشعر؛
و أمّا العلمیّة فبحسب توسّط قواه الثلاث ـ: الشهویّة و الغضبیّة و الفکریّة ـ فی الاستعمال لتحصیل مکارم الأخلاق و ملکة العدالة؛ قال اللّه ـ تعالى ـ: (وَ إنَّکَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِیمٍ)، و هی أحدّ من السیف.
فالصراط المستقم له وجهان، أحدهما أدقّ من الشعر، و الآخر أحدّ من السیف. و الانحراف عن الوجه الأوّل یوجب الهلاک الدائم، (إِنَّ الَّذِینَ لاَیُؤْمِنُونَ بِالاْخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاکِبُونَ)(161)، و الوقوف على الوجه الثانی یوجب الشقّ و القطع ـ کما قیل: «من وقف علیه شقّه» ـ ؛ و إلیه أشیر بقوله ـ تعالى ـ: (یَقِفُونَ فِی الْحَمِیمِ)(162)، و بقوله: (أَثَّاقَلْتُمْ إِلَى الاَرضِ أَ رَضِیتُمْ بِالْحَیَاةِ الدُّنیَا مِنَ الاْخِرَةِ)(163)، و قوله ـ صلّى الله علیه و آله و سلّم ـ کما حکاه عنه ـ تعالى ـ: (إِنَّ هَذَا صِرَاطِی مُستَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ)(164)، أی: مرّوا على صراط الآخرة مستویاً من غیر انحرافٍ و میلٍ.
و تحقیق ذلک: انّ کمال الآدمیّ فی المشابهة بالملائکة و هم متفکّرون عن هذه الأوصاف المتضادّة، و لیس فی قدرة البشر الانفکاک و إن لم یکن حقیقة الانفکاک و هو التوسّط، فانّ
المتوسّط بین الضدّین بمنزلة الخالی عنها ـ فانّ الفاتر یقال له: لاحارٌّ و لاباردٌ؛ و الفیلیّ: لاأبیض و لاأسود ـ. فالبخل و التبذیر صفات الإنسان و السخیّ کأنّه لابخیل و لامبذّر، فالّذی یطلب غایة البعد من الطرفین یکون على الوسط. و لو فرضنا حلقة حدیدةٍ محماةً بالنار و وقع نملةٌ فهی تهرب بطبعها و لایمر إلّا على المرکز، لأنّه الوسط الّذی فی غایة البعد عن المحیط المحرق. و کلا جانبی هذا الصراط جحیمٌ، و لهذا قیل: «الیمین و الشمال مضلّةٌ»(165)
هذا بالقیاس إلى طائفةٍ؛ و أمّا بالنسبة إلى طائفةٍ أخرى ـ کطریقة أهل الأعراف، و هم الموحّدون الّذین (یَعْرِفُونَ کُلّاً بِسِیَماهُمْ)(166) ـ فالجنّة على یمینهم و النار على شمالهم.
و هذا الصراط یظهر یوم القیامة على الأبصار؛ و على قدر نور المارّین علیه یکون سرعة مشیهم و مرورهم إلى الجنّة، فیکون دقیقاً فی بعض الناس جلیّاً فی حقّ آخرین. و کذلک یختلف مقدار زمان المرور ـ قصراً و طولاً ـ بحسب تفاوت نور الإیمان شدّةً و ضعفاً؛ کما ورد فی الخبر(167) و یصدّق ذلک قوله ـ تعالى ـ: (نُورُهُمْ یَسْعَى بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ بِأَیمَانِهِم)(168) و «السعی» مشیٌ؛ و ما ثمّ طریقٌ إلّا الصراط»(169)؛ انتهى کلامه.
و «الطریقة»: ولایة الأئمّة – علیهم السلام ـ ؛ روى الصدوق فی کتاب معانی الأخبار(170)
باسناده عن الصادق – علیه السلام ـ انّه سئل عن «الصراط»؛ فقال: «هو الطریق إلى معرفة اللّه – عزّ و جلّ ـ. و هما صراطان:
صراطٌ فی الدنیا؛
و صراطٌ فی الآخرة؛
و أمّا الصراط الّذی فی الدنیا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرّفه فی الدنیا و اقتدى بهداه مرّ على الصراط ـ الّذی هو جسر جهنّم ـ فی الآخرة، و من لم یعرفه فی الدنیا زلّت قدمه عن الصراط فی الآخرة فتردّى فی نار جهنّم»؛
و باسناده عنه(171) أیضاً قال: «الصراط المستقیم أمیرالمؤمنین – علیه السلام ـ»؛
فی بصائر الدرجات(172) عن الصادق – علیه السلام ـ سئل عن قول اللّه – عزّ و جلّ ـ :
(وَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَیَّ مُستَقِیمٌ)(173) قال: «هو و اللّه علیٌّ، هو و اللّه(174) الصراط و المیزان»؛
و فی تفسیر أبی محمّد العسکریّ(175) – علیه السلام ـ: «الصراط المستقیم صراطان:
صراطٌ فی الدنیا؛
و صراطٌ فی الآخرة؛
فأمّا الطریق فی الدنیا فهو ما قصر عن العلوّ و ارتفع عن التقصیر و استقام، فلم یعدل إلى شیءٍ من الباطل؛ و الطریق الآخر طریق المؤمنین إلى الجنّة، و هو مستقیمٌ لایعدلون عن الجنّة إلى النار و لا إلى غیر النار سوى الجنّة».
فالصراط و المارّ علیه شیءٌ واحدٌ فی کلّ خطوةٍ یضع قدمه على رأسه ـ أعنی: یعمل على مقتضى نور معرفته الّتی هی بمنزلة رأسه ـ، بل یضع رأسه على قدمه ـ أی: یبنى معرفته على نتیجة عمله الّذی کان بناؤه على المعرفة السابقة ـ حتّى یقطع المنازل و یصل إلى اللّه،
(وَ إِلَى اللَّهِ المَصِیرُ)(176)
قوله – علیه السلام ـ: «و اجعلنی على ملّتک أموت و أحیى».
«الملّة»: الدین و الشریعة المستفادّة من مشکاة النبوّة، ثمّ اتّسعت فاستعملت فی الملّة الباطلة أیضاً؛ فقیل: ملّة الکفر و الزندقة.
و حرف الاستعلاء مؤذنٌ بالثبات، أی: ثابتاً على ملّتک. و هو متعلّقٌ بـ «أموت» و «أحیا» على سبیل التنازع. و تقدیمه للتخصیص ـ أی: على ملّتک لا على غیرها ـ مع ما فیه من الاهتمام و رعایة السجع. و تقدیم «الموت» لرعایة السجع إن کان المراد من «الحیاة»: الدنیا؛ و أمّا إن کان المراد: الحیاة بعد الموت – و هو البعث ـ فتقدیم «الموت» لایحتاج إلى عذرٍ.
و قیل: «تقدیم الموت للاهتمام به، لأنّ أقوى الناس داعیاً إلى العمل من نصب موته بین عینیه»(177)
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ مَتِّعْنِی بِالاْقْتِصَادِ، وَ اجْعَلْنِی مِنْ أَهْلِ السَّدَادِ، وَ مِنْ أَدِلَّةِ الرَّشَادِ، وَ مِنْ صَالِحِ الْعِبَادِ، وَ ارْزُقْنِی فَوْزَ الْمَعَادِ، وَ سَلاَمَةَ الْمِرْصَادِ.
«الإقتصاد»: افتعالٌ من القصد بمعنى: العدل، و هو التوسّط بین طرفی الإفراط و التفریط(178) و هو الطریق الوسط الحقّ الّذی لا میل له إلى أحد الجانبین ـ المعبّر بالصراط المستقیم، کما عرفت ـ.
و «السَّداد» ـ بالفتح ـ: الصواب و القصد من القول و العمل؛ یقال: سدّ یسدّ ـ من باب
ضرب یضرب ـ سدوداً: أصاب فی قوله و فعله، فهو سدیدٌ.
و «الأدلّة»: ـ جمع دلیل، و هو فعیلٌ ـ بمعنى: الهدایة و الارشاد؛ یقال: دلّه على الطریق أی: هداه و أرشده إلیه.
و «الرَّشاد» و «الرُّشد» ـ بالضم ـ و «الرَّشَد» ـ بالتحریک ـ: الهدى و الاستقامة و الصواب؛ أی: اجعلنی من أدلّة الرشاد و الاستقامة، لأنّه – علیه السلام ـ هو الصراط المستقیم و الطریق القصد الّتی أخذ اللّه على العباد سلوکها، فهو دلیلٌ للمخلوق إلى الحقّ.
و «الفوز»: النجاة و الظفر بالبغیة.
و «المعاد» فی اللغة بمعنى: الرجوع ـ مصدرٌ أو اسم مکانٍ ـ ؛ و حقیقته توجّه الشیء إلى ما کان علیه. و فی عرف الحکماء و المتکلّمین عبارةٌ عن: الرجوع إلى الوجود بعد الفناء(179)؛ أو رجوع أجزاء البدن إلى الاجتماع بعد التفرّق و إلى الحیاة بعد الموت و الأرواح إلى الأبدان بعد المفارقة؛ أو رجوع الأرواح إلى ما کانت علیه من التجرّد عن علائق البدن؛ على اختلاف الآراء(180)؛
و فی اصطلاح الشرع عبارةٌ عن: رجوع الإنسان بعد الموت لأجل الفوز بجزاء الأعمال و الأفعال الّتی صدرت عنه قبل الموت فی الدنیا.
<و «المرصاد» ـ کالمنهاج ـ: المکان الّذی یرصد فیه من الطریق؛ یقال: رَصَدته رصْداًـ من باب قتل ـ: إذا قعدت له على الطریق تترقّبه؛ و منه: أرصدت له العقوبة: إذا أعددتها له>(181)
و هو <ناظرٌ إلى قوله ـ تعالى ـ: (إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرصَادِ)(182) و فیه تفاسیر(183) :
أحدها: انّه ـ على طریق التمثیل ـ أنّه ـ تعالى ـ لایفوته شیءٌ من أعمالهم ـ کما لایفوت عمّن هو بالمرصاد ـ ؛
و ثانیها: ما روی عن علیٍّ – علیه السلام ـ انّه قال: «المرصاد قنطرةٌ على الصراط لایجوزها عبدٌ بمظلمة عبدٍ»(184) ـ یعنی: ینتصف من الظالم للمظلوم ـ ؛
و ثالثها: انّ المراد هو الصراط؛ و عن أبی جعفرٍ – علیه السلام ـ: «یوضع على جهنّم صراطٌ أدقّ من الشعر و أقطع من السیف، علیه ثلاث قناطر: الأولى علیها الأمانة و الرحم، و الثانیة علیها الصراط، و الثالثة علیها ربّ العالمین لا إله غیره»(185)>(186)
اللَّهُمَّ خُذْ لِنَفْسِکَ مِنْ نَفْسِی مَا یُخَلِّصُهَا، وَ أَبْقِ لِنَفْسِی مِنْ نَفْسِی مَا یُصْلِحُهَا، فَإِنَّ نَفْسِی هَالِکَةٌ أَوْ تَعْصِمَهَا.
قیل: «أی: الشیء الّذی یخلّص نفسی بسبب أخذک إیّاه من نفسی من الذنوب و العیوب ما یصلحها من الطاعة. و معنى: «لنفسک»: لرضا ذاتک. و انما طلبت منک أخذ ما یفسد نفسی من الذنوب و إبقاء ما یصلحها من الطاعة؛ لأنّ نفسی مردّدةٌ بین الهلاک، أو حفظک إیّاها، فان لم تحفظها فهی هالکةٌ، و إن حفظتها فهی ناجیةٌ؛ و لذلک طلبت منک ما هو لازمٌ لحفظک. و المفصّلة حقیقیّةٌ. و لفظة «أو» فی قوله – علیه السلام ـ: «أو تعصمها» بمعنى: «إلى أن»، أو: «إلّا أن» ـ کما قیل».
و الحاصل: انّی لولا عصمتک لهلکت و لم أنج بنفسی.
و قیل: «خذ لنفسک عن نفسی ما یخلصها من البلایا و المحن و الآلآم، فانّها کفّارة الذنوب، و فی الحدیث: «انّها ینقّی الإنسان من الذنوب کما ینقّی الکیر خبث الحدید»(187) و
حاصل المعنى: انّ الخلاص من العذاب الأخرویّ إذا کان موقوفاً على مثل هذا القصاص الدنیویّ فخذه منّی فی الدنیا حتّى لاتقاصّنی یوم القیامة بجنایاتی»(188)
و قیل: «المراد بالمأخوذ هنا: الصفات الذمیمة و الأفعال القبیحة، فانّ أخذها و رفعها سببٌ للقرب و الخلاص من العذاب، فـ «الأخذ» هنا بمعنى: الرفع و السلب» .
و قیل: «معناه: افعل بی ما یوجب نجاة نفسی و خلاصها من نفعٍ أو ضرٍّ أو فقرٍ أو غنىً أو موتٍ أو حیاةٍ ـ و إن کرهت بعض ذلک – لخلاص نفسی؛ و ابق منها مایکون فیه صلاحها، فانّ الخلاص قد یکون مع عدم الصلاح»(189)
و قیل: «المعنى: اصطف من أعمال نفسی ما یخلصها من سخطک و ابق لها من مساعیها مایکون به صلاحها».
و قال الفاضل الشارح: «انّه لما کانت النفس مکلّفةً بالقیام بأمرین:
أحدهما للّه ـ تعالى ـ، و هو سبب نجاتها و خلاصها من سخطه و عذابه ـ تعالى ـ؛
و الثانی للنفس، و هو ما لابدّ لها منه من أمر معاشها سئل – علیه السلام ـ أن یجعل نفسه قائمةً بما هو للّه ـ تعالى ـ، و هو سبب خلاصها. و لمّا کان هذا المعنى یوجب استغراق النفس فیه بحیث لایمکنها الاشتغال معه بغیره و لا التوجّه و الالتفات إلى أمرٍ آخر، سأل ثانیاً أن یبقى لنفسه من نفسه ممّا لابدّ لها منه مقدار مایکون فیه صلاحها کی لاتکلّ و لاتحسر عن القیام بما هو للّه و لاتأشر و تبطر فتشتغل بغیر ما هو للّه، فیکون اشتغالها به فی الحقیقة عائدآ إلى الأمر الأوّل، و فی ذلک صلاحها»(190)
و قیل: «المعنى: استعملنی فی مرضاتک، فان کان المرض و الفقر خیراً لطاعتک إیّای فخذ منّی الصحّة و الغنى ـ لأنّ المرض و الفقر مع طاعتک و رضاک خیرٌ لی من ضدّها مع
معصیتک ـ.
و فی نسخةٍ: «خذ نفسی من نفسک»، و فیه اشارةٌ إلى التخلّق بأخلاق اللّه، أی: خذ من جنابک المقدّس أخلاقآ حسنةً لنفسی بأن تذهب عنها الأخلاق الذمیمة و تجعلها متّصفةً بالأخلاق الکریمة و ابق الأعمال الحسنة الّتی هی سببٌ لصلاح نفسی و اذهب عنّی الأعمال السیّئة؛ لأنّک تمحو ما تشاء و تثبت.
و یحتمل أن یکون المعنى: استعملنی بأعمالٍ تکون سبباً لصلاح نفسی».
هذا ما ذکره العلماء الأعلام فی هذا المقام؛ و لایخفى رکاکة بعضها و بعد بعضٍ و أبعدیّة آخر!.
فالحقّ الحقیق بالتحقیق ما ألهمنی اللّه ـ تعالى ـ بفضله المنعام؛ و هو موقوفٌ على مقدّماتٍ:
الأولى: انّه لمّا کانت للهویّة الواحدیّة بالوحدة الحقیقیّة أحکام الکثرة بل کانت أحکام الکثرة منمحیّةً بمقتضى القهر الأحدیّ فی مقام الجمع المعنویّ ثمّ ظهرت فی مظاهر متفرّقةٍ غیر جامعةٍ من مظاهر هذه العوالم العینیّة على سبیل التفصیل و التفریق بحیث غلبت الکثرة فی أحکامها على أحکام الوحدة بحسب اقتضاء التفریق الفعلیّ و التفصیلیّ العینیّ أراد الحقّ أن یظهر ذاته فی مظهرٍ کاملٍ یتضمّن سائر المظاهر النوریّة و المجالی الظلّیّة و یشتمل على جملة الحقائق السرّیّة و الجهریّة و یحتوی على جملة الدقائق البطنیّة و الظهریّة ـ و هو الإنسان الکامل، فانّه الجامع بین مظهریّة الذات المطلقة و بین مظهریّة الأسماء و الصفات و الأفعال بما فی نشأته الکلّیّة من الجمعیّة و الاعتدال و بما فی مظهریّته من السعة و الکمال ـ ؛ و هو الجامع أیضاً بین الحقائق الوجوبیّة و نسب الأسماء الإلهیّة و بین الحقائق الإمکانیّة و الصفات الخلقیّة، فهو جامعٌ بین مرتبتی الجمع و التفصیل محیطٌ بجمیع ما فی سلسلة الوجود من المراتب. فلهذه الجمعیّة له الخلافة العظمى على الکلّ؛
و الثانیة: انّ الإنسان فیما بین سائر الأکوان مختصٌّ بالتطوّر فی الأطوار و الخروج من کلّ ما له من الکون المستعار و الانتقال من هذه الدار إلى عالم الآخرة و دار القرار و المهاجرة
من بیته ـ الّذی فیه ـ مهاجراً إلى اللّه الواحد القهّار ـ کما فی قوله سبحانه: (وَ مَنْ یَخْرُجْ مِن بَیتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ)(191) ـ. و إذ لیس له فی الوجود مقامٌ لایتعدّاه فله السیر إلى جمیع المقامات، و إذ لیست له صورةٌ معیّنةٌ فله التصوّر بکلّ صورةٍ و التحلّی بکلّ حلیةٍ ـ قال الشاعر:
لَقَدْ صَارَ قَلبِی قَابِلاً کُلَّ صُورَةٍ++
فَمَرعىً لِغِزْلاَنٍ وَ دَیرٌ لِرُهبَانِ(192) ـ
سیّما الکامل منه للمرتبة التمامیّة الجمعیّة؛
و الثالثة: انّ المراد من فناء العبد فی الحقّ لیس هو فناء ذاته ـ إذ یستلزم انقلاب الممکن إلى الواجب، و هو محالٌ ـ ؛ بل المراد: فناء بشریّته فی جهة ربوبیّة الحقّ ـ إذ لکلّ عبدٍ جهةٌ من الحضرة الإلهیّة، (وَ لِکُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیهَا)(193) ـ. و هذا الفناء لایحصل إلّا بتوجّهٍ تامٍّ إلى خالق الأنام حتّى غلبت جهة الحقّیّة و ضعفت جهة الخلقیّة ـ کالقطعة من الفحم المجاورة للنار الجسمانیّة، فانّها بسبب المجاورة و الاستعداد لقبول الناریّة تشتعل قلیلاً قلیلاً إلى أن تصیر ناراً، فیحصل منها ما یحصل من النار من الإحراق و الانضاج و الاضاءة و غیرها، و قبل الاشتعال کانت مظلمةً باردةً ـ.
و ذلک التوجّه لایمکن إلّا بالمحبّة الذاتیّة الکامنة فی الجبلّة، و ظهورها لایکون إلّا بالاجتناب عمّا یعارضها و یناقضها ـ و هو التقوى ممّا عداها ـ. فالمحبّة هی الرکب و الزاد هو التقوى، و هذا الفناء موجبٌ لأن یتعیّن بتعیّناتٍ حقّانیّةٍ و صفاتٍ ربّانیّةٍ ـ و هو البقاء بالحقّ ـ.
إذا عرفت هذه المقدّمات الثلاث فنقول: معنى قوله – علیه السلام ـ: «خذ لنفسک من نفسی ما یخلصها» أی: المقام الّذی یخلص من الأنّیّة و یوصلها إلى الحضرة الأحدیّة بالفناء
عن ذاتها بالکلّیّة، و هو المقام و المرتبة الکمالیّة الجمیّة الإمامیّة و المظهریّة التامّة للحضرة الإلهیّة. و هذا المقام له – علیه السلام ـ بالمقدّمة الأولى و الثانیة ـ و هو المعبّر عنه عندهم بالصحو بعد المحو، و البقاء بعد الفناء ـ ؛ و ذلک لمرتبة الجمعیّة. و هو المراد من قوله – علیه السلام ـ: «و ابق لنفسی من نفسی ما یصلحها» لئلّا یلزم الانقلاب ـ کما عرفت فی المقدّمة الثالثة ـ ؛ و لذا علّل هذا بقوله – علیه السلام ـ: «فانّ النفس هالکةٌ أزلاً أبداً فی جمیع المقامات و الحالات ـ کما قیل:
سیه روئى ز ممکن در دو عالم++
جدا هرگز نشد و اللّه اعلم(194) ! ـ.
و قوله – علیه السلام ـ: «أو تعصمها».
<«أو» هنا مثلها فی قولک: «لألزمنّک أو تعطینی حقّی» أی: إلى أن، أو: إلّا أن>(195)؛ و
المعنى: ما یخلصها من قید الدنیا و الآخرة ـ و هو العبادة الحرّة ـ.
«و ابق لنفسی ما یصلحها» اشارةٌ إلى العبادة للاخرة.
«أو تعصمها» اشارةٌ إلى العبادة الدنیویّة، فانّها تحتاج إلى العصمة. و ذلک لمقاماته الکثیرة و مرتبته الجمعیّة؛ أو لتعلیم الأمّة ـ کما قیل ـ.
فعلى هذا فقوله – علیه السلام ـ: «أو تعصمها» عطفٌ على «یصلحها»؛ فتأمّل فیما ذکرناه لک فی هذا المقام حتّى یظهر لک حقیقة المرام!.
اللَّهُمَّ أَنْتَ عُدَّتِی إِنْ حَزِنْتُ، وَ أَنْتَ مُنْتَجَعِی إِنْ حُرِمْتُ، وَ بِکَ اسْتِغَاثَتِی إِنْ کَرِثْتُ، وَ عِنْدَکَ مِمَّا فَاتَ خَلَفٌ، وَ لِمَا فَسَدَ صَلاَحٌ، وَ فِیما أَنْکَرْتَ تَغْیِیرٌ، فَامْنُنْ عَلَیَّ قَبْلَ الْبَلاَءِ بِالْعَافِیَةِ، وَ قَبْلَ الطَّلَبِ بِالْجِدَةِ، وَ قَبْلَ الضَّلاَلِ بِالرَّشَادِ، وَ اکْفِنِی مَؤُونَةَ مَعَرَّةِ الْعِبَادِ، وَ هَبْ لِی أَمْنَ یَوْمِ الْمَعَادِ، وَ امْنِحْنِی حُسْنَ الاِْرْشَادِ.
«العُدّة»: ما یعدّیه من حوادث الدهر ـ من المال و السلاح -.
<و «حزنت» ـ على وزن علمت(196)، من الحزن ـ: خلاف السرور؛ یقال: حزن یحزن حزناً ـ من باب تعب، و الاسم بالضمّ ـ، فهو حزینٌ؛ و على وزن فتحت من الحزونة: ضدّ السهولة(197)>(195)
<و «إن»: حرف شرطٍ استغنى عن جوابه بحذفه ـ لدلالة ما تقدّم من الکلام علیه ـ، و التقدیر: إن حزنت ـ على الوجهین ـ فأنت عدّتی و ذخری ـ، فحذف الجواب وجوباً، لما ذکر ـ>(198)
<و فی بعض النسخ: بالراء المهملة و الباء الموحّدة، من: حربه یحربه: إذا أخذ ماله و ترکه بلاشیءٍ؛ و قد حُرِب ـ على صیغة المجهول ـ ماله أی: سلب؛ قاله فی الصحاح(199)
و «منتجعی» أی: محسنی و شافعی؛ أو اسم مفعولٍ من انتجع فلانٌ فلاناً أی: طلب معروفه. و أصل «الانتجاع»: طلب الکلاء فی موضعه؛ أی: أنت من أرجو فضله و أؤمّل وفده. و أمّا على نسخة: «و إلیک منتجَعی»(200) ـ على اسم المکان ـ فمعناه: إلیک محلّ انتجاعی و موضع طلبتی.
«إن حُرِمت» ـ بصیغة المجهول ـ أی: إذا مُنعت من المعروف عن غیرک.
و «استغاث به»: طلب أن یغیثه ـ أی: یعینه و ینصره ـ، فهو مغیثٌ له.
و «کَرِثتُ» ـ کعلمت ـ أی: اغتممت غمّاً شدیداً. و فی نسخةٍ: «کربت»(201) ـ بالباء الموحّدة، من الکرب بمعنى: الشدّة ـ.
<و «فات» الأمر یفوت: ذهب.
و «الخَلَف» ـ بفتحتین ـ: اسمٌ من أخلف اللّه علیه ـ بالألف ـ أی: ردّ علیه ما ذهب، فهو بمعنى: العوض>(198)؛ أی: و عندک ممّا فات منّی من العبادات عوضٌ.
و «فَسَد» الشیء ـ من باب قعد ـ: خرج عن کونه منتفعاً به؛ و مقابله: الصلاح، و هو الحصول على الحالة المستقیمة النافعة؛ أی: و لما فسد من حالی و دینی و دنیای فعندک اصلاحه.
و «أنکرت» علیه فعله انکاراً: عبته و هجنته.
و «غیّرت» الشیء تغیّراً: أزلته عمّا کان فتغیّر هو؛ و المعنى: و أنت قادرٌ على تغییر ما لاترید إلى ماترید، لأنّک فعّالٌ لما یرید. و المعنى: تغییر الأمور السیّئة بالأمور الحسنة، قال اللّه ـ تعالى ـ: (فَأُولَئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ)(137)، و قد سبق تحقیق ذلک. و فی بعض النسخ: «فیما» بدل «ممّا».
و «الفاء» فصیحةٌ.
و «المنّ» قد سبق معناه؛ أی: إذا کنت بهذه الصفات فأعطنی العافیة دون البلاء. یعنی: إذا حکمت بالعافیة قبل البلاء فلایمکن انزاله ـ لاجتماع المتنافیین – ؛و علیه فقس البواقی.
و «الجدة»: الغنى و إدراک المأمول.
و «الضلال»: خلاف الصواب؛ <و قیل: «سلوک طریقٍ لایوصل إلى المطلوب».
و «الرشاد»: الهدایة.
و «المؤونة» قیل: «من مانه یمونه: إذا قام بکفایة أمره. و أصلها: موونة ـ بواوین، على وزن فعولة، قلبت الواو الأولى همزةً، لأنّ الواو المضمومة المتوسّطة تقلب همزةً، نحو: أدؤر فی جمع دار ـ»؛
و قیل: «الهمزة أصلیّةٌ، فهو فعولةٌ بمعنى الثقل، من: مانت القوم: إذا احتملت مؤونتهم»؛
و قیل: «بمعنى: العدّة من قولهم: أتانی هذا الأمر و ما مأنت له مأناً ـ بالهمز ـ: إذا لم یستعدّ
له»؛و قیل: «من الأون بمعنى: الثقل، لکون المؤونة مستلزمةً للثقل. و الأصل: مأونة ـ على وزن مفعلة ـ، فنقلت حرکة الواو إلى الهمزة و ضمّ ما قبل الواو بمناسبتها»>(202)
و استبعد بکثرة التغییر فیه.
و قد یستعمل بدون الهمزة، فیقال: مونة ـ کسورة ـ.
و «المعرّة»: مفعلةٌ من العرّ؛ و قد ورد تارةً بمعنى: الفساد و المشقّة؛ و أخرى بمعنى الإثم و الأذى و الخیانة.
<و المعنى على الأوّل: اکفنی المشقّة الحاصلة من العباد بکفّهم و منعهم عن الاجتراء على ایصالها إلیّ.
و على الثانی: اکفنی الإثم الحاصل لی من العباد ـ بغیبةٍ و نحوها ـ باقلاعی إیّاه>(203)
و «المعاد»: إمّا مصدرٌ، أو اسم مکانٍ ـ کما تقدّم ـ.
و «المنح»: العطاء.
و المراد بـ: «حسن الارشاد»: الهدایة الّتی لا ارتداد معها. و فی نسخةٍ: «حسن الارتیاد» أی: الطلب؛ یقال: ارتاد الرجل الشیء ارتیاداً أی: طلبه. و «حسن الطلب» من الأمور المهمّة، لأنّ «من طلب شیئاً و جدّ وجد، و من قرع باباً و لجّ ولج»(204)
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ادْرَأْ عَنِّی بِلُطْفِکَ، وَ اغْذُنِی بِنِعْمَتِکَ، وَ أَصْلِحْنِی بِکَرَمِکَ، وَ دَاوِنِی بِصُنْعِکَ، وَ أَظِلَّنِی فِی ذَرَاکَ، وَ جَلِّلْنِی رِضَاکَ، وَ وَفِّقْنِی إِذَا اشْتَکَلَتْ عَلَیَّ الاُمُورُ لاَهْدَاهَا، وَ إِذَا تَشَابَهَتِ الاَعْمَالُ
لاَزْکَاهَا، وَ إِذَا تَنَاقَضَتِ الْمِلَلُ لاَرْضَاهَا.
<«ادرء» أی: ادفع، من دَرَء الشیء دَرْءً ـ من باب نفع ـ: دفعه؛ و حذف المفعول للتعمیم مع الاختصار.
و «بلطفک» أی: بتوفیقک.
و «اغذنی» أی: ربِّنی، من غذوت الصبیّ باللبن فاغتذى أی: ربّیته به.
و «بنعمتک» أی: بالاغتذاء بها، لأنّ الغذاء ما یتغذّى به من الطعام و الشراب، و هو ما به نماء الجسم و قوامه. و استعمال «الغذاء» فیها استعارةٌ مکنیّةٌ تخییلیّةٌ>(205)
و علیک بتعمیم الرزق و النعمة حتّى یشتمل الصوریّة و المعنویّة ـ کما هو الشأن فی الکلمات المعصومیّة ـ.
و «الاصلاح»: إعادة ما فسد إلى الصلاح.
و «الکرم»: إفادة ما ینبغی لالغرضٍ؛ أی: بصفحک عن ذنوبی، فانّ فساد العبادة بالذنوب.
و «داونی»: من المداواة؛ یقال: داویته مداواةً أی: عالجته بالدواء؛ و هو ما یتداوى به ـ أی: لدفع المرض ـ. و حذف متعلّق «المداواة» للتعمیم؛ أی: داونی من کلّ داءٍ.
«بصنعک» أی: بمعروفک و احسانک.
و «أظلّنی» أی ألق علیَّ ظلّاً، من: أظلّه: ستره عن الشمس و ألقى علیه ظلّه.
<و «الذَرى» ـ بالفتح ـ: کلّ ما استترت به؛ یقال: أنا فی ظلّ فلانٍ و فی ذَراه أی: فی کنفه و ستره؛ حکاه الجوهریّ عن الأصمعیّ(206)>(207) و المعنى: اجعل على رأسی ظلّاً فی کنف
رحمتک و ستراً من وقایتک تظلّنی یوم القیامة من شمس عقابک. و یجوز أن یراد من الظلّ و
الذری معناهما المجازیّ، یقال: فلانٌ فی ظلّ فلانٍ و فی ذراه أی: فی جنب شفقته و عطوفته. و یجوز أن یکون «الذرى» من: الذروة ـ و هی: أرفع موضعٍ من الشیء ـ، یعنی: اجعل منزلتی فی ظلّ عرشک الّذی هو أرفع من کلّ شیءٍ.
و فی نسخةٍ: «فی دارک» أی: فی جنّتک الّتی هی دار السلام.
و «جلّلنی» من التجلیل بمعنى: التغطیة و الستر؛ یقال: جلّل الأرض المطر ـ بالتثقیل ـ : عمّها و طبّقها و غطّاها.
<و «اشتکلت» الأمور أی: اشتبهت و التبست؛ و فی نسخةٍ: «أشکلت».
و «أهدى» الأمور: أقربها إلى الصواب، أو أعظمها دلالةً إلى الحقّ>(135) و أشدّها هدایةً؛ متعلّقٌ بقوله: «وفّقنی»، أی: وفّقنی لأهدى الأمور إذا اشتبهت و التبست علیَّ.
و «لأذکاها» متعلّقٌ بـ «وفّقنی»، أی: وفّقنی لأزکى الأعمال؛ یعنی: أظهرها و ألیقها بی ـ أو بک ـ إذا اشتبهت و التبست لایدرى أیّها أزکى.
و «تناقض» الکلامان: تدافعهما، لأنّ کلّ واحدٍ نقض الآخر ـ أی: أبطله ـ، و نقیض الشیء: رفعه.
و «الملل»: جمع ملّة، و هی المذهب.
و «أرضاها» أی: أعظمها ارضاءً لک، أی: وفّقنی لاختیار أرضى الملل و الأدیان إذا تعارضت.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ تَوِّجْنِی بِالْکِفَایَةِ، وَ سُمْنِی حُسْنَ الْوِلاَیَةِ، وَ هَبْ لِی صِدْقَ الْهِدَایَةِ، وَ لاَتَفْتِنِّی بِالسَّعَةِ، وَ امْنِحْنِی حُسْنَ الدَّعَةِ، وَ لاَتَجْعَلْ عَیْشِی کَدّاً کَدّاً، وَ لاَتَرُدَّ دُعَائِی عَلَیَّ رَدّاً، فَإِنِّی لاَ أَجْعَلُ لَکَ ضِدّاً، وَ لاَ أَدْعُو مَعَکَ نِدّاً.
قال الجوهریّ: «تَوَّجَهُ(208) فتتوّج أی: ألبسه التاج فلبسه»(209) و هو ما یصاغ للملوک من الذهب و الجواهر فیضعونه على رؤوسهم.
و «الکفایة»: الاستغناء. شبّه «الکفایة» فی نفسه بـ «التاج» فی الاجلال و العظمة و دلّ على ذلک بالتتویج، فتکون استعارةً بالکنایة، و اثبات التتویج تخییلٌ(210) و المعنى: أی: صیّرنی ذا تاجٍ و عظمةٍ بسبب کفایتک مهمّاتی و اجعل کفایة مهمّاتی تاجاً على رأسی حتّى أفتخر بین الناس، و یکون ذلک سبباً لارتفاع شأنی و علوّ مکانتی عندهم و لا أکون محتاجاً إلى غیرک؛
أو: وفّقنی لکفایة مهمّات الخلائق و قضاء حوائجهم على یدی حتّى أعرف به کالتاج ـ على ما قالوا فی المقام(211) ـ.
و هو کما ترى! لأنّه – علیه السلام ـ أجلٌّ شأناً من أن یطلب الکفایة فی الأمور الدنیویّة بالنهج المذکور. فلعلّه – علیه السلام ـ أراد الکفایة و الاتّساع للمظهریّة التامّة و المرتبة الجمعیّة ـ کما مرّ تحقیق ذلک فی أوّل الکتاب؛ فتذکّر! ـ.
و علیک باستخراج معنى الفقرات التالیة من هذا إن کنت من أهله!.
و «سُمنی» ـ بضمّ السین ـ: أمرٌ من سامه کذا یسومه أی: أولاه و أعطاه؛ أو: عرضه و أورده علیه؛ أو: طلبه و أراده منه؛ قال فی الأساس: «سمت المرءة المعانقة: أردتها منها و عرضتها علیها»(212) أی: أولنی حسن الولایة، أو: أردها منّی؛ لکنّه کثر استعماله فی العذاب و الشرّ، یقول: سامه خسفاً و ذلّاً؛ أو بکسرها أمرٌ من <وسمه یسمه: إذا أثرت فیه بعلامةٍ و
کیٍّ، و منه المیسم للمکواة، و فی حدیث علیٍّ – علیه السلام ـ: «أنا صاحب المیسم»(213) ـ أوهو المیسم، أی: به بسم اللّه عزّ و جلّ خلص عباده المخلصین ـ. و قوله ـ تعالى ـ : (سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرطُومِ)(214)، معناه: «سنجعل لهم سمة أهل النار. و کذا القول فی قوله – علیه
السلام ـ : «و لاتسمنا» ـ فی دعاء الاستخارة ـ، و قوله – علیه السلام ـ: «و لاتسمنی» ـ فی دعاء عرفة، بضمّ السین و کسرها ـ>(215)
و کذلک <«الوِلایة» هنا ـ بفتح الواو و کسرها ـ، قال سیبویه: «بالفتح مصدرٌ(216) و بالکسر اسمٌ(217)، مثل الأمارة و النِقابة»(218) و المراد بـ: «حسن الولایة»: حسن القیام بما یتولّاه و یقوم به من الأمور. و «الوِلایة» ـ بالفتح و الکسر أیضاً ـ: النصرة>(219) و المحبّة ؛ فالمعنى على الأولى: أعطنی حسن ولایتی و أمارتی للناس و من هو تحت یدی من الموجودات، أو: حسن محبّتی و نصرتی؛ و على الثانی أی: أعملنی بحسن الولایة، یعنی: اجعل تولیتک لأموری علامةً أمتاز بها بین الناس و أفتخر. و الظاهر من التتبّع انّ هذا اللفط مهما تذکر فی هذه الأدعیة مع الباء فهو بمعنى: العلامة، و مهما تذکر بدون الباء فهو بمعنى: الاعطاء و الإیراد.
و «الصدق» فی اللغة: خلاف الکذب، و هو مطابقة الخبر للواقع؛ و قد یراد به مطلق الجودة. و فی اصطلاح أهل الحقیقة هو: أن یتّفق رضى الحقّ بعمل العبد أو حاله أو وقته و ایقان العبد و قصده، فیکون العبد راضیاً مرضیّاً.
و قیل: «هو أن لایکون فی أحوالک شوبٌ و لا فی اعتقادک ریبٌ و لا فی أعمالک عیبٌ»؛
و قیل: «هو أن تصدق فی موضعٍ لاینجیک منه إلّا الکذب!»(220)
و قیل: «هو قول الحقّ فی مواطن الهلاک»(221)
و هو من شرائف الصفات و نفائس الملکات، و قد کثر مدحه فی الأخبار و الآیات، قال خالق البریّات: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ)(222)، (الصَّابِرِینَ وَ الصَّادِقِینَ وَ الْقَانِتِینَ وَ الْمُنفِقِینَ وَ الْمُسْتَغْفِرِینَ بِالاَسحَارِ)(223)، (رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ)(224)؛
و قال الصادق: «انّ الرجل لیصدق حتّى یکتبه اللّه صدّیقاً»(225)؛
و قال: «من صدق لسانه زکی عمله»(226)؛
و قال: «لاتنظروا إلى طول رکوع الرجل و سجوده، فانّ ذلک شیءٌ اعتاده فلوترکه لاستوحش لذلک!، و لکن انظروا إلى صدق حدیثه و أداء أمانته»(227)؛
و قال – علیه السلام ـ: «إنّ علیّاً – علیه السلام ـ إنّما بلغ ما بلغ به عند رسول اللّه ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ بصدق الحدیث و أداء الأمانة»(228) و الأخبار فی ذلک کثیرةٌ.
و لها أنواعٌ عدیدةٌ؛
منها: الصدق فی الشهادة، و یقابله شهادة الزور؛
و الصدق فی الیمین، و یقابله الیمین الکاذبة؛
و الوفاء بالعهد، و یقابله خلف الوعد؛ و یشمله نوعٌ واحدٌ هو الصدق فی القول؛
و منها: الصدق فی النیّة، و قد سبق؛
و منها: الصدق فی العزم، فانّ الإنسان قد یعزم على عملٍ، فان کان مصمّماً جازماً کان صادقاً؛
و منها: الصدق فی الوفاء بالعزم، فانّ الإنسان ربما یعزم على فعلٍ متعلّقٍ بشرطٍ أو صفةٍ ثمّ بعد حصولها تمنعه الشهوات عن أدائه، قال اللّه ـ تعالى ـ: (رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ)؛
و منها: الصدق فی الأفعال، أی: مطابقة الظاهر و الباطن و استواء السرّ و العلانیة، أو کون الباطن أحسن من الظاهر، و هو أعزّ من الأنواع السابقة و أعلاها. و یستلزم هذا النوع أن لایقول ما لایفعل، قال الصادق – علیه السلام ـ: «فإذا أردت أن تعلم أ صادقٌ أنت أم کاذبٌ فانظر إلى(229) قصد معناک و غور دعواک و عیّرها بقسطاسٍ من اللّه – عزّ و جلّ ـ کأنّک(230) فی القیامة ـ قال اللّه تعالى: (وَ الوَزْنُ یَومَئِذٍ الحَقُّ)(231) ـ ؛ فإذا اعتدل معناک بدعواک
ثبت لک الصدق. و أدنى حقّ الصدق أن لایخالف اللسان القلب و لا القلب اللسان»(232)
و منها: الصدق فی مقامات الدین ـ کالصبر و الشکر و الخوف و الرجاء و الزهد و التوکّل و التعظیم و الرضا و الحبّ و التسلیم ـ، و هو من أعظم أنواعه.
ثمّ انّ لهذه الأنواع عرضٌ عریضٌ لاغایة لها لاناطتها بمعرفة اللّه ـ تعالى ـ، و هی غایةٌ لاتدرک، فکلّ من حصل له بقدر استعداده و سعیه من المعرفة حصلت له من تلک الأنواع
بقدرها.
و المراد بـ «صدق الهدایة» هنا: الهدایة الخاصّة، و هی کشف الأسرار الملکوتیّة و العلوم اللدنّیّة بالاتّصال إلى الحضرة الأحدیّة ـ کصاحب هذه الصحیفة ـ.
و قیل: «الهدایة الموصلة إلى المطلوب لامجرّد إراءة الطریق».
و «لاتفتنّی بالسعة» أی: لاتضلّنی بالغنى، لأنّ الإنسان (لَیَطغَى – أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى)(145)
بالمال و الثروة على الظاهر؛ و بالمعارف الحقّة و الأمور المنکشفة علیّ لولا العصمة.
<و «المنح»: العطاء.
و «الدعة»: الراحة و السعة فی العیش. و «الهاء» عوضٌ من الواو، تقول: ودُع الرجل ـ بالضمّ ـ فهو وادعٌ أی: فی العمل و الکسب>(233)
و «کدّاً کدّاً» أی: مشقّةً بعد مشقّةٍ. و لعلّ السرّ فی تکریره: انّ المعیشة یطلب فی کلّ وقتٍ، فإذا ضاقت على العبد وقع فی تعبٍ و شدّةٍ. و قیل: «الثانی تأکیدٌ للأوّل تأکیداً للنفی لا للمنفیّ ـ حتّى یلزم أن یکون سؤاله علیه السلام نفی مشقّةٍ بعد مشقّةٍ دون أصل المشقّة ـ.
و «ردّاً»: مفعولٌ مطلقٌ موکّدٌ لعامله.
و «الضدّ»: النظیر و الکفؤ. و الظاهر انّ المراد بالضدّ هنا: المخالف.
و «النِدّ» ـ بالکسر ـ: المثل.
و فی نسخة الشهید: «لاأدعوه» بالضمیر، و هو راجعٌ إلى المصدر ـ الّذی هو الدعاء ـ.
و لمّا کانت الاستعدادات مفطورةً على الخیر الإضافیّ الصوریّ أو المعنویّ بحسب درجاتها فی الأزل کان کلّ دعاءٍ منها و طلبٍ للخیر ـ بتهیئة قابلیّتها و تصفیتها و شوقها إلیه ـ یوجب حصول ذلک له عاجلاً و فیضانه علیه من المبدء الفیّاض الّذی هو منبع الخیرات و البرکات ـ کقوله: (وَ آتَاکُمْ مِنْ کُلِّ مَا سَأَلُتمُوهُ)(234) ـ، و کلّما فاض علیه خیرٌ
باستحقاقه له ـ تصفیةً و تزکیةً زاد استعداده بانضمام هذا الخیر إلیه فصار أقوى و أقبل من الأوّل، فیکون المبدء ـ تعالى ـ أسرع إجابةً و أکثر إفاضةً علیه؛ و هکذا یزداد الفیض حتّى بلغ مداه ـ و هو مرتبة ترک ما سواه ـ، فلذا علّل – علیه السلام ـ عدم ردّ الدعاء بترک الندّ و الضدّ؛ فتبصّر تفهم!.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ امْنَعْنِی مِنَ السَّرَفِ، وَ حَصِّنْ رِزْقِی مِنَ التَّلَفِ، وَ وَفِّرْ مَلَکَتِی بِالْبَرَکَةِ فِیهِ، وَ أَصِبْ بِی سَبِیلَ الْهِدَایَةِ لِلْبِرِّ فِیما أُنْفِقُ مِنْهُ.
«السَرَف» ـ محرّکةً ـ: اسمٌ من أسرف إسرافاً: إذا جاوز الحدّ فی النفقة و غیرها ؛ و المراد به هنا الأوّل، و قد مرّ تحقیقه فی اللمعة الثامنة. و قیل: «السَرَف: ضدّ القصد». و المراد: امنعنی عن الخروج عن القصد فی کلّ شیءٍ إلى طرفی الإفراط و التفریط.
و «حصّنه» تحصیناً: حماه و منعه.
و «الرزق» قد تقدّم معناه.
و «تلِف» تلَفاً ـ من باب تعب ـ: هلک و فنى، فهو تالفٌ؛ و أتلف ماله.
و «وفّرت» الشیء توفیراً: کثّرته.
و «المَلَکَة» ـ محرّکةً ـ: هی القیام بالممالیک و ما یملک من ذات الید(235)، أی: اجعل مالکیّتی للرزق وافراً بسبب البرکة و النماء فیه؛ فالمراد بـ «توفیر الملکة»: توفیر متعلّقها ـ أعنی: ما یملک، و هو الرزق المقدّم ذکره ـ. و ایقاع التوفیر علیها مجازٌ عقلیٌّ.
و قیل: «الملکة بمعنى الملک، أی: اجعل مملوکاً متوافرةً متکاثرةً بأن تعطی البرکة فیها»؛
و هو خطأٌ!.
<و «أَصِبْ بی» من الاصابة بمعنى: القصد، أی: اقصد بی طریق الهدایة.
و «البرّ»: هو الخیر و الاتّساع فی الإحسان.
و «الانفاق»: صرف المال فی الحاجة.
و ضمیر «منه» للرزق>(135) و فی نسخةٍ «فیه» بدل «منه».
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اکْفِنِی مَؤُونَةَ الاِکْتِسَابِ، وَ ارْزُقْنِی مِنْ غَیْرِ احْتِسَابٍ، فَلاَ أَشْتَغِلَ عَنْ عِبَادَتِکَ بِالطَّلَبِ، وَ لاَ أَحْتَمِلَ إِصْرَ تَبِعَاتِ الْمَکْسَبِ. اللَّهُمَّ فَأَطْلِبْنِی بِقُدْرَتِکَ مَا أَطْلُبُ، وَ أَجِرْنِی بِعِزَّتِکَ مِمَّا أَرْهَبُ.
<«کفاه» الأمر: إذا قام به.
و «المؤونة»: الثقل و المشقّة.
و «کسَب» ـ من باب ضرب ـ کسباً و اکتساباً: طلب المعیشة. و فی الاکتساب مزید اعتمالٍ ناشٍ من اعتناء النفس بتحصیل الغرض و سعیها فی طلبه؛ أی: اجعل رزقی بحیث لایلزم ارتکاب المشقّة فی اکتسابه(236)
و «الاحتساب» إمّا افتعالٌ من حسِبه ـ من باب علم ـ حِسباناً ـ بالکسر ـ، أی: ظنّه؛ أو من حسَبه ـ من باب قتل ـ حسْبا و حُسباناً ـ بالضمّ ـ أی: عدّه، أی:>(237) من حیث لایحتسب. و هو إشارةٌ إلى قوله ـ تعالى ـ: (وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیثُ لاَیَحْتَسِبُ)(238) أی: من حیث لایدری، کقوله – علیه السلام ـ: «أبى اللّه إلّا أن یجعل رزق المؤمن من حیث لایحتسب لئلّا یثق و یعتمد على ذلک الوجه الّذی قد علمه»(239) أو: و ارزقنی رزقاً کثیراً لایحسب و لایعدّ ـ لکثرته ـ.
<و «الفاء» من قوله - علیه السلام ـ: «فلااشتغل» سببیّةٌ، و نصب المضارع بعدها بـ
«أن» مضمرةً وجوباً لکونها مسبوقةً بالدعاء ـ کقوله:
رَبِّ وَفِّقْنِی فَلاَأَعْدِلَ عَنْ++
سَنَنَ السَّاعِینَ فِی خَیرِ سَنَنْ(240) ـ
و «أشتغل»: مضارع اشتغلت، بالبناء للفاعل. و قال بعضهم: «بالبناء للمفعول، لأنّ الافتعال إن کان مطاوعاً فلازمٌ لا غیر؛ و إن کان غیر مطاوعٍ فلابدّ أن یکون فیه معنى التعدّی، نحو: اکتسبت المال و اکتحلت و اختضبت، أی: کحّلت عینی و خضبت یدی. و اشتغلت لیس بمطاوعٍ و لیس فیه معنى التعدّی»؛
و أجیب: «بانّه فی الأصل مطاوعٌ لفعلٍ هجر استعماله فی فصیح الکلام، و الأصل: اشغلته ـ بالألف ـ فاشتغل ـ مثل: أحرقته فاحترق ـ و فیه معنى التعدّی، فانّک تقول: اشتغلت بکذا».
و الجارّ و المجرور فی معنى المفعول. و قد نصّ الأزهریّ على استعمال مشتغِل و مشتغَل(241)
و فی نسخة ابن ادریس: «فلاأُشْغَل» ـ بالبناء للمفعول ـ مضارع شغلت به؛ و هو أحسنٌ>(242)
<و «الإصر»: الإثم و الثقل.
و «التبعات»: جمع تبعة ـ على وزن کلمة ـ، و هی ما یتبع المال من نوائب الحقوق، من: تبعت الرجل بحقّی>(243)
و «المکسب» ـ على وزن مکتب ـ بمعنى: الکسب.
و قوله – علیه السلام ـ: «فاطلبنی» من باب الإفعال، أی: اسعفنی حاجتی و ما أطلب،
قال الجوهریّ: «أطلبه: أسعفه من الطلب و أحوجه إلى الطلب، فهو من الأضداد(244)»(245) و المراد الأوّل.
و «أجاره» إجارةً: حفظه و أمنه.
و «رهِب» رهْباً ـ من باب تعب ـ: خاف، و الاسم: الرُهبة.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ صُنْ وَجْهِی بِالْیَسَارِ، وَ لاَتَبْتَذِلْ جَاهِی بِالاِقْتَارِ فَأَسْتَرْزِقَ أَهْلَ رِزْقِکَ، وَ أَسْتَعْطِیَ شِرَارَ خَلْقِکَ فَأَفْتَتِنَ بِحَمْدِ مَنْ أَعْطَانِی، و أُبْتَلَى بِذَمِّ مَنْ مَنَعَنِی، وَ أَنْتَ مِنْ دُونِهِمْ وَلِیُّ الاِْعْطَاءِ وَ الْمَنْعِ.
«الصون» من الصیانة، و هو: الحفظ و الوقایة.
<و «الوجه» هنا بمعنى: الجاه و القدر، و منه: «کان لعلیٍّ وجهٌ من الناس حیاة فاطمة»(246) ـ.
و «الیَسار» ـ بالفتح ـ: الغنى و الثروة.
و «ابتذله»: امتهنه و لم یصنه.
و «الجاه»: القدر و المنزلة و المرتبة. قیل: «هو مقلوبٌ من الوجه»>(247)
و «الاقتار»: هو التضییق فی النفقة، <أی: لاتجعل جاهی بسبب الفقر کالثوب الممتهن الخَلِق، فأسال و لاأجاب>(248)، و هذا لاستلزام الغنى الحرمة عند الناس و الفقر المهانة عندهم؛ و فی بعض الآثار: «أحسنوا تعهّد المال، فانّه ما افتقر أحدٌ قطّ إلّا أصابه ثلاث
خصالٍ: رقّةٌ فی دینه، و ضعفٌ فی عقله، و ذهابٌ من مروّته، و الرابعة هی العظمى، و هی استخفاف الناس به»(149)
و «استعطی» أی: أطلب العطاء من شرار خلقک الّذین لیسوا بأهل للاستعطاء فیصیر هذا سبباً لافتتانی بحمد من أعطانی.
و «أُبتُلِى» ـ بالمجهول و المعلوم ـ عطفٌ على «أفتتن»، أی: و یصیر هذا أیضاً سببآ لابتلائی بذمّ من منعنی؛
أمّا الافتتان بالحمد فلأنّ حمد غیره ـ تعالى ـ سببٌ للبعد والشقاء؛
و أمّا الابتلاء بذمّ من منعنی من حیث الظاهر فلأنّ فیهم من لیس بأهل الذمّ ـ و فی الأمثال: «ربّ ملومٍ لاذنب له»(249) ـ، و أیضاً: «لعلّ له عذراً و أنت تلوم!»(250)؛
و من حیث الباطن فلأنّ حمدک العبد إذا أعطى و ذمّک إذا منع ـ یعنی الرضا عند العطاء و الغضب عند المنع ـ دلیل عدم التوکّل و الرضاء و التسلیم، بل هو شرکٌ على مذهب العارفین!.
و «الواو» من قوله: «و أنت» للحال، أی: و الحال أنت ولیّ الإعطاء و المنع و أقرب إلیَّ منهم، فلایلیق بأحدٍ أن یستعطی عبادک.
و فی هذا الفصل من الدعاء إشارةٌ إلى استحقار الدنیا و لذّاتها و الذلّ و المسکنة و اهراق ماء الوجه فی طلبها. بیان ذلک: انّ الأوهام العامّیّة ذهبت إلى أن اللذّات القویّة المستعلیة هی الحسّیّة و انّ ما عداها ضعیفةٌ؛ کلّا! بل کلّها خیالاتٌ محضةٌ و أوهامٌ صرفةٌ!؛ قال فی الإشارات: «و قد یمکن أن ینبّه مِن جملتهم مَن له تمیّزٌ مّا، فیقال له: أ لیس ألذّ ما تصفونه من هذا القبیل هو المنکوحات و المطعومات و أمورٌ تجری مجراها و أنتم تعلمون انّ المتمکّن من
غلبةٍ مّا و لو فی أمرٍ خسیسٍ ـ کالشطرنج و النرد ـ قد یعرض له معطومٌ و منکوحٌ فیرفضه لما یعتاضه من لذّة الغلبة الوهمیّة و قد یعرض مطعومٌ و منکوحٌ لطالب العفّة و الرئاسة مع صحبته جسمه فی صحّة حشمه فینفض الید منهما مراعاةً للحشمة فیکون مراعاة الحشمة آثر و الذّ لامحالة هناک من المطعوم و المشروب(251) و إذا عرض للکرام الناس الالتذاذ بانعامٍ
یصیبون موضعه آثروه على الالتذاذ بمشتهىً حیوانیٍّ متنافس فیه و آثروا فیه غیرهم على أنفسهم مسرعین إلى الانعام به. و کذلک فانّ کبیر النفس منهم(252) یستصغر الجوع و العطش عند المحافظة على ماء الوجه و یستحظر(253) الموت و مفاجاة العطب منه مناجزة الاقتران(254) و المبارزین. و ربّما اقتحم الواحد منهم على عدوّهم(255) ممتطیاً ظهر الخطر لما یتوقّعه من لذّة الحمد و لو بعد الموت کان ذلک یصل إلیه و هو میّتٌ!؛ فقد بان أنّ اللذّات الباطنیّة مستعلیةٌ على اللذّات الحسّیّة»(256)
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنِی صِحَّةً فِی عِبَادَةٍ، وَ فَرَاغاً فِی زَهَادَةٍ، وَ عِلْماً فِی اسْتِعْمَالٍ، وَ وَرَعاً فِی إِجْمَالٍ.
<«الصحّة»: حالةٌ طبیعیّةٌ تجری معها الأفعال على المجرى الطبیعیّ. و قد استعیرت للمعانی، فیقال: صحّ الخبر: إذا طابق الواقع و نفس الأمر؛ و: صحّ العقد: إذا ترتّب علیه الأثر.
و «العبادة»: هی أقصى غایة التذلّل و الخضوع للحضرة الأحدیّة، و منه: طریقٌ معبّدٌ أی: مذلّل.
و «الفراغ» هنا: الخلاص من المهمّات مطلقاً إلّا همّاً واحداً.
و «الزهادة»: الزهد. و هو فی اللغة: ترک المیل إلى الشیء(257)؛ و فی الإصطلاح>(258) : اعراض النفس عن الدنیا و طیّباتها.
و قیل: «هو ترک راحة الدنیا لطلب راحة الآخرة»(259)
أقول: بل هو العدول عن غیره ـ تعالى ـ إلیه.
و قیل: «اسقاط الرغبة عن القلب بالکلّیّة»(260)
و هی للعامّة قربةٌ، و للخاصّة خشیةٌ.
و هو من أرفع منازل الدین و أعلى مقامات السالکین؛ و الآیات و الأخبار فی ترک الدنیا و الزهد عنها أزید من أن تحصى، فلابدّ لنا أوّلاً معرفة «الدنیا» حتّى «نزهد» فیها و معرفة «الآخرة» حتّى «نرغب» إلیها. فنقول:
«الدنیا» فی عرف أهل الشریعة عبارةٌ عن دار التکلیف، و «الآخرة» عن دار الجزاء؛ و فی عرف أهل الحقیقة عبارةٌ عن هذه الدار البائدة الهالکة الجسمانیّة، و الآخرة عبارةٌ عن دار البقاء و الحیاة الأبدیّة. فهما مختلفان فی جوهر الوجود. و لو کانت الآخرة من جوهر الدنیا لم یصحّ «أنّ الدنیا تخرب و الآخرة تبقى»(261) فوجود الدنیا یخالف وجود الآخرة ذاتاً و جوهراً، و إلّا لکان القول بالآخرة تناسخاً، و لکان المعاد عبارةً عن عمارة الدنیا بعد خرابها، و إجماع العقلاء منعقدٌ على انّ الدنیا تضمحلّ و تفسد ثمّ لاتعود أبداً.
و أکثر أهل العبادة و الزهّاد من غیر العارفین ـ معرفةً حقّةً إلهیّةً ـ یتصوّرون أنّ لذّات الآخرة و نعیمها من جنس لذّات الدنیا إلّا انّ تلک ألذّ و أدوم؛ فهم بالحقیقة طلبة الدنیا عشّاقاً للشهوات و الهوى على آکد وجهٍ و أقوى. و یؤکّد ما قرّرناه ما ورد فی ألسنة الشریعة: «انّ للّه عالمین: الدنیا و الآخرة».
فظهر أن لانسبة بین هذا العالم و العالم الآخرة بحسب الوضع و المکان؛ و ما ورد من «أنّ أحدهما باطن الآخر و الآخر ظاهره»(262) لاینافی ما ذکرناه ـ کما فی النفس و البدن، لأنّ باطنیّة أحدهما الآخر لایستلزم اتّحاد وجودهما، بل للنفس وجودٌ و للبدن وجودٌ آخر ـ.
ثمّ اعلم! أنّ حبّ الدنیا من حیث نحو وجودها لیس بمذمومٍ، بل ممدوحٌ، و إنّما المذموم منها عند أهل الشریعة حبّ الحظوظ العاجلة الّتی لایتوسّل بها إلى الآخرة. و عند أهل الحقیقة الدنیا من حیث هی؛ و هو المراد من قوله ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ: «حبّ الدنیا رأس کلّ خطیئةٍ»(263) و إذا لوحظ التعیّن فالدنیا و الآخرة سواءٌ، فلذا قال أمیرالمؤمنین – علیه السلام ـ : «ماعبدتک خوفاً من نارک و لا طمعاً فی جنّتک، بل(264) وجدتک مستحقّاً(265) للعبادة فعبدتک»(266)
فالاحتمالات العقلیّة أربعةٌ:
اجتماع الدنیا و الآخرة، و هو محالٌ، لما عرفت من أنّهما متخالفان بالوجود، فلایجتمعان؛ و هو المراد بقوله ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ: «الدنیا حرامٌ على أهل الآخرة و الآخرة
حرامٌ على أهل الدنیا»(267)؛
و ارتفاعهما، و هو المراد بقوله ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ: «و هما حرامان على أهل اللّه»؛
و وجود أحدهما بدون الآخر.
ثمّ اعلم! أنّ حظوظ الدنیا و إن لم تکن بأسرها معرضةً لسخط اللّه و عذابه لکنّها حائلةٌ بین العبد و بین الدرجات العالیة مفوّتةً لحظوظٍ دائمةٍ باقیةٍ مع کونها فی جنبها حقیرةً زائلةً فانیةً و موجبةً لطول الحساب و المناقشة من ربّ الأرباب. و معلومٌ انّ طول الموقف فی عرصة القیامة لأجل الحساب أیضاً نوعٌ من العذاب ـ و لذا قال رسول اللّه: «فی حلالها حسابٌ و فی حرامها عقابٌ»(268) ـ، فمن کانت معرفته باللّه ـ سبحانه ـ أقوى و أتمّ کان حذره من الدنیا أکثر و أعظم؛ حتّى أنّ عیسى بن مریم – علیه السلام ـ وضع رأسه على حجرٍ لمّا نام ثمّ رمى به، إذ تمثّل له إبلیس و قال: «رغبت فی الدنیا!»(269)
و کلّ من کان عنایته ـ تعالى ـ به أکثر و منّته علیه أوفر ابتلاه فی الدنیا بأنواع المحن و البلاء ـ من الأنبیاء و الأولیاء، ثمّ الأمثل فالأمثل ـ فی درجات العلى لیوفّر من الآخرة حظّه ـ کما یمنع الوالد المشفق ولده عن لذائذ الفواکه و الأطعمة و یلزمه بالفصد و الحجامة حبّاً له و اشفاقاً علیه ـ. و لأجله لم یرض لهم بقلیل الدنیا و کثیرها. روی أنّ روح اللّه – علیه السلام ـ اشتدّ به المطر و الریح و الرعد و البرق یوماً، فجعل یطلب بیتاً یلجأ إلیه، فرفعت إلیه خیمةٌ من بعیدٍ فأتاها فاذاً فیها إمرأةٌ، فحاد عنها، ثمّ نظر(270) فاذا هو بکهفٍ فی جبلٍ فأتاه فإذاً فیه أسدٌ!، فرفع(271) یده و قال: «إلهی! جعلت لکلّ شیءٍ مأوىً و لم تجعل لی
مأوىً؟!
فأوحى اللّه إلیه: مأواک فی مستقرٍّ من(272) رحمتی»(273) ـ… الحدیث ـ.
و بالجملة إذا انتبهت النفس عن نوم الغفلة و استیقظت من رقدة الجهالة و فتحت عین بصیرتها و عاینت عالمها و عرفت مبدأها و معادها تیقّنت انّ المستلذّات الجسمیّة و المحاسن المادّیّة ـ کلّها ـ کعکوس الفضائل العقلیّة و خیالات الأنوار الروحانیّة لیست لها حقیقةٌ متأصّلةٌ و ذاتٌ مستقلّةٌ، بل (کَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ یَحسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئاً وَ وَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابِهِ)(274)
1) کریمة 112 النساء.
2) راجع: «وسائل الشیعة» ج 12 ص 287 الحدیث 16323، «بحار الأنوار» ج 72 ص 194،«جامع الأخبار» ص 148، «صحیفة الرضا» ص 49 الحدیث 36، «عیون أخبار الرضا» ج 2ص 33 الحدیث 63.
3) راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 334.
4) راجع: «عدّة الداعی» ص 303، و انظر أیضاً: «وسائل الشیعة» ج 15 ص 239 الحدیث20381، «بحار الأنوار» ج 67 ص 285، «مستطرفات السرائر» ص 650.
5) کریمة 38 الأعراف.
6) کریمة 134 آل عمران.
7) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 342.
8) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 343.
9) راجع: «الکافی» ج 2 ص 209 الحدیث 5، «بحار الأنوار» ج 73 ص 46.
10) قارن: «نور الأنوار» ص 126، مع تقدیمٍ و تأخیرٍ.
11) کریمة 1 الأنفال.
12) لم یأت الأخفش بکلامه هذا فی «معانی القرآن» عند ذکر معانی آی سورة الأنفال ـ راجع:«معانی القرآن» ج 2 ص 541 ـ، و لکنّه یوجد فی بعضٍ من المصادر، فانظر: «صحاح اللغة»ج 6 ص 2553 القائمة 2، «لسان العرب» ج 15 ص 495 القائمة 2.
13) کریمة 11 الضحى.
14) راجع: «بحار الأنوار» ج 16 ص 190، ج 64 ص 369، «الغارات» ج 1 ص 96، «مکارمالأخلاق» ص 18.
15) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 346.
16) الکشاف: ـ انّ.
17) الکشّاف: + عند الإنحطاط.
18) الکشّاف: فی التواضع.
19) راجع: «تفسیر الکشّاف» ج 3 ص 131.
20) کریمة 215 الشعراء.
21) هذا قول القفّال على ما حکاه العلّامة المدنیّ، راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 347، وانظر: «التفسیر الکبیر» ج 20 ص 191.
22) قارن: «شرح الصحیفة» ص 207.
23) کریمة 46 الأنفال.
24) المصدر: لها.
25) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 348.
26) لم أعثر علیه فی مصادرنا، و انظر: «سنن أبی داود» ج 3 ص 129 الحدیث 2926، «مسندأحمد» ج 1 ص 190.
27) و انظر: «شرح الصحیفة» ص 207، «نور الأنوار» ص 126.
28) قارن: «التعلیقات» ص 48.
29) راجع: «المصباح المنیر» ص 360.
30) هذا قول محدّث الجزائریّ، راجع: «نور الأنوار» ص 126.
31) قال: «و عیّره الأمر، و لاتقل بالأمر»، راجع: «القاموس المحیط» ص 416 القائمة 2.
32) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 350.
33) راجع: «شرح الصحیفة» ص 207.
34) راجع: «الکافی» ج 2 ص 356 الحدیث 3، و انظر أیضاً: «وسائل الشیعة» ج 12 ص 276الحدیث 16295، «مستطرفات السرائر» ص 643.
35) المصدر: ـ و قال… الآخرة.
36) لم أعثر علیه، و روى الجزائریّ: «من أنّب مؤمناً أنّبه اللّه فی الدنیا و الآخرة»، راجع: «نورالأنوار» ص 126.
37) لتفصیل هذه النسخة راجع: «شرح الصحیفة» ص 207.
38) راجع: «الکافی» ج 4 ص 30 الحدیث 1، و انظر: «من لایحضره الفقیه» ج 2 ص 57 الحدیث1692، «وسائل الشیعة» ج 16 ص 299 الحدیث 21599، «الأمالی» – للطوسی ـ ص643 الحدیث 1336.
39) هذا مفادّ کلام العلّامة المدنیّ، راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 353.
40) المصدر: أوّلاً فدعواه.
41) راجع: «نهج البلاغة» الکلمة 32 ص 474، «شرح ابن أبی الحدید علیه» ج 18 ص 149.
42) لم أعثر علیه، و قریبٌ منه: «… ملکٌ ینادی:… یا صاحب الخیر أتم و أبشر»، راجع: «بحارالأنوار» ج 58 ص 143.
43) المصدر: ـ إنّما هی.
44) الریاض: علیکم.
45) راجع: «مجموعة ورّام» ج 1 ص 105، و انظر: «بحار الأنوار» ج 74 ص 180.
46) المصدر: یجب.
47) راجع: «الکافی» ج 2 ص 116 الحدیث 19، «وسائل الشیعة» ج 12 ص 196 الحدیث16072، «بحار الأنوار» ج 68 ص 306.
48) راجع: «الکافی» ج 2 ص 115 الحدیث 16، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 27 ص 21 الحدیث33103، «بحار الأنوار» ج 68 ص 304.
49) المصدر: + و جلالی.
50) راجع: «الکافی» ج 2 ص 115 الحدیث 13، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 12 ص 189الحدیث 16046، «مستدرک الوسائل» ج 9 ص 25 الحدیث 10105، «الإختصاص» ص230، «الخصال» ج 1 ص 5 الحدیث 15.
51) راجع: «الأعلام» ج 8 ص 195 القائمة 1، «الوافی بالوفیات» ج 2 ص 309، «طبقات الأدباء» ص 238.
52) راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 354.
53) إشارةٌ إلى ما روی عن أبی عبداللّه – علیه السلام ـ انّه قال: «سئل رسول اللّه ـ صلّى اللّهعلیه و آله و سلّم ـ عن جماعة أمّته، فقال: جماعة أمّتی أهل الخیر و إن قلّوا»، راجع: «المحاسن»ج 1 ص 220.
54) و انظر: «نور الأنوار» ص 126.
55) راجع: «القاموس المحیط» ص 1182 القائمة 2.
56) المصدر: ـ کما هو… هوائهم.
57) لم أعثر على هذا التعریف بلفظه فی کتب أصول الفقه للعامّة، و انظر: «المستصفى من علمالأصول» ج 2 ص 228.
58) راجع: «ربیع الأبرار» ج 2 ص 40.
59) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 361.
60) کریمة 13 المائدة / 46 النساء.
61) کریمتان 169 / 168 البقرة.
62) کریمة 26 ص.
63) المصدر: ولایتنا.
64) المصدر: ـ و.
65) المصدر: ـ الجهّال.
66) المصدر: و اضلّوا.
67) راجع: «مستدرک الوسائل» ج 17 ص 309 الحدیث 21429، و انظر: «بحار الأنوار» ج 2ص 84، «التفسیر المنسوب إلى الإمام العسکریّ» – علیه السلام ـ ص 53 الحدیث 26.
68) راجع: «الکافی» ج 1 ص 42 الحدیث 2، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 27 ص 21 الحدیث33102، «الخصال» ج 1 ص 52 الحدیث 66.
69) راجع: «الکافی» ج 1 ص 43 الحدیث 7، «وسائل الشیعة» ج 27 ص 23 الحدیث 33108،«بحار الأنوار» ج 2 ص 113، «الأمالی» – للصدوق ـ ص 420 الحدیث 14.
70) راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 2 ص 626 الحدیث 3215، و انظر: «نهج البلاغة» الکلمة382 ص 544، «شرح ابن أبی الحدید» علیه ج 19 ص 323، «وسائل الشیعة» ج 15 ص168 الحدیث 20224، «بحار الأنوار» ج 2 ص 122.
71) راجع: «عیون أخبار الرضا» ج 2 ص 46 الحدیث 173، و انظر: «الکافی» ج 7 ص 409الحدیث 2، «تهذیب الأحکام» ج 6 ص 223 الحدیث 23.
72) راجع: «الکافی» ج 1 ص 57 الحدیث 17، «وسائل الشیعة» ج 27 ص 41 الحدیث33162.
73) راجع: «الکافی» ج 1 ص 56 الحدیث 11، «وسائل الشیعة» ج 27 ص 40 الحدیث33156، «المحاسن» ج 1 ص 215 الحدیث 99.
74) کریمتان 20 / 19 إبراهیم.
75) کریمة 105 الأنبیاء.
76) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 363.
77) راجع: «القاموس المحیط» ص 971 القائمة 1.
78) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 364.
79) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 365.
80) کریمتان 9 / 8 النجم.
81) المصدر: + الدرجة الأولى.
82) المصدر: ثمّ تحقیق.
83) المصدر: + الدرجة.
84) المصدر: و سقوط.
85) راجع: «منازل السائرین» بشرح العارف الکاشانی ص 553.
86) کریمة 30 / 28 آل عمران.
87) المصدر: + ثلاثةٌ.
88) المصدر: الاتّصال.
89) المصدر: ـ فی العلّة.
90) راجع: نفس المصدر ص 558.
91) و انظر: «النهایة» ج 3 ص 61.
92) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 366.
93) کریمة 81 طه.
94) راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 367.
95) المصدر: عبدٌ منکم.
96) راجع: «مستدرک الوسائل» ج 13 ص 29 الحدیث 14652، «بحار الأنوار» ج 74 ص 187،«اعلام الدین» ص 342، «شرح نهج البلاغة» ج 3 ص 158.
97) و انظر: «ریاض السالکین» ج 3 ص 368.
98) و انظر: «التعلیقات» ص 49.
99) کریمة 9 النجم.
100) راجع بنفس العبارة: «القاموس المحیط» ص 426 القائمة 2.
101) هیهنا حذف المصنّف قطعةً من المصدر.
102) المصدر: + لطائف.
103) المصدر: ـ رقّ اتیان.
104) کریمة 29 الأنفال.
105) راجع: «منازل السائرین» بشرح العارف الکاشانی ص 60.
106) کریمة 185 الأعراف.
107) کریمة 8 الروم.
108) کریمة 191 آل عمران.
109) المصدر: التفکیر.
110) راجع: «کشف الغمّة» ج 1 ص 573، و لم أعثر علیه فی غیره من مصادرنا.
111) راجع: «مستدرک الوسائل» ج 11 ص 183 الحدیث 12689، «بحار الأنوار» ج 68 ص327، «تفسیر العیّاشی» ج 2 ص 208 الحدیث 26، و انظر: «نور الأنوار» ص 126.
112) لم أعثر علیه، و روی: «ساعة العالم… خیرٌ من…»، راجع: «عدّة الداعی» ص 75.
113) راجع: «الکافی» ج 2 ص 55 الحدیث 5، «وسائل الشیعة» ج 15 ص 196 الحدیث20262، «مجموعة ورّام» ج 2 ص 184.
114) المصدر: + فی.
115) راجع: «الکافی» ج 2 ص 55 الحدیث 3، «وسائل الشیعة» ج 15 ص 196 الحدیث20260، «بحار الأنوار» ج 68 ص 321.
116) راجع: «بحار الأنوار» ج 68 ص 325.
117) راجع: «الکافی» ج 2 ص 55 الحدیث 4، «وسائل الشیعة» ج 15 ص 196 الحدیث20261، «بحار الأنوار» ج 68 ص 322، «مجموعة ورّام» ج 2 ص 183.
118) لم أعثر علیه، و انظر: «مجموعة ورّام» ج 1 ص 250.
119) راجع: «الکافی» ج 1 ص 93 الحدیث 7، «وسائل الشیعة» ج 16 ص 195 الحدیث21327، «بحار الأنوار» ج 3 ص 259، «التوحید» ص 458 الحدیث 20.
120) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 371.
121) من أبیاتٍ لأبی العتاهیة، راجع: «دیوانه» ص 122، و انظر: «الأغانی» ج 4 ص 39.
122) کریمة 109 الکهف.
123) المصدر: و تحسب.
124) راجع: «أنوار العقول» ص 249.
125) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 372.
126) لم أعثر علیه بین نصوص اللغویّین، فانظر مثلاً: «المصباح المنیر» ص 633، «لسان العرب» ج6 ص 325 القائمة 2، «القاموس المحیط» ص 555 القائمة 2.
127) قارن: «نور الأنوار» ص 126.
128) لم أعثر علیه، فانظر مثلاً: «لسان العرب» ج 12 ص 318 القائمة 2، «تاج العروس» ج 16 ص383 القائمة 1.
129) النهایة: + و بدنه.
130) کما حکاه عنه ابن الأثیر، راجع: «النهایة» ج 3 ص 209.
131) و قال الفیومیّ: «و العرض – بالکسر ـ…: الحسب»، راجع: «المصباح المنیر» ص 553.
132) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 373.
133) کما حکاهما العلّامة المدنیّ، راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 379.
134) کریمة 18 النحل.
135) قارن: نفس المصدر.
136) فانظر: «مجمع البیان» ج 7 ص 312.
137) کریمة 70 الفرقان.
138) راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 380.
139) راجع: نفس المصدر.
140) کریمة 77 الأنبیاء.
141) هذا قول العلّامة المدنیّ، راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 382.
142) و هذه نسخة الکفعمیّ على ما حکاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 210.
143) قارن: «التعلیقات» ص 49.
144) کما حکاه المحقّق الفیض من غیر اسنادٍ إلیها، راجع: نفس المصدر.
145) کریمتان 7 / 6 العلق.
146) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 382.
147) قال الزبیدیّ: «و قد شاقنی حبّها شوقاً…: هاجنی… و اشتاقه و اشتاق إلیه بمعنىً واحدٍ»،راجع: «تاج العروس» ج 13 ص 258 القائمة 1.
148) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 384.
149) لم أعثر علیه.
150) کریمة 63 طه.
151) هذا تفسیرٌ حکاه الطبرسیّ عن سیّدنا أمیرالمؤمنین – علیه السلام ـ، راجع: «مجمع البیان»ج 7 ص 35.
152) الکافی: + ثمّ الّذین یلونهم.
153) راجع: «الکافی» ج 2 ص 252 الحدیث 1، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 3 ص 261 الحدیث3584، «مستدرک الوسائل» ج 2 ص 440 الحدیث 2408.
154) المصدر: مع.
155) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 388.
156) لم أهتد إلى مراده.
157) کریمة 108 یوسف.
158) کریمة 112 هود.
159) کریمة 30 ق.
160) کریمة 6 الفاتحة.
161) کریمة 74 المؤمنون.
162) کریمة 72 غافر.
163) کریمة 38 التوبة.
164) کریمة 153 الأنعام.
165) راجع: «نهج البلاغة» الخطبة 16 ص 58، «الکافی» ج 8 ص 67 الحدیث 23، «بحار الأنوار»ج 29 ص 593، «عوالی اللئالی» ج 4 ص 110 الحدیث 167.
166) کریمة 46 الأعراف.
167) کما ورد: «ألا و من أحبّ علیّاً مرّ على الصراط کالبرق الخاطف»، راجع: «تأویل الآیات»ص 824، «مأة منقبة» ص 64.
168) کریمة 8 التحریم.
169) لم أعثر علیه، و انظر: «تفسیر القرآن الکریم» ـ له ـ ج 1 ص 123.
170) راجع: «معانی الأخبار» ص 32 الحدیث 1، و انظر: «بحار الأنوار» ج 24 ص 11.
171) راجع: «معانی الأخبار» ص 32 الحدیث 2، و انظر: «الکافی» ج 1 ص 432 الحدیث 91،«بحار الأنوار» ج 35 ص 366.
172) راجع: «بصائر الدرجات» ص 512 الحدیث 25، و انظر: «تأویل الآیات» ص 139،«تفسیر العیّاشی» ج 1 ص 255 الحدیث 182.
173) کریمة 41 الحجر.
174) المصدر: + علیٌّ.
175) نقله عنه فی «بحار الأنوار» ج 8 ص 69 مع تغییرٍ یسیرٍ، و لم أعثر علیه فیه.
176) کریمة 28 آل عمران / 42 النور / 18 فاطر.
177) هذا قول علّامة المدنیّ، راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 389.
178) و انظر: «شرح الصحیفة» ص 210.
179) راجع: «النافع یوم الحشر» ص 52.
180) لتفصیل الآراء فی المقام انظر: «الأربعین» ص 275، «قواعد العقائد» ص 46، «تلخیص المحصّل» ص 378، «إرشاد الطالبین» ص 385.
181) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 391.
182) کریمة 14 الفجر.
183) لجمیع هذه التفاسیر راجع: «مجمع البیان» ج 10 ص 351.
184) لم أعثر علیه مرویّاً عن أمیرالمؤمنین – علیه السلام ـ، و یوجد منسوباً إلى سادس ائمّتنا الأطهار ـ سلام اللّه علیهم أجمعین ـ، راجع: «بحار الأنوار» ج 8 ص 64، ج 72 ص 323.
185) راجع: «روضة الواعظین» ج 2 ص 498، «بحار الأنوار» ج 7 ص 125.
186) قارن: «نور الأنوار» ص 127.
187) راجع: «إرشاد القلوب» ج 1 ص 43.
188) هذا قول محدّث الجزائریّ، راجع: «نور الأنوار» ص 128.
189) کما حکاه العلّامة المدنیّ، راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 392.
190) راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 393.
191) کریمة 100 النساء.
192) من منظومة «تناوحت الأرواح» لابن عربی، راجع: «ترجمان الأشواق» ص 43.
193) کریمة 148 البقرة.
194) انظر: «الحکمة المتعالیة» ج 1 ص 69.
195) قارن: «نور الأنوار» ص 128.
196) فی المخطوطتین: نصرت.
197) و انظر: «شرح الصحیفة» ص 212.
198) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 395.
199) قال: «و قد حرب ماله أی: سلبه»، راجع: «صحاح اللغة» ج 1 ص 108 القائمة 2.
200) کما حکاه المحدّث الجزائریّ، راجع: «نور الأنوار» ص 128.
201) کما حکاه الجزائریّ أیضاً، راجع: نفس المصدر.
202) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 396.
203) قارن: «نور الأنوار» ص 128، مع تغییرٍ یسیر.
204) و عن أمیرالمؤمنین – علیه السلام ـ: «من استدام قرع الباب و لجّ ولج»، راجع: «غررالحکم» ص 193 الحکمة 3758.
205) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 398، مع تغییرٍ یسیر.
206) قال فی مفتتح مادّة «ذرا»: «الأصمعیّ: الذرا – بالفتح ـ: کلّ ما استتر به، یقال: أنا فی ظلّ فلانٍو فی ذراه أی: فی کنفه و ستره و دفئه»، راجع: «صحاح اللغة» ج 6 ص 2345 القائمة 1.
207) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 399.
208) فی المطبوع من صحاح اللغة: تَوَجَّهُ.
209) راجع: «صحاح اللغة» ج 1 ص 301 القائمة 1.
210) و انظر: «ریاض السالکین» ج 3 ص 400.
211) الأوّل مختار محدّث الجزائریّ، و الثانی نقله من غیر اسناده إلى أحدٍ، راجع: «نور الأنوار»ص 128.
212) راجع: «أساس البلاغة» ص 315 القائمة 1.
213) راجع: «بحار الأنوار» ج 40 ص 154، «بصائر الدرجات» ص 202 الحدیث 5، «البلدالأمین» ص 291.
214) کریمة 16 القلم.
215) قارن: «شرح الصحیفة» ص 214.
216) لسان العرب: المصدر.
217) لسان العرب: الاسم.
218) لم أعثر علیه فی «الکتاب»، و حکاه عنه ابن منظور، راجع: «لسان العرب» ج 15 ص 407القائمة 1.
219) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 401.
220) هذا قول الجنید فی معنى الصدق، راجع: «الرسالة القشیریّة» ص 320.
221) کما حکاه القشیریّ، راجع: نفس المصدر ص 318.
222) کریمة 119 التوبة.
223) کریمة 17 آل عمران.
224) کریمة 23 الأحزاب.
225) راجع: «الکافی» ج 2 ص 105 الحدیث 8، «وسائل الشیعة» ج 12 ص 163 الحدیث15961، «بحار الأنوار» ج 68 ص 6.
226) راجع: «الکافی» ج 2 ص 104 الحدیث 3، «بحار الأنوار» ج 66 ص 407، «إرشاد القلوب»ج 1 ص 134، «کشف الغمّة» ج 2 ص 208.
227) راجع: «الکافی» ج 2 ص 105 الحدیث 12، «وسائل الشیعة» ج 19 ص 68 الحدیث24168، «بحار الأنوار» ج 68 ص 8.
228) راجع: «الکافی» ج 2 ص 104 الحدیث 5، «وسائل الشیعة» ج 19 ص 67 الحدیث24166، «بحار الأنوار» ج 68 ص 4.
229) المصدر: فی.
230) المصدر: ـ کأنّک.
231) کریمة 8 الأعراف.
232) راجع: «بحار الأنوار» ج 68 ص 10.
233) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 402.
234) کریمة 34 إبراهیم.
235) و انظر: «ریاض السالکین» ج 3 ص 405.
236) المصدر: ـ أی… اکتسابه.
237) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 406.
238) کریمة 3 الطلاق.
239) لم أعثر علیه، و رواه المحدّث الجزائریّ، راجع: «نور الأنوار» ص 129.
240) البیت من مشهور شواهد النحاة، و قال الأستاذ محمّد محیی الدین عبدالحمید ـ و هو خبیرٌ بهذاالشأن -: «لا یعرف قائله»، راجع: «شرح قطرالندى» ص 100.
241) کما حکاه عنه الفیومیّ بنصّ العبارة، راجع: «المصباح المنیر» ص 431.
242) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 408.
243) قارن: «التعلیقات» ص 50، و انظر أیضاً بنصّ العبارة حرفیاً: «نور الأنوار» ص 129.
244) قال: «و أطلبه أی: أسعفه بما طلب؛ و أطلبه أی: أحوجه إلى الطلب، و هو من الأضداد».
245) راجع: «صحاح اللغة» ج 1 ص 172 القائمة 1.
246) راجع: «بحار الأنوار» ج 28 ص 353، «شرح نهج البلاغة» ج 6 ص 46، «کشف الغمّة» ج1 ص 474.
247) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 411.
248) قارن: «نور الأنوار» ص 129.
249) هذا المثل من قول أکثم بن صیفی، و لتفصیله راجع: «مجمع الأمثال» ج 1 ص 305 القائمة 1العدد 1628.
250) راجع: نفس المصدر ج 2 ص 192 القائمة 1 العدد 3334.
251) المصدر: من المنکوح و المطعوم.
252) المصدر: ـ منهم.
253) المصدر: یستحقر هول.
254) المصدر: ـ الاقتران.
255) المصدر: الواحد على عددهم.
256) راجع: «شرح الإشارات و التنبیهات» ج 3 ص 334.
257) لم أعثر على هذا التعریف بنصّه بین نصوص اللغویّین، و انظر: «المصباح المنیر» ص 350،«صحاح اللغة» ج 1 ص 478 القائمة 1.
258) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 424 مع تغییرٍ یسیر.
259) کما قال بعضهم فی وصف الزاهدین: «… ترکوا النعیم الفانی للنعیم الباقی»، راجع: «الرسالةالقشیریّة» ص 205.
260) هذا قول الشیخ العارف الأنصاری، راجع: «منازل السائرین» بشرح العارف الکاشانیص 120.
261) کما ورد: «انّ الآخرة تبقی و الدنیا تفنی»، و کذا مایشبهه، انظر: «بحار الأنوار» ج 33 ص542، «شرح نهج البلاغة» ج 6 ص 66، «الغارات» ج 1 ص 144.
262) لم أعثر علیه فی مصادرنا الروائیّة.
263) راجع: «الکافی» ج 2 ص 130 الحدیث 11، «بحار الأنوار» ج 51 ص 258، «شرح نهجالبلاغة» ج 9 ص 239، «عوالی اللئالی» ج 1 ص 27 الحدیث 9.
264) المصدر: و لکن.
265) المصدر: أهلاً.
266) راجع: «بحار الأنوار» ج 67 ص 234، و انظر: «عوالی اللئالی» ج 2 ص 11 الحدیث 18،«نهج الحقّ» ص 248.
267) راجع: «عوالی اللئالی» ج 4 ص 119 الحدیث 190.
268) لم أعثر علیه منسوباً إلى نبیّ اللّه الأعظم، و یوجد مرویّاً عن أمیرالمؤمنین – علیه السلام ـ،راجع: «نهج البلاغة» الکلام 82 ص 106، «غرر الحکم» ص 127 الحکمة 2161، «کنزالفوائد» ج 1 ص 345.
269) راجع: «مجموعة ورّام» ج 1 ص 152.
270) المصدر: ـ ثمّ نظر.
271) المصدر: فوضع.
272) المصدر: ـ من.
273) راجع: «التحصین» ص 28.
274) کریمة 39 النور.