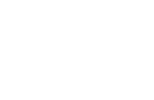اعلم! أنّ التوکّل المأمور به فی الأخبار الواردة عن أهل بیت الأطهار هو اعتماد القلب فی الأمور کلّها على اللّه الواحد القهّار و انقطاعه بالکلیّة إلیه. و لاینافیه التوسّل بالأسباب إذا لم تسکن إلیها و کان سکونک إلیه ـ جلّ و تعالى ـ فی التشبّث بها و العکوف علیها مجوّزاً أن یوصلک إلى مطلوبک دونها من حیث لاتحتسب و یؤتیک ما تطمح إلیه بصرک من کسبک و إن لم تکتسب ؛ سواءٌ کان التوسّل بها لجلب نفعٍ متوقّعٍ أو لدفع ضررٍ منتظرٍ فی الاستقبال، أم لازالة آفةٍ واقعةٍ مشوّشةٍ للبال مزعجةٍ فی الحال؛ و سواءٌ کانت مقطوعاً بها ـ کمدّ الید إلى الطعام لیصل إلى فیک أو الشرب لدفع عطشٍ یقلقلک أو یردیک ـ، أم مظنونةٍ کحمل الزاد للأسفار و اتّخاد السلاح لدفع اللصوص و الأشرار و کاتّخاذ البضاعة للتجارة والادّخار لتجدّد الاضطرار، و کالتداوی لازالة الأمراض و التحرّز عن البیتوتة فی مکامن السباع و مواطن الحشار و النوم ممرّ السیل و الکون تحت الحائط الکثیر المیل.
فمن کان طعامه موضوعاً بین یدیه و هو جائعٌ نائعٌ محتاجٌ إلیه و لکنّه لم یمدّ یده إلى تناوله معتذراً فی ذلک بتفویضه و توکّله فهو مجنونٌ لامحالة مغلوبٌ على عقله ملومٌ على ما اعتمده و عرج علیه فی فعله؛ فانّه إن انتظر أن یوجد اللّه فی الطعام حرکةً إلى فیه أو یخلق اللّه شبعاً فیه بدون أن یتناول غذاءً یغنیه و یأمر بمضغه و إیصاله إلى معدته ملکاً من ملائکة الکرام فقد جهل سنّة اللّه الجاریة فی اشباعه الأنام!؛ و من لم یذرع الأرض أو بذر فی أرضٍ غیر صالحةٍ بعیدةٍ عن مجاری المیاه و طمع فی أن ینبت اللّه له نباتاً من غیر بذرٍ أو یحصد ما
یشتهیه و یهواه؛ أو تلد إمرأته من غیر وقاعٍ ـ کما ولدت مریم البتول ـ فقد خرج عن مقتضى العقول و خالف مرتضى المنقول. فلیمدد یده و لیمضغ بطواحن أسنانه و لیثق بفضل ربّه فی ادامة إحسانه و لیتذکّر ماتشاء علیه و تحقّق لدیه بقوّة إیمانه انّ اللّه ـ جلّ شأنه ـ قادرٌ على أن یزیل قواه الموصلة له إلى مرامه و یعدم ما یتوصّل به إلى مبتغاه فی یقظته و منامه، أو یسلّط علیه ما یزعجه من مقامه و یفرّق بینه و بین طعامه. فبذلک فلیفرح و علیه فلیعوّل. فما دام وثوقه باللّه ـ لا بما سواه ـ فهو متوکّلٌ.
و کذلک مساق الکلام فی الأسباب الظنّیّة الّتی لیست متعیّنةً لحصول ما یقصد و یرام، لکن الغالب انّ المسبّبات لاتحصل بدونها، نظراً إلى ما یتراءى من جریان عادة اللّه فی حفظ الأنام و ابقاء النظام. و إنّما لایبطل التوکّل بملابسة الأسباب القطعیّة و الظنّیّة ـ مع أنّ اللّه قادرٌ على إعطاء المطلوب بدون ذلک الأمور السببیّة ـ، لأنّ اللّه أبى أن یجری الأشیاء إلّا بالأسباب، و أحبّ لعباده أن یطلبوا منه مقاصدهم بما عرّفها لهم فی إیصالهم إلى الرغائب و انجائهم من المهالک. فلیحفظوا زادهم و أمتعتهم و لیأخذوا حذرهم و أسلحتهم واثقین بفضله، لابجلادتهم و شهامتهم متمسّکین بحبله فی ظعنهم و إقامتهم.
و لامدخل لخفاء الأسباب و جلائها فی التوکّل ـ کما زعمه أولئک الأقساب ـ، بل یستوی وجودها و عدمها لمن تذکّر و أناب بعد ما تقرّر عند أولی الألباب من أنّ معناه الثقة باللّه وحده، لا بما سبّبها لعباده من الأسباب. نعم! تتفاوت درجات المتوکّلین بحسب تفاوت مراتبهم فی الیقین؛ فمنهم من هو من المقرّبین؛ و منهم من هو من أصحاب الیمین؛ و منهم لاتوکّل له أصلا لسقوطه عن درجة الموقنین. و من أکمل إیمانه لم یلتفت أصلا إلى الأسباب، فانّه صابرٌ أوّاب و إنّ عند اللّه (لَزُلفَى وَ حُسنَ مَآبٍ)(1)، فیرزقه اللّه (مِنْ حَیثُ لاَیَحْتَسِبُ)(2)، کسب أم لم یکتسب. إلّا انّه لایترک الاکتساب و لاینظر إلى قطع الأسباب، بل تمثّل أمر اللّه فی ذلک حسب جهده و طاقته، و لیس وثوقه إلّا باللّه فی غناه و فاقته. و قد
روینا عن الصادق – علیه السلام ـ انّه قال: «أبى اللّه أن یجعل أرزاق المؤمنین إلّا من حیث لایحتسبون»(3)؛
و إنّما خصّ ذلک بالمؤمنین، لأنّ ثمرة کمال الإیمان و مقتضاه أن لایثق صاحبه إلّا باللّه؛ فکأنّ غیرهم لایکون بذلک حقیقاً، أولئک (مَعَ الَّذِینَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَیهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولَئِکَ رَفِیقاً)(4)
إِلَهِی لاَتُخَیِّبْ مَنْ لاَیَجِدُ مُعْطِیاً غَیْرَکَ، وَ لاَتَخْذُلْ مَنْ لاَیَسْتَغْنِی عَنْکَ بِأَحَدٍ دُونَکَ.
«خاب» یخیب خیبةً: لم یظفر بما طلب؛ أو من باب التفعیل، أی: لایصیر محروماً خائباً، أو لاتجعل محروماً آئساً.
<و «خَذَلَه» ـ من باب قتل ـ: ترک نصره و اعانته، و الاسم: الخِذلان ـ بالکسر ـ.
و «استغنیت» بالشیء: اکتفیت به>(5) و فی روایةٍ: «لایخیّب… و لایخذل»(6) ـ بالیاء المثنّاة من تحتٍ، بصیغ المعلوم فی الأوّل و المجهول فی الثانی ـ. هذا فی صورة الاضطرار، و أمّا فی صورة الاختیار إذا انقطع عبده إلیه لایهمله ألبتّة.
و قیل: «هذا من قبیل الدعاء بما یعلم الإنسان انّه حاصلٌ له قبل الدعاء من فضل اللّه، إمّا لاستدامته و إمّا لاعتداد تلک النعمة، و إمّا لاظهار الانقطاع إلیه و بثّ الفقر إلى مسألته؛ و یجری ذلک مجرى قوله ـ تعالى ـ: (لاَتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِینَا أَو أَخْطَأْنَا)(7)، و (قَالَ رَبِّ احْکُمْ بِالْحَقِّ)(8)، (رَبَّنَا وَ اتِنَا مَا وَعَدتَنَا عَلَى رُسُلِکَ)(9)، إذ من المعلوم المحقّق انّ اللّه
ـ سبحانه ـ لایخیّب و لایخذل المنقطع إلیه، بنصّ: (وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسبُهُ)(2)، أی: کافیه فی جمیع أموره»(10)
إِلَهِی فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لاَ تُعْرِضْ عَنِّی وَ قَدْ أَقْبَلْتُ عَلَیْکَ.
و «الإعراض»: خلاف الإقبال.
و «الإقبال» إلى الشیء: التوجّه إلیه؛ و إلى اللّه ـ تعالى ـ: الإنابة و الرجوع إلیه؛ أی: لاتصرّف وجه عنایتک و رأفتک و الحال انّی قد أقبلت بوجه قلبی علیک.
وَ لاَ تَحْرِمْنِی وَ قَدْ رَغِبْتُ إِلَیْکَ.
«حرمه»: منعه.
و «رغب» إلیه: سأله؛ أی: لاتجعلنی محروماً عن فیض إقبالک علیَّ و الحال انّی قد التجأت و أتیت راغباً إلیک؛ و على هذا القیاس الجمل الآتیة.
وَ لاَ تَجْبَهْنِی بِالرَّدِّ وَ قَدِ انْتَصَبْتُ بَیْنَ یَدَیْکَ.
مأخوذٌ من الجبهة، یقال: جبهه بالمکروه أی: جعل مکروهه مواجهةً؛ أی: کن مواجهی بالإقبال و لاتکن مواجهی بالردّ و الحال انّی قد قمت بالعجز و العبودیّة فی ساحة قدسک.
أَنْتَ الَّذِی وَصَفْتَ نَفْسَکَ بِالرَّحْمَةِ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ؛ وَ ارْحَمْنِی، وَ أَنْتَ الَّذِی سَمَّیْتَ نَفْسَکَ بِالْعَفْوِ، فَاعْفُ عَنِّی.
<«الوصف» فی اللغة: ذکر ما فی الموصوف من الصفة(11) ـ أی: المعنى القائم به ـ. و هذا المعنى لایصحّ فی الواجب ـ تعالى ـ، لأنّ صفاته>(12) عین ذاته ـ سبحانه کما مرّ فیما سلف؛ فتذکّر! ـ.
و «سمّیته» بزیدٍ: جعلته اسماً له.
و «العفْو» على ما هو الروایة المشهورة بسکون فائه، <أی: صاحب العفو؛ أو بتضمین «سمّیت» معنى(13): وصفت. و یجوز أن یکون «التسمیة» هنا بمعناها اللغویّ، أی: رفعت نفسک على کلّ أحدٍ بسبب عفوک عن المذنبین>(14) و على نسخة ابن ادریس: بضمّ الفاء و تشدید الواو، و هذا أظهر، لخلوصه عن تکلّف المجاز.
و إنّما لم یقل: «وصف نفسه و سمّى نفسه» ـ مع أنّه الأکثر فیما إذا کان الموصول أو موصوفه خبراً عن مخاطبٍ ـ تلذّذاً بخطابه ـ تعالى ـ ؛ فحمل على المعنى. و هو جائزٌ کثیراً و إن کان کون العائد غائباً أکثر.
قَدْ تَرَى ـ یَا إِلَهِی! ـ فَیْضَ دَمْعِی مِنْ خِیفَتِکَ، وَ وَجِیبَ قَلْبِی مِنْ خَشْیَتِکَ، وَ انْتِقَاضَ جَوَارِحِی مِنْ هَیْبَتِکَ.
<«قد» هنا للتکثیر، مثلها فی قوله ـ تعالى ـ: (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّمَاءِ)(15)،
أی: ربّما نرى(16)، و معناه کثرة الرؤیة>(17)
و «فاض» الماء فیضاً: إذا سال، و هو کنایةٌ عن کثرة الدموع. و فی نسخة ابن ادریس: «دموعی».
و «الخیفة»: الخوف؛ و قد مرّ.
و «وجب» القلب یجب وجباً و وجیباً: رجف و اضطرب.
و «الانتفاض» ـ بالفاء و الضاد المعجمة فی إحدى الروایتین ـ: التحرّک، من نفض الثوب نفضاً ـ من باب قتل ـ فانتفض: حرّکه لیزول عنه الغبار. و النَفَض ـ بالتحریک ـ فی الأصل: ما سقط من الورق و الثمر. و فی روایةٍ أخرى بالقاف و الضاد المعجمة(18)، إمّا من نَقَض الحبل نَقْضاً ـ من باب قتل ـ حلّ برمه فانتقض هو ـ و منه: نقضت ما أبرمه: إذا أبطلته، و انتقضت الطهارة: بطلت ـ ؛ و إمّا من أنقض الجمل ظهره أی: أثقل. فعلى الأوّل المراد بانتقاض الجوارح: رعشتها و ارتعادها، و على الثانی: ضعفها و عدم إحکامها.
و «الهیبة»: قیل: «هی بمعنى الخوف و الخشیة، من هابه یهابه هیبةً: خافه»(19)؛ و قال ابن فارسٍ: «الهیبة: الاجلال»(20)؛
و قال العارفون: «الهیبة حالةٌ فوق الخوف مقتضاها غیبة القلب عن علم ما یجری من أحوال الخلق ـ بل من أحوال نفسه! ـ بما یرد علیه من الحقّ إذا عظم الوارد و استولى علیه سلطان الحقیقة»(21)
قالوا: «و هی لاتسکن إلّا فی کلّ قلبٍ منیبٍ أوّابٍ، و لاتلمّ إلّا بساحة کلّ مصلحٍ توّابٍ».
کُلُّ ذَلِکَ حَیَاءٌ مِنِّی لِسُوءِ عَمَلِی، وَ لِذَاکَ خَمَدَ صَوْتِی عَنِ الْجَأْرِ إِلَیْکَ، وَ کَلَّ لِسَانِی عَنْ مُنَاجَاتِکَ.
«کلّ» مبتدءٌ. و «حیاءٌ منّی» خبره، و فی نسخةٍ بالنصب إمّا مفعولٌ له، أو المتمییز، و حینئذٍ فالخبر محذوفٌ؛ أی: کلّ ذلک کائنٌ من الحیاء منّی. و لایخفى انّ لفظ «منّی» نسخةٌ بعد لفظ «الحیاء». و «الحیاء» قد مرّ معناه.
و «ذلک» «ذاؤه»: اسم اشارةٍ، و «لامه» جیء بها للدلالة على بُعد المشار إلیه، و «کافه» للخطاب؛ و المشار إلیه و لو کان متعدّداً ـ من فیض الدمع و ما بعده ـ، لکنّه مأوّلٌ بما ذکر، أو ما تقدّم.
فان قیل: المشارإلیه هنا قریبٌ لیس ببعیدٍ!
قلنا: باعتبار المقتضی فی حکم المتباعد، و هذا فی کلّ کلامٍ یحدّث الرجل بحدیثٍ ثمّ یقول: و ذلک ما لاشکّ فیه، و یحسب الحاسب ثمّ یقول: فذلک کذا و کذا؛ قال اللّه ـ تعالى ـ: (لاَ فَارِضٌ وَ لاَ بِکْرٌ عَوَانٌ بَینَ ذَلِکَ)(22)، و قال: (ذَلِکُمَا مِمَّا عَلَّمَنِی رَبِّی)(23)
و «خَمَِد» خموداً ـ من باب قعد و علم ـ: سکن، من خمدت النار: إذا سکن لهبها.
و «الجَأْر» ـ بفتح الجیم و سکون الهمزة، و بضمّ الجیم على ما فی نسخة الشهید ـ: رفع الصوت بالدعاء، و منه: (ثُمَّ إِذَا مَسَّکُمُ الضُّرُّ فَإِلَیهِ تَجْأَرُونَ)(24) أی: توقعون أصواتکم. و فی نسخة الشهید: «و الجوار»(18) ـ على وزن خوار ـ: أیضاً بمعنى الصوت العالی، یقال: جأر الثور یجأر أی: صاح، کذا فی الصحاح(25) و قرء قوله ـ تعالى ـ: (فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ
خُوَارٌ)(26) بالجیم ـ على قراءةٍ نادرةٍ(27) ـ. و المعنى: إنّ من کثرة معصیتی لایرفع صوتی إلیک.
و «کَلَّ» السیف کلولاً ـ من باب ضرب ـ: إذا لم یقطع، و کَلَّ لسانی أی: ضعف و وهن.
و «ناجیته» مناجاةً: ساررته، و الاسم: النجوى.
یَا إِلَهِی! فَلَکَ الْحَمْدُ، فَکَمْ مِنْ عَائِبَةٍ سَتَرْتَهَا عَلَیَّ فَلَمْ تَفْضَحْنِی، وَ کَمْ مِنْ ذَنْبٍ غَطَّیْتَهُ عَلَیَّ فَلَمْ تَشْهَرْنِی، وَ کَمْ مِنْ شَائِبَةٍ أَلْمَمْتُ بِهَا فَلَمْ تَهْتِکْ عَنِّی سِتْرَهَا.
«الفاء» الأولى للترتیب، و الثانیة للسببیّة؛ إذ المعنى: یا إلهی! فبعد الأمور المذکورة لک الحمد بسبب کثیر ما عاملتنی به من ستر معایبی من غیر أن تتعقّبها فضیحةٌ.
و «کم» خبریّةٌ للتکثیر، کقوله ـ تعالى ـ: (وَ کَمْ مِنْ قَرْیَةٍ أهْلَکنَاهَا)(28)
و قال الفاضل الشارح: «و «من» لبیان الجنس على الصحیح لا زائدةٌ کما زعم بعضهم، حتّى ذهب الفرّاء إلى أنّها إذا لم تکن مذکورةً لفظاً فخفض التمییز بها تقدیراً بالإضافة. و عمل الجارّ المقدّم و إن کان فی غیر هذا الموضع نادراً، إلّا أنّه لمّا کثر دخول «من» على ممیّز الخبریّة ـ نحو: (وَ کَمْ مِنْ قَریَةٍ)، و: (کَمْ مِنْ فِئَةٍ) ـ ساغ عمله مقدّرآ، لأنّ الشیء إذا عرف فی موضعٍ جاز ترکه ـ لقوّة الدلالة علیه ـ. على أنّ المشهور من مذهب النحویّین ما عدا الأخفش انّ «من» لاتزاد فی الإیجاب»(29) -(30)؛ انتهى کلامه.
و قیل: «کم هی الخبریّة، و «من» زائدةٌ للاستغراق؛ أو للتکثیر؛ أو لئلّا یتوهّم انّ ما بعده نصب على شریطة التفسیر ـ لوجود المفسّر، کما ذکره أرباب العربیّة فى قوله تعالى : (سَلْ بَنِی إِسرَائِیلَ کَمْ آتَینَاهُمْ مِنْ آیَةٍ)(31)»(32)؛ انتهى.
أقول: روایة ابن ادریس: «فکم عائبةٍ» من دون «من» باضافة «کم» إلى «عائبة»(33)، و
هی مؤیّدةٌ لقول القیل؛ فتدبّر.
<و «العائبة» ـ بالعین المهملة و الهمزة و الیاء المثنّاة و الباء الموحّدة ـ: مصدرٌ بمعنى: العیب، جاء على فاعلةٍ ـ کعافیة و عاقبة ـ.
و «الفاء» من قوله: «فلم تفضحنی» عاطفةٌ سببیّةٌ، کقوله ـ تعالى ـ: (فَوَکَزَهُ مُوسَى)(34)
و «شَهَرَه» شُهرةً ـ بالضمّ، من باب منع ـ: أظهره و أعلنه؛ و قال فی القاموس: «الشُهرة ـ بالضمّ ـ: ظهور الشیء فی شنعةٍ»(35)؛ و فی النهایة: «الشُهرة: الفضیحة»(36)>(37) و هذه الفقرة ـ أی: «و کم من ذنبٍ عظیمةٍ … إلى آخره» ـ کالعطف التفسیریّ للسابقة.
<و «الشائبة» ـ بالهمزة والتاء ـ: واحدة الشوائب، و هی: الأقذار و الأدناس. و فی بعض النسخ بالنون بعد الهمزة، من الشین: خلاف الزین، و هی متّجهةٌ بحسب المعنى دون الروایة>(38)
و «ألممت بها»: قصدتها و نزلت بها.
و «هتک» ـ من باب ضرب ـ بمعنى: خرقه، أی: لم تخرق علیَّ سترها، بل أخفیت حتّى لاأکون خجلاً على رؤوس الأشهاد.
وَ لَمْ تُقَلِّدْنِی مَکْرُوهَ شَنَارِهَا، وَ لَمْ تُبْدِ سَوْءَاتِهَا لِمَنْ یَلْتَمِسُ مَعَایِبِی مِنْ جِیرَتِی، وَ حَسَدَةِ نِعْمَتِکَ عِنْدِی. ثُمَّ لَمْ یَنْهَنِی ذَلِکَ عَنْ أَنْ جَرَیْتُ إِلَى
سُوءِ مَا عَهِدْتَ مِنِّی!!.
و «لم تقلّدنی»: من القلادة، و هی: الطوق الّذی یکون فی العنق.
و «الشَنَار» ـ بالفتح ـ: العیب و العار؛ قال فی القاموس: «هو(39) أقبح العیب، و العار، و الأمر المشهور بالشنیعة»(40)
و «مکروه شَنار» من إضافة الصفة إلى الموصوف. و اضافتها إلى الجنس للتبیّن ـ إذ المکروه یحتمل أن یکون من الشَنار و من غیره ـ. و المعنى: إنّ العیوب المکروهة الصادرة عنّی لم تجعلها قلادة عنقی.
و قوله – علیه السلام ـ: «و لم تبد سوءاتها».
«السوءات» ـ جمع سَوءة، بالفتح ـ: الفرج و الفاحشة؛ أی: لم تظهر قبائحها.
<و «المعایب» ـ بلاهمزٍ ـ: جمع معابة، و هی العیب ـ کمنائر جمع منارة ـ.
و «الجیرة»: جمع جار، و هو المجاور فی المسکن، و یجمع على جیران أیضاً. و إنّما خصّ الجیرة بالتماس المعایب لأنّ الحسد فیهم أکثر؛ و قد قیل: «الحسد فی ثلاثة أجناسٍ من الناس: الجیران فی المنزل، و الشرکاء فی العمل، و القربات فی النسب. و ذلک لما یکون بین هؤلاء من المناظرة و المباهاة و طلب تفوّق کلّ واحدٍ منهم على الآخر».
و «الحسدة»: جمع حاسد، و هو المتمنّی زوال النعمة من المحسود إلیه.
و قوله: «عندی» فی محلّ نصبٍ على الحال من «النعمة».
و «ثمّ» هذا لاستبعاد عدم النهی بعد وضوح ماذکر من حسن صنعه ـ تعالى ـ إلیه من ستر معایبه الکثیرة، و قد کان مقتضاه أن ینتهی و یقف عن کلّ مالایرضاه ـ سبحانه ـ.
و «نهاه» عن الشیء ینهاه نهیاً فانتهى: کفّه عنه>(41)
و «جریت»: من الجری، أی: جریانی ـ کجریان الماء ـ.
و «عهدت» بمعنى: عرفت و شهدت؛ و المعنى: لم یمنعنی ذلک التفضّل منک على ارتکاب الأعمال السیّئة الّتی عرفتها و شاهدتها منّی!.
فَمَنْ أَجْهَلُ مِنِّی ـ یَا إِلَهِی! ـ بِرُشْدِهِ؟ وَ مَنْ أَغْفَلُ مِنِّی عَنْ حَظِّهِ؟ وَ مَنْ أَبْعَدُ مِنِّی مِنِ اسْتِصْلاَحِ نَفْسِهِ حِینَ أُنْفِقُ مَا أَجْرَیْتَ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ فِیما نَهَیْتَنِی عَنْهُ مِنْ مَعْصِیَتِکَ؟.
«الفاء» فصیحةٌ؛ أی: إذا کان هذا حالی فمن أجهل منّی؟!.
و «الجهل» على ثلاثة أضربٍ ـ کما قاله الراغب ـ: «الأوّل: خلوّ النفس عن العلم، هذا هو الأصل؛ و الثانی: اعتقاد الشیء بخلاف ما هو علیه؛
و الثالث: فعل الشیء بخلاف ما حقّه أن یفعل، سواء اعتقد فیه اعتقاداً صحیحاً أو فاسداً ـ کمن ترک الصلاة متعمّداً ـ، و على ذلک قوله ـ تعالى ـ حکایةً عن موسى: (أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَکُونَ مِنَ الْجَاهِلِینَ)(42)، فجعل فعل الهزو جهلاً»(43)؛ انتهى.
و المراد هنا هو القسم الثالث.
و «الرُشد» ـ بالضمّ ـ: الصلاح، و هو خلاف الغیّ؛ و المراد منه: الطریق المستقیم و المسلک الحقّ القویم.
<و «الغفلة»: غیبة الشیء عن بال الإنسان و عدم تذکّره له؛ و قد تستعمل فیمن ترکه إهمالاً و اعراضاً، کقوله ـ تعالى ـ: (وَ هُمْ فِی غَفْلَةٍ مُعرِضُونَ)(44)
و «الحظّ»: النصیب؛ قیل: «مطلقاً»(45)؛ و قیل: «خاصٌّ بالنصیب من الخیر»(46)؛ و هو المراد هنا.
و «استطلح» الشیء: طلب صلاحه، و هو خلاف الفساد.
و «الانفاق»: اخراج المال.
و «أجریت» علیه رزقاً: جعلته جاریاً.>(47)
وَ مَنْ أَبْعَدُ غَوْراً فِی الْبَاطِلِ وَ أَشَدُّ إِقْدَاماً عَلَى السُّوءِ مِنِّی حِینَ أَقِفُ بَیْنَ دَعْوَتِکَ وَ دَعْوَةِ الشَّیْطَانِ فَأَتَّبِعُ دَعْوَتَهُ.
<و «من أبعد غوراً» أی: ذهاباً و توغّلاً فیه، من: غار یغور: إذا أتى الغور، فهو غائرٌ. و «غور» کلّ شیءٍ: قعره>(48)
<و «أشدّ إقداماً» أی: اجتراءً؛ و قال الفیّومی: «أقدم على العیب إقداماً: کنایةٌ عن الرضا به»(49)
و «السوء»: فی الأصل مصدر: ساءه یسوء سوءً: إذا أحزنه، یطلق على جمیع المعاصی ـ سواءٌ کانت من أعمال الجوارح أو أفعال القلوب، لاشتراکها کلّها فی أنّها تسوء صاحبها بعواقبها ـ.
و المراد بـ «الوقوف» بین الدعوتین: الاستعداد لقبول کلٍّ منهما، فانّ الإنسان خلق مستعدّاً للهدایة و الضلالة>(50)، لأنّه مرکّبٌ من الوجود و المهیّة.
و «الدعوة»: اسمٌ من دعاه: إذا طلب إقباله. و المراد بـ «دعوته» ـ تعالى ـ: الآیات الأنفسیّة أو الآفاقیّة ـ و قیل: «الأدلّة العقلیّة و الشرعیّة» ـ ؛ وبدعوة الشیطان: الأدلّة
التسویلیّة النفسیّة و الخارجیّة.
و «الفاء» من قوله – علیه السلام ـ: «فاتّبع» للعطف و التعقیب؛ و: «أتبعت» القوم ـ على افتعلت ـ: مشیت خلفهم. و فی نسخة ابن ادریس: «فأتبع» ـ من الثلاثی المجرّد ـ.
عَلَى غَیْرِ عَمىً مِنِّی فِی مَعْرِفَةٍ بِهِ وَ لاَ نِسْیَانٍ مِنْ حِفْظِی لَهُ؟ وَ أَنَا حِینَئِذٍ مُوقِنٌ بِأَنَّ مُنْتَهَى دَعْوَتِکَ إِلَى الْجَنَّةِ، وَ مُنْتَهَى دَعْوَتِهِ إِلَی النَّارِ.
و «العمى» فی الأصل عبارةٌ عن: عدم ملکة البصر الجسمیّ الحسّیّ، ثمّ استعیر لعمى البصیرة القلبیّ؛ و وجه الشبه أن الأعمى کما لایهتدى لمقاصده المحسوسة بالبصر ـ لفقده ـ کذلک أعمى البصیرة لایهتدی لمقاصده المعقولة، لعدم عقله.
<و قوله: «منّی»: صفةٌ لـ «عمى»، أی: کائنٌ منّی.
و «فی معرفةٍ»: صفةٌ أخرى له، و یحتمل أن یکون حالاً منه أیضاً ـ دون الظرف الأوّل ـ لتخصیص النکرة بالصفة الأولى.
و «النسیان»: هو الغفلة عن الشیء مع انمحاء صورته أو معناه عن خزانة الخیال أو الذکر>(51)
و قوله – علیه السلام ـ: «من حفظی» متعلّقٌ بـ «نسیان» و صفةٌ له، أی: نسیانٌ کائنٌ من حفظی.
و «الحفظ» یطلق تارةً على القوّة الحافظة؛ و تارةً على استعمال تلک القوّة.
و «له» متعلّقٌ بـ «نسیان» أیضاً، و هذه «اللام» هی المسمّاة: لام التقویة مزیدةٌ لتقویة عاملٍ ضعیفٍ ـ و هو هنا: «النسیان»، فانّه مصدرٌ و عمل المصدر ضعیفٌ، لکونه فرعاً لعمل الفعل؛ فهو کقولک: ضربی لزیدٍ حسنٌ ـ.
<و «الواو» من قوله - علیه السلام ـ: «و أنا حینئذٍ موقنٌ» للحال، و الجملة حالٌ من
ضمیر «أتّبع».
و «حینئذٍ» أی: حین أتّبع دعوته، فحذفت الجملة ـ للعلم بها ـ و عوّض عنها التنوین و کسرت الذال ـ لالتقاء الساکنین ـ. و قد مرّ الکلام علیه.
و «الیقین» قد مرّ معناه فیما سبق.
و «المنتهى»: مصدرٌ میمیٌّ بمعنى: النهایة، یقال: انتهى الأمر أی: بلغ النهایة، و هو أقصى ما یمکن أن یبلغه>(52) و حاصل المعنى: إنّک ـ یا ربّ! ـ تدعونی إلى طاعتک و الشیطان إلى معصیتک مع عدم العمى و عدم النسیان من حفظى له و علمی بأنّک تدعونی إلى الجنّة و بأنّه یدعونی إلى النار، مع هذا أترک دعوتک و أتّبع دعوة الشیطان!، فمن أبعد غوراً فی الباطل منّی؟!.
سُبْحَانَکَ! مَا أَعْجَبَ مَا أَشْهَدُ بِهِ عَلَى نَفْسِی، وَ أُعَدِّدُهُ مِنْ مَکْتُومِ أَمْرِی!.
«سبحانک»: تعجّبٌ، و قد مرّ استعماله فی مقام التعجّب فی اللمعة الثالثة عشر؛ أی: هنا موضع شهادتی على نفسی و اعترافی بصدور العمل القبیح عنّی.
و «تعداد» ما کتم من أمری یعنی: ما أعدد من قبائح أعمال المخفیّة.
وَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِکَ أَنَاتُکَ عَنِّی وَ إِبْطَاوُکَ عَنْ مُعَاجَلَتِی!، وَ لَیْسَ ذَلِکَ مِنْ کَرَمِی عَلَیْکَ، بَلْ تَأَنِّیاً مِنْکَ لِی، وَ تَفَضُّلاً مِنْکَ عَلَیَّ لاَنْ أَرْتَدِعَ عَنْ مَعْصِیَتِکَ الْمُسْخِطَةِ، وَ أُقْلِعَ عَنْ سَیِّئَاتِیَ الْمخْلِقَةِ، وَ لاَنَّ عَفْوَکَ عَنِّی أَحَبُّ إِلَیْکَ مِنْ عُقُوبَتِی.
و المشار إلیه بـ «ذلک» هو ما شهد على نفسه و عدّده من مکتوم أمره، و استعمال «ذلک» <لفخامته و فضاعته و بُعده فی مرتبة العجب.
و «الإناة» ـ على وزن حصاة ـ: اسمٌ من تأنّى فی الأمر: إذا تمکّث و لم یعجل، و عدّاها بـ «عن» لتضمینها معنى الصفح، أو التجاوز>(53)؛ أی: حلمک عنّی.
و «إبطاؤک عن معاجلتی» أی: تأخیرک عن عقوبتی، و لیس ذلک الإبطاء و العفو لعزّتی و احترامی فی جنابک.
فـ «من» فی قوله: «من کرمی» للتعلیل؛ و الظرف فی محلّ النصب خبرٌ لـ «لیس».
و «تأنّناً» عطفٌ علیه، أو نصب على أنّه خبرٌ لکان مقدّرة ـ و التقدیر: بل کان ذلک تأنّیاًـ ؛ أو على أنّه مفعولٌ مطلقٌ، أی: بل تأنّیت تأنّیاً.
و «تفضّلاً»: عطفٌ على تأنّیاً.
و «لاِنْ» بکسر اللام و فتح الألف و سکون النون، و «لامـ» ـه للتعلیل؛ و «أن» مصدریّةٌ ناصبةٌ، أی: لَعلّی أرتدع و أنزجر عن معصیتک.
«المسخطة» أی: المغضبة، لأنّ «المسخطة» اسم فاعلٍ من أسخطه بمعنى: أغضبه. و وصف المعصیة بالمسخطة لیکون أرفع.
و «أقلع» عن الأمر إقلاعاً: ترکه.
و «المخلقة»: اسم فاعلٍ من أخلق الثوب: إذا لبسه حتّى أبلاه؛ قال فی الصحاح: «و ثوبٌ خَلَقٌ أی: بالٍ، یستوی فیه المذکّر و المؤنّث، لأنّه فی الأصل مصدر الأخلق ـ و هو: الأملس ـ، و الجمع: خلُقان»(54) أی: و لأجل أن أترک سیّئاتی الّتی جعلتنی کالثوب الخَلَق ـ بالتحریک ـ.
و «لأنّ» ـ بالنون المشدّدة ـ عطفٌ على قوله: «لأن أرتدع»، أی: تأنّیک و تفضّلک لما ذکرناه لأجل أنّ عفوک عن ذنوبی أشدّ حبّاً إلیک من عقوبتی علیها، لأنّ العفو مقتضى الرحمة ـ و هی ذاتیّةٌ له سبحانه ـ و العقوبة مقتضى الغضب ـ و هو مطلوبٌ له بالعرض، لأنّه
من تبعات أفعال العباد و لوازم سیّئاتهم ـ. و الأحسن أن یحمل أفعل التفضیل هنا على معنى أصل الفعل ـ کما فی قوله تعالى فی قصّة یوسف علیه السلام: (رَبِّ السِّجنُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا یَدْعُونَنِی)(55) ـ، لأنّ العقوبة لیس محبوباً عنده ـ سبحانه ـ أصلا.
بَلْ أَنَا ـ یَا إِلَهِی! ـ أَکْثَرُ ذُنُوباً وَ أَقْبَحُ آثَاراً وَ أَشْنَعُ أَفْعَالاً وَ أَشَدُّ فِی الْبَاطِلِ تَهَوُّراً وَ أَضْعَفُ عِنْدَ طَاعَتِکَ تَیَقُّظاً وَ أَقَلُّ لِوَعِیدِکَ انْتِبَاهاً وَ ارْتِقَاباً مِنْ أَنْ أُحْصِیَ لَکَ عُیُوبِی، أَوْ أَقْدِرَ عَلَى ذِکْرِ ذُنُوبِی.
الفقرة الأولى و مابعدها کلّها مفضّلةٌ، و المفضّل علیه ـ بعد الفقرات الستّ ـ قوله – علیه السلام ـ: «من أن أحصی لک عیوبی».
و «الآثار» و «الأفعال» هنا متقاربان فی المعنى.
و «شنُع» الشیء ـ بالضمّ ـ شناعةً: قبح، فهو شنیعٌ.
و «الباطل»: خلاف الحقّ، و أصله من بطل الشیء بمعنى: فسد.
و «التهوّر»: الجرأة المفرطة المتضمّنة لعدم المبالات.
و «التیقّظ»: ضدّ النوم.
و «التنبّه»: الفطانة.
و «الوعید»: التهدید.
و «الارتقاب»: الترصّد و الانتظار.
<و انتصاب «ذنوباً» و ما بعده على التمییز، و «أن» ـ من قوله: «من أن أحصى» ـ مصدریّةٌ متأوّلةٌ هی و الفعل بعدها بمصدرٍ؛ و التقدیر: من احصائی لک عیوبی>(56)
و لمّا عدّ – علیه السلام ـ فی کلماته السابقة ذنوبه و توهّم انّ الغرض منه تعداد ذنوبه، أزال هذا التوهّم بأنّ ذنوبی فی الکثرة و آثاری فی القباحة و أفعالی فی الشناعة و تهوّری فی
الباطل و ضعف تیقّظی و قلّة انتباهی و ارتقابی لوعیدک أکثر من أن أقدر على احصائها و ذکرها؛ فلیس غرضی من ذکرها احصاؤها و حصرها، بل الغرض توبیخ نفسی و تعییرها لأجل الطمع فی رحمتک ـ الّتی تنشأ منها صلاح أمر المذنبین ـ ؛ و هذا هو المراد بقوله – علیه السلام ـ:
وَ إِنَّمَا أُوَبِّخُ بِهَذَا نَفْسِی طَمَعاً فِی رَأْفَتِکَ الَّتِی بِهَا صَلاَحُ أَمْرِ الْمُذْنِبِینَ، وَ رَجَاءً لِرَحْمَتِکَ الَّتِی بِهَا فَکَاکُ رِقَابِ الْخَاطِئِینَ.
«و رجاءً» عطفٌ على «طمعاً»، أی: تعداد ذنوبی لتوبیخ نفسی طمعاً فی رأفتک و رجاءً لرحمتک الّتی بسببها تعتق رقاب الخاطئین العاصین عن العذاب. و فی نسخةٍ: «الخطّائین» بدل: «الخاطئین»، و المعنى واحدٌ.
و هکذا شأن هذا اللفظ فی هذا الکتاب ـ کما نبّهنا علیه مراراً ـ ؛ و ذلک لأنّ المذنب إذا وبّخ نفسه بالذنوب یرحمه اللّه و یغفر ذنوبه، إذ لیس شیءٌ أدخل فی مغفرة الذنوب من الاعتراف بها؛ قال الباقر – علیه السلام ـ: «ماینجو من الذنب إلّا من أقرّ به»(57)؛
و قال أیضاً: «ألاَ! و اللّه! ما أراد اللّه من الناس إلّا خصلتین: أن یقرّوا له بالنعم فیزیدهم، و بالذنوب فیغفرها لهم!»(58)؛
و قال الصادق – علیه السلام ـ: «و اللّه ما خرج عبدٌ من ذنبٍ إلّا باقراره(59)»(60)
و ذلک أیضاً سبیل العارفین فی سلوک سبیل ربّ العالمین، فانّ لهم <فی سلوک سبیل اللّه و مرابطتهم مع أنفسهم مقاماتٍ خمسةٍ؛ و هی: المشارطة؛ ثمّ المراقبة؛ ثمّ المحاسبة؛ ثمّ المعاینة؛
ثمّ المعاقبة.
و ضربوا لذلک مثالاً، فقالوا: ینبغی أن یکون حال الإنسان مع نفسه کحاله مع شریکه إذا سلم إلیه مالاً لیتّجر به، فالعقل هو التاجر فی طریق الآخرة و مطلبه و ربحه تزکیة النفس ـ إذ بها فلاحها، کما قال تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاهَا)(61) ـ. فالعقل یستعین بالنفس فی هذه التجارة إذ یستسخرها فیما یزکّیها کما یستعین الإنسان بشریکه. و کما انّ الشریک یصیر خصماً منازعاً یجازیه فی الربح فیحتاج إلى أن یشارطه أوّلاً و یراقبه ثانیاً و یحاسبه ثالثاً و یعاتبه أو یعاقبه رابعاً، فکذلک العقل یحتاج إلى هذه المقامات الخمس؛
الأوّل: المشارطة، و هی أن یشارط النفس أوّلاً فیوظّف علیها الوظائف و یأمرها بسلوک طریق الحقّ و یرشدها إلیه و یحرم علیها سلوک غیره، کما یشترط التاجر على شریکه؛
و الثانی: المراقبة، و هی أن لایغفل عنها لحظةً فلحظةً عند خوضها فی الأعمال و یلاحظها بالعین الکالئة، فانّ الإنسان إن غفل عن نفسه و أهملها لم یر منها إلّا الخیانة و تضییع رأس المال، کالعبد الخائن إذا انفرد بمال سیّده؛
و الثالث: المحاسبة، و هی أن یحاسبها بعد الفراغ من العمل و یطالبها بالوفاء بما شرط علیها أوّلاً، فانّ هذه تجارة ربحها الفردوس الأعلى، فتدقیق الحساب فی هذا أهمّ من التدقیق فی أرباح الدنیا ـ لحقارتها بالنسبة إلى نعم الآخرة ـ. فلاینبغی أن یترک مناقشتها فی ذرّةٍ من حرکاتها و سکانتها و خطراتها و لحظاتها، فانّ کلّ نفَسٍ من أنفاس العمر جوهرةٌ نفیسةٌ لاعوض لها یمکن أن یشترى بها کنزاً من کنوز الآخرة لایتناهى نعیمه و لایظعن مقیمه. قالوا: «و ینبغی للإنسان أن یخلو عقیب فریضة کلّ صبحٍ بنَفْسه و یقول للنَفْس: ما لی بضاعةٌ إلّا العمر! و مهما فنى فقد فنى رأس مالی و وقع البأس من التجارة و طلب الربح، و هذا یومٌ جدیدٌ قد أمهلنی اللّه فیه و لو توفّانی لقلت: (رَبِّ ارْجِعُونِ – لَعَلِّی أَعْمَلُ صَالِحاً
فِیَما تَرَکتُ)(62)، فاحسبی انّک توفّیت ثمّ رددت، فإیّاک و تضییع هذا الیوم و الفغلة فیه»؛
و الرابع: المعاینة و التوبیخ، و قد علمت أنّ لک نَفْساً أمّارةً بالسوء میّالةً إلى الشرّ و قد أمرت بتقویمها و قودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربّها و طاعة خالقها. فسبیل المعاینة و التوبیخ أن تعدّد للنفس عیوبها و تذکّر لها ما هی علیه من الجهل فی ارتکاب المعاصی و انحرافها فی سلوک سبیل اللّه لتذلّ و تنکسر فتضعف سورة شهوتها و تستعدّ بذلک إلى استنزال رحمة اللّه ـ تعالى ـ و رأفته ـ کما أرشد إلیه سیّد العابدین و إمام المتّقین فی هذا الدعاء ـ. قال بعض العارفین: «اعلم! أنّ النفس شرورٌ جموحٌ، فان أهملتها لم تظفر بها بعد ذلک! و إن لازمتها بالتوبیخ و المعاتبة و الملائمة کانت نفسک هی النفس اللوّامة»؛
و الخامس: المعاقبة و المجاهدة، و ذلک إذا رأى نفسه قد قارفت معصیةً أو همّت بها فینبغی أن یعاقبها بالتضییق علیها فی الأمور المباحة و یأخذها بالصبر عنها، و إذا رءاها توانت و کسلت من شیءٍ من الفضائل و وردٍ من الأوراد فینبغی ان یؤدّبها بتثقیل الأوراد علیها و یلزمها فنوناً من الطاعات جبراً لما فات. قال بعض أرباب العرفان: «إنّ هذه النفس فی غایة الخساسة و الدناءة و نهایة الجهل و الغباوة، و ینبّهک على ذلک انّها إذا همّت بمعصیةٍ أو انبعثت لشهوةٍ لو تشفّعت إلیها باللّه ـ سبحانه ـ ثمّ برسوله و بجمیع أنبیائه ثمّ بکتبه و السلف الصالح من عباده و عرضت علیها الموت و القبر و القیامة و الجنّة و النار لاتکاد تعطی القیاد و لاتترک الشهوة، ثمّ إن منعتها رغیفاً سکنت و ذلّت و لانت بعد الصعوبة و الجماح و ترکت الشهوة!>(63)
اللَّهُمَّ وَ هَذِهِ رَقَبَتِی قَدْ أَرَقَّتْهَا الذُّنُوبُ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَعْتِقْهَا بِعَفْوِکَ. وَ هَذَا ظَهْرِی قَدْ أَثْقَلَتْهُ الْخَطَایَا، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ خَفِّفْ
عَنْهُ بِمَنِّکَ.
«الرِقّ» ـ بالکسر ـ: العبودیّة، و یتعدّی بالهمزة فیقال: أرقّه، فهو مرقٌّ؛ و قد یتعدّی بالحرکة أیضاً، فیقال: رَقَّهَ یَرقُّه ـ من باب قتل ـ، فهو مرقوقٌ. و تعلّق الرقّیّة بالرقبة لأنّها تظهر فیها حیث تجعل الرقبة ذلیلاً منقاداً مقیّداً ـ کما تعلّق القدرة بالید، لأنّها تظهر فیها ـ. و أمّا أرقّه ـ من الرقّة، مقابل الغلظ، کما توهّم ـ لایلائم الاعتاق؛ أی: صیّرتها رقّاً و عبداً، و هو کنایةٌ عن کثرة الذنوب. کذا قوله – علیه السلام ـ: «قد أثقلته الخطایا».
<و «اعتقه» أی: خلّصه من الرقّ، فهو معتَقٌ، و لایقال: عتقه فهو معتوقٌ.
و لمّا کان المعتاد فی الأثقال حملها على الظهر خصّ «الظهر» بـ «أثقال الخطایا» له.
و «الخطایا»: جمع خطیئة، و هی الذنب. و قیل: «الفرق بینهما: انّ الذنب قد یطلق على ما یقصد بالذات، و الخطیئة تغلب على ما یقصد بالعرض، لأنّها من الخطأ»(64)>(65)
و فی نسخة ابن ادریس بدل «عنه»: «عنّی».
و «المنّ» قد مرّ معناه.
یَا إِلَهِی لَوْ بَکَیْتُ إِلَیْکَ حَتَّى تَسْقُطَ أَشْفَارُ عَیْنَیَّ، وَ انْتَحَبْتُ حَتَّى یَنْقَطِعَ صَوْتِی، وَ قُمْتُ لَکَ حَتَّى تَتَنَشَّرَ قَدَمَایَ،
«لو بکیت إلیک» ضمّن فیه معنى الالتجاء و نحوه ممّا یقتضیه کلمة «إلى»، أو «إلى» بمعنى: «اللام» ـ کما قیل فی قوله تعالى: (وَ الاَمرُ إِلَیکِ)(66) -(67) ـ ؛ أی: بکیت لک. و هذا شرطٌ جزاؤه ما سیأتی من قوله – علیه السلام ـ: «ما استوجبت لذلک»؛ أو قوله: «لم أرفع» باقحام لفظ «ثمّ».
و «أشفار» العین: منابت الهُدُب، و یقال بالفارسیّ: «پلک چشم»؛ جمع شُفر ـ بالضمّ، کقفل و اقفال ـ، و قد یفتح. و قال ابن قتیبة: «و العامّة تجعل أشفار العین: الشعر، و هو غلطٌ، و إنّما الأشفار حروف العین التی ینبت علیها الشعر؛ و الشعر: الهُدُب»(68)
و «النحب» و النحیب و الانتحاب ـ بالحاء المهملة ـ: البکاء الّذی فیه صوتٌ طویلٌ و مدٌّ ـ کما مرّ ـ.
و تتنشّر ـ بتائین بعدهما نونٌ، أو بینهما نونٌ ـ بمعنى: تنتفخ أعصابهما من التعب.
وَ رَکَعْتُ لَکَ حَتَّى یَنْخَلِعَ صُلْبِی، وَ سَجَدْتُ لَکَ حَتَّى تَتَفَقَّأَ حَدَقَتَایَ.
«الانخلاع»: زوال المفصل عن مکانه، و یقال بالفارسیّة: «از جاى خود کنده شدن».
و «الصُلب» ـ بالضمّ ـ: الظهر، و فی القاموس: «هو عظمٌ من لدن الکاهل إلى العجب»(69)
و «التفقّؤ»: خروج العین من موضعه.
و «الحدقة»: سواد العین، و تطلق على جملة العین.
وَ أَکَلْتُ تُرَابَ الأَرْضِ طُولَ عُمْرِی وَ شَرِبْتُ مَاءَ الرَّمَادِ آخِرَ دَهْرِی.
«طول العمر» منصوبٌ على الظرفیّة، أی: مدّة امتداد عمری، من طال الشیء بمعنى: امتدّ.
و «ماء الرماد» أی: الممزوج به، أو الّذی على لونه. <و إنّما خصّ «الرماد» بالذکر بوجهین:
أحدهما: تجفیفه الّذی هو خلاف الغرض المطلوب من شرب الماء ـ و هو الترطیب ـ، فلایکون فی شربه غناءٌ للشارب، فانّ الرماد بأنواعه مجفّفٌ؛
و الثانی: تکدیره الماء تکدیراً لایکاد یصفو معه أبداً>(70)
و «آخر» منصوبٌ بنزع الخافض، أی: إلى آخر مدّة عمری. و قال الفاضل الشارح: «آخر دهری أی: أبداً»(71)، و استشهد على ذلک بقول أئمّة اللغة(72)؛
و هو بعیدٌ هنا! ـ کما لایخفى ـ.
وَ ذَکَرْتُکَ فِی خِلاَلِ ذَلِکَ حَتَّى یَکِلَّ لِسَانِی، ثُمَّ لَمْ أَرْفَعْ طَرْفِی إِلَى آفَاقِ السَّمَاءِ اسْتِحْیَاءً مِنْکَ.
و «الطرف»: نظر العین، قال الخلیل: «لایثنّى و لایجمع»(73)، لأنّه مصدر: طَرَف: إذا حرّک جفونه فی النظر.
<و «الآفاق»: جمع أُفُق ـ بضمّتین ـ، و هو الناحیة من السماء و الأرض. و عدم رفع النظر إلى آفاق السماء کنایةٌ عن غضّ الطرف و الإطراق من الحیاء، فانّ الإنسان إذا استحیى کسر طرفه و أطرق برأسه رامیاً ببصره إلى الأرض>(74) و ذلک الاستحیاء لکثرة المعصیة و قلّة الطاعة بالنسبة إلى ما تستحقّه بجلال وجهک الکریم و بهاء عزّک العظیم.
و فی هذه الفقرات تأییدٌ للقول بأنّ قبول التوبة بالتفضّل، لا بالوجوب ـ کما ذهب إلیه المعتزلة ـ(75)
مَا اسْتَوْجَبْتُ بِذَلِکَ مَحْوَ سَیِّئَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ سَیِّئَاتِی.
هذا جواب «لو».
<و «استوجب» الشیء: استحقّه، من وجب الحقّ: إذا ثبت.
و «السیّئة» أصلها: سیوءة ـ على فیعلة ـ من ساء یسوؤه سوءً و مساءةً، قلبت الواو یاءً کراهة اجتماعهما ـ لجریانهما مجرى المثلین ـ، وادغمت فی الیاء قبلها. و هی من الصفات الغالبة تتناول جمیع المعاصی ـ صغرت أو کبرت ـ.
و «واحدة»: صفةٌ مفادّها التوکید ـ کـ: (نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ)(76) ـ>(77) و المعنى: لو بکیت مع جمیع المذلّات والخشوعات المذکورة لم أستوجب محو سیّئةٍ واحدةٍ، فکیف محو السیّئات الکثیرة؟!.
و ذلک لأنّ الممکن لیسٌ صرفٌ و لاشیء محض بحسب الذات و الحقیقة، فلایستحقّ شیئاً من هذه الحیثیّة؛ و قد مرّ فیما سبق أنّ نحو الوجود ذنبٌ و خطیئةٌ عند أرباب الحقیقة ـ کما قیل:
وُجُودُکَ ذَنبٌ لاَیُقَاسُ بِهِ ذَنبٌ(78) ـ
و إلّا فأهل بیت النبوّة ـ علیهم الصلاة و السلام ـ قد أذهب اللّه عنهم رجس الذنوب و طهّرهم تطهیراً. و قس علیه کلّ ما ورد عنه و عنهم من التکلّم بأمثال ذلک؛ فلایحتاج إلى العذر بأنّ أمثال هذا من باب تعلیم الأمّة و قد صدر عنهم – علیهم السلام ـ فی السرّ و الخفیّة!.
وَ إِنْ کُنْتَ تَغْفِرُ لِی حِینَ اسْتَوْجِبُ مَغْفِرَتَکَ وَ تَعْفُو عَنِّی حِینَ اسْتَحِقُّ عَفْوَکَ فَإِنَّ ذَلِکَ غَیْرُ وَاجِبٍ لِی بِاسْتِحْقَاقٍ، وَ لاَ أَنَا أَهْلٌ لَهُ بِاسْتِیجَابٍ، إِذْ کَانَ جَزَائِی مِنْکَ فِی أَوَّلِ مَا عَصَیْتُکَ النَّارَ، فَإِنْ تُعَذِّبْنِی فَأَنْتَ غَیْرُ ظَالِمٍ
لِی. «و إن کنت». «إن» للشرط، و جزاؤه قوله – علیه السلام ـ: «فان ذلک جزاءٌ غیر واجبٍ لی».
و «کنتَ» هنا تفید الاستمرار و الدوام، فانّ «کان» یختصّ باستمرار خبرها لاسمها؛ أی: إن غفرت لی فی الوقت الّذی تفضّلت به و جعلته وقتاً للاستحقاق، و هذا الاستحقاق لیس منّی و بحسن سعیی، بل هذا أیضاً بفضلک و کرمک، و لستُ لائقاً بهذا العفو بالوجوب علیک و لا أنا مستوجبٌ ذلک العفو و المغفرة لعملی.
و قیل: «الغرض المبالغة فی نفی استحقاق المغفرة، یعنی: انّی و إن استحقّها بالعرض فی بعض الأوقات فذلک الاستحقاق کلا استحقاقٍ! ـ للفقد الذاتیّ ـ، فلامنافاة بین نفی الاستیجاب أوّلاً و اثباته ثانیاً». و ذلک لما ذکرناه لک من أنّ الممکن فی حدّ ذاته لیسٌ صرفٌ و لاشیء محض.
و قوله – علیه السلام ـ: «إذ کان جزائی»، «إذ» لتعلیل نفی وجوب ذلک له، أی: إنّ ذلک غیر واجبٍ لی باستحقاقٍ لأجل کون جزائی أوّل ما عصیتک النار.
و لاینافی هذا مذهب المعتزلة ـ الّذین یوجبون على اللّه جزاء الأعمال، بمعنى أنّه لاینفکّ فی الحکمة ـ کما یقال: یجب وجود المعلول عند وجود العلّة ـ، لا بمعنى انّ تارکه مستحقٌّ للعذاب فی الآخرة ـ کما فهمته الأشاعرة و اعترضت و شنّعت على المعتزلة! ـ.
و التحقیق ما مرّ من أنّ نحو الوجود ذنبٌ و خطیئةٌ؛ فالمعنى: إذ کان جزائی فی أوّل ما عصیتک بنحو وجودی النار؛ فالجزاء لاینفکّ عن العمل بهذا المعنى؛ فتدبّر تفهم!.
و «الفاء» من قوله – علیه السلام ـ: «فإن تعذّبنی» فصیحةٌ، أی: إذا کان الأمر هکذا فإن تعذّبنی فأنت غیر ظالمٍ لی؛ لأنّ الظلم وضع الشیء فی غیر موضعه، و هنا لیس کذلک.
إِلَهِی فَإِذْ قَدْ تَغَمَّدْتَنِی بِسِتْرِکَ فَلَمْ تَفْضَحْنِی، وَ تَأَنَّیْتَنِی بِکَرَمِکَ فَلَمْ تُعَاجِلْنِی، وَ حَلُمْتَ عَنِّی بِتَفَضُّلِکَ فَلَمْ تُغَیِّرْ نِعْمَتَکَ عَلَیَّ، وَ لَمْ تُکَدِّرْ
مَعْرُوفَکَ عِنْدِی. فَارْحَمْ طُولَ تَضَرُّعِی، وَ شِدَّةَ مَسْکَنَتِی، وَ سُوءَ مَوْقِفِی.
تکریر النداء فی هذا الدعاء للتضرّع و اظهار کمال الخضوع و الخشوع و التذلّل الّذی هو مرتبة العبودیّة و غرضٌ للاعتراف بالألوهیّة.
<و «الفاء» من قوله - علیه السلام ـ: «فإذ تغمّدتنی» للترتیب الذکریّ کالتفصیل بعد الاجمال، المفهوم من معاملته ـاسبحانه ـ له بخلاف مقتضى الجزاء وقت العصیان.
و قول بعضهم: «إنّها للتعقیب»؛
غلطٌ! کأنّه لم یفرّق بین الترتیب و التعقیب، و لم یعلم انّ المراد بالترتیب: أن یکون المعطوف بها متأخّراً عن المعطوف علیه؛ و بالتعقیب: أن یکون متّصلاً بالمعطوف علیه بلاتراخٍ>(79)
و «إذ» فی هذا المقام قیل: «حرفٌ للتعلیل» ـ کما مرّ ـ ؛ و قیل: «ظرفیّةٌ»، هکذا ذکره الفاضل الشارح(80) و فی بعض النسخ: «و إذ» ـ بالواو ـ.
و «الغمد»: غلاف السیف، و فی القاموس: «تغمّده اللّه برحمته: غمره بها»(81)
و «السِتر» بالفتح: المصدر، و بالکسر: ما یستر به؛ و هکذا هذه الصیغة ـ کالغسل و الغسل، و العطر و العطر ـ.
و «تأنّى» فی الأمر: تمکث و لم یعجّل. و عدّاه بنفسه لتضمینه معنى: أمهلتنی و أنظرتنی. و «تأنّیتنی» عطفٌ على «تغمّدتنی».
و «حلُم» ـ بالضمّ ـ حِلماً ـ بالکسر ـ: صفح و ستر، و لذلک یعدّى تارةً بـ «عن»، فیقال: حلم عنه، لأنّه بمعنى: صفح؛ و تارةً بـ «على»، فیقال: حلم علیه، لأنّه بمعنى: ستر. و فی نسخةٍ: «حملت» ـ بتقدیم المیم على اللام ـ، و کأنّه تصحیفٌ.
<و «غیّرت» الشیء تغییراً: أزلته عمّا کان علیه.
و «کدر» الماء یکدر ـ مثلّثةً ـ: زال صفاؤه؛ و یتعدّی بالتضعیف، فیقال: کدّرته. قال فی الأساس: «و من المجاز: کدر عیشه و تکدّر، و صفا أمری فکدره فلانٌ(82)»(83)؛ انتهى.
و «المعروف»: الجود و الإحسان؛ و قیل: «هو اسم ما تبذله و تعطیه». أضمر تشبیهه بالماء الصافیّ و أثبت له التکدّر ـ الّذی هو من لوازم المشبّه ـ، فالکلام استعارةٌ مکنیّةٌ تخییلیّةٌ.
و الفاء من قوله – علیه السلام ـ: «فارحم»: زائدةٌ على القول بأنّ «إذ» من قوله: «فإذ تغمّدتنی» حرف تعلیلٍ؛ و أمّا على القول بأنّها ظرفیّةٌ فهی رابطةٌ لأجزاء الظرف مجرى کلمة الشرط ـ کما ذکر سیبویه(84) فی نحو: «زیدٌ حین لقیته فأنا أکرمه» ـ و قال الرضیّ: «یجوز أن یکون ممّا أضمر فیه أمّا»(85)، و التقدیر على هذا: فأمّا إذ تغمّدتنی فارحم!(86)
و قیل: «و إذ تغمّدتنی شرطیّةٌ، جزاؤه: «فارحم»؛
و فیه ما لایخفى!.
و «المسکنة» قیل: «مشتقّةٌ من لفظ المسکین، کما اشتقّوا منه الفعل فقالوا: تمسکن»؛
و قیل: «هی مفعلةٌ من السکون ـ کالمنجلة من النجل ـ، و معناها الخضوع و الذلّة».
و المراد بـ: «الموقف»: محلّ الوقوف؛ و یمکن أن یراد به الوقوف و سوء الموقف ـ کسوء المآب و سوء العمل، و مقابله: حسن الموقف و حسن المآب ـ ؛ أی: و لمّا فعلت الأمور المذکور بمحض فضلک و کرمک فتمّم ذلک بالترحّم على طول تضرّعی و شدّة مسکنتی و سوء موقفی.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ قِنِی مِنَ الْمَعَاصِی وَ اسْتَعْمِلْنِی بِالطَّاعَةِ، وَ ارْزُقْنِی حُسْنَ الإِنَابَةِ، وَ طَهِّرْنِی بِالتَّوْبَةِ، وَ أَیِّدْنِی بِالْعِصْمَةِ، وَ اسْتَصْلِحْنِی بِالْعَافِیَةِ، وَ أَذِقْنِی حَلاَوَةَ الْمَغْفِرَةِ، وَ اجْعَلْنِی طَلِیقَ عَفْوِکَ، وَ عَتِیقَ رَحْمَتِکَ، وَ اکْتُبْ لِی أَمَاناً مِنْ سُخْطِکَ، وَ بَشِّرْنِی بِذَلِکَ فِی الْعَاجِلِ دُونَ الآجِلِ. بُشْرَى أَعْرِفُهَا، وَ عَرِّفْنِی فِیهِ عَلاَمَةً أَتَبَیَّنُهَا.
«الوقایة»: الحفظ و الصیانة.
«استعملنی» أی: للعمل بالطاعة، یقال: عمل عملاً و أعمله غیره و استعمله بمعنىً.
و «الانابة»: الرجوع عن الذنب، و أناب إلى اللّه أی: أقبل و رجع عن المعصیة ـ کـ : تاب ـ. و قیل: «التوبة: الندم، و الانابة: ترک المعاصی»، کما سیأتی فی دعائه – علیه السلام ـ فی ذکر التوبة و طلبها: «أللّهمّ إن یکن الندم توبةً إلیک فأنا أندم النادمین، و إن یکن الترک لمعصیتک إنابةً فأنا أوّل المنیبین».
و «أیّده» تأییداً: قوّاه.
<و «العصمة» فی اللغة: اسمٌ من عَصَمَه اللّه من المکروه یَعصِمُه ـ من باب ضرب ـ بمعنى: حفظه و وقاه؛ و فی العرف: «فیضٌ إلهیٌّ یقوی به العبد على تحرّی الخیر و تجنّب الشرّ»، ذکره الراغب(87)
و عند المتکلّمین عبارةٌ عن: أن لایخلق اللّه فی العبد ذنباً(88)؛ و هذا قریبٌ منه.
و قال الحکماء: «هی ملکةٌ تمنع الفجور و یحصل بها العلم بمثالب المعاصی و مناقب
الطاعات»(89)؛
و قیل: «هی ملکة اجتناب المعاصی مع التمکّن منها».
و «استصلحه»: طلب صلاحه>(90)، و هو نقیض الاستفساد.
و «العافیة»: عبارةٌ عن دفاع اللّه جمیع المکاره البدنیّة و الدینیّة؛
و قیل: «انّه مِن: عفى اللّه عنه أی: محى ذنوبه و اسقطها؛ و عفاه اللّه أی: محى عنه الضرّ و البلاء و الشرّ»؛
و قیل: «محى عنه الأسقام»؛
و الظاهر هو الإطلاق. و العافیة اسمٌ منه ـ کالناشئة و الخاتمة و العافیة ـ ؛ و فی الدعاء: «أسألک العفو و العافیة»(91)، أی: ترک العقوبة و السلامة.
و «المغفرة»: اسمٌ من: غَفَر اللّه له غَفْرا و غُفرَاناً ـ من باب ضرب ـ: صفح عنه. و فی الکلام استعارةٌ ترشیحیّة، فانّه استعار الحلاوة لثمرة المغفرة بجامع اللذّة، ثمّ فرّع علیها ما یلائم الحلاوة من الإذاقة.
و «الطلیق» هو الأسیر الّذی أطلق عنه إساره و خلّی سبیله.
و «العتیق» مثله، من: أعتقت العبد: إذا خلّصته من الرقّ. شبّه – علیه السلام ـ العفو و الرحمة بالمعتق، فهذه استعارةٌ بالکنایة، و اثبات التطلیق و العتق ـ اللَّذَین هما من لوازم المشبّه به ـ للمشبّه تخییلٌ.
و «اکتب لی» أی: أوجب لی. و لم یقل: «و اجعل لی» و: «أوجب لی»، لأنّ الکتابة أثبت و أدوم، یقال: کتب رزق فلانٍ فی الدیوان، فیدلّ ذلک على دوامه و ثبوته على مرور
الأزمان.
و «الأمان» هو ما یؤمّن به.
و «التبشیر»: الإخبار بما یسرّ المخبر به؛ <قیل: «اشتقاقه من البُشْر ـ و هو السرور ـ، فیختصّ بالخیر الّذی یسرّ. و أمّا قوله ـ تعالى ـ: (فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ)(92)، و: (إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالاُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً)(93) فمن باب التهکّم و الاستهزاء!».
و قیل: «من البَشَرَة، و هو ظاهر الجلد لتأثیره فی تغییر بشرة الوجه؛ فیکون فی ما یسرّ و یغمّ، لأنّ السرور کما یوجب تغییر البشرة فکذلک الحزن یوجبه، فوجب أن یکون لفظ التبشّر حقیقةً فی القسمین. لکنّه عند الإطلاق یختصّ فی العرف بما یسرّ، و إن أرید خلافه قُیّد، قال اللّه ـ تعالى ـ: (فَبَشِّرْ عِبَادِ)(94)، و فی الثانی: (فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ)».
و «البُشرى» ـ بالضمّ>(95) و القصر، بلاتنوینٍ، کما فی قوله تعالى : (قَالَ یَا بُشْرَى هَذَا
غُلاَمٌ)(96) ـ: اسمٌ منه، و هو مفعولٌ مطلق لـ «بشّرنی».
و «العاجل» و «الآجل»: وصفان لمحذوفٍ.
و «دون» هنا بمعنى: قبل، أی: فی الوقت العاجل ـ و هو الدنیا ـ قبل الوقت الآجل ـ و هو الآخرة ـ.
و «عرّفه» الأمر تعریفاً: أعلمه به؛ و عرّفه بیته: أعلمه بمکانه.
و «العلامة»: الأمارة الّتی یُعرف بها الشیء.
و «تبیّن» بمعنى: اتّضح و انکشف. و فی قوله – علیه السلام ـ: «و بشّرنی بذلک فی العاجل» <إشارةٌ إلى قوله ـ تعالى ـ: (الَّذِینَ آمَنُوا وَ کَانُوا یَتَّقُونَ - لَهُمُ الْبُشْرَى فِی الْحَیَاةِ الدُّنیَا وَ فِی الاْخِرَةِ)(97) و قد جاءت الروایات فیها مختلفةً على وجوهٍ، و کلّها على
نهج الصواب(98)؛
الأوّل: إنّ المراد بها: الرؤیا الصالحة یراها المؤمن لنفسه أو تُرى له، و (فِی الاْخِرَةِ) بالجنّة؛ و هی ما تبشّرهم الملائکة عند خروجهم من القبور و فی القیامة إلى أن یدخلوا الجنّة یبشّرون بها حالاً بعد حالٍ، و هو المرویّ عن النبیّ(99) ـ صلّى الله علیه و آله و سلّم ـ، و عن أبی جعفرٍ(100) – علیه السلام ـ ؛
و عن الرضا – علیه السلام ـ قال: «إنّ رسول اللّه ـ صلّى الله علیه آله و سلّم ـ إذا أصبح قال لأصحابه: هل من مبشّراتٍ؟، یعنی به الرؤیا»(101) و کان – علیه السلام ـ یقول: الرؤیا الحسنة من الرجل الصالح جزءٌ من ستّةٍ و أربعین جزءً من النبوّة؛ و إنّ الرؤیا الصالحة من اللّه، فإذا رأى أحدکم ما یحبّ فلایحدّث بها إلّا من یحبّ، و إذا رأى رؤیا مکروهةً فلیتفلّ عن یساره ثلاثاً و لیتعوّذ من شرّ الشیطان و شرّها و لایحدّث بها أحداً، فإنّها لن تضرّه»؛
و الثانی ما روی عن أبی عبداللّه – علیه السلام ـ انّه قال فی قوله ـ تعالى ـ : (لَهُمُ الْبُشرَى فِی الْحَیَاةِ وَ فِی الاْخِرَةِ): «الإمام یبشّرهم بقیام القائم و بظهوره و بقتل أعدائهم و بالنجاة فی الآخرة»(102)؛
و الثالث ماروی عنه – علیه السلام ـ من: «انّ رسول اللّه ـ صلّى الله علیه و آله و سلّم ـ و علیّاً – علیه السلام ـ یدخلان على المؤمن وقت الاحتضار، فیجلس رسول اللّه عند رأسه و علیٌّ – علیه السلام ـ عند رجلیه، فیکبّ علیه رسول اللّه ـ صلّى الله علیه و آله و سلّم ـ فیقول: یا ولیّ اللّه أبشر! أنا رسول اللّه، انّی خیرٌ لک ممّا ترکت من الدنیا!، ثمّ
ینهض رسول اللّه فیقوم علیٌّ – علیه السلام ـ حتّى یکبّ علیه فیقول: یا ولیّ اللّه أبشر! أنا علیّ بن أبی طالبٍ الّذی کنت تحبّه، أمّا انّی لأنفَعک(103) !؛ فقال: و ذلک قوله ـ تعالى ـ: (لَهُمُ الْبُشرَى فِی الْحَیَاةِ الدُّنیَا وَ فِی الاْخِرَةِ)»(104)
و قال بعض المفسّرین: «المراد بـ: «البشرى فی الحیاة»: هی ما بشّرهم اللّه ـ تعالى ـ فی القرآن على الأعمال الصالحة»(105)؛
و قیل: «المراد بها: بشارة الملائکة للمؤمنین (أَلاَّتَخَافُوا وَ لاَتَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ)(106)»(107)>(108)؛
و الرابع: قال ابن عبّاس: «(البُشرَى فِی الدُّنیَا) یرید: عند الموت یأتیهم الملائکة بالبشارة، و (فِی الاْخِرَةِ) عند خروج نفس المؤمن یعرج بها إلى اللّه و یبشّر برضوان اللّه»(109)؛
و قیل: «القوم إذا حضرتهم الوفاة فلابدّ لهم من مشاهدة اثنتی عشرة صورةً یشهدونها کلّها أو بعضها، لابدّ من ذلک!؛ و هو: صورة عمله، و: صورة اعتقاده، و: صورة مقامه، و: صورة حاله، و: صورة رسوله، و: صورة الملک، و: صورة اسمٍ من أسماء الأفعال، و: صورة اسمٍ من أسماء الصفات، و: صورة اسمٍ من أسماء النعوت ـ و هی أسماء النسب، کالأوّل و الآخر و ما یجری هذا المجرى ـ، و: صورة اسمٍ من أسماء التنزیه، و: صورة اسمٍ من أسماء
الذات ـ کاللّه، و هو، و هو أرفع ـ. و هذه کلّها بشارات الحیاة الدنیا للّذین قال فیهم: (الَّذِینَ آمَنُوا وَ کَانُوا یَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشرَى فِی الْحَیَاةِ الدُّنیَا)».
و من هنا قالوا: إنّ العارف و إن کان فی الدنیا بجسده فهو فی مشاهدته بعین بصیرته لأحوال الجنّة و سعادتها و أحوال النار و شقاوتها کالّذین شاهدوا الجنّة بعین حسّهم و تنعّموا فیها؛ و کالّذین شاهدوا النار و عذّبوا فیها؛ و هی مرتبة عین الیقین ـ الّذی مرّ ـ.
إِنَّ ذَلِکَ لاَیَضِیقُ عَلَیْکَ فِی وُسْعِکَ، وَ لاَ یَتَکَأَّدُکَ فِی قُدْرَتِکَ، وَ لاَ یَتَصَعَّدُکَ فِی أَنَاتِکَ، وَ لاَ یَؤُودُکَ فِی جَزِیلِ هِبَاتِکَ الَّتِی دَلَّتْ عَلَیْهَا آیَاتُکَ، إِنَّکَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَ تَحْکُمُ مَا تُرِیدُ، إِنَّکَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ.
«إنّ ذلک» ـ… إلى آخره ـ تعلیلٌ للدعاء.
<و «ضاق» علیه الأمر: شقّ و تعسّر.
و «الوُسع» ـ بالضمّ ـ: الطاقة و القوّة ـ و منه: (لاَیُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)(7) ـ>(110)، و الملأ و الغناء و الرحمة.
و «لایتکاءدک» ـ من باب التفاعل ـ، أو: «لایتکأدّک» ـ من باب التفعّل ـ، و کذا: «لایتصعّدک» أی: لایشقّ علیک فی جنب قدرتک و لا فی جنب «أناتک»، أی: حلمک و امهالک.
و «لایؤودک» أی: لایثقلک، یقال: أدّه الشیء: ثقل علیه.
<و «جزُل» الحطب ـ بالضمّ ـ: إذا عظم و غلظ، فهو جزِلٌ و جزیلٌ؛ ثمّ استعیر للعطاء، فقیل: أجزل له فی العطاء: إذا أوسعه؛ و هو جزیل العطاء.
و «الهبات»: جمع الهبة ـ کالعدات جمع العدة ـ، و هی العطیّة بلاعوضٍ.
و «الآیات»: جمع آیة، و هی العلامة. و یحتمل أن یراد بها هنا الآیات القرآنیّة>(110)؛ و
المعنى: لایثقل الکرم فی کثرة عطیّتک و هباتک الّتی علیها آیاتک القرآنیّة أو العلامات الآفاقیّة و الأنفسیّة.
و قد مرّ معنى «الإرادة» و «المشیّة» و الفرق بینهما فی اللمعة الأولى.
—
هذا آخر اللمعة السادسة عشرة من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة، إملاء المستقیل من ذنوبه الکثیرة محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة؛ و قد وفّقنی اللّه ـ تعالى ـ لاتمامها فی ظهر یوم الأربعاء لأربعٍ خلون من شهر ذی القعدة سنة ثلاثین و مأتین و ألفٍ من الهجرة.
1) کریمتان 25 / 40 ص.
2) کریمة 3 الطلاق.
3) راجع: «مستدرک الوسائل» ج 13 ص 42 الحدیث 14687، «بحار الأنوار» ج 100 ص 35،«التمحیص» ص 53 الحدیث 104، و انظر: «الکافی» ج 5 ص 83 الحدیث 1.
4) کریمة 69 النساء.
5) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 127.
6) کما حکاه العلّامة المدنی، راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 128.
7) کریمة 286 البقرة.
8) کریمة 112 الأنبیاء.
9) کریمة 194 آل عمران.
10) هذا قول العلّامة المدنی، راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 128.
11) و انظر: «القاموس المحیط» ص 793 القائمة 2.
12) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 129.
13) المصدر: مضى.
14) قارن: «نور الأنوار» ص 113.
15) کریمة 144 البقرة.
16) هذا نصّ کلام الزمخشریّ، راجع: «الکشّاف» ج 1 ص 319.
17) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 130.
18) کما حکاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 179.
19) کما قال الفیروزابادی: «الهیبة: المخافة… و هابه یهابه هیباً و مهابةً: خافه»، راجع: «القاموس المحیط» ص 147 القائمة 1.
20) راجع: «مجمل اللغة» ج 4 ص 458.
21) و انظر: «الفتوحات المکّیة» ـ الطبعة المصحّحة ـ ج 13 ص 223، «لطائف الأعلام» ص 580الاصطلاح 1588.
22) کریمة 68 البقرة.
23) کریمة 37 یوسف.
24) کریمة 53 النحل.
25) راجع: «صحاح اللغة» ج 2 ص 607 القائمة 2.
26) کریمة 88 طه.
27) لم أعثر على هذه القراءة، و انظر: «معجم القراءات القرآنیّة» ج 4 ص 104.
28) کریمة 4 الأعراف.
29) و انظر: «مغنی اللبیب» ج 1 ص 428.
30) راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 134.
31) کریمة 211 البقرة.
32) هذا قول المحدّث الجزائری، انظر: «نور الأنوار» ص 113.
33) کما حکاه العلّامة المدنی، راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 134.
34) کریمة 15 القصص.
35) راجع: «القاموس المحیط» ص 392 القائمة 2.
36) لم أعثر علیه فی «النهایة»، و فیه: «الشهرة: ظهور الشیء فی شُنعةٍ حتّى یشهره الناس ـ کما فی«القاموس» ـ»، راجع: «النهایة» ج 2 ص 515.
37) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 135.
38) قارن: «شرح الصحیفة» ص 180، مع تغییرٍ یسیر.
39) المصدر: ـ هو.
40) راجع: «القاموس المحیط» ص 391 القائمة 2.
41) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 137.
42) کریمة 67 البقرة.
43) راجع: «المفردات» ص 209 القائمة 1، نقلاً مع تصرفٍ واسع.
44) کریمة 1 الأنبیاء.
45) کما قال الفیّومی: «و الحظّ: النصیب»، راجع: «المصباح المنیر» ص 194.
46) هذا قول اللیث، راجع: «تاج العروس» ج 10 ص 465 القائمة 2.
47) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 139.
48) قارن: «شرح الصحیفة» ص 181.
49) راجع: «المصباح المنیر» ص 676.
50) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 141.
51) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 142.
52) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 143.
53) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 145.
54) راجع: «صحاح اللغة» ج 4 ص 1472 القائمة 1، و انظر: «شرح الصحیفة» ص 182.
55) کریمة 33 یوسف.
56) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 147.
57) راجع: «الکافی» ج 2 ص 426 الحدیث 1، «بحار الأنوار» ج 6 ص 36، «مجموعة ورّام» ج 1ص 18، «مشکاة الأنوار» ص 110.
58) راجع: «الکافی» ج 2 ص 426 الحدیث 2، «وسائل الشیعة» ج 16 ص 58 الحدیث20975، «بحار الأنوار» ج 6 ص 36.
59) المصدر: بالاقرار.
60) قارن: «عدّة الداعی» صص 161 / 179.
61) کریمة 9 الشمس.
62) کریمتان 99 / 100 المؤمنون.
63) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 152، مع تغییرٍ یسیر فی بعض الألفاظ.
64) کما عن الجزائری، راجع: «فروق اللغات» ص 121.
65) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 154.
66) کریمة 33 النمل.
67) لم أعثر على قائله، فانظر مثلاً: «التفسیر الکبیر» ج 24 ص 194، «التبیان» ج 8 ص 93،«الکشّاف» ج 3 ص 146، «تفسیر القرطبی» ج 13 ص 195.
68) راجع: «أدب الکاتب» ص 21.
69) راجع: «القاموس المحیط» ص 111 القائمة 1.
70) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 156.
71) راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 157.
72) کالجوهریّ و الزمخشریّ و الرمانیّ، راجع: نفس المصدر أیضاً.
73) راجع: «ترتیب العین» ج 2 ص 1074 القائمة 2.
74) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 157.
75) العبارة مأخوذةٌ من کلام المحقّق الجزائری، راجع: «نور الأنوار» ص 113.
76) کریمة 13 الحاقّة.
77) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 158.
78) راجع: «وفیات الأعیان» ج 1 ص 374، «مصباح الأنس» ص 693، «الراح القَراح»ص 74.
79) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 160.
80) راجع: نفس المصدر.
81) راجع: «القاموس المحیط» ص 289 القائمة 2.
82) أساس البلاغة:… و تکدّر، و خذ ما صفا و دع ما کدر، و کدر علیَّ فلانٌ.
83) راجع: «أساس البلاغة» ص 538 القائمة 1.
84) راجع: التعلیقة الآتیة.
85) قال الرضی: «کما ذکر سیبویه فی نحو قولهم: زیدٌ حین لقیته فأنا أکرمه… و یجوز أن یکون قوله… ممّا أضمر فیه أمّا»، راجع: «شرح الرضی على الکافیة» ج 4 ص 475.
86) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 161.
87) لم أعثر علیه فی «المفردات»، و انظر: المصدر ص 569 القائمة 2، و لم یوجد فی «الذریعة إلىمکارم الشریعة» أیضاً.
88) لم أعثر على هذا التعریف فی کتب المتکلّمین، و هذا تعریفٌ غریبٌ جدّاً، و انظر: «اللوامع الإلهیّة» ص 243، «تقریب المعارف» ص 103، «مطلع الاعتقاد» ص 65.
89) کما قال شمس الدین محمود الإصفهانیّ: «العصمة ملکةٌ نفسانیّةٌ تمتنع عن الفجور و تتوقّف على العلم بمثالب المعاصی و مناقب الطاعات»، راجع: «مطالع الأنظار» ص 211.
90) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 162.
91) راجع: «الکافی» ج 4 ص 431 الحدیث 1، «من لایحضره الفقیه» ج 2 ص 535، «بحارالأنوار» ج 83 ص 70، «الاقبال» ص 247.
92) کریمات 21 آلعمران / 34 التوبة / 24 الانشقاق.
93) کریمة 58 النحل.
94) کریمة 7 الزمر.
95) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 164.
96) کریمة 19 یوسف.
97) کریمتان 63 / 64 یونس.
98) و انظر: «البرهان فی تفسیر القرآن» ج 2 ص 189، «کنز الدقائق» ج 6 ص 74.
99) راجع: «الکافی» ج 8 ص 90 الحدیث 60، «من لایحضره الفقیه» ج 1 ص 133الحدیث 352.
100) راجع: «بحار الأنوار» ج 6 ص 145.
101) راجع: «الکافی» ج 8 ص 90 الحدیث 59، «بحار الأنوار» ج 58 ص 177.
102) راجع: «الکافی» ج 1 ص 429 الحدیث 83، «بحار الأنوار» ج 24 ص 353.
103) المصدر: أما لأنفعنّک.
104) راجع: «الکافی» ج 3 ص 128 الحدیث 1، «بحار الأنوار» ج 6 ص 185، «المحاسن» ج 1 ص175 الحدیث 158.
105) هذا قول الزجّاج و الفرّاء، راجع: «مجمع البیان» ج 5 ص 205.
106) کریمة 30 فصّلت.
107) هذا قول قتادة و الزهری و الضحّاک و الجبّائی، راجع: نفس المصدر.
108) قارن: «نور الأنوار» ص 114.
109) لم أعثر علیه، و أورده القرطبی نقلاً عن عطاء و قتادة، راجع: «تفسیر القرطبی» ج 8ص 358.
110) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 166.