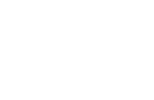بسم اللّه الرحمن الرحیم
و به نستعین
الحمد للّه الّذی أمرنا بالاستعاذة من الشیطان فی القرآن و جنّبنا الامتثال لأمره فی کلّ آنٍ و زمانٍ؛ و الصلاة و السلام على نبیّه المبعوث على الإنس و الجانّ و على آله الهادین لبنی نوع الإنسان.
و بعد؛ فهذه اللمعة السابعة عشرة من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة، إملاء المستعیذ من الشیطان و مکائده محمّد باقر بن السیّد محمد من السادات الموسویّة ـ استعاذهما اللّه من شرّ الشیطان و نفسهما الأمّارة، بمحمّدٍ و أهل بیته الطاهرة ـ.
وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ ـ عَلَیْهِ السَّلاَمُ ـ إِذَا ذُکِرَ الشَّیْطَانُ فَاسْتَعَاذَ مِنْهُ وَ مِنْ عَدَاوَتِهِ وَ کَیْدِهِ.
«الاستعاذة»: طلب العوذة، و هو الالتجاء، و الاستجارة، أو الالتصاق ـ یقال: أطیب اللّه اللحم أعوذه، و هو الملتصق منه بالعُظم ـ.
و «الشیطان» قد مرّ معناه.
و «الکید»: المکر.
قال سیّد الساجدین ـ صلوات اللّه علیه و على آبائه و أبنائه الطاهرین -:
اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِکَ مِنْ نَزَغَاتِ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ کَیْدِهِ وَ مَکَایِدِهِ، وَ مِنَ الثِّقَةِ بِأَمَانِیِّهِ وَ مَوَاعِیدِهِ وَ غُرُورِهِ وَ مَصَایِدِهِ.
<«النزغات»: جمع نزغة، و هی فعلةٌ من النزع؛ یقال: نَزَغَ الشیطان بین القوم ـ من باب نفع ـ أی: أفسد>(1)؛ قال ـ سبحانه ـ: (بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّیطَانُ بَینِی وَ بَینَ إِخْوَتِی)(2)،
أی: أفسد. فـ «نزغات الشیطان»: مفاسده(3)
و «الرجیم»: فعیلٌ بمعنى مفعولٍ ـ أی: المرجوم ـ، مأخوذٌ من الرجم، و هو لغةً: الرمی بالحجارة(4) و وصف به الشیطان لأنّه یرمى بالسبّ و الشهب طرداً له من عالم السماوات، ثمّ وصف به کلّ شرّیرٍ متمرّدٍ.
و «الکید» قد مرّ معناه آنفاً؛ و هو لیس فی نسخة الشهید ـرحمه اللّه ـ.
و «المکائد»: جمع المکیدة، و هی المکر و الحیلة.
و «الثقة»: الاعتماد.
و «الأمانیّ» ـ بالتشدید، و قد یخفّف ـ: جمع أمنیّة؛ أصلها: أمنویة ـ على أفعولة ـ، قلبت الواو یاءً و أدغمت فی الیاء. و هی اسمٌ من تمنّى الشیء: إذا طلب حصوله ـ ممکناً کان أو ممتنعاً ـ، و معناه فی الفارسیّة: «آرزو». <و قد یطلق على حدیث النفس بما یکون و مالایکون، و أصله من مَنَى الشیء ـ کرمى ـ بمعنى: قدّره، لأنّ المتمنّی یقدّر حصول مایتمنّاه>(5) ـ و منه الأمانیّ فی قوله تعالى: (وَ مِنْهُمْ أُمِّیُّونَ لاَیَعْلَمُونَ الْکِتَابَ إِلاَّ أَمَانِیَّ)(6) ـ.
و قیل: «المراد من الأمانی: الأحادیث المختلقة و الأکاذیب المفتعلة، یقال: فلانٌ یتمنّی الحدیث أی: یفتعلها(7)، فیکون مقلوباً من المین ـ و هو الکذب ـ.
و «الغُرور» ـ بالضمّ ـ: ما اغترّ به، أی: خدع به.
و «المصاید»: جمع المصیدة ـ کالمعیشة ـ، و هو ما یصاد به ـ کالحبالة و الشبکة ـ ؛ <و المراد بها هنا الشهوات و اللذّات الدنیویّة، استعار لها المصاید لمشابهتها إیّاها فی استلزام الحصول فیها للبعد عن السلامة و الحصول فی العذاب>(8) و المعنى: ألّلهمّ إنّا نعوذ بک من مفاسد الشیطان و وساوسه ـ الملعون المطرود من ساحة عزّ جنابه ـ، و من مکایده و حیله و من الاعتماد بأمانیّه ـ و هو الأهواء الباطلة و الأحادیث المختلقة و الأکاذیب المفتعلة الّتی یلقیها فی قلب الإنسان فیمنیه طول الدنیا و الخلود فیها و الظفر على مقصوده و الاستیلاء على أعدائه، و بالجملة حصول مطالبه الشهویّة و الغضبیّة ـ، فیصدّه عن الطاعة و العبادة و یلقیه فی المعصیة و تسویف التوبة، و من مواعیده الکاذبة و خدعه الباطلة و مصایده المنبسطة من محسنّات الشهوات و اللذّات الدنیویّة فی الأنظار الاعتباریّة.
روی عن الأئمّة: «انّ إبلیس کان یأتی الأنبیاء من لدن آدم إلى أن بعث اللّه المسیح یتحدّث عندهم و یسألهم، و لم یکن بأحدٍ منهم أشدّ أنساً منه بیحیى بن زکریّا- علیه السلام ـ. فقال له یحیی: یا أبامرّة! أحبّ أن تعرض علیّ مصایدک و فخوظک الّتی تصطاد بها بنی آدم،
فقال له إبلیس: حبّاً و کرامةً!، و واعده لغدٍ. فلمّا أصبح یحیى قعد فی بیته ینتظر الموعد، و أغلق علیه اغلاقاً. فما شعر حتّى دخل إلیه من خوخةٍ کانت فی بیته؛ فإذاً وجهه على صورة وجه القرد و جسده على صورة الخنزیر، و إذاً عیناه مشقوقتان طولاً و فمه مشوقٌ طولاً!، و إذاً أسنانه عظمٌ واحدٌ بلاذقنٍ و لا لحیةٍ!، و له أربع أیدٍ یدان فی صدره و یدان فی منکبه!، و
إذاً عراقیبه قوادمه و أصابعه خلفه و علیه قباءٌ و قد شدّ وسطه بمنطقةٍ فیها خیوطٌ معلّقةٌ بین أحمر و أصفر و أخضر و جمیع الألوان!، و إذاً بیده جرسٌ عظیمٌ و على رأسه بیضةٌ و إذاً فی البیضة حدیدةٌ معلّقةٌ شبیهةٌ بالکلاب!.
فلمّا تأمّله یحیى – علیه السلام ـ قال له: ما هذه المنطقة الّتی فی وسطک؟
فقال: هذه المجوسیّة الّتی(9) سننتها و زیّنتها لهم!،
فقال له: ما هذه الخیوط الألوان؟
قال: هذه جمیع أصباغ النساء!، لاتزال المرأة تصبغ الصبغ حتّى تقع مع لونها فافتتن الناس بها!،
فقال له: فما هذا الجرس الّذی بیدک؟
قال: مجمع کلّ لذّةٍ من طنبورٍ و بربطٍ و معزفةٍ و طبلٍ و نایٍ و صرنایٍ؛ و إنّ القوم لیجلسون على شرابهم فلایستلذّونه، فأحرّک الجرس فیما بینهم فإذا سمعوه أشخصهم(10)
الطرب، فمن بین من یرقص و(11) من یقرقع أصابعه و من بین من یشقّ ثیابه!،فقال له: و أیّ الأشیاء أقرّ لعینک؟
قال: النساء!، هنّ فخوخی و مصائدی، فانّه إذا اجتمعت علیّ دعوات الصالحین و لعناتهم صرت إلى النساء فطاب نفسی بهنّ!.
فقال له یحیى – علیه السلام ـ: فما هذه البیضة الّتی على رأسک؟
قال: بها أتوقّى دعوة المؤمنین!،
قال: فما هذه الحدیدة الّتی أرى فیها؟
قال: بهذه أقلّب قلوب الصالحین،
قال یحیى – علیه السلام ـ: فهل ظفرت بی ساعةً قطّ؟
قال: لا!، و لکن فیک خصلةٌ تعجبنی!،
قال یحیى: فما هی؟
قال: أنت رجلٌ أکولٌ فاذا أفطرت أکلت و شبعت(12) فیمنعک ذلک من بعض صلاتک و قیامک باللیل!،
قال یحیى – علیه السلام ـ: فانّی أعطی اللّه عهداً أنّی لاأشبع من الطعام حتّى ألقاه!،
قال له إبلیس: و أنا أعطی اللّه عهداً انّی لاأنصح مسلماً حتّى ألقاه!.
ثمّ خرج فما عاد إلیه بعد ذلک»(13)
وَ أَنْ یُطْمِعَ نَفْسَهُ فِی إِضْلاَلِنَا عَنْ طَاعَتِکَ، وَ امْتِهَانِنَا بِمَعْصِیَتِکَ، أَوْ أَنْ یَحْسُنَ عِنْدَنَا مَا حَسَّنَ لَنَا، أَوْ أَنْ یَثْقُلَ عَلَیْنَا مَا کَرَّهَ إِلَیْنَا.
أی: نعوذ بک من حالةٍ یجعل الشیطان نفسه طامعاً فی اظلالنا فی تلک الحالة عن طاعتک و عبادتک.
و «الامتهان»: افتعالٌ من المهنة بمعنى: الخدمة(14)؛ یقال: امتهنه فامتهن أی: استعمله
للخدمة. و الماهن: الخادم، و منه حدیث سلمان: «أکره أن أجمع على ماهنٍ مهنتین»(15)
و قیل: «یحتمل أن یکون من الإهانة، أی: احتقارنا بسبب معصیتک».
«أو أن یحسن عندنا ما حسّن لنا»، و الفعل الأوّل من المجرّد و الثانی من التفعیل، أو بالعکس؛ یقال: حسن الشیء عنده یحسُن ـ بالضمّ ـ: لائم طبعه، و حسن له تحسیناً: زیّنه حتّى مال إلیه طبعه. أی: نعوذ بک من أن یحسن عندنا فعلٌ قبیحٌ یحسن الشیطان لنا حتّى
نرتکبه؛ أو: یزیّن عندنا شیئاً حسن لنا بسبب تزیینه.
و «الثقل»: فی الأصل للحمل، یقال: ثقُل علیه الحمل ـ بالضمّ ـ یثقل ثقلاً: إذا کلّ علیه؛ ثمّ توسّع فیه فاستعمل فی ما لائم بالطبع.
و «کرّه» إلیه الشیء: قبّحه له؛ أی: و من أن یکون ثقیلاً علینا ما کرّهه و قبّحه الشیطان، فانّه یحسّن للإنسان معاصی اللّه ـ تعالى ـ و یکره إلیه طاعاته.
اللَّهُمَّ اخْسَأْهُ عَنَّا بِعِبَادَتِکَ، وَ اکْبِتْهُ بِدُؤُوبِنَا فِی مَحَبَّتِکَ، وَ اجْعَلْ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ سِتْراً لاَ یَهْتِکُهُ، وَ رَدْماً مُصْمِتاً لاَ یَفْتُقُهُ.
«خَسَأ» الکلب ـ من باب نفع ـ خَسأً و خسوءً: أطرده، قال اللّه ـ تعالى ـ: (اخْسَؤُوا فِیهَا وَ لاَتُکَلِّمُونِ)(16)، و قال رسول اللّه ـ صلّى الله علیه و آله و سلّم ـ: «أ لا أخبرکم بشیءٍ إن فعلتموه تباعد الشیطان عنکم کما تباعد المشرق من المغرب؟
قالوا: بلی یا رسول اللّه – صلّى اللّه علیه و آله و سلم ـ !
قال: الصوم یسوّد وجهه و الصدقة تکسر ظهره و الحبّ فی اللّه ـ تعالى ـ و المواظبة(17)
على العمل الصالح یقطع دابره و الاستغفار یقطع وتینه»(18) یعنی: إبعد الشیطان و اطرده عنّا
بسبب عبادتنا إیّاک، فانّه یصیر سبباً لطرده. ففی الکلام تخییلٌ مکنیّةٌ.
<و «اکبته» ـ بتقدیم الباء الموحّدة، من: کَبَت اللّه العدوّ، من باب ضرب ـ: ردّه بغیظه و أهانه؛ و کبته ـ أیضاً ـ: صرعه و أخزأه و صرفه و کسّره و أهلکه.
و «بدؤوبنا» ـ باشباع الواو ـ، من: دَأَبَ الرجل فی العمل ـ من باب نفع ـ دؤوباً: اجتهد فیه و تعب؛ أو بمعنى: العادة و الشوق الشدید؛ أی: اجعله مکبّاً على وجهه، أو اصرفه عنّا، أو
أذلله بسبب تعبنا فی لوازم محبّتک.
و «لایهتکه» من باب المجرّد، و التفعیل؛ و کذا «لایفتقه». و الأوّل من الهتک، و هو أن یجذب الستر حتّى ینزعه من مکانه، أو یشقّه؛ و الثانی من الفتق، و هو نقض خیاطة الثوب حتّى فصّلت بعضه من بعضٍ.
و «الردم»: السدّ.
و قال عبیدة: «المصمت: الّتی لاجوف له»(19)
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اشْغَلْهُ عَنَّا بِبَعْضِ أَعْدَائِکَ، وَ اعْصِمْنَا مِنْهُ بِحُسْنِ رِعَایَتِکَ، وَ اکْفِنَا خَتْرَهُ، وَ وَلِّنَا ظَهْرَهُ، وَ اقْطَعْ عَنَّا إِثْرَهُ.
قال الفاضل الشارح: «شغلت زیداً بکذا ـ من باب نفع ـ: جعلته له شغلاً، و شغلنی الأمر: صار لی شغلاً. و لمّا کان الشغل لایتعلّق بالذوات تحتّم هنا تقدیر مضافٍ، أی: اشغله عنّا بملازمة بعض أعدائک. و فی هذه الفقرة من البدیع «الادماج»، و هو أن یضمن المتکلّم کلاماً ساقه لمعنىً معنىً آخر بشرط أن لایشعر فی کلامه بأنّه مسوقٌ لأجله، کقوله ـ تعالى ـ: (وَ لَهُ الْحَمدُ فِی الاُولَى وَ الاْخِرَةِ)(20) ـ لتفرّده تعالى بوصف الحمد ـ، و أدمج فیه الإشارة إلى البعث و الجزاء. و هکذا عبارة الدعاء، فانّها سیقت لسؤال شغل الشیطان عنه حتّى لایشتغل به و أدمج فیه الدعاء على أعداء اللّه ـ سبحانه ـ»(21)؛ انتهى کلامه.
أقول: هذا کلامٌ لاطائل تحته!. و إنّما قال – علیه السلام ـ: «ببعض أعدائک» لا «بکلّها»، لأنّه من جملة الأعداء؛ و یحتمل أن یکون المراد بـ «بعض أعدائک» من أمثالنا!؛ فتدبّر تفهم!.
و «العصمة»: المحافظة، یقال: عَصَّمه اللّه من المکروه ـ من باب ضرب ـ: حفظه.
و «الرعایة» ـ بالکسر ـ: اسمٌ من رعاه یرعاه بمعنى: حفظه، أی: بحسن محافظتک.
و «کفاه» اللّه السوء یکفیه: دفعه عنه.
و «الخَتْر»: کالغَدْر وزناً و معنىً. و قیل: «الخدیعة و أقبح الغدر»(22)
<و «التولیة»: جعل الشیء یلی غیره، یقال: ولّاه ظهره: إذا جعله یلیله. و هو کنایةٌ عن الانهزام، لأنّ المنهزم یجعل ظهره ممّا یلی المنهزم عنه؛ فقوله - علیه السلام ـ: «و ولّنا ظهره» أی: اهزمه عنّا و ارفع شرّه.
و «الأَثَر» ـ بفتحتین، کما فی أکثر النسخ ـ: وسم الرجل الماشی فی الأرض. و هو کنایةٌ عن سؤاله منعه من وصوله إلیه، لأنّه إذا لم یصل إلیه انقطع مشیه إلیه، فانقطع أثره>(23) قیل: «و فی بعض النسخ «إِثْر» ـ بکسر الهمزة و السکون ـ، یقال: جئت فی إثْره؛ و أیضاً بفتحتین، أی: تبعته عن قربٍ. فمعناه: اقطع عنّا مجیئه على أثرنا».
و قد یظنّ أنّ فی الکلام تقلیباً، و المراد: اقطع عنه أثرنا فلایرى لنا أثراً فیتبعه؛ و لایخفى بعده!.
و کذا ما قیل: «هو کنایةٌ عن موته، فانّ من مات لم یبق له أثرٌ»(24)
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَمْتِعْنَا مِنَ الْهُدَى بِمِثْلِ ضَلاَلَتِهِ، وَ زَوِّدْنَا مِنَ الْتَّقْوَى ضِدَّ غَوَایَتِهِ، وَ اسْلُکْ بِنَا مِنَ التُّقَى خِلاَفَ سَبِیلِهِ مِنَ الرَّدَى.
و «أمتعنا» ـ من باب الإفعال، و التفعیل بدون الهمزة ـ أی: اجعلنا متمتّعین من الهدایة بقدر ضلالته.
و «الزاد»: طعام المسافر المتّخذ لسفره.
و «الضِدّ» – بالکسر ـ: المثل و المخالف؛ و فی عرف الحکماء یطلق على أحد الشیئین الوجودیّین الّلذین لایجتمعان فی موضوعٍ أو محلٍّ واحدٍ بینهما غایة الخلاف(25) ـ کالسواد و
البیاض ـ.
و لمّا کان التقوى ممّا یتقوّی به النفس على الوصول إلى جناب القدس فی السفر الأخرویّ ـ کما تتقوّی الطبیعة بالزاد على الحرکة الحسّیّة فی السفر الدنیویّ ـ استعار لها لفظ «الزاد».
و «الغَوایة»: الضلالة؛ و المعنى: و اجعل زادنا التقوى على ضدّ تزوّده بالغوایة و الإغواء.
<و «سَلَکت» الطریق سلوکاً ـ من باب قعد ـ: ذهبت فیه، یتعدّی بنفسه و بالباء أیضاً، فیقال: سلکت زیداً الطریق و سلکت به الطریق.
و «التقى»: مصدر وقاه ـ کهداه ـ بمعنى: اتّقاه، و الاسم: التقوى>(26)؛ و قد مرّ معناه لغةً و اصطلاحاً فی الروضة الرابعة، فلیرجع إلیه.
و «السبیل»: الطریق.
و «الردَى»: الهلاک، أی: اذهب بنا طریق التقوى الّذی هو خلاف طریق الهلاکة و الظلالة الّتی سلک بها الشیطان.
اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ لَهُ فِی قُلُوبِنَا مَدْخَلاً، وَ لاَ تُوَطِّنَنَّ لَهُ فِیما لَدَیْنَا مَنْزِلاً.
<«المَدخل» ـ بفتح المیم، على وزن مسکن ـ: إمّا مصدرٌ میمیٌّ بمعنى: الدخول، أو اسم مکانٍ؛ یقال: هذا مدخل البیت أی: موضع الدخول إلیه. و بضمّ المیم و فتح الخاء ـ على المصدر ـ بمعنى: الإدخال. و فی نسخة الشهید ـ رحمه اللّه ـ بکسر الخاء ـ على اسم الفاعل،
من باب الإفعال ـ>(27)
<و «التوطین»: التمهید، و منه: وطّن نفسه على الأمر: إذا مهّدها لفعله.
و «ما» فی قوله – علیه السلام ـ: «فیما لدینا» إمّا موصولةٌ، أو نکرةٌ موصوفةٌ؛ أی: فی الّذی لدینا، أو: فی شیءٍ لدینا>(28)
<و «مَنزِلاً» ـ بفتح المیم و کسر الزاء ـ: اسم مکانٍ بمعنى: موضع النزول؛ و بفتح المیم و الزاء مصدرٌ میمیٌّ للمجرّد بمعنى: النزول؛ و بضمّ المیم و فتح الزاء مصدرٌ میمیٌّ للمزید بمعنى: الإنزال. و فی نسخة الشهید ـ رحمه اللّه ـ بکسر الزاء، اسم فاعلٍ من باب الإفعال>(29)؛ و فی نسخةٍ أخرى اسم مفعولٍ منه. و یکون «منزلاً» فی حیّز المفعول صفةً لموصوفه المحذوف؛ و تقدیر الکلام: لاتوطّننّ فیما لدینا ـ أی: فی قلوبنا و جوارحنا و ضمائرنا و نیّاتنا ـ شیئاً منزلاً للشیطان؛ أی: لاتسکنه فی منزلٍ فی جنبنا؛ قال النبیّ ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ : «لولا انّ الشیاطین یحومون على قلوب بنی آدم لنظروا إلى ملکوت السماوات»(30)
اللَّهُمَّ وَ مَا سَوَّلَ لَنَا مِنْ بَاطِلٍ فَعَرِّفْنَاهُ، وَ إِذَا عَرَّفْتَنَاهُ فَقِنَاهُ، وَ بَصِّرْنَا مَا نُکَایِدُهُ بِهِ، وَ أَلْهِمْنَا مَا نُعِدُّهُ لَهُ، وَ أَیْقِظْنَا عَنْ سِنَةِ الْغَفْلَةِ بِالرُّکُونِ إِلَیْهِ، وَ أَحْسِنْ بِتَوْفِیقِکَ عَوْنَنَا عَلَیْهِ.
<«التسویل»: تحسین الباطن و تزیینه و تحبیبه إلى الإنسان لیفعله أو یقوله.
و «الباطل»: ما یخالف الحقّ ـ من عقیدةٍ أو قولٍ أو عملٍ ـ>(28)، أی: الباطل الّذی یزیّنه الشیطان لنا حتّى نرتکبه.
«فعرِّفناه» أی: اجعلنا عارفاً له حتّى لانتبعه. و إذا جعلتنا عارفاً به «فقناه»، أی:
فاحفظنا منه، لأنّ علمنا بالبطلان لایکفی فی الاحتراز عنه لو لم یکن حفظک عنه.
و «بصّرنا» ـ أی: علّمنا ـ «ما نکایده به»، بالیاء المثنّاة فی جمیع النسخ المعتبرة، لا بالهمزة ـ بمعنى: المکر و الخدعة ـ. و أخطأ من زعم انّه من «تتکأدّنی» و «تکأدّنی»، أی: شقّ علیّ؛ أی: علّمنا تدبیر دفع کیده و مکره به.
و العائد راجعٌ إلى الموصول.
و «الإلهام» قد مرّ معناه.
و «أعدّ» الشیء إعداداً: هیّأه.
و «الإیقاظ»: خلاف النوم.
و «السِنة»: فتورٌ و کلالٌ فی الحواسّ یتقدّم النوم، و یسمّى النعاس.
<و «الغفلة»: غیبة الشیء عن البال. شبّهها بالنوم و أثبت لها السِنة و الإیقاظ تخییلاً>(31)، و هو وقوع الشیء فی القلب من غیر فکرٍ و رویّةٍ؛ أی: عرّفنا بلامشقة فکرٍ استعداد حربه و دفعه.
و «الرکون»: الاعتماد، و «باؤه» للسببیّة متعلّقةٌ بـ «الغفلة»، أی: الغفلة بسبب الرکون إلیه؛ أی: اجعلنا متیقّظین عن نوم الغفلة الحاصلة بسبب المیل إلى الشیطان. و إنّما طلب الإیقاظ عن سنة الغفلة دون نومها لأنّ الأوّل یستلزم الثانی، بخلاف العکس.
و «التوفیق»: جعل اللّه فعل العبد موافقاً لما یحبّه و یرضاه.
و «العون»: الظهیر، أی: انصرنا على الشیطان نصراً حسناً بتوفیقک. و النصرة على الشیطان عبارةٌ عن عدم اطاعته.
و المراد بـ «حسنها»: کون ذلک لوجه اللّه ـ تعالى ـ، لأنّ الشیطان ـ لعنه اللّه ـ کثیراً مّا یزیّن الباطل فی صورة الحقّ و الحقّ فی صورة الباطل و الخیر فی صورة الشرّ و الشرّ فی صورة الخیر، فالتمیّز بینهما لایمکن إلّا بتوفیق اللّه ـ تعالى ـ ؛ «أللّهمّ أرنا الحقّ حقّاً حتّى
نتبعه، و أرنا الباطل باطلاً حتّى نجتنبه»(32)؛ بحقّ محمّدٍ و آله.
اللَّهُمَّ وَ أَشْرِبْ قُلُوبَنَا إِنْکَارَ عَمَلِهِ، وَ الْطُفْ لَنَا فِی نَقْضِ حِیَلِهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ حَوِّلْ سُلْطَانَهُ عَنَّا، وَ اقْطَعْ رَجَاءَهُ مِنَّا، وَ ادْرَأْهُ عَنِ آلْوُلُوعِ بِنَا.
«أشرب» ـ بصیغة الأمر، من باب الإفعال ـ: إمّا مأخوذٌ من الشراب ـ یقال: أشرب الصوب الصبغ: إذا أشبعه منه، و أشرب زیداً: إذا سقاه ـ ؛ أو: الإشراب بمعنی التلوین.
و «أنکرت» علیه عمله: عتبته و قبّحته، یعنی: اسق قلوبنا و خالطها إنکار عمله، أو إنکار عمل الشیطان فی قلوبنا بحیث لاینفکّ ذلک الإنکار عنها، کما لاینفکّ البیاض ممّا خالط به اللبن. <و على هذا السبیل قوله ـ عزّ من قائل ـ: (وَ أَشْرِبُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْعِجلَ)(33)، أی: خولطوا حبّه و تداخلهم الحرص على عبادته کما یتداخل الجوف الشراب، أو: کما یخالط الصبغ الثوب. ففی الکلام استعارةٌ بالکنایة و تخییلٌ.
و «اللطف»: التوفیق، أی: وفّق لنا>(34)؛ و فی نسخةٍ: «بنا» ـ بالباء الموحّدة(35) ـ.
و «الحیل»: جمع حیلة، و هی اسمٌ من الاحتیال. و أصلهما الواو، قال فی القاموس: «هو الحذق و جودة النظر و القدرة على التصرّف»(36) و المراد بـ «نقض حیله»: ابطالها حتّى لاتؤثّر فینا؛ یقال: نقضت ما أبرمه: إذا أبطلته، و أصله من: نقضت الحیل نقضاً أی: حللت برامه؛ أی: اجعل لطفک شاملاً لحالنا حتّى ننقض کیده و مکره. شبّه الحیل بالحبل، و اثبات
النقض له تخییلٌ؛ أو المعنى: فی هدم الحیل، فیکون قد شبّهها بالبناء. و یحتمل أن یکون المراد: علّمنا تدابیر لطیفة فی نقض حیله ـ کقوله فی دعاء الثغور الآتی: «و ألطف بهم فی المکر»(37) ـ.
و «التحویل»: النقل من موضعٍ إلى موضعٍ.
<و «سلطانه» أی: تسلّطه و غلبته بالاغواء المستتبع للاستجابة، و إلّا فلاسلطان له ـ کما قال سبحانه :(وَ مَا کَانَ لِی عَلَیْکُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُکُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِی)(38) ـ.
و «اقطع رجاءه» أی: آیسه منّا حتّى لایطمع على حالٍ فی إغوائنا.
و «دَرَأتُ» الشیء دَرْءً ـ من باب نفع ـ: دفعته>(39)، فقوله – علیه السلام ـ: «و ادرأ» أی: ادفعه؛ و فی الحدیث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»(40) أی: ادفعوا.
و «الوُلوع» فی جمیع النسخ بضمّ الواو، و لکن المنصوص علیه فی کتب اللغة انّ الولوع ـ سواءٌ کان مصدراً أو اسماً ـ هو بفتح الواو(41)، قال فی الصحاح: «إنّ(42) المصدر و الاسم کلیهما(43)
بفتح الواو»(44)، و هو بمعنى الاغراء و التحریص؛ أی: ادفع شدّة حرصه بنا فی اضلالنا و إغوائنا، کما أخبر اللّه ـ تعالى ـ عن شدّة تحریصه باغوائنا فی کتابه المبین ـ: (فَبِعِزَّتِکَ لاُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ)(45) ـ.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ آبَاءَنَا وَ أُمَّهَاتِنَا وَ أَوْلاَدَنَا وَ أَهَالِیَنَا
وَ ذَوِی أَرْحَامِنَا وَ قَرَابَاتِنَا وَ جِیرَانَنَا مِنَ الْمُوْمِنِینَ وَ الْمُوْمِنَاتِ مِنْهُ فِی حِرْزٍ حَارِزٍ، وَ حِصْنٍ حَافِظٍ، وَ کَهْفٍ مَانِعٍ، وَ أَلْبِسْهُمْ مِنْهُ جُنَناً وَاقِیَةً، وَ أَعْطِهِمْ عَلَیْهِ أَسْلِحَةً مَاضِیَةً.
<«الآباء»: جمع أب محذوف اللام، و هی واوٌ ـ لأنّه یثنّى على أبوین ـ.
و «الأمّهات»: جمع أمّ، و هی الوالدة؛ قیل: «أصلها: أمهة، و لهذا تجمع على أمّهات؛
و أجیب بزیادة الهاء، و انّ الأصل: أمّات؛ قال ابن جنّی: «دعوى الزیادة أسهل من دعوى الحذف». و کثر فی الناس «أمّهات»، و فی غیر الناس: «أمّات» للفرق بینهما»(46)
و «الأولاد»: جمع وَلَد ـ بفتحتین، فَعَل بمعنى مفعولٍ ـ یطلق على الذکر و الأنثى و المثنّى و المجموع. و الوُلْد ـ على وزن قُفْل ـ لغةٌ فیه، و قیسٌ تجعل المضموم جمع المفتوح ـ مثل أُسْد جمع أَسَد ـ>(47)
و «الأهالی»: جمع أهل، و أصله «أهال» زادوا فیه الیاء على غیر قیاسٍ ـ کما جمعوا لیلاً على لیالی ـ. و قیل: «الأهل تجمع تارةً جمع السالم، و منه قوله ـ تعالى ـ: (قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ)(48) ـ أصله: أهلین، سقطت النون بالاضافة ـ ؛ و تارةً جمع مکسّرٍ على أهلات و أهلال و أهالی. و الأصل فی الأهل: القرابة، و قد أطلق على الأتباع؛ و قال فی القاموس: «أهل الرجل: عشیرته و ذوو قرباه»(49)
و «ذوی»: جمع ذو بمعنى: صاحب.
و «الأرحام»: جمع رحم بمعنى: القرابة، و قد مرّ معناه فی اللمعة الثانیة.
<و «قراباتنا» یحتمل أن یکون معطوفاً على «الأرحام»، فیکون مجروراً ـ أی: ذوی قراباتنا ـ، و یحتمل أن یکون معطوفاً على «ذوی» فیکون منصوباً، و الکسرة فیه نائبةٌ عن
الفتحة. و عطفه على ما قبله امّا من عطف العامّ على الخاصّ إن قصر الرحم على من یحرم نکاحه، أو على من هو أخصّ من مطلق القرابة؛ و إلّا فهو من عطف الشیء على مرادفه تأکیداً.
و «الجیران»: جمع جار، و هو لغةً: الجار الّذی یجاورک بیت بیت(50)؛ و شرعاً قیل: «مرجعه إلى العرف»؛ و قیل: «إلى أربعین داراً من کلّ جانبٍ». و هو المرویّ من طرق العامّة و الخاصّة، روت عائشة عن النبیّ ـ صلّى الله علیه و آله سلّم ـ انّه قال: «الجار إلى أربعین داراً»(51)؛
و روى فی الکافی(52) بسندٍ حسنٍ أو صحیحٍ عن أبی جعفر – علیه السلام ـ قال: «حدّ الجوار أربعون داراً من کلّ جانبٍ ـ: من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله ـ»؛ و مثله عن أبی عبداللّه – علیه السلام ـ(53)>(54)
و قوله: «حرز حارز» أی: موضع محفوظ ـ من قبیل: ظلٌّ ظلیلٌ و لیلٌ ألیلٌ ـ. و من قواعد العربیّة انّهم إذا أرادوا المبالغة فی أمرٍ اشتقّوا من المصدر اسماً و حملوه علیه، فمعنى قولهم: ظلٌّ ظلیل: إنّ ظلّ الشیء صاحب ظلٍّ کالشخص، مبالغةً فی مدّه. قال ابن الأثیر فی النهایة: «و منه حدیث الدعاء: «أللّهمّ اجعلنا فی حرزٍ حارزٍ»(55) أی: کهفٍ منیعٍ. و هذا کما یقال: شعرٌ شاعرٌ، فأجرى اسم الفاعل صفةً للشعر و هو لقائله؛ و القیاس أن یکون: حرزٌ
محرِزٌ أو حرزٌ حریزٌ، لأنّ الفعل منه أحرز، و لکن کذا روی. و لعلّه لغةٌ»(56)؛ انتهى.
و «الحصن»: واحد الحصون، و هو: الحصار.
و «حافظ» أی: محکم کالعلّة.
و «الکهف»: الغار الواسع الّذی فی الجبال کأنّه بیتٌ منقورٌ، و الجمع: الکهوف؛ و یقال: فلانٌ کهفٌ أی: ملجأٌ. و المعنى: فی کهفٍ من رحمة اللّه مانعٍ تصرّف الشیطان.
قوله – علیه السلام ـ: «و ألبسهم منه جنناً واقیةً».
«منه» متعلّقٌ بـ «واقیة»، و «الواقیة» بمعنى: الحافظة؛ أی: أکسهم دروعاً حافظةً من الشیطان.
<قال الجوهریّ: «الجُنّة ـ بالضمّ ـ: ما استترت به من سلاحٍ، و الجُنّة: السترة، و الجمع: الجنن؛ یقال: استجنّ بجُنّةٍ أی: استتر بسترةٍ»(57)؛ انتهى. و استعار «الجنن» لعنایاته ـ سبحانه ـ بهم بحفظهم من مکاید الشیطان، و اثبات الالباس و الوقایة ترشیحٌ.
و «الأسلحة»: جمع سلاح، و هو ما یقاتل به فی الحرب و یدافع. و التذکیر فیه أغلب من التأنیث، فیجمع على التذکیر: أسلحة ـ کحمار و أحمرة ـ، و على التأنیث: سلاحات(58)
«ماضیة» أی: قاطعةٌ نافذةٌ، من: مضى السیف فی الضریبة مضاءً أی: قطع>(59)؛ و من هذا یقال: «الوقت سیفٌ»(60) أی: یمرّ و لایرجع کما انّ السیف یقطع و لایوصل، أو: فوت الوقت یؤلم کجراحة السیف. و المراد بـ «الأسلحة»: الأذکار و الأعمال الصالحة الّتی یدفع بها الوساوس و الشیطنة، و هی استعارةٌ مرشّحةٌ أیضاً ـ و وصفها بـ «الماضیة» هو الترشیح ـ؛ و فیه تشبیهٌ للشیطان ضمناً بالمحارب المبارز.
اللَّهُمَّ وَ اعْمُمْ بِذَلِکَ مَنْ شَهِدَ لَکَ بِالرُّبُوبِیَّةِ، وَ أَخْلَصَ لَکَ بِالْوَحْدَانِیَّةِ، وَ عَادَاهُ لَکَ بِحَقِیقَةِ الْعُبُودِیَّةِ، وَ اسْتَظْهَرَ بِکَ عَلَیْهِ فِی مَعْرِفَةِ الْعُلُومِ الرَّبَّانِیَّةِ.
«العموم» فی اللغة: الشمول، و فی العرف عبارةٌ عن: الاحاطة بالأفراد.
و «بذلک» أی: الحرز و الأسلحة.
و «شهد لک بالربوبیّة» أی: أقرّ لک بأنّک ربّ کلّ شیءٍ بالشهادة القولیّة و الفعلیّة بنحو وجوده.
و «أخلص لک بالوحدانیّة» أی: لم یلتفت مع ملاحظة جلالک و عظمتک إلى سواک، و هذا لایتحقّق إلّا بأن یغیب العارف عن نفسه بالمرّة، بل فنى بحیث لایکون له خبرٌ و لا أثرٌ ـ و قد بسطنا الکلام فی هذا المقام فی اللمعة الأولى، فتذکّر! ـ.
و «عاداه» فاعله ضمیرٌ یرجع إلى «مَن»، و مفعوله إلى «الشیطان»؛ أی: عادى الشیطان بما هو حقّ العبودیّة، لأنّ العبد ما لم یصر عبداً محضاً لم تحصل له معاداة الشیطان حقّ العداوة.
و «استظهر بک علیه» أی: استعان و استغلب بتوفیقک على الشیطان فی معرفة العلوم الربّانیّة، لأنّ الشیطان مانعٌ عن معرفة اللّه ـ لأنّ من عرف اللّه لایطیع الشیطان، و لهذا لیس شیءٌ أشقّ و أشدّ على الشیطان من المعرفة ـ و لایزال یمنع الشخص من تحصیل المعرفة.
اللَّهُمَّ احْلُلْ مَا عَقَدَ، وَ افْتُقْ مَا رَتَقَ، وَ افْسَخْ مَا دَبَّرَ، وَ ثَبِّطْهُ إِذَا عَزَمَ، وَ انْقُضْ مَا أَبْرَمَ.
«الحلّ»: خلاف العقد و الشدّ، أی: افتح ما قفل.
و «فَتَقَه» فَتْقاً ـ من باب قتل ـ: شقّه، أی: اقصم و اکسر ما سدّد و حکّم من المکائد؛ و استعمال الأفعال المذکورة فی هذه المعانی استعارةٌ تبعیّةٌ.
و «الفسخ» فی الأصل: ازالة الشیء عن موضعه، و فسخ الرأی: نقضه، و فسخ التدبیر:
افساده. قال الفاضل الشارح: «و من غریب ما وقع لبعض المترجمین هنا انّه قال: «اتّفقت النسخ على فتح السین من قوله: و أفسخ ما دبّره، و ضابطة القاموس تقتضی الضمّ»؛ انتهى؛
یشیر إلى ما ذکره صاحب القاموس فی أوّل الکتاب حیث قال: «و إذا ذکرت المصدر مطلقاً أو الماضی بدون الآتی و لا مانع فالفعل على مثال کتب»(61)؛ انتهى؛ و قال فی مادّة «ف س خ»: «الفسخ الضعف و الجهل و الطرح و افساد الرأی و النقض»(62)؛ فذکر المصدر مطلقاً و هو یقتضی أن یکون الفعل منه على مثال «کتب»، هذا معنى قول المترجم: «و ضابطة القاموس تقتضی الضمّ». و هو غلطٌ منه أوقعه فیه غفلته عن قول صاحب القاموس: «و لامانع»، فانّ المانع من کون الفعل هنا على مثال «کتب» متحقّقٌ ـ و هو کون لام الفعل على حرف حلقٍ، و هو الخاء، فانّ کون الفعل حلقیّ عینٍ أو لامٍ مانعٌ من کونه على مثال «کتب» إلّا ما ورد به السماع، کدخل یدخل ـ. و إنّما نبّهنا على ذلک لئلّا یقع الواقف على کلامه فی مثل ما وقع فیه. و اللّه الملهم للصواب!»(63)؛ انتهى.
أقول: هذا تحقیقٌ حسنٌ عامّ البلوى، فلذا ذکرناه. و مقصوده من «بعض المترجمین»: الشاه محمّد الشیرازی(64)
و «التدبیر»: هو أن تنظر إلى ما یؤول إلیه عاقبة الأمر، من: دبّر الأمر تدبیراً: قرّره عن فکرٍ و رویّةٍ، کأنّه نظر فی دبره ـ و هو عاقبتة ـ.
و «التثبیط»: ضدّ التحریص، من: ثبّطه عن الأمر تثبیطاً: عوّقه و حبسه، أی: امنعه و اشغله و عوّقه إذا قصد إغوائنا و اضلالنا.
قوله – علیه السلام ـ: «و انقض ما أبرم» أی: أکسر ما أتقن و أحکم من تدبیراته فی الإغواء.
اللَّهُمَّ وَ اهْزِمْ جُنْدَهُ، وَ أَبْطِلْ کَیْدَهُ، وَ اهْدِمْ کَهْفَهُ، وَ أَرْغِمْ أَنْفَهُ.
و «اهزم» أمرٌ من هَزَمَ الجیش هَزْماً ـ من باب ضرب ـ: کسر، و الاسم: الهزیمة.
و «الجُند» ـ بالضمّ ـ: الجیش. و هذه الفقرة قد مرّ تفسیر أکثر لغاتها.
و «أرغِم أنفه» ـ بکسر الغین، و بفتحها من الإفعال، و من باب قتل، و فی لغةٍ من باب تعب ـ: کنایةٌ عن الذلّ و الهوان، کأنّه لصق بالرغام ـ و هو التراب ـ، أی: ألصق أنفه بالرغام اذلالاً و اهانةً له.
اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا فِی نَظْمِ أَعْدَائِهِ، وَ اعْزِلْنَا عَنْ عِدَادِ أَوْلِیَائِهِ، لاَ نُطِیعُ لَهُ إِذَا اسْتَهْوَانَا، وَ لاَ نَسْتَجِیبُ لَهُ إِذَا دَعَانَا، نَأْمُرُ بِمُنَاوَاتِهِ، مَنْ أَطَاعَ أَمْرَنَا، وَ نَعِظُ عَنْ مُتَابَعَتِهِ مَنِ اتَّبَعَ زَجْرَنَا.
قال الفاضل الشارح: «النظم: الجماعة، یقال: جاءنا نظمٌ من جرادٍ أی: صفٌّ منه. و أصله من: نَظَم اللؤلؤ نَظْماً ـ من باب ضرب ـ جعله فی سلکٍ؛ أی: اجعلنا فی صفّ أعدائه و جماعتهم الّذین کأنّهم نظموا فی سلکٍ واحدٍ. و من فسّر «النظم» بـ: «السلک» فقد أخطأ!، فانّ السلک لایقال له: نظمٌ، بل: نظامٌ»(65)؛ انتهى.
أقول: قول المفسّر هکذا: «أصل النظم: عقد اللؤلؤ فی السلک، و المراد هنا الانتظام فی سلک أعدائه»؛
و هذا لایدلّ على ماذکره الفاضل الشارح، فتخطأته خطأٌ!؛ فتدبّر!.
و «أعزلنا» أی: أبعدنا <و جنّبنا من أن نعدّ فی أولیائه.
و تعدیة «نطیع» بـ «اللام» مع أنّه متعدٍّ بنفسه لتضمّنه معنى: ننقاد، أی: لاننقاد له مطیعین>(66) و هو بیانٌ للنظم فی سلک الأعداء.
<و «استهوانا» أی: استمالنا و اختدعنا بما یهواه؛ أو: طمع فینا أن یذهب بنا بحبائله ـ الّتی هی مهواة الغوایة و هاویة الظلالة ـ ؛ و فی التنزیل: (کَالَّذِی اسْتَهْوَتْهُ الْشَّیَاطِینُ)(67)>(68)؛ أو: طلب ظلالتنا، کالّذی استهامه العشق و ذهب هائماً حائراًـ یقال:هام على وجهه یهیم هیماً و هیاماً: ذهب من العشق و غیره؛ و: قلبٌ مستهامٌ أی: هائمٌ ـ.
«بمناواته» أی: بمعاداته، و أصله الهمز ـ من النوء، بمعنى: النهوض ـ، لأنّ کلّاً من المتعادیین ینوء إلى صاحبه(69)
<و «الوعظ»: النصح، و تعدیته بـ «عن» لتضمّنه معنى: الزجر. و قیل: «هو تذکیرٌ مشتملٌ على زجرٍ و تخویفٍ». و حمل على طاعة اللّه بلفظٍ یرقّ له القلب، و الاسم: الموعظة>(70) والجملتان ـ و هما: قوله علیه السلام: «لانطیع له»، و قوله: «نأمر بمناواته» ـ یجوز أن تکونا حالین من الضمیر المنصوب، أو تکونا مستأنفتین؛ کأنّه سئل: کیف تکونون إذا جعلکم فی نظم أعدائه و عزلکم من عداد أولیائه؟
فقال: لانطیع له ـ… إلى آخره ـ ؛ ثمّ استأنف الجملة الأخرى، فکأنّه سئل: ثمّ ما یکون منکم فی أمره بعد عدم اطاعته و استجابته؟
فقال: نأمر بمناواته ـ… إلى آخره ـ ؛ و على هذا فلامحلّ لهما من الإعراب.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِیِّینَ وَ سَیِّدِ الْمُرْسَلِینَ وَ عَلَى أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ. وَ أَعِذْنَا وَ أَهَالِیَنَا وَ إِخْوَانَنَا وَ جَمِیعَ الْمُوْمِنِینَ وَ الْمُوْمِنَاتِ مِمَّا اسْتَعَذْنَا مِنْهُ، وَ أَجِرْنَا مِمَّا اسْتَجَرْنَا بِکَ مِنْ خَوْفِهِ.
<«خاتِم» ـ بکسر التاء، و فتحها و هو الأشهر ـ: ما یختم به الشیء ـ کالطابع لما یطبع
به الشیء ـ، أو(71) بمعنى: الزینة، کما انّ الخاتم زینة الید>(68)
و «خاتم النبیّین»: من أغلق به باب النبوّة. و البرهان على ذلک:
أمّا على طریقة الحکماء فیحتاج إلى تمهید مقدّمةٍ؛ و هی: إنّ الإنسان الکامل ذو أجزاءٍ ثلاثةٍ: عقلٍ، و نفسٍ، و طبیعةٍ؛ و کلٌّ منها من عالمٍ آخر، و لکلٍّ منها کمالٌ و نقصٌ، و قلّ من الإنسان ما یکون کاملاً فی الجمیع؛
فکمال العقل ـ و یقال له: الروح أیضاً، و هو العقل النظریّ ـ بالعلم بالحقائق و الأمور الإلهیّة؛
و کمال النفس ـ و هو القوّة الخیالیّة باستثبات الصور الجزئیّة؛
و کمال الطبیعة هو التصرّف فی الموادّ الکونیّة بالقلب و التحریک و الاحالة. و النبیّ هو الشخص الکامل فی القوّة النظریّة من جهة الإلهامات الربّانیّة، فإذا حصلت له الرسالة أیضاً کمل أیضاً فی القوّة النفسانیّة، و إذا کان صاحب شریعةٍ و عزمٍ فقد صار جامعاً للکمالات الثلاثة؛ فکأنّه ربٌّ إنسانیٌّ یجب طاعته بعد طاعة اللّه فی العوالم الإمکانیّة!.
و تتفاوت بحسب هذه الکمالات الثلاثة ـ فی الشدّة و الضعف و الکمال و الیقین ـ مراتب الأنبیاء و الأولیاء، فأدناها ما اشتملت على أضعف مراتب الکمالات الثلاثة المذکورة، و أعلاها ما اشتملت على أقواها ـ الّتی لاتتصوّر فوقها مرتبةٌ فی العوالم الإمکانیّة ـ، و هی مرتبة العقل الأوّل الّتی لیست فوقها مرتبةٌ إلّا مرتبة الحضرة الأحدیّة. فالنبوّة إذا وصلت إلى هذه المرتبة تختم.
و إذا تمهّد هذه المقدّمة فنقول: هذه المرتبة العلیا ـ الّتی لامرتبة فوقها فی العوالم الإمکانیّة ـ حصلت لنبیّنا محمّد بن عبداللّه ـ صلّى الله علیه و آله و سلّم ـ بین الأنبیاء السالفة؛ بدلیل العقل و النقل؛
أمّا العقل: فآثارة الباقیة الدائرة بین الأمّة المرحومة ـ من القرآن و الأحادیث و العلوم
الربّانیّة و کثرة الآثار المحکمة المتقنة ـ دلیل شدّة وجود المؤثّر و قوّته ـ کما هو مقرّرٌ فی محلّه ـ؛
و أمّا النقلیّة فلما ورد عنه – علیه السلام ـ: «أوّل ما خلق اللّه عقلی(72)»(73)، أو: «روحی»(74)، و: «لی مع اللّه حالٌ لایسعنی ملکٌ مقرّبٌ و لانبیٌّ مرسلٌ»(75)
و أمّا على طریقة العرفاء و الصوفیّة: فلجامعیّته الکاملة و مظهریّته التامّة؛ فانّهم قالوا: بین أسماء اللّه ـ تعالى ـ تضادٌّ و تقابلٌ و کلّ واحدٍ منها یرید الغلبة و الظهور على مقابله و مضادّه ـ و من هذا سرت المضادّة فی المظاهر ـ، فلابدّ من حاکمٍ عدلٍ بین الأسماء و بین المظاهر أیضاً حتّى تنتظم سلسلة عالم الأسماء و المظاهر و یبلغ کلّ واحدٍ منها مرتبة کماله. و هذا الحاکم العدل هو الحقیقة المحمّدیّة المظهر لاسم اللّه الجامع، لأنّ سائر الأنبیاء الماضیة لهم الحاکمیّة فی المظاهر فقط لا فی الأسماء، بخلاف نبیّنا محمّدٍ ـ صلّى الله علیه و آله و سلّم ـ ؛ فهو قطبٌ أزلیٌّ أبدیٌّ یدور حوله فلک النبوّة ـ کما مرّ الکلام علیه مستوفىً فی اللمعة الثانیة، فلیرجع إلیه ـ.
و «السیّد» قد مرّ الکلام علیه فی أوّل الکتاب.
و الفرق بین «النبیّ» و «الرسول» قد عرفته فی اللمعة الأولى.
<و «أهل بیته» - علیهم السلام ـ: هم أهل العباء، المنزل فی شأنهم: (إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الْرِّجسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطهِیراً)(76)>(77)
و هذه الآیة تدلّ على عصمة الأئمّة، لأنّ اثبات الطهارة لهم بعد نفی الرجس و اذهابه دلیلٌ على عدم الخطأ منهم قطعاً و إلّا لانتفت الطهارة و ثبت الرجس، و هو خلاف مدلول
الآیة و خلاف مراد اللّه ـ تعالى ـ ؛ و هو غیر جائزٍ قطعاً.
قال المحیی الدین الأعرابیّ فی الباب التاسع و العشرین من الفتوحات المکّیّ ـ: «فی معرفة سرّ سلمان الّذی ألحق بأهل البیت، و الأقطاب الّذین وردت منهم معرفة أسرارهم»ـ: «اعلم أیّدک اللّه! أنّا روینا من حدیث جعفر بن محمّد الصادق – علیه السلام ـ عن أبیه محمّد بن علیٍّ عن أبیه علیّ بن الحسین عن أبیه الحسین(78) عن أبیه علیّ بن أبی طالبٍ عن رسول اللّه ـ صلّى الله علیه و آله و سلّم ـ انّه قال: «مولى القوم منهم»(79) -(80) و لمّا کان رسول اللّه ـ صلّى الله علیه و آله و سلّم ـ عبداً محضاً قد طهّره اللّه و أهل بیته تطهیراً و أذهب عنهم الرجس ـ و هو کلّ ما یشینهم، فانّ «الرجس» هو القذر عند العرب، هکذا حکى الفرّاء(81) ـ ؛ قال ـ تعالى ـ: (إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ أَهلَ الْبَیتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطهِیراً)، فلایضاف إلیهم إلّا مطهّرٌ و لابدّ!، فانّ المضاف إلیهم الّذی یشینهم، فما یضیفون لأنفسهم إلّا من له حکم الطهارة و التقدیس. فهذه شهادةٌ من النبیّ ـ صلّى الله علیه و آله و سلّم ـ لسلمان الفارسیّ ـ رضی اللّه عنه ـ بالطهارة و الحفظ الإلهیّ و العصمة حیث قال فیه رسول اللّه ـ صلّى الله علیه و آله و سلّم ـ: «سلمانٌ منّا أهل البیت»(82) و شهد اللّه لهم بالتطهیر و ذهاب الرجس عنهم. و إذا کان لاینضاف إلیهم إلّا طهرٌ مقدّسٌ و حصلت له العنایة الإلهیّة بمجرّد الإضافة، فما ظنّک بأهل البیت فی نفوسهم!، فهم المطهّرون، بل هم عین الطهارة!!، فهذه الآیة تدلّ على أنّ اللّه قد شرّک أهل البیت مع رسول اللّه ـ
صلّى الله علیه و آله و سلّم ـ فی قوله: (لِیَغْفِرَ لَکَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ مَا تَأَخَّرَ)(83)؛ و أیّ وسخٍ و قذرٍ أقذر من الذنوب و أوسخ؟!. فطهّر اللّه ـ سبحانه ـ نبیّه ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ بالمغفرة. فما ذنبٌ بالنسبة إلینا لو وقع منه ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ کان ذنباً فی الصورة لا فی المعنى، لأنّ الذمّ لایلحق به على ذلک من اللّه و لا منّا شرعاً. فلوکان حکمه على حکم الذنب یصحبه ما یصحب الذنب من المذمّة، و لم یصدق قوله: (لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطهِیراً).
فدخل الشرف أولاد فاطمة کلّهم و من هو من أهل البیت ـ مثل سلمان الفارسیّ ـ إلى یوم القیامة فی حکم هذه الآیة من الغفران، فهم المطهّرون اختصاصاً من اللّه و عنایةً لهم لشرف محمّدٍ ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ»(84) ـ … إلى أن قال ـ: «و لیس لنا ذمّ أحدٍ فکیف بأهل البیت؟!، فانّا إذا نزلنا عن طلب حقوقنا و عفونا عنهم فی ذلک ـ أی: فیما أصابوه منّا ـ کانت لنا بذلک عند اللّه الید العظمى و المکانة الزلفى، فان النبیّ ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ ما طلب منّا ـ عن أمر اللّه ـ إلّا المودّة فی القربى، و فیه سرّ صلة الرحم(85) و من لم یقبل سؤال نبیّه فیما سأله فیه ممّا هو قادرٌ علیه بأیّ وجهٍ تلقاه غداً و یرجو شفاعته و هو ما أسعف نبیّه ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ فیما طلب منه من المودّة فی قرابته فکیف بأهل بیته؟!. فهم أخصّ القرابة»(86)؛ و أنشد ـ رضی اللّه عنه ـ:
رَأَیتُ وِلاَیَةَ آلِ طه فَرِیضَةً++
عَلَى زَعمِ أَهلِ الْبُعدِ یُورِثُنِى الْقُربَى
فَلَمْ یَطْلُبْ الْمَبْعُوثُ أَجرآ عَلَى الْهُدَى++
بِتَبلِیغِهِ إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُربَى(87)
»؛انتهى کلامه.
أقول: من صدر منه مثل هذا الکلام هل من الإنصاف أن ینسب إلى التسنّن؟، کلّا!، بل
من له تتبّعٌ فی کلامه و کتبه قطع بأنّ مذهبه مذهب الامامیّة و إن لم تکن لنا صرفة فی تشیّعه.
اعلم! أنّه لایستأهل دار اللّه و جواره إلّا المطهّرون، و لا الصعود إلى المنزل الأعلى إلّا المنوّرون ـ کما قال تعالى: ) لاَتُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ لاَیَدْخُلُونَ آلْجَنَّةَ)(88)… الآیة ـ ؛ و ذلک لکثافة جوهرهم و دناءة ذاتهم و خسّة وجودهم الطبیعیّ، فلایمکنهم أن یدخلوا دار السلام فی زمرة الملکوت إلّا أن یتحوّل نحو وجودهم و یتبدّل، کما أشار إلیه بقوله: (وَ مَا نَحْنُ بِمَسبُوقِینَ – عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَکُمْ وَ نُنْشِئَکُمْ فِی مَا لاَتَعْلَمُونَ)(89)، و بقوله: (أَ یَطْمَعُ کُلُّ امْرِىءٍ مِنْهُمْ أَنْ یُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِیمٍ – کَلاَّ انَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا یَعلَمُونَ)(90)، یعنی: إنّ وجودهم مکوّنٌ من شیءٍ معلوم الدناءة و الخسّة ـ کالنطفة و مایجری مجراها ـ، و مثل هذا المخلوق لایناسب عالم القدس و لایصلح دخول الجنّة إلّا أن یتبدّل فی أکوانه و یتطوّر فی أطواره الذاتیّة حتّى یصلح لذلک.
و ممّا یؤیّد ذلک قوله: (وَ قَدْ عَلِمْتُمُ النَّشأَةَ الاُولَى فَلَولاَ تَذَکَّرُونَ)(91)، أی: هذه النشأة الأولى الإنسانیّة معلومةٌ لکم رتبة وجودها و دناءة حالها، فهلّا تذکّرون حتّى تعلموا أن لایمکن حصول الفوز بالنجاة و الخلاص من العقاب إلّا بتبدیل هذه النشأة الزائلة إلى النشأة الباقیة؟! ـ و ذلک بالریاضات و المجاهدات و التوفیقات الربّانیّة و سلوک سبیل الآخرة باقتناء المعارف الحقّة و الاجتناب عن الأخلاق الرذیلة ـ. و إلى ذلک التبدیل و التنویر وقعت الإشارة فی قوله ـ تعالى ـ: (إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ)(76) ـ… الآیة ـ.
وَ اسْمَعْ لَنَا مَا دَعَوْنَا بِهِ، وَ أَعْطِنَا مَا أَغْفَلْنَاهُ، وَ احْفَظْ لَنَا مَا نَسِینَاهُ، وَ صَیِّرْنَا بِذَلِکَ فِی دَرَجَاتِ الصَّالِحِینَ وَ مَرَاتِبِ الْمُوْمِنِینَ. آمِینَ رَبَّ
الْعَالَمِینَ.
«اسمع لنا» أی: استجب دعاءنا علیه.
و «ما دعوناه» أی: ما سألناه. و فی نسخةٍ: «اسمع»(92) ـ بقطع الهمزة ـ من الإسماع.
و «ما أغفلناه» أی: إعطنا ما أغفلنا سؤاله.
و «الحفظ»: ضدّ السهو و النسیان.
و «ما نسیناه» أی: ما نسینا طلبه منک. و الفرق بین الجملتین: إنّ الإغفال من الغفلة، و هو یقتضی أن لایکون الشیء منسیّاً بالکلّیّة، بل غاب غیبةً قلیلةً ـ قال الجوهریّ: «أغفلت الشیء: إذا ترکته على ذکرٍ منک»(93) ـ ؛ و إنّ السؤال فی الأولى أن یعطیه و فی الثانیة أن یحفظه.
و بینهما فرق ظاهرٌ، لأنّ الإعطاء یتعلّق بما لیس بحاصلٍ رأساً، و الحفظ بما هو حاصلٌ.
و «صیّرنا» أی: إجعلنا بذلک الدعاء و أدرجنا به «فی درجات الصالحین و مراتب المؤمنین» فی الجنّة.
<و «الدرجات»: جمع دَرَجَة ـ محرّکةً ـ، و هی: المرقاة، و استعیرت للمنزلة الرفیعة المعنویّة>(94)
و «آمین ربّ العالمین» قد تقدّم الکلام علیه فی آخر اللمعة الثانیة عشرة؛ فلیرجع إلیه.
—
و قد وفّقنی اللّه ـ تعالى ـ لاتمام هذه اللمعة فی لیلة العید من ذی الحجّة سنة ثلاثین و مأتین و ألف من الهجرة ـ على مهاجرها آلاف الصلاة و التحیّة ـ.
1) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 187.
2) کریمة 100 یوسف.
3) و انظر: «نور الأنوار» ص 114.
4) کما عن الفیروزابادی: «الرجم:… و رمیٌ بالحجارة»، راجع: «القاموس المحیط» ص 1024القائمة 2.
5) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 188.
6) کریمة 78 البقرة.
7) هذا قریبٌ من قول المحدّث الجزائری، انظر: «نور الأنوار» ص 114.
8) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 190.
9) المصدر: أنا الّذی.
10) المصدر: استخفّهم.
11) المصدر: + من بین.
12) المصدر: بشمت.
13) راجع: «نور الأنوار» ص 115، «الأمالی» ـ للطوسی ـ ص 338 الحدیث 692.
14) و انظر: «شرح الصحیفة» ص 187.
15) لم أعثر علیه، و حکى ابن أثیر عنه ـ رضی اللّه عنه ـ: «أکره أن أجمع على ماهنی مهنتین»،راجع: «النهایة» ج 4 ص 376.
16) کریمة 108 المؤمنون.
17) المصدر: المؤازرة.
18) راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 2 ص 75 الحدیث 1774، «التهذیب» ج 4 ص 191الحدیث 6، «بحار الأنوار» ج 66 ص 380، و انظر: «نور الأنوار» ص 115.
19) لم أعثر علیه منسوباً إلى عبیدة، و العبارة توجد فی «المصباح المنیر» ص 474. و هناک منقولةٌعن أحمد بن عبید فی هذه المادّة لاترتبط بهذه العبارة، راجع: «تاج العروس» ج 3 ص 87القائمة 2، «لسان العرب» ج 2 ص 56 القائمة 2.
20) کریمة 70 القصص.
21) راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 193.
22) هذا قول العلّامة المدنی، راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 194.
23) قارن: نفس المصدر، مع زیادةٍ مّا.
24) کما حکاه المحدّث الجزائری، انظر: «نور الأنوار» ص 115.
25) راجع: «غرر الفوائد» ص 116، وانظر: «الحکمة المتعالیة» ج 1 ص 343.
26) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 195.
27) قارن: «شرح الصحیفة» ص 188، مع تغییرٍ یسیر فی بعض الألفاظ.
28) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 196.
29) قارن: «شرح الصحیفة» نفس الصفحه.
30) راجع: «بحار الأنوار» ج 56 ص 163، ج 67 ص 161.
31) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 197.
32) من النبویّات، انظر: «کشف الأسرار و عدّة الأبرار» ج 1 ص 178، «المغنی عن حملالأسفار» ج 2 ص 366.
33) کریمة 93 البقرة.
34) قارن: «شرح الصحیفة» ص 189.
35) کما حکاه المحقّق الداماد عن أصل نسخة شیخه قبل أن یصلحه باللام، و عن نسخة الشیخ عبدالعالی الکرکی أیضاً، راجع: نفس المصدر ص 190.
36) راجع: «القاموس المحیط» ص 910 القائمة 1.
37) راجع: «الصحیفة» المبارکة، الدعاء 27 القطعة 2 ص 126.
38) کریمة 22 ابراهیم.
39) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 199.
40) راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 4 ص 74 الحدیث 5146، «مستدرک الوسائل» ج 18 ص58 الحدیث 22024، «الإقبال» ص 627.
41) کما قال الفیّومی: «أولع بالشیء ـ بالبناء للمفعول ـ یولع وَلوعاً ـ بفتح الواو ـ: علق به»،راجع: «المصباح المنیر» ص 926.
42) المصدر: ـ انّ.
43) المصدر: جمیعاً.
44) راجع: «صحاح اللغة» ج 3 ص 1304 القائمة 1.
45) کریمة 82 ص.
46) هذا کلام الفیّومی، راجع: «المصباح المنیر» ص 31.
47) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 201.
48) کریمة 6 التحریم.
49) راجع: «القاموس المحیط» ص 887 القائمة 1.
50) کما حکاه الثعلب عن ابن الأعرابیّ، راجع: «المصباح المنیر» ص 158.
51) راجع: «بحار الأنوار» ج 65 ص 223، «کنز العمّال» الحدیث 24895.
52) راجع: «الکافی» ج 2 ص 669 الحدیث 2، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 12 ص 132 الحدیث15855.
53) راجع: «مستدرک الوسائل» ج 8 ص 431 الحدیث 9907، «الخصال» ج 2 ص 554الحدیث 20.
54) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 202.
55) لم أعثر علیه فی مصادر العامّة، و یمکن أن یکون اشارةً إلى هذه القطعة من «الصحیفة»المبارکة.
56) راجع: «النهایة» ج 1 ص 366.
57) راجع: «صحاح اللغة» ج 5 ص 2094 القائمة 1.
58) هذا نصّ عبارة الفیّومی، راجع: «المصباح المنیر» ص 386.
59) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 203.
60) قال ثانی الشهیدین: «و فی الخبر: الوقت سیفٌ»، راجع: «منیة المرید» ص 230.
61) راجع: «القاموس المحیط» مقدّمة المؤلّف، ص 40.
62) راجع: نفس المصدر ص 248 القائمة 2.
63) راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 207.
64) و هو استاذ الشیخ العلّامة الحزین اللاهیجی، و اسم الشرح «ریاض العارفین» أو «روضةالعارفین»، و الشرح لم یطبع بعد. انظر: «الذریعة» ج 13 ص 358.
65) راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 209.
66) قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 209.
67) کریمة 71 الأنعام. و انظر: «شرح الصحیفة» ص 191.
68) قارن: «نور الأنوار» ص 116.
69) هذا مأخوذٌ من قول المحقّق الداماد، انظر: «شرح الصحیفة» ص 191.
70) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 210.
71) و انظر: «التعلیقات» ص 45.
72) المصدر: العقل.
73) راجع: «بحار الأنوار» ج 10 ص 97، «شرح نهج البلاغة» ج 18 ص 185، «عوالی اللئالی»ج 4 ص 99 الحدیث 141.
74) راجع: «بحار الأنوار» ج 54 ص 306.
75) راجع: «بحار الأنوار» ج 18 ص 360، ج 79 ص 243، مع تغییرٍ فی بعض الألفاظ.
76) کریمة 33 الأحزاب.
77) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 211.
78) المصدر: + بن علیّ.
79) راجع: «بحار الأنوار» ج 64 ص 169، «دعائم الإسلام» ج 2 ص 317 الحدیث 1195.
80) هیهنا حذف المصنّف قطعةً من کلام الشیخ.
81) کما حکاه الفیّومی عن الأزهری، راجع: «المصباح المنیر» ص 298.
82) راجع: «بحار الأنوار» ج 11 ص 313، «التفسیر المنسوب إلى الإمام» ص 120، «تفسیرفرات الکوفیّ» ص 170 الحدیث 218، «عیون أخبار الرضا» ج 2 ص 64 الحدیث 282.
83) کریمة 2 الفتح.
84) راجع: «الفتوحات المکّیة» ج 1 ص 196، و المصنّف نقل العبارة من غیر تقییدٍ بألفاظها.
85) المصدر: الأرحام.
86) راجع: نفس المصدر.
87) لم أعثر على البیتین فی «الفتوحات المکّیة»، و لا فی غیره من آثار الشیخ الّذی فحصته.
88) کریمة 40 الأعراف.
89) کریمتان 60 / 61 الواقعة.
90) کریمتان 38 / 39 المعارج.
91) کریمة 62 الواقعة.
92) کما حکاه المحقّق الداماد و العلّامة المدنی، راجع: «شرح الصحیفة» ص 192، «ریاض السالکین» ج 3 ص 214. و المحدّث الجزائری حکاه ناسباً إیّاه إلى نسخة ابن ادریس، انظر:«نور الأنوار» ص 116.
93) راجع: «صحاح اللغة» ج 5 ص 1783 القائمة 1.
94) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 214.