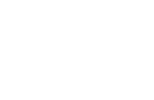بسم اللّه الرحمن الرحیم
و به نستعین
أللّهمّ یا کافی الحزب من الفرید الضعیف، و یا واقی الکرب من الطرید النحیف؛ و الصلاة و السلام على نبیّک الّذی هو أشرف من کلّ شریفٍ، و على آله سیّما وصیّه الّذی هو ألطف من کلّ لطیفٍ.
و بعد؛ فیقول العبد الضعیف المحتاج إلى کفایة مولاه اللطیف، محمّد باقر بن السیّد محمّد: هذه اللمعة الحادیة و العشرون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة ـ على صاحبها صنوف الآلآء و التحیّة ـ.
وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ ـ عَلَیْهِ السَّلاَمُ ـ إِذَا حَزَنَهُ أَمْرٌ وَ أَهَمَّتْهُ الْخَطَایَا.
«الحزن» ـ بالنون ـ: الهمّ، یقال: حزنه الأمر یحزنه حزوناً: أهمّه، هذا لغة قریش. و تمیم تعدّیه بالألف فتقول: أحزنه؛ و علیها روایة: «أحزنه» ـ کما فی بعض النسخ ـ. و فی روایة ابن ادریس بالباء الموحّدة(1)، یقال: حزبه الأمر: أصابه و ألمّ به.
<و «أهمّه» الأمر ـ بالألف ـ: أقفله. و «هَمَّه» همّاً ـ من باب قتل ـ مثله.
و «الخطایا»: جمع خطیئة، اسمٌ من خطىء یخطأ ـ من باب علم ـ: إذا أثم. و أصل «الخطایا»: خطائی ـ على فعائل ـ، فلمّا اجتمعت الهمزتان قلبت الثانیة یاءً ـ لأنّ قبلها کسرةٌ ـ، ثمّ استثقلت و الجمع ثقیلٌ، و هو معتلٌ مع ذلک، فقلبت الیاء ألفاً ثمّ قلبت الهمزة الأولى یاءً ـ لخفائها بین الألفین ـ>(2)
اللَّهُمَّ یَا کَافِیَ الْفَرْدِ الضَّعِیفِ، وَ وَاقِیَ الاَمْرِ الْمَخُوفِ، أَفْرَدَتْنِی الْخَطَایَا فَلاَصَاحِبَ مَعِی، وَ ضَعُفْتُ عَنْ غَضَبِکَ فَلاَمُوَیِّدَ لِی، وَ أَشْرَفْتُ عَلَى خَوْفِ لِقَائِکَ فَلاَمُسَکِّنَ لِرَوْعَتِی. وَ مَنْ یُوْمِنُنِی مِنْکَ وَ أَنْتَ أَخَفْتَنِی؟ وَ مَنْ یُسَاعِدُنِی وَ أَنْتَ أَفْرَدْتَنِی؟ وَ مَنْ یُقَوِّینِی وَ أَنْتَ أَضْعَفْتَنِی؟
قیل: «أللّهمّ بتقدیر یا اللّه، فـ «یا کافی الفرد» بدلٌ عنه أو بیانٌ له؛ یعنی: أنت تکفی جمیع مهمّات الفرید الوحید الضعیف، و لاتحتاج فی کفایة مهمّه إلى غیرک؛ أو تخصیصٌ بعد التعمیم ـ کأنّه قال: یا مستجمع الکمالات ـ، ثمّ خصّصه من بین الکمالات بکفایة الهمّ لتمهید ما بعده ـ و هو قوله علیه السلام: «أفردَتْنی الخطایا ـ… إلى آخره ـ، فخلّصنی»؛ انتهى.
و هو بعیدٌ!؛ فالأولى انّ «کفى» یکون بمعنى: أجزأ و أغنى، و المعنى: یا مجزیه و مغنیه عن کلّ صاحبٍ و مؤیّدٍ.
و «الفرد»: الواحد.
و «الضعیف»: خلاف القویّ، لاخلاف الصحّة من الضعف.
و «الوقایة»: الحفظ و الصیانة. و الإضافة إمّا بتقدیر «من» ـ أی: یا واقیاً من الأمر المخوف، مأخوذٌ من وقیته: إذا صنته ـ ؛ و إمّا إضافةً إلى أحد مفعولی الفعل، من وقیته الشرّ أی: کفیته إیّاه ـ و هو المفعول الثانی ـ، و التقدیر: و واقی العباد الأمر المخوف، فحذف المفعول الأوّل للعلم به.
و «أفردته» إفراداً: صیّرته فرداً؛ و «الفاء» للسببیّة، أی: فبسبب ذلک «لاصاحب معی». و قس علیه مابعده، کأنّه قطع أسباب السماوات و الأرضین عنّی بسبب ذلک، <فلاصاحب معی من المؤمنین؛
و قیل: «من الملائکة الکاتبین»؛
و قیل: «من التوفیقات الربّانیّة»؛
و قیل: «معناه: انّی صرت بسبب الخطایا متفرّداً غیر مصاحبٍ لأحدٍ مشتغلاً بالتفکّر فی أمرها و لاصاحب معی مثلی فی الخطایا ـ من قبیل قوله علیه السلام: أنا الّذی أوقرت الخطایا ظهره»(3) ـ»>(4)
و قیل: «معناه: انّه انفرد بحسب الذنوب عن صالحی الأصحاب فلاصاحب له من الصلحاء الأخیار، لأنّ المطلوب الصاحب الصالح لا مطلق الصاحب»(5)
و لایخفى بعد بعضها و أبعدیّة بعضٍ آخر!.
و «الضعف»: العجز.
<و «الأید»: القوّة، من: أدّ یإید أیداً: إذا قوى و اشتدّ>(6)؛ <أی: عجزت عن تحمّل غضبک فلاتورده علیَّ؛ أو: انّی ضعفت عن استمرار ما حملتنیه منه فارفعه عنّی.
و قیل: «المراد: ضعفت من خوف غضبک»؛
و هو قریبٌ من الأوّل>(4)
و قیل: «یعنی: لیس لی طاقة حمل غضبک، لأنّ غضب الحلیم أشدّ!»؛
و هو أیضاً یرجع إلى الأوّل، بل عینه.
و «أشرف» على الشیء إشرافاً: اطّلع علیه. قال السیّد السند الداماد(7) ـ و تبعه الفاضل
القاسانی(8) ـ: «معناه: أشرفت على خوف لقائک مع أنّ لقاءک أعظم لذّةً مبتغاةً أبغیها و أبهج
سعادةً متوخّاةً أتوخّاها».
و قیل: «أشرفت أی: اطّلعت على الخوف من ملاقاتک، یعنی: أنا مشرفٌ بالموت و خائفٌ ـ لأنّه لیس لی عملٌ صالحٌ ترجى معه النجاة ـ».
و قال الفاضل التستریّ: «و الأظهر فی نظری انّه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف(9)، أی: قرّبت و صرت مشرفاً على لقائک المخوّف الّذی أوّله الموت»(10)
و قال الفاضل الشارح: «و المراد بـ «لقائه» ـ تعالى ـ: المصیر و البعث إلیه و الوقوف بین یدیه، و بـ «خوفه»: خوف موته ـ أی: خوف سوء لقائک ـ»(11)
أقول: و لایخفى انّ بعض هذه الوجوه منافٍ للعصمة! و بعضها لایخلو من رکاکةٍ!. فالمراد من «الخوف»: خوف احتراق الأنّیّة بالمرّة من أشعّة شمس الحقیقة عند الملاقات و المقارنة، کما یشاهد عند مقارنة الکواکب النیّرة عن شمس الظاهریّة.
و «الروع»: الفزع و الخوف؛ و «تسکین الروع» عبارةٌ عن ازالة الخوف.
و «الواو» من قوله – علیه السلام ـ: «و مَن یؤمننی» استینافیّةٌ؛ و مِن «أنت أخفتنی» حالیّةٌ؛ و «من» للاستفهام الإنکاریّ، أی: لایجعلنی أحدٌ مأموناً منک و الحال انّک أنت الّذی جعلتنی خائفاً.
<قیل: «إخافته ـ تعالى ـ هو ما تضمّنته آیات الوعید، کما قال ـ سبحانه ـ: (ذَلِکَ یُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ یَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ)(12)؛
و هو محتملٌ، غیر انّ الظاهر انّ اسناد کلٍّ من «الإخافة» و «الإفراد» و «الإضعاف» إلیه
ـ سبحانه ـ من باب الفناء(13) عن ملاحظة الوسائط و مشاهدة الأفعال و الترقّی عن مقام الصفات إلى ملاحظة الوسائط و الأفعال و الصفات، ثمّ أعرض عن ذلک و قطع النظر عنه و استأنف راغباً إلى الذات فقال: «من یؤمننی منک و أنت أخفتنی». و نظیر ذلک ما ورد فی الدعاء النبویّ: «و أعوذ بک منک»(14)، و فی الکلام العلویّ: «و فرّوا إلى اللّه من اللّه»(15)>(16)
قال بعض العارفین: «اعلم! أنّ فرار العبد إلى اللّه ـ تعالى ـ على مراتب؛
فأولیها: الفرار من بعض آثاره إلى بعضٍ ـ کالفرار من أثر غضبه إلى أثر رحمته، کما قال تعالى عن المؤمنین فی التضرّع إلیه: (رَبَّنَا وَ لاَتُحَمِّلنَا مَا لاَطَاقَةَ لَنَا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا)(17)… الآیة ـ. فکأنّهم لم یروا إلّا اللّه ـ تعالى ـ و أفعاله ففرّوا من بعضها إلى بعضٍ؛
الثانیة: أن یغنی العبد عن مشاهدة الأفعال و یترقّی فی درجات القرب و المعرفة إلى مصادر الأفعال ـ و هی الصفات ـ، فیفرّ من بعضها إلى بعضٍ ـ کما ورد عن زین العابدین علیه السلام: «أللّهمّ اجعلنی أسوة من قد انهضته بتجاوزک عن مصارع الخاطئین، و خلّصته بتوفیقک من ورطات المجرمین، فأصبح طلیق عفوک من اسر سخطک»(18)، و «السخط» و «العفو» صفتان فاستعاذ بإحدیهما من الأخرى؛
الثالثة: أن یترقّى عن مقام الصفات إلى ملاحظة الذات فیفرّ منها إلیها ـ کقوله تعالى: (لاَمَلْجَأَ مِنَ آللَّهِ إِلاَّ إِلَیْهِ)(19)، و کالوارد فی الدعاء فی القیام إلى الصلاة: «منک و بک و لک و
إلیک»(20) أی: منک بدو الوجود و بک قیامه و لک ملکه و إلیک رجوعه ـ، ثمّ أکّد ذلک بقوله: «لاملجأ و لامنجى و لامفرّ منک إلّا إلیک». و قد جمع الرسول صلّى اللّه علیه و آله و سلّم هذه المراتب حتّى أمر بالقرب فی قوله تعالى: (وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ)(21)، فقال فی سجوده: «أعوذ بعفوک من عقابک و أعوذ برضاک من سخطک و أعوذ بک منک»(22)، فاستعاذ أوّلاً ببعض أفعاله من بعضٍ، ثمّ ترقّى إلى مصادرها فاستعاذ ببعض صفاته من بعضٍ، ثمّ ترقّى إلى ملاحظة الذات فاستعاذ بها منها؛ فهذه ثلاث مراتب للفرار إلى اللّه ـ تعالى ـ. و المرتبة الثالثة هی أوّل مقام الوصول إلى ساحل العزّة؛ ثمّ للسباحة فی لجّة الوصول درجاتٌ لاتتناهى؛ و اللّه أعلم»؛ انتهى کلامه.
لاَیُجِیرُ ـ یَا إِلَهِی ـ إِلاَّ رَبٌّ عَلَى مَرْبُوبٍ، وَ لاَیُوْمِنُ إِلاَّ غَالِبٌ عَلَى مَغْلُوبٍ، وَ لاَ یُعِینُ إِلاَّ طَالِبٌ عَلَى مَطْلُوبٍ. وَ بِیَدِکَ ـ یَا إِلَهِی! ـ جَمِیعُ ذَلِکَ السَّبَبِ، وَ إِلَیْکَ الْمَفَرُّ وَ الْمَهْرَبُ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَجِرْ هَرَبِی، وَ أَنْجِحْ مَطْلَبِی.
«لایجیر» أی: لاینفذ و لایغیث، من: أجرت فلاناً علی فلانٍ: إذا اغثته منه و منعته عنه. قال الفاضل الشارح: «على تفید الاستعلاء و القدرة و التسلّط کأنّه أغاثه و منعه منه قادراً على کفّه عنه متسلّطاً علیه فی المنع منه. و المستثنى فی الفقرات الثلاث ما بعد إلّا و الظرف جمیعاً، فانّ الحصر فی کلٍّ منهما مقصودٌ ـ أی: لایجیر أحدٌ على أحدٍ إلّا ربٌّ على مربوبٍ ـ، و قس علیه مابعده.
و فیه شاهدٌ لمن أجاز استثناء شیئین من شیئین بأداةٍ واحدةٍ بلاعطفٍ مطلقاً ـ سواءٌ کان المستثنى منهما مذکورین أو مقدّرین ـ ؛ و مثله فی التنزیل: (وَ مَا نَرَاکَ اتَّبَعَکَ إِلاَّ الَّذِینَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِیَ الرَّأْیِ)(23)، إذ التقدیر: و ما نراک اتّبعک أحدٌ فی حالةٍ إلّا أراذلنا فی بادىء الرأی.و قال المانعون: المستثنى انّما هو الأوّل، و الثانی معمولٌ لمحذوفٍ، و التقدیر فی الآیة: اتّبعوک فی بادىء الرأی. و على هذا فالظرف فی الدعاء متعلّقٌ بمحذوفٍ، و التقدیر: لایجیر إلّا ربٌّ یجیر على مربوبٍ.
و قال بعضهم: «انّ الظرف یتّسع فیه فیجوز فیه مالایجوز فی غیره، فجاز تعلّقه بما قبل «إلّا» و إن لم یجز عمل ما قبلها إذا تمّ فیما بعدها فی غیر الظرف».
و ممّا لایکاد یقضی منه العجب قول بعض الشارحین المترجمین هنا: «انّ قوله: «على مربوبٍ» متعلّقٍ بـ «قادرٍ» مقدّرٍ و نحوه، لأنّ تعدیة «أجار» بـ «على» غیر مذکورٍ فی کتب اللغة»؛ انتهى.
و کأنّه لم یسمع قوله ـ تعالى ـ: (قُلْ مَنْ بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَ هُوَ یُجِیرُ وَ لاَیُجَارُ عَلَیهِ اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)(24) نسأل اللّه الهدایة إلى سواء السبیل!»(25)
و قیل: «بیان الشارح و غیره من المحشّین و المترجمین هنا خارجٌ عن الصواب، بل لفظة «على» فی المواضع الثلاثة من قبیل قولک: أجرنی و أمنّی و أعنّی على عدوّی؛ و فی التنزیل: (وَ هُوَ یُجِیرُ وَ لاَیُجَارُ عَلَیهِ)، أی: لایجیر أحدٌ أحداً على أحدٍ إلّا الربّ، فانّه یجیر الخائف على مربوبه.
و على هذا القیاس جملة: «و لایؤمن… و لایعین…». و اللّه ـ تعالى ـ هو الطالب لعباده و مدرکهم إن هربوا؛ و منه یقال: «انّه الطالب الغالب و العبد مطلوبٌ و هاربٌ»؛ و فی دعاء
الرهبة: «أللّهمّ انّک طالبنی إن أنا هربت و مدرکی إن أنا فررت»(26) و روی انّه سئل ربیع بن خثیم: «لم لاتنام باللیل؟
قال: لأنّی مطلوبٌ».
و المراد: انّ ماسواه من الإجارة و الإعانة و الإیمان فلااعتناء بها و ما أضعف أثرها؛ أو الحصر إضافیٌّ بالنظر إلى العکس ـ و هو أن یجیر المربوب مثلاً على الربّ ـ، فالمقصود: لایجیرنی أحدٌ و أنا المربوب علیک و أنت الربّ، بل إنّما یجیر علیّ؛ و هذا بعینه مضمون قوله ـ تعالى ـ: (وَ هُوَ یُجِیرُ وَ لاَیُجَارُ عَلَیهِ)(24) و هکذا باقی الجمل.
و قال السیّد السند الداماد ـ رحمه اللّه ـ: «معنى قوله – علیه السلام ـ: «لایجیر یا إلهی إلّا ربٌّ على مربوبٍ»: انّه لایمضی و لاینفذ إلّا خفارة ربٍّ(27) على مربوبٍ، فإذا أجار ربٌّ أحداً و خفره فلایکون لمربوبٍ من مربوبیه أن ینقض علیه خفارته و أمانه؛ و منه الحدیث: «و یجیر علیهم أدناهم»(28)، أی: إذا أجار أدنى رجلٍ(29) من المسلمین کافراً أو أمّنه جار ذلک على جمیع المسلمین لاینقض أحدٌ علیه جواره(30) -(31)
و قوله – علیه السلام ـ: «و لایؤمن إلّا غالبٌ على مغلوبٍ» أی: <لاینفذ إلّا أمان الغالب على المغلوب، فاذا أمن غالبٌ أحداً فلایکون لأحدٍ من مغلوبیه أن ینقض و یردّ علیه أمانه>(32)
و قوله – علیه السلام ـ: «و لایعین إلّا طالبٌ على مطلوبٍ» من أعانه على کذا أی: سلّطه علیه. و ملخّص المعنى: انّ الطلب سبب التسلّط على المطلوب، لأنّ الدعاء من أسباب حصول البغیة و نیلها»(33)؛ انتهى کلامه.
و هذا کما ترى!؛ و لعلّ لفظ «الدعاء» – من طغیان القلم ـ وقع موضع «الطلب»(34)،
فقصده أن یبیّن التقریب فی إطلاق الطالب على الله ـ تعالى ـ بمعنى: الغالب و المتسلّط بانّ الطلب من أسباب حصول البغیة.
و قد یتوهّم: «انّه أراد انّ الطالب بعین نفسه، و یسلّطها على مطلوبه و مقصوده بالدعاء و الالتجاء إلى اللّه ـ تعالى ـ ؛
و لایخفى تکلّفه و سماجته و مخالفته للفقرتین السابقتین!»؛ انتهى کلامه.
أقول: لایخفى ما فی کلامه من الفساد و الخبط!، بل فی کلامهم أیضاً؛ فتأمّل تفهم!.
و تحقیق هذا الفصل من الدعاء: انّ المستفادّ من أقوال کبراء الحکماء و القدماء هو انّ لکلّ موجودٍ من موجودات هذه النشأة الدنیاویّة من الجواهر و الأعراض ـ حتّى الحرکات و السکنات و الهیئات و الطعوم و الروائح ـ له صورةٌ فی النشأة الوسطى متقدّمةً علیه فی الوجود، و له حقیقةٌ فی النشأة العلیا متقدّمةً على کلتیهما، بل کلّ ما فی هذا العالم الأدنى ـ من الذرّات و الهیئات و النسب و الأشکال و الترتیبات الجسمانیّة و النفسانیّة ـ ظلالٌ و رسومٌ و تمثالاتٌ لما فی العالم الأعلى من الذوات الروحانیّة، و الهیئات العقلیّة و النسب المعنویّة انّما تنزّلت و تکدّرت و تجرّمت بعد ما کانت نقیّةً صافیةً مقدّسةً عن النقص و الشین مجرّدةً عن الکدورة و الرین متعالیةً عن الآفة و القصور منزّهةً عن الهلاک و الدثور، بل جمیع صور الکائنات و ذوات المبدعات آثارٌ و أنوارٌ للوجود الحقیقیّ و النور القیّومیّ، و هو منبع الجمال
المطلق و الجلال الأتمّ الألیق الّذی صور المعاشیق و حسن الموجودات الروحانیّة و الجسمانیّة قطرةٌ بالنسبة إلى بحر ذلک الجمال و ذرّةٌ بالقیاس إلى شمس تلک العظمة و الجلال. و لولا أنواره و أضواؤه فی صور الموجودات الظاهریّة لم یمکن الوصول إلى نور الأنوار الّذی هو الوجود المطلق الإلهیّ.
و لکلٍّ من الثلاث طبقاتٌ متفاوتةٌ مترتّبةٌ، فالإنسان العقلیّ مثلاً إنّما یفیض بنوره على هذا الإنسان السفلیّ و هو ربّه، و تمامه و کماله بوسائط مترتّبةٍ فی العوالم العقلیّة و المثالیّة کلّها أناس متفاوتوا المراتب و النشئات؛ و کذلک بین النار العقلیّة و النار السفلیّة نیراناتٌ مترتّبةٌ، و لهذا ورد فی الحدیث: «إنّ هذه النار غسلت بسبعین ماءً ثمّ أنزلت»(35)، إشارةً إلى تنزّل مرتبتها من کمال حقیقتها الناریّة و تضعّف تأثیرها و تنقّص جوهرها على حسب کلّ نزولٍ. و من هنا قال بعض متألّهة الحکماء: «انّ هذه الحسائس عقولٌ ضعیفةٌ و تلک العقول حسائس قویّةٌ»(36)
فلکلٍّ من الموجودات الحسّیّة ربٌّ ملکوتیٌّ فی العقول المجرّدة، سیّما للإنسان الّذی هو أشرف الأنواع الکونیّة. فهو الّذی یدبّره و یکون هو تحت حیطة تصرّفه، و الإجارة و الأمان و الإعانة مفوّضٌ إلى هذا الربّ العقلیّ.
ثمّ هذا الربّ العقلیّ نورٌ من أنوار الوجود الحقیقیّ و النور القیّومیّ الإلهیّ.
و هو المراد بقوله – علیه السلام ـ: «و بیدک ـ یا إلهی! ـ جمیع ذلک السبب و إلیک المفرّ و المهرب»، لأنّ الکلّ ینتهی إلیک. و هما مصدران میمیّان بمعنىً، و عطف الثانی على الأوّل من عطف الشیء على مرادفه. قال الزجّاج: «المفَرّ بالفتح: الفرار، و بالکسر: موضع الفرار، و یحتمل بالفتح موضع الفرار أیضاً»(37)
و لمّا کانت الحقیقة المحمّدیّة مظهر المرتبة الجمعیّة الإلهیّة و قلنا انّ الکلّ ینتهی إلى المرتبة الإلهیّة فبالحقیقة الکلّ ینتهی إلیها، فلذا طلب الصلاة على محمّدٍ و آله و الإجارة لهربه و الانجاح لمطلبه؛ فتأمّل تفهم!.
قوله – علیه السلام ـ: «و أجر هرَبی» بفتح الراء، کما وقع فی قوله ـ تعالى ـ: (وَ لَنْ نَعْجِزَهُ هَرَباً)(38) و سکون «الراء» غلطٌ. و إیقاع «الإجارة» على «الهرب» مجازٌ عقلیٌّ، فانّ الإجارة انّما تکون للهارب لا للهرب، ولکن جعلها للهرب لتلبّسه به.
و «أنجح مطلبی» أی: حصّل مقصدی و اقض حاجتی؛ فی القاموس: «النَجاح ـ بالفتح ـ و النُجح ـ بالضمّ ـ: الظفر بالشیء»(39)
اللَّهُمَّ إِنَّکَ إِنْ صَرَفْتَ عَنِّی وَجْهَکَ الْکَرِیمَ أَوْ مَنَعْتَنِی فَضْلَکَ الْجَسِیمَ أَوْ حَظَرْتَ عَلَیَّ رِزْقَکَ أَوْ قَطَعْتَ عَنِّی سَبَبَکَ لَمْ أَجِدِ السَّبِیلَ إِلَى شَیْءٍ مِنْ أَمَلِی غَیْرَکَ، وَ لَمْ أَقْدِرْ عَلَى مَا عِنْدَکَ بِمَعُونَةِ سِوَاکَ، فَإِنِّی عَبْدُکَ وَ فِی قَبْضَتِکَ، نَاصِیَتِی بِیَدِکَ. لاَأَمْرَ لِی مَعَ أَمْرِکَ، مَاضٍ فِیَّ حُکْمُکَ، عَدْلٌ فِیَّ قَضَاوُکَ، وَ لاَقُوَّةَ لِی عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ سُلْطَانِکَ، وَ لاَأَسْتَطِیعُ مُجَاوَزَةَ قُدْرَتِکَ، وَ لاَأَسْتَمِیلُ هَوَاکَ، وَ لاَأَبْلُغُ رِضَاکَ، وَ لاَأَنَالُ مَا عِنْدَکَ إِلاَّ بِطَاعَتِکَ وَ بِفَضْلِ رَحْمَتِکَ.
قال الفاضل الشارح: «صرَفَه صرْفاً ـ من باب ضرب ـ: ردّه و قلّبه. و «صرف الوجه» فی من یجوز علیه ذلک کنایةٌ عن الاستهانة والسخط، لأنّ من أکرم إنساناً و رضی عنه أقبل بوجهه علیه، و من استهان به و سخط علیه صرف وجهه عنه. ثمّ کثر و اشتهر حتّى صار الإقبال عبارةً عن الإکرام و الإحسان، و صرف الوجه عبارةً من الاستهانة و السخط و إن
لم یکن ثَمّ إقبالٌ و لاصرفٌ. ثمّ جاء فیمن یجوز علیه ذلک مجرّداً، فجاء الإقبال بمعنى: الرضاء و الإحسان فی نحو: «و أقبل علیَّ بوجهک ذی الجلال و الإکرام»(40)، و صرف الوجه بمعنى:
الاستهانة و السخط ـ کما فی عبارة الدعاء ـ. و کلاهما مجازٌ عمّا وقعا کنایةً عنه فیمن یجوز علیه الإقبال و الصرف.
هکذا حقّقه الزمخشریّ فی نظیر هذه العبارة(41) و هو تصریحٌ منه بأنّ الکنایة یعتبر فیها صلوح إرادة الحقیقة و إن لم ترد، و أنّ الکنایات قد تشتهر حتّى لاتبقى تلک الجهة ملحوظةً، و حینئذٍ تلحق بالمجاز. و لایجعل مجازاً إلّا بعد الشهرة، لأنّ جهة الانتقال إلى المعنى المجازیّ أوّلاً لا غیر واضحةٍ بخلاف المکنّى عنه.
و استشکل بما ذکره فی قوله ـ تعالى ـ: (بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ)(42)، و: (السَّمَاوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِهِ)(43)، و: (الرَّحمَنُ عَلَى الْعَرشِ اسْتَوَى)(44) ـ و نحو ذلک ـ: انّها کلّها کنایاتٌ مع امتناع المعنى الحقیقیّ قطعاً.
و أجاب صاحب الکشّاف بـ: انّه لمّا کان هذا المجاز متفرّعاً عن الکنایة جاز أن یسمّى مجازاً و أن یسمّى کنایةً»(45)؛ انتهى کلامه.
هذا تحقیقٌ ظاهریٌّ لاطائل تحته!.
و قیل: «المراد من «وجهک»: ذاتک»؛
و قیل: «بابک الّذی تؤتى منه، و هو الطاعات و العبادات»؛
و قیل: «المراد به جهة الکرم، أو جهة القهر و الغضب».
هذا ما قیل فی هذا المقام؛ و هو ـ کما ترى ـ لایسمن و لایغنی من جوعٍ!.
و التحقیق انّ الوجه هنا مستعملٌ فی معناه الحقیقیّ، لما عرفت فیما سبق من أنّ الممکن زوجٌ ترکیبیٌّ من الوجود و المهیّة، فله وجهان: وجهٌ إلى موجده و خالقه، و وجهٌ إلى نفسه و ذاته؛ و الأوّل بالکمال و الوجوب، و الثانی بالنقص و الإمکان؛ و الأوّل موجبٌ لبقائه و دوامه، و الثانی لهلاکه و فساده؛ و بالأوّل یتقرّب الأشیاء إلى اللّه و یتوجّهن نحوه، و بالثانی یتبعّدن عنه و یتخلّفن عن الوصول إلیه. و قد عرفت سابقاً أیضاً انّ الکمال و الجمال من الأوّل و عدمهما من الثانی؛ و انّ کمال کلّ شیءٍ بحسب نحو وجوده ـ من لدن العقل الأوّل إلى الهیولی الأولى ـ، فما کان نحو وجوده أشدّ و أقوى کان کماله اللائق به أتمّ و أحرى، و انّ کمال الإنسان من بین سائر الأکوان منوطٌ بمعرفة علّة عالم الإمکان و خالق الإنس و الجان ـ کما فی قوله تعالى: (وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الاِنسَ إِلاَّ لِیَعبُدُونِ)(46) ـ. و هی وجهه الّذی یوجب بقاءه الأخرویّ و سعادته السرمدیّة. و لکن قواطع طریق معرفته و أسباب وقوع ظلالته أکثر من أن تحصى! لمزیّته على سائر الأشیاء بتطوّره فی الأطوار و عدم وقوفه على طورٍ واحدٍ و مرتبة جامعیّته و خلافته ـ کما تقدّم الکلام علیه مستوفىً ـ.
و قد عرفت فیما سبق أیضاً معنى «الرزق» و «العبودیّة»، و انّ وجودات الممکنات عین التعلّق و الربط و انّ کلّ ما وقع و لم یقع غیر خارجٍ عن عالم قضائه و قدره، و انّ القرب بالحضرة الأحدیّة لایکون إلّا بالمعرفة و العبادة؛ و ذلک لایکون إلّا بالتوفیق و الفضل و الرحمة.
فاذا تذکّرت هذه الأمور المذکورة قدرت على فهم هذه الفقرات من الأدعیّة؛ و قد أعرضنا عن تفصیلها فی هذا المقام خوفاً للتکرار و الإطالة.
و «أللّهمّ إنّک إن صرفت» شرطٌ، و جزاؤه قوله – علیه السلام ـ: «لم أجد».
و «الجسیم» فی الأصل: العظم فی الجسم، ثمّ استعمل فی المعانی.
و «النِعمة» بالکسر: ما یتنعّم به ـ کما فی قوله تعالى: (وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ)(47) ـ، و بالفتح: التنعّم ـ قال اللّه تعالى: (أُولِی النَّعمَةِ)(48) ـ ؛ و المراد هنا الأوّل.
<و «حظرت» ـ بالحاء المهملة و الظاء المعجمة ـ أی: منعت، قال اللّه ـ تعالى ـ: (وَ مَا کَانَ عَطَاءُ رَبِّکَ مَحْظُوراً)(49) أی: ممنوعاً. قال فی النهایة: «و کثیراً مّا یرد فی الحدیث ذکر «المحظور» و یراد به الحرام، و قد حظرت الشیء: إذا حرّمته، و هو راجعٌ إلى المنع»(50) و قال الجوهریّ: «الحظر(51) هو خلاف الإباحة، و المحظور: المحرّم»(52)
و ما وقع فی بعض التعالیق من انّ الحظْر ـ بالتسکین ـ بمعنى: المنع و أمّا الحظَر بمعنى ضدّ الإباحة فبالتحریک(53)؛
لا أصل له!، بل هو بالمعنیین بالسکون لم یفرّق بینهما أحدٌ، کیف و أحد المعنیین أصل الآخر!>(54) و النسخة الّتی هی بالخاء المعجمة و الطاء المهملة(55) لااعتبار بها هنا.
و «سببک»: واحد الأسباب؛ و هی فی اللغة: الحبل(56)، ثمّ استعیر لکلّ ما یتوصّل به إلى المطلوب، أی: اقطع عنّی حبل رجائی. و یحتمل أن یکون المراد به جمیع ما یتوصّل به إلى قربه ـ تعالى ـ.
و المراد بـ «السبیل» هنا: الوسیلة الّتی بینه و بین اللّه ـ تعالى ـ.
و «الأمل» بمعنى: المأمول ـ کاللفظ بمعنى: الملفوظ ـ.
<و «غیر» أداة الاستثناء بمعنى: إلّا، و نصبها على الاستثناء. و حینئذٍ فالمفعول الثانی لـ «أجد» محذوفٌ؛ أو على البدل من المستثنى منه ـ و هو «السبیل» ـ، لأنّها تعرب إعراب الاسم التالی لـ «إلّا».
و قیل: «انّ(57) الفتحة فیها فتحة بناءٍ، لاضافتها إلى المبنیّ»>(58)
<و یجوز أن یکون «غیرک» بمعنى: مغایرک، فیکون مفعولاً ثانیاً لأجد. و أمّا جعلها صقة «السبیل» ـ مثلها فی (غَیرِ الْمَغضُوبِ عَلَیهِمْ)(59)، کما قاله بعضهم ـ فغیر جیّدٍ، لأنّ الّذی حسّنه هناک أمران: جنسیّة ما قبلها حتّى کأنّه نکرةٌ؛ و اشتهار مابعدها بضدّیّته ـ کقولک: الحرکة غیر السکون ـ ؛ و الثانی غیر موجودٍ هنا>(4)
و «قدرت» على الشیء: قویت علیه و تمکّنت منه.
و «المعونة»: اسمٌ من أعانه، أی: ساعده.
و «السَواء» ـ بالأوجه الثلاثة ـ بمعنى: الغیر، أی: لم یمکننی أخذ ما عندک بمعونة أحدٍ غیرک.
و «الفاء» بمعنى: «لام» التعلیل، أی: لأنّی عبدک و فی قبضتک ـ أی: فی قبضة قدرتک ـ ؛ و هذا کما فی قوله ـ تعالى ـ: (وَ الاْرضُ جَمِیعاً قَبضَتُهُ یَومَ الْقِیَامَةِ وَ السَّمَاوَاتُ مَطوِیَّاتٌ بِیَمِینِهِ)(43)، حیث لاتوهّم هناک یدٌ و لاقبضةٌ.
قال الشیخ صدرالدین القونویّ: «إنّ الیدین اللتین أعطى بهما آدم هما المسمّیان فی القرآن بالقبضة فی قوله ـ تعالى ـ: (وَ الاْرضُ جَمِیعاً قَبضَتُهُ)، و فی الحدیث المتّفق على صحّته بـ «الشمال»، و لهذا عبّر فی الآیة بـ «الیمین» حیث قال: (وَ السَّمَاوَاتُ مَطوِیَّاتٌ
بِیَمِینِهِ)، فالمقبوض بالقبضة ـ المسمّاة بالشمال – عالم العناصر و ما ترکّب و تولّد منهما. و من ذلک صورة آدم العنصریّ، فانّها نتیجة القبضة المذکورة و ظاهرةٌ بصفتها، بخلاف بقیّة آدم ممّا هو خارجٌ عن نشأته العنصریّة».
و قال أیضاً: «کما انّ للإنسان یمیناً و یساراً ظاهرتین ـ و هما یداه المحسوستان ـ فکدا له یمینٌ و یسارٌ باطنیّان ـ و هما روحانیّةٌ و طبیعیّةٌ ـ. و لمّا کانت السماوات محلّ الأرواح و الیمین أقوى من الیسار نسب السماوات إلى الیمین و أضاف الأرض و ما فیها من الصور الطبیعیّة إلى الید الأخرى، و کنّى عنها بالقبضة»(60)؛ انتهى کلامه.
أقول: الیدان لهما حقیقةٌ واحدةٌ یعبّر عنها فی کلّ عالمٍ بشیءٍ، ففی العالم الإلهیّ بالجمال و الجلال، و فی العالم الإمکانیّ بالمجرّد و المادّی و السماء و الأرض و الإیمان و الکفر. کما مرّ مراراً من أنّ لکلّ معنىً من المعانی حقیقةً و روحاً، و له صورة و قوالب، و انّه قد یتعدّد الصور و القوالب لحقیقةٍ واحدةٍ بحسب العوالم المتعدّدة.
و «الناصیة»: شعر مقدّم الرأس؛ قال الطبرسیّ: «سمّی شعر مقدّم الرأس ناصیةً لاتّصاله بالرأس، من قولهم: ناصى یناصی مناصاةً: إذا وصل»(61)؛ و قال الأزهریّ: «الناصیة عند العرب منبت الشعر فی مقدّم الرأس، لا الشعر. و إنّما تسمّیه العامّة باسم منبته»(62)؛ انتهى.
فاستعمال «الناصیة» فی شعر مقدّم الرأس من قبیل تسمیة الشیء باسم محلّه. و على أیّ تقدیرٍ فهنا تجوّزٌ عن العجز و نهایة التذلّل، لأنّ الشخص إذا کان شعر مقدّم رأسه فی ید غیره کان عاجزاً مسخّراً لذلک الغیر، و کان العرب إذا أسروا الأسیر فأرادوا إطلاقه و المنّ علیه جرّوا ناصیته، فکان علامةً لقهره. فکأنّه – علیه السلام ـ کنّى عمّا هو ملاک الذات و
قوام الهویّة بـ «الناصیة». بل المراد بالناصیة هو الفیض الإنبساطیّ و الحقّ المخلوق به الساری فی جمیع الموجودات الأمریّة و الخلقیّة، و هو الّذی یعبّر عنه بالصراط المستقیم؛ فتدبّر تفهم!.
قوله – علیه السلام ـ: «لا أمر لی مع أمرک»، قیل: «أی: لا أمر لی یخالف إرادتک و أمرک أو یوافقه إذا کنت أنت الآمر؛ أو: لا أمر لی بحیث أکون مستقلّاً بأسبابه»(63)؛
و قیل: «معناه: إذا تعارض الحکمان فحکم العبد مضمحلٌّ فی جنب حکم اللّه و إن کان للعبد اختیارٌ فی الجملة، لکن هذا إذا لم یتعلّق إرادة اللّه الحتمیّة على خلاف مراد العبد؛ کما قال المحقّق الطوسیّ فی التجرید: «فإذا تعلّقت الإرادتان على أمرٍ وقع مراد اللّه»(64)
قال الفاضل الشارح: «و یحتمل أن یراد بالأمر المنفیّ مایریده من الأمور، و بأمره ـ تعالى ـ خلاف النهی؛ و هو ظاهرٌ»(65)؛ انتهى.
أقول: هذا ما ذکروه فی هذا المقام. و التحقیق الکاشف عن نقاب المرام هو انّه قد عرفت فیما سبق من الکلام انّ الممکنات فاقرات الذوات متعلّقة الهویّات إلى جاعل المهیّات ـ بل الفقر عین ذواتهم و اللاشیئیّة نفس هویّاتهم! ـ، و انّ الموجودات على تفاوتها و ترتیبها فی الشرف الوجودیّ و تخالفها فی الذوات و الأفعال و تباینها فی الصفات و الآثار تجمعها حقیقةٌ واحدةٌ إلهیّةٌ جامعةٌ لجمیع حقائقها و درجاتها و طبقاتها. و مع أنّ تلک الحقیقة فی غایة البساطة و الأحدیّة تنفذ نورها فی أقطار جمیع الموجودات من السماوات و الأرضین، و لاذرّة من ذرّات أکوان الوجودیّة إلّا و نور الأنوار محیطٌ بها قاهرٌ علیها، و هو قائمٌ على کلّ نفسٍ بما کسبت؛ بل لیست الموجودات إلّا شؤونه و أطواره.
فاذن کما انّه لیس شأنٌ إلّا شأنه فکذلک لیس فعلٌ إلّا فعله و لا أمرٌ إلّا و هو أمره، و لا
حکم إلّا و هو حکمه.، و «لا حول و لا قوّة إلّا باللّه العلیّ العظیم» یعنی کلّ حولٍ حوله و کلّ قوّةٍ قوّته مع علوّه و عظمته، فهو مع علوّه ینزل منازل الأشیاء و یفعل فعلها، کما انّه مع تجرّده و تقدّسه عن جمیع الأکوان لایخلو منه أرضٌ و لاسماءٌ ـ کما قال إمام الموحّدین علیّ بن أبی طالبٍ – علیه السلام: «مع کلّ شیءٍ لابمقارنةٍ و غیر کلّ شیءٍ لا بمزایلةٍ»(66) ـ.
فإذا تحقّق هذا المقام ظهر انّ نسبة الفعل و الإیجاد إلى العبد صحیحةٌ کنسبة الوجود و التشخّص إلیه من الوجه الّذی نسب إلیه ـ تعالى ـ.
و کما انّ وجود زیدٍ بعینه أمرٌ متحقّقٌ فی الواقع و هو شأنٌ من شؤون الحقّ الأوّل و لمعةٌ من لمع وجهه، کذلک هو فاعلٌ لما یصدر عنه بالحقیقة ـ لا بالمجاز ـ و مع ذلک فعله أحد أفاعیل الحق الأوّل بلاشوب قصورٍ و تشبیهٍ ـ تعالى الواحد القیّوم عن نسبة النقص و الشین إلیه! ـ. فالتنزیه و التقدیس بحاله، لأنّ التنزیه و التقدیس یرجع إلى مقام الأحدیّة الّتی یستهلک فیها کلّ شیءٍ ـ و هو الواحد القهّار، الّذی لیس أحدٌ غیره فی الدار! ـ؛ و التشبیه راجعٌ إلى مقام الکثرة و المعلولیّة و المحامد کلّها راجعةٌ إلى وجه الأحد؛ و له عواقب الثناء و التقدیس.
و ذلک لأنّ شأنه إفاضة الوجود على الکلّ و الوجود کلّه خیرٌ محضٌ و هو المجعول، و الشرور أعدامٌ و الأعدام غیر مجعولةٍ؛ و کذا الماهیّات ما شمّت رائحة الوجود. فعین الکلب نجسٌ و وجوده الفائض عنه ـ تعالى ـ علیه طاهرٌ، و الکافر نجس العین من حیث ماهیّته و عینه الثابتة، لامن حیث وجوده؛ لأنّه الطاهر المطهّر. کنور الشمس الواقع على القاذورات و الأوراث، فانّه لایخرج عن نورانیّته و ضیائه بوقوعه علیها و لایتّصف بصفاته من الرائحة الکریهة و الکدورة الشدیدة؛ فکذلک کلّ وجودٍ و کلّ أثر وجودٍ من حیث کونه أثراً. فالوجود خیرٌ محضٌ و حسنٌ لیس بشرٍّ و لاقبیحٍ، و لکن من حیث نقصه عن التمام شرٌّ و
من حیث منافاته لخیرٍ آخر قبیحٌ. و کلٌّ من ذلک راجعٌ إلى نحو عدمٍ و العدم غیر مجعولٍ.
فأنت ـ أیّها الراغب فی تحقیق الحقّ الساعی إلى ساحة عالم التقدیس! ـ لاتکن ممّن اتّصف بأنوثة التشبیه المحض و لابفحولة التنزیه الصرف و لابحثوثة الجمع بینهما ـ کمن هو ذوالوجهین! ـ،بل کن مقتدیاً بسکّان صوامع الملکوت ـ الّذین هم من العالّین ـ لیست لهم شهوة أنوثة التشبیه و لا غضب ذکورة التنزیه و لا الخلط و الامتزاج بین الصفتین، و إنّما هم أهل الوحدة الجمعیّة الإلهیّة، فانّ اللّه ـ تعالى ـ عالٍ فی دنوّه دانٍ فی علوّه واسعٌ برحمته کلّ شیءٍ، لایخلو منه أرضٌ و لاسماءٌ؛ (وَ هُوَ مَعَکُمْ أَینَما کُنتُمْ)، (مَا یَکُونُ مِنْ نَجوَى ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَ لاَ خَمسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُم)(67)؛ فتأمّل فی أطراف الکلام حتّى یظهر لک حقیقة المرام، فانّه من مزالّ الأقدام ـ و اللّه المستعان فی کلّ حالٍ و مقامٍ! ـ.
و قوله – علیه السلام ـ: «ماضٍ فی حکمک».
یقال: مضى الأمر مضیاً: نفذ.
<و «الحکم»: مصدر حکم الحاکم علیه بکذا: إذا قضى علیه به. و أصله: المنع، کأنّه منعه من خلافه فلم یقدر على الخروج؛ أی: نافذٌ فی حکمک لاأستطیع ردّه و لا الخروج منه>(68)
و «القضاء»: قد مرّ معناه لغةً و اصطلاحاً.
و کلمة «فی» الجارّة قد أضیفت إلى یاء المتکلّم فی الموضعین.
و «حکمک» و «قضائک» یحتمل أن یکونا مبتدئین؛ و أن یکونا نکرتین، فانّ ذلک یجوز إذا کان الکلام مفیداً ـ نحو: کوکبٌ انقض الساعة ـ ؛ و یحتمل أن یکونا خبرین، على أن یکون التقدیر: حکمک ماضٍ فیَّ و قضاؤک عدلٌ فیَّ.
و «السلطان»: قدرة الملک و موضع تسلّطه؛ أی: لاأستطیع الخروج من قدرتک و من حیطة ملکک، و لهذا قیل: «الخروج من ملک اللّه ـ تعالى ـ من الممتنعات».
و «لاأستطیع مجاوزة قدرتک» کالعطف التفسیریّ للأولى.
و «المجاوزة»: التعدیة، أی: لاأستطیع أن أتعدّی قدرتک و أستعصی علیها.
و «لاأستمیل هواک».
«الإستمالة»: طلب المیل و المحبّة،<من: مال إلیه بمعنى: أحبّه.
و «الهوى»: – مقصوراً ـ مصدر هویته – من باب تعب ـ: إذا أحببته؛ و المعنى: لاأقدر على>(69) تحصیل محبّتک، لأنّ محبوبیّة العبد للحقّ خارجةٌ عن حیطة قوّته و قدرته.
و قیل: «أی: لا أقدر على تحصیل هواک و حبّک لی إلّا بالطاعة و العبادة. أو «هواک» بمعنى: مهوبک و محبوبک من المثوبات الأخرویّة و الإفضالات الدنیویّة»(70)
و قیل: «و إن کان الظاهر نفی الاستمالة لکن المراد انّه لاقادرٌ على استمالة إرادتک موافقةً لإرادتی و تدبیری».
و قیل: «معناه: لاأقدر على أن أصرف عن نفسی ماتهواه و تریده منّی من البلایا و الموت؛ أو: لاأقدر على أن أمیل و أعرف حقیقة ما تحبّه منّی إلّا بتوفیقک و إطاعتی لک»(71)
و «لا أبلغ رضاک».
«البلوغ»: الإدراک.
و «الرضاء» قد مرّ معناه؛ أی: لاأقدر أن أدرک رضاک.
و «نال» مطلوبه یناله نیلاً: أدرکه؛ أی: لاأدرک ما عندک، لأنّ العبد متناهٍ و اللّه ـ تعالى ـ غیر متناهی الحضرة، فکذا ماعنده.
و قیل: «المراد بـ «ما عندک»: النعم الدنیویّة و الأخرویّة».
«إلّا بطاعتک» استثناءٌ مفرّغٌ من محذوفٍ عامٍّ؛ أی: بشیءٍ من الأشیاء «إلّا بطاعتک و
بفضل رحمتک». و بعض الشارحین جعل الاستثناء من جمیع الجمل الثلاث، لا الأخیرة فقط؛ و هذا حسنٌ. و یمکن أن یکون استثناءً من الأخیرة أو الأخیرتین.
إِلَهِی أَصْبَحْتُ وَ أَمْسَیْتُ عَبْداً دَاخِراً لَکَ لاَأَمْلِکُ لِنَفْسِی نَفْعاً وَ لاَضَرّاً إِلاَّ بِکَ، أَشْهَدُ بِذَلِکَ عَلَى نَفْسِی وَ أَعْتَرِفُ بِضَعْفِ قُوَّتِی وَ قِلَّةِ حِیلَتِی، فَأَنْجِزْ لِی مَا وَعَدْتَنِی، وَ تَمِّمْ لِی مَا آتَیْتَنِی، فَإِنِّی عَبْدُکَ الْمِسْکِینُ الْمُسْتَکِینُ الضَّعِیفُ الضَّرِیرُ الْحَقِیرُ الْمَهِینُ الْفَقِیرُ الْخَائِفُ الْمُسْتَجِیرُ.
قال الفاضل الشارح: «أصبح و أمسى یکونان تامّین بمعنى: وصلنا إلى الصبح و المساء و دخلنا فیهما؛ و یکونان ناقصین، و لهما حینئذٍ معنیان:
أحدهما: أن یکونا بمعنى: صار، مطلقاً من غیر اعتبار الوقتین الّلذین یدلّ علیهما ترکیب الفعل ـ أعنی: الصبح و المساء ـ، بل باعتبار الزمن الّذی یدلّ علیه صیغة الفعل ـ أعنی: الماضی ـ فیهما، أو الحال أو الإستقبال فی مضارعهما، فیکونان لافادة الانتقال من حالٍ إلى حالٍ مجرّداً عن ملاحظة الوقت ـ و منه قوله تعالى: (فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعمَتِهِ إِخْوَاناً)(72) ـ ؛
و الثانی: أن یکونا بمعنى: کان فی الصبح و کان فی المساء، فیقترن فی هذا المعنى مضمون الجملة ـ أعنی: مصدر الخبر مضافاً إلى الاسم ـ بزمانی الفعل ـ أعنی: الّذی یدلّ علیه ترکیبه و الّذی تدلّ علیه صیغته ـ. فمعنى أصبح زیداً أمیراً: انّ إمارة زیدٍ مقترنةٌ بالصبح فی الزمن الماضی.
إذا عرفت ذلک فاعلم: أنّ بعض الفضلاء صرّح فی نظیر هذه العبارة من الدعاء انّ أصبح و أمسى محتملةٌ للمعانی الثلاثة؛ فقال: «أصبح و أمسى إمّا تامّةٌ؛ أو بمعنى: صار؛ أو لاقتران مضمون الجملة بهذین الوقتین»؛ انتهى.
و لایخفى انّ احتمال کونهما هنا بمعنى «صار» باطلٌ!؛
أمّا أوّلاً: فلو قصد هذا المعنى لاکتفى بأحد الفعلین عن الآخر ـ إذ هما بمعنىً واحدٍ على هذا المعنى ـ ؛
و أمّا ثانیاً: فلأنّ المقصود بایراد الفعلین الاستمرار ـ أی: کلّ صباحٍ و مساءٍ ـ، و کونهما بمعنى صار ینتفی معه هذا الغرض، فلم یبق إلّا احتمال المعنیین الآخرین»(73)؛ انتهى کلام الفاضل الشارح.
أقول: یحتمل أن یکون مراد بعض الفضلاء بقوله: «محتملةٌ للمعانی الثلاثة» مجرّد الاحتمالات العقلیّة و إن لم یکن هنا مراداً؛ فتدبّر!.
و قوله – علیه السلام ـ: «عبداً» إمّا حالٌ على المعنى الأوّل ـ أی: حال کونی عبداًـ ؛ و إمّا خبرٌ على الثانی على التنازع فیهما.
و «داخراً»: صفةٌ لعبدٍ، أی: ذلیلاً صاغراً، مأخوذٌ من الدخور ـ و هو الصغار و الذلّ ـ. و لیس المراد به هنا الطرد و الابعاد ـ کما قاله الجوهریّ(74) ـ.
و «لک» إمّا صفةٌ بعد صفةٍ، أو حالٌ من «عبد» تخصّصه بالوصف.
<و جملة «لا أملک» إمّا خبرٌ ثان لـ «أصبحت» و «أمسیت»؛ أو حالٌ من فاعلهما؛ أو مستأنفةٌ.
و «اللام» من قوله: «لنفسی» إمّا متعلّقةٌ بـ «أملک»، أو بمحذوفٍ وقع حالاً من «نفعاً» ـ أی: لاأقدر لأجل نفسی على جلب نفعٍ مّا و لا على دفع ضرٍّ ما ـ.
و «إلّا بک» استثناءٌ مفرّغٌ، أی: بشیءٍ إلّا بک ـ أی: بمشیّتک أو بقدرتک ـ. و فیه اقتباسٌ من قوله ـ تعالى ـ: (قُلْ لاَ أَمْلِکُ لِنَفسِی نَفْعاً وَ لاَضَرّاً إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ)(75)>(76)
قیل: «درّجهم على شهود الأفعال بسلب الملک و التأثیر عن نفسه و وجوب وقوع ذلک
عنه بمشیّته ـ سبحانه ـ لیعرفوا آثار القیامة؛ ثمّ لوّح إلى أنّ القیامة الصغرى هی بانقضاء آجالهم بقوله: (وَ لِکُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ)(77)
و «أشهد بذلک» أی: بالذلّ و عدم القدرة. و فصّل هذه الجملة لکمال انقطاعها عمّا قبلها؛ و اختار الفعلیّة لإفادة التجدّد، و المضارع لافادة الاستمرار.
و «أعترف بضعف قوّتی» کالعطف التفسیریّ للفقرة الّتی قبلها.
و «قلّة حیلتی» أی: تدبیری.
و «الإنجاز»: الایفاء بالوعد.
و المراد بـ «ما وعده»: إمّا الرزق فی الدنیا و المغفرة فی الآخرة، أو إجابة الدعاء المضطرّ و کشف السوء.
و «تمّم لی ما آتیتنی»: إمّا الإیمان؛ و إمّا إتمام العمر بالطول و إتمام الرزق بالبرکة و إتمام الأولاد بالصلاح و إتمام الزوجة بالعفاف ـ على ما قیل ـ. و الأحسن انّ المراد بـ «تمّم»: ما آتاه من الوجود و افناء کمالاته اللائقة به على قدر ظرفیّته و وعاء وجوده.
و «المسکین»: من المسکنة، و هی الافتقار و الذلّة.
و «المستکین»: الخاضع الذلیل؛ یقال: استکان أی: خضع. و هو من السکون ـ کما صرّح به فی الأساس(78) ـ، أشبعت حرکة عینه؛ و کذا المسکین. فـ «المسکین» و «المستکین» کلاهما من بابٍ واحدٍ.
و قیل: «انّه استفعالٌ من کان یکن، أی: خضع»؛
<و قال أبوعلیٍّ الفارسیّ فی قوله ـ تعالى ـ: (وَ مَا ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَکَانُوا)(79) : «لا أقول انّه افتعلوا من السکون و زیدت الألف، لکنّه عندی استفعلوا ـ مثل استقاموا(80) ـ، و العین
حرف علّةٍ، و لذا ثبت فی اسم الفاعل نحو مستکین و فی نحو یستکن. على أنّه یجوز أن یکون من الزیادات اللازمة؛ کما قالوا: مکان ـ و هو مفعلٌ من الکون ـ ثمّ قالوا: أمکنة و أماکن، و تمکّن و استمکن على توهّم أصالة المیم للزومه و ثباته فی جمیع متصرّفاته»>(81)
و «الضریر»: فعیلٌ بمعنى مفعولٍ من الضُرّ ـ بالضمّ ـ، و هو الفاقة و الفقر و سوء الحال و الشدّة. و ما کان ضدّ النفع فهو بفتحها. و قیل: «هو بالضمّ اسمٌ و بالفتح مصدرٌ».
و «الذُلّ»(82) ـ بالضمّ و الکسر ـ: اسمٌ من ذلّ یذلّ ذلاً ـ من باب ضرب ـ: هان.
و «حقُر» الشیء ـ بالضمّ ـ حقارةً: هان قدره فلایعبأ به، فهو حقیرٌ.
و «المهین»: فعیل المهانة، تأکیدٌ للحقیر.
و «الفقیر»: المحتاج.
و «الخائف»: فاعلٌ من خاف یخاف خوفاً و خیفةً و مخافةً. و عرّفوا الخوف بأنّه توقّع حلول مکروهٍ أو فوات محبوبٍ.
و «المستجیر»: اسم الفاعل من الاستجارة؛ یقال: استجاره أی: طلب منه أن یجیره و یؤمّنه ممّا یخاف؛ و منه «الجار»، لأنّه یأخذ الحمایة بالجار.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لاَتَجْعَلْنِی نَاسِیاً لِذِکْرِکَ فِیما أَوْلَیْتَنِی، وَ لاَغَافِلاً لاِحْسَانِکَ فِیما أَبْلَیْتَنِی، وَ لاَ آئِساً مِنْ إِجَابَتِکَ لِی وَ إِنْ أَبْطَأَتْ عَنِّی، فِی سَرَّاءَ کُنْتُ أَوْ ضَرَّاءَ، أَوْ شِدَّةٍ أَوْ رَخَاءٍ، أَوْ عَافِیَةٍ أَوْ بَلاَءٍ، أَوْ بُوْسٍ أَوْ نَعْمَاءَ، أَوْ جِدَةٍ أَوْ لاْوَاءَ، أَوْ فَقْرٍ أَوْ غِنىً.
<«النسیان»: خلاف الذکر؛ و قد یطلق على الترک، أی: لاتجعلنی غیر حافظٍ أو تارکاً لذکرک>(83)
<و قوله - علیه السلام ـ: «فیما أولیتنی» أی: أعطیتنی و جعلت ولایته علیّ.
و الظرف متعلّقٌ بـ «الذکر»، أو بـ «النسیان»>(84)
و «فی» ظرفیّةٌ مجازیّةٌ.
و «ما» موصولةٌ، و العائد محذوفٌ؛ أی: فیما أولیتنیه. و قیل: «للسببیّة، فانّ تزاید النعم من أسباب الغفلة و النسیان لمولاها عند أرباب الجهالة»(85)
<و «الغفلة»: غیبة الشیء عن البال، و قد یستعمل فی ترک الشیء إهمالاً و إعراضاً ـ کما فی قوله تعالى: (وَ هُمْ فِی غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ)(86) ـ.
و عدّی بـ «اللام» و حقّه أن یعدّى بـ «عن» ـ فیقال: غفلت عنه ـ لتضمینه معنى النسیان.
و «ابلیتنی» أی: أنعمتنی، من الإبلاء بمعنى: الانعام و الاحسان؛ و منه حدیث: «من أبلى فذکر فقد شکر»(87)>(83) <و فی نسخة ابن ادریس: «ابتلیتنی»، أی: اختبرتنی. و الاحتمالان
السابقان فی الظرف المتقدّم جاریان فی هذا أیضاً>(84)
و «لا آیساً» أی: مأیوساً خائباً؛ قال صاحب القاموس: «الإیاس مصدر أیس منه ـ کسمع ـ إیاساً: قنظ»(88)؛ و یشهد له ما یروى من شعر المجنون:
یَقُولُونَ عَن لَیلَى غَنَیتُ وَ إنَّمَا++
بِیَ الْیَأسُ عَن لَیلَى وَ لَیسَ بِیَ الصَّبرُ
وَ انِّی لاَهوَاهَا وَ انِّی لآیِسْ++
هَوىً وَ إِیَاسٌ کَیفَ ضَمَّهُمَا الصَّدرُ(89)
<و «إن» من قوله - علیه السلام ـ: «ان أبطأتْ عنّی» شرطیّةٌ وصلیّةٌ؛ و جوابها محذوفٌ اعتماداً على دلالة ما قبله علیه، أی: إن إبطأت عنّی فلاتجعلنی آیساً. و الجملة معطوفةٌ على أخرى مثلها محذوفةٌ للدلالة المذکورة علیها، أی: إن لم تبطىء عنّی و إن ابطأت عنّی، فانّ الشیء إذا تحقّق مع المنافی فلئن یتحقّق مع عدمه أولى>(90)
و «ابطأت»: صیغة الخطاب؛ أو بالصیغة المؤنثة الغائبة مسندةً إلى الإجابة – کما قیل ـ.
و «السرّاء»: <المسرّة و الغنى و السعة؛ و «الضرّاء» بخلاف ذلک. و یستعمل فی الأکثر فی العاهات البدنیّة ـ کالعمى و الزمانة ـ ؛ و البأساء فی العاهات النفسانیّة ـ کالفقر و الذلّ و المسکنة(91) ـ. و هذه الثلاثة صیغ تأنیثٍ لامذکّر لها>(92)
<و الظرف من قوله: «فی سرّآء» مستقرٌّ متعلّقٌ بمحذوفٍ خبرٌ لـ «کنت»، قدّم علیها جوازاً. و الشاهد على جواز تقدیم خبر کان علیها بیت العروض:
إِعلَمُوا أَنِّی لَکُمْ حَافِظٌ++
شَاهِداً مَّا کُنتُ أَو غَائِباً
و «کنت» حالٌ من مفعول «لاتجعلنی» ـ نحو: أضربه قام أو قعد ـ ؛ و التقدیر: کنت فی سرّآء أو ضرّاء، أی: کائناً على کلّ حالٍ>(93)
و «الرَخاء» ـ بالفتح ـ: ضدّ الشدّة و البلاء، یجیء بمعنى: النعمة و النقمة، و لکن هنا بمعنى النقمة لمقابلته بالعافیّة.
و «البؤس» ـ بالضمّ ـ: الفقر و شدّة الحاجة؛ یقال: بَئِس ـ من باب سمع ـ بُؤساً ـ بالضمّ ـ: إذا اشتدّت حاجته.
و «الجِدَة» ـ کالعدة ـ: الغنى.
و «الْلاَواء» ـ على وزن زهراء ممدوداً ـ: الشدّة و ضیق المعیشة.
اعلم! أنّ أنواع البلاء و الضرّآء و البأساء و صنوف اللأواء تکسر شدّة النفس و تلطّف القلب بکشف حجب صفات النفس، و ترقّق کثافات الطبع و ترفع غشاوات الهوى، فلذلک ینزع قلوبهم بالطبع إلى مبدئها فی تلک الحالة لرجوعها إلى مقتضى فطرتها و عودها إلى نوریّتها الأصلیّة و قوّتها الفطریّة و میلها الذاتیّة إلى العروج ـ الّذی هو فی سنخها ـ لزوال المانع، فانّ المیل إلى الجهة العلویّة و المبادی النوریّة مفطورٌ فی طباع القوى الملکوتیّة کلّها ـ حتّى النفس الحیوانیّة لو تزکّت عن الهیآت البدنیّة! ـ، فانّ التسفّل من العوارض الجسمانیّة حتّى انّ البهائم و الوحوش إذا اشتدّت الحال علیها فی أوقات المحل و الجدب اجتمعت رؤوسها إلى السماء!، کأنّ ملکوتها تشعر بنزول الفیض من الجهة العلویّة فیستمدّ منها. فکذا إذا توافرت على الناس نعم الظاهرة و تکاملت علیهم الإمدادات الطبیعیّة و المرادات الجسمانیّة قویت النفس من جهة المدد السفلیّة و استطالت قواها بالترفّع على القلب و تکاثف الحجاب و غلظ و تسلّط الهوى و غلب و صارت السلطنة للطبیعة الجسمانیّة و ارتکمت الهیئات البدنیّة الظلمانیّة فتشکّل القلب بهیئة النفس و قسى و غلظ و أبطرته النعمة، فکفر و عمى و مال إلى الجهة السفلیّة لبعده عن الهیئة النوریّة حینئذٍ؛ و بقدر استیلاء النفس على القلب یستولى الوهم على العقل؛
هذا إذا لم تصل النفس إلى مرتبتها المطمئنّة.
و أمّا إذا وصلت إلى هذه المرتبة ـ بل إلى مرتبة العصمة ـ تساوت جمیع هذه الأمور المتقابلة ـ کما لایخفى على ذوی البصیرة ـ.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ ثَنَائِی عَلَیْکَ وَ مَدْحِی إِیَّاکَ وَ حَمْدِی لَکَ فِی کُلِّ حَالاَتِی، حَتَّى لاَأَفْرَحَ بِمَا آتَیْتَنِی مِنَ الدُّنْیَا وَ لاَأَحْزَنَ عَلَى مَا مَنَعْتَنِی فِیهَا، وَ أَشْعِرْ قَلْبِی تَقْوَاکَ، وَ اسْتَعْمِلْ بَدَنِی فِیما تَقْبَلُهُ
مِنِّی، وَ اشْغَلْ بِطَاعَتِکَ نَفْسِی عَنْ کُلِّ مَا یَرِدُ عَلَیَّ حَتَّى لاَأُحِبَّ شَیْئاً مِنْ سُخْطِکَ، وَ لاَأَسْخَطَ شَیْئاً مِنْ رِضَاکَ.
«الثناء» و «المدح» و «الحمد» قد تقدّم الکلام علیها فی اللمعة الأولى.
<و الظرف من قوله - علیه السلام ـ: «فی کلّ حالاتی» مستقرٌّ فی محلّ نصبٍ على أنّه مفعولٌ لـ «اجعل»، لأنّه بمعنى: «صیّر» ـ المتعدّی إلى مفعولین ـ.
و «حتّى» تعلیلیّةٌ مرادفةٌ لـ «کی»، أی: اجعلنی مشغولاً بثنائک و مدحک و حمدک دائماً کی لایداخلنی فرحٌ بما منحتنی من الدنیا و لاحزنٌ على ما منعتنی فیها. و فی روایةٍ «منها» بدل: «فیها»، و هو أظهر>(94)
و یحتمل أن یکون «حتّى» متعلّقةً بـ «اجعل» و بما قبله، لما فیه من التلمیح(95) إلى قوله ـ تعالى ـ: (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فِی الاَرضِ وَ لاَ فِی أَنْفُسِکُمْ إِلاَّ فِی کِتَابٍ مِنْ قَبلِ أَنْ نَبْرَءَهَا إِنَّ ذَلِکَ عَلَى اللَّهِ یَسِیرٌ – لِکَیْلاَ تَأْسَوا عَلَى مَا فَاتَکُمْ وَ لاَتَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَاکُمْ)(96)، و قد مرّ تفسیر هذه الآیة.
و قوله – علیه السلام ـ: «و أشعر قلبی تقواک» <من «الشعار»، و هو: الثوب الّذی یلی الجسد ـ کما انّ «الدثار» هو الثوب الّذی یکون فوقه>(97)؛ <و فی الحدیث: «أنتم یا أهل الکوفة الشعار و غیرکم الدثار»(98) ـ. و المعنى: اجعل تقواک ملاصقاً لقلبی ملاصقة الثوب للبدن(99) و یجوز أن یکون «شعر» بمعنى: عرف، فیتعدّی بالهمزة إلى اثنین؛ أی: اجعل قلبی
عارفاً و عالماً بتقواک>(84)
و قوله – علیه السلام ـ: «و استعمل بدنی فیما تقبله منّی» لأنّ القبول لایکون إلّا أن یکون العمل خالصاً للّه.
و «اشغَل»: أمرٌ من باب علم، و هو متعدٍّ؛ و من باب الإفعال غیر فصیحٍ.
و «سَخَطُک» ـ على وزن فرسٍ، أو قفلٍ، کما مرّ مراراً ـ، أی: ما یوجبه(100)، أو مسخوطک؛ و مثله «من رضاک».
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ فَرِّغْ قَلْبِی لَمحَبَّتِکَ، وَ اشْغَلْهُ بِذِکْرِکَ، وَ انْعَشْهُ بِخَوْفِکَ وَ بِالْوَجَلِ مِنْکَ، وَ قَوِّهِ بِالرَّغْبَةِ إِلَیْکَ، وَ أَمِلْهُ إِلَى طَاعَتِکَ، وَ أَجْرِ بِهِ فِی أَحَبِّ السُّبُلِ إِلَیْکَ، وَ ذَلِّلْهُ بِالرَّغْبَةِ فِیما عِنْدَکَ أَیَّامَ حَیَاتِی کُلِّهَا.
<«و فرّغ قلبی لمحبّتک»، مصدرٌ بمعنى: الحبّ مشتقٌّ من حَباب الماء ـ بفتح الحاءـ: معظمه، لأنّ المحبّة معظم مهمّات القلب. و قیل: «مشتقٌّ من اللزوم و الثبات(101)، لأنّه قاهرٌ للقلب و لازمٌ له»>(84)؛ و قد بسطنا الکلام فی المحبّة فی اللمعة الأولى.
و المراد بـ «تفریغ قلبه – علیه السلام ـ لمحبّته»: جعله خالیاً عن محبّة غیره ـ تعالى ـ، فاذا ملأ القلب عن محبّته ـ تعالى ـ سرى إلى سائر الأعضاء و الجوارح حتّى صار الشخص بتمامه عین المحبّة، فاذاً لایشغل بشیءٍ إلّا بمحبّته؛ فإذاً سأل – علیه السلام ـ الاشتغال بذکره. ثمّ من أخلص فی ورده و صدق فی حبّه کان استلذاذه بمنعه أکثر من استلذاذه بعطائه ـ فانّ کلّ أحدٍ یذکره فهو یقربه ـ. و إنّما المخلص فی حقّه و عهده من لایفترّ عن أداء حقّه و إن کان
یبلیه و یعذبّه!. حکی انّ الشبلی کان فی داره دیکٌ یصقع باللیل، فأخذه لیلةً و شدّ قوائمه و طرحه فی بیتٍ، فلم یصقع فی تلک اللیلة، فلمّا أصبح قال له: «یا مدّعی! أنت انّما تذکره من رأس عافیةٍ فحین أصبک البلاء سکتت و لم تذکره!!». ـ قال الجوهریّ: «صقع الدیک(102) :
صاح»(103) ـ.
و سئل یحییبن معاذ عن المحبّة؟
فقال: هو ما لایزید بالبرّ و لاینقص بالجفاء!»(104)
و حکی انّ الشبلی حبس فدخل علیه قومٌ، فقال: «من أنتم؟
فقالوا: أحبّاؤک. فأخذ یرمیهم بالحجارة!، فمرّوا و فرّوا؛
فقال: یاکذبة! لو صدقتم ولائی ما هربتم عن بلائی!»(105)
ثمّ لمّا کان من لوازم صدق المحبّة الرهبة و الرغبة و الانقیاد و الطاعة فی أوّل الوهلة سألها – علیه السلام ـ بعدها.
بیان ذلک: انّ المحبّة مع تصوّر هیبة المحبوب تقتضی الخوف و الرهبة، و مع تصوّر رحمته فی الرأفة تقتضی الطمع فیما عنده و الرغبة، و مع تجرّی موافقته و الاذعان له تقتضی الانقیاد له و الاطاعة.
و «انعشه»: أمرٌ من نعش، أی: نبّه قلبی بسبب خوفک و خشیتک؛ و إمّا بمعنى: رفع القدر و الدرجة، أی: ارفع قلبی بسبب خوفک و خشیتک ـ لأنّ الخوف من اللّه سببٌ لارتفاع القلب ـ ؛ أو بمعنى: التدارک، أی: تدارکه بالخوف ممّا تورّط فیه من الذنوب و التقصیر.
و «الوَجَل» ـ بالتحریک ـ: الفزع.
و «قوّه»: أمرٌ من التقویة.
و «أمِلْهُ»: أمرٌ من الامالة.
و «أجْرِ»: أمرٌ من الإجراء. و فی نسخة ابن ادریس: «خذ» بدل أجْر. و المعنى: و اجعله جاریاً و ساعیاً فی السبیل الّتی هی أحب السبل إلیک، فـ «الباء» للالصاق لشدّة الاهتمام بشأن القلب فی إجرائه على أحبّ السبل ـ و هو طریقٌ یوصل إلى اللّه تعالى ـ.
و «أیّام حیاتی» متعلّقٌ بجمیع الأفعال المذکورة على طریق التنازع.
و «کلّـَِها»: بالکسر تأکیدٌ للـ «حیاة»، و بالنصب تأکیدٌ للـ «أیّام».
وَ اجْعَلْ تَقْوَاکَ مِنَ الدُّنْیَا زَادِی، وَ إِلَى رَحْمَتِکَ رِحْلَتِی، وَ فِی مَرْضَاتِکَ مَدْخَلِی. وَ اجْعَلْ فِی جَنَّتِکَ مَثْوَایَ، وَ هَبْ لِی قُوَّةً أَحْتَمِلُ بِهَا جَمِیعَ مَرْضَاتِکَ. وَ اجْعَلْ فِرَارِیَ إِلَیْکَ، وَ رَغْبَتِی فِیما عِنْدَکَ.
و «التقوى» قد سبق الکلام علیها.
و «الزاد»: الطعام الّذی یتّخذ للسفر، أی: اجعل زادی المأخوذ من الدنیا لسفر الآخرة التقوى ـ کما قال تعالى: (وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیرَ الزَّادِ التَّقوَى)(106) ـ. و أمّا من حمل «الدنیا»
على الجزاء فسخیفٌ.
و «الرِحلة» ـ بالکسر ـ: اسمٌ من الارتحال. قیل: «قد تضمّ»؛ و الصواب انّها بالکسر: الارتحال، و بالضمّ: الوجه الّذی تقصده؛ یقال: قربت رِحلتنا ـ بالکسر ـ أی: ارتحالنا؛ و: أنت رُحلتنا ـ بالضمّ ـ أی: المقصد الّذی نقصده؛ کذا قیل(107) أی: و اجعل رحلتی من الدنیا إلى رحمتک.
و «المرضات»: الرضاء، قال ـ تعالى ـ: (ابْتِغَاءَ مَرضَاتِ اللَّهِ)(108)، أی: رضاه.
و «المَدخل» ـ بفتح المیم ـ: مصدرٌ میمیٌّ بمعنى: الدخول.
و «فی» ظرفیّةٌ مجازیّةٌ، أی: اجعل دخولی منحصراً فی رضاک.
و «المثوى»: المنزل، مأخوذٌ من قولهم ثوى بالمکان یثوی ثوآءً ـ بالمدّ ـ: إذا قام ؛ أی: اجعل فی جنّتک مکان اقامتی و قراری.
و لایخفى على البصیر <فی هذه الفقرات الأربع من البدیع مراعات النظیر ـ و یسمّى بـ : «التناسب» ـ، و هو أن یجمع المتکلّم بین لفظین أو ألفاظٍ متناسبة المعانی، کقوله ـ تعالى ـ : (وَ الشَّمسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ)(109)، فانّها متناسبةٌ معنىً من حیث اشتراکها فی وصفٍ مشهورٍ هو الإنارة>(110) و کذا هنا جمع بین «الزاد» و «الرحلة» و «المدخل» و «المثوى».
و «القوّة»: خلاف الضعف، أی: هب لی قوّةً و قدرةً على قهر النفس الأمّارة للقیام بجمیع مرضات حضرة الأحدیّة.
و قوله – علیه السلام ـ: «و اجعل فراری إلیک و رغبتی فیما عندک» قد مرّ معناه فی أوائل هذه اللمعة.
وَ أَلْبِسْ قَلْبِیَ الْوَحْشَةَ مِنْ شِرَارِ خَلْقِکَ، وَ هَبْ لِیَ الاُْنْسَ بِکَ وَ بِأَوْلِیَائِکَ وَ أَهْلِ طَاعَتِکَ.
«الوحشة» من الشیء: الانقطاع و البعد و النفور.
و المراد بـ «شرار الخلق»: من یرتکب منهم الشرّ.
و «الأنس»: خلاف الوحشة. و فی الکلام استعارةٌ مکنیّةٌ و تخییلیّةٌ، شبّه القلب فی النفس بالشخص الآئس و اثبت له لازماً من لوازم المشبّه به ـ و هو اللباس ـ.
و الحثّ على مصاحبة الأخیار و مجانبة الأشرار فی الأخبار و الآثار الواردة عن النبیّ
المختار و أهل بیته الأطهار أکثر من أن تحصر؛ و قد ورد عن خیر البشر: «المرء على دین خلیله و قرینه»(111)؛
و عنه: «انظروا من تحادثون، فانّه لیس من أحدٍ ینزل به الموت إلّا مثّل له أصحابه إلى اللّه، إن کانوا خیاراً فخیاراً و إن کانوا شراراً فشراراً. و لیس أحدٌ یموت إلّا تمثّلت له عند موته!»(112)؛
و عن عیسى بن مریم – علیه السلام ـ انّه قال: «صاحب الشرّ یعدی و قرین السوء یردی»(113)؛
و عن أمیرالمؤمنین – علیه السلام ـ: «لاتصحب الفاجر فتزیق لک فعله و یودّ لو انّک مثله»(114)؛
و عن أبی عبداللّه – علیه السلام ـ: «لاتصحبوا أهل البدع و لاتجالسوهم فتصیروا عند الناس کواحدٍ منهم»(115)؛
و قال لقمان لابنه: «یابنیّ! من یشارک الفاجر یتعلّم من طرقه و من یقارن قرین السوء لایسلم، فانّ المجالسة تؤثّر»(116)؛
و قالوا: «إیّاک و مجالسة الأشرار، فانّ طبعک یسرق من طبعهم و أنت لاتدری!»؛
<قال الشاعر:
عَنِ الْمَرءِ لاَتَسأَلْ وَ سَلْ عَنْ قَرِینِهِ++
فَکُلُّ قَرِینٍ بِالْمُقَارِنِ یَقتَدِی(117)
و لیس إعداء الجلیس جلیسه بمقاله و فعاله فقط! بل بالنظر إلیه، فالنظر إلى الصور یؤثّر فی النفوس أخلاقاً مناسبةً لخُلق المنظور؛ فانّ من دامت رؤیته لمسرورٍ سرّ، أو لمحزونٍ حزن>(118)؛ و لذا ورد: «إنّ النظر إلى العالم عبادةٌ»(119)
و لیس فی الإنسان فقط، بل فی الحیوانات و النباتات! فالجمل الصعب قد یصیر ذلولاً بمقارنة الجمال الذلل و الذلول قد یعصب بمقارنة الصعاب!، و الریحانة الفضّة تذبل لمجاوزة الذابلة، و لهذا یلتقط أصحاب الفلاحة الرمم عن الزروع لئلّا تفسدها. و إذا کانت هذه الأشیاء قد بلغت من قبول التأثیر هذا المبلغ فما الظنّ بالنفوس البشریّة ـ الّتی موضوعها قبول صور الأشیاء، و خیرها و شرّها ـ. و قد قیل: «سمّی الإنسان إنساناً لأنّه یأنس ما یراه، إن خیراً و إن شرّاً». قال بعض الحکماء: «و من صحب خیراً أصابته برکته».
فجلیس أولیاء اللّه لایشقی و إن کان کلباً ککلب أصحاب الکهف حیث قال ـ تعالى ـ : (وَ کَلبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیهِ بِالْوَصِیدِ)(120) و لهذا أوصت الحکماء بمنع الأحداث من مجالسة السفهاء؛ و فی الحدیث: «الوحدة خیرٌ من الجلیس السوء!»(121)
وَ لاَتَجْعَلْ لِفَاجِرٍ وَ لاَکَافِرٍ عَلَیَّ مِنَّةً، وَ لاَلَهُ عِنْدِی یَداً، وَ لاَ بِی إِلَیْهِمْ حَاجَةً، بَلِ اجْعَلْ سُکُونَ قَلْبِی وَ أُنْسَ نَفْسِی وَ اسْتِغْنَائِی وَ کِفَایَتِی بِکَ وَ بِخِیَارِ خَلْقِکَ.
«الفاجر»: العاصی الفاسق؛ یقال: فجر فجوراً: عصى و فسق، <فهو فاجرٌ؛ قال الزمخشریّ فی الفائق: «و أصل الفجر: الشقّ، و به سمّی الفجر(122) : فلقاً(123) و و العاصی فاجرٌ،
لأنّه(124) شاقٌّ لعصا الطاعة». و عرّفوا الفجور بأنّه هیئةٌ حاصلةٌ للنفس بها یباشر أموراً على خلاف الشرع و المروّة>(125)
و «الکفر» فی الأصل: التغطیة و الستر ـ کما مرّ ـ ؛ و فی الشرع عبارةٌ عن جحد ما أوجب اللّه ـ تعالى ـ معرفته من أصول الدین و فروعه. و قیل: «هو إنکار ما علم بالضرورة مجیء الرسول – علیه السلام ـ به».
و «المنّة»: النعمة، أی: لاتجعلنی ممنوناً بنعمة الفجرة و الکفرة.
و «الید»: النعمة و الإحسان، سمّیت باسم الجارحة لأنّ العطاء یکون بها؛ أو: القوّة و القدرة، أی: لاتجعل لکلّ واحدٍ منهم علیَّ قدرةً، یعنی: لاتجعلنی ذلیلاً مقهوراً له.
و «الباء» من «بی» للإلصاق، مثلها فی قوله: «به داءٌ».
و الضمیر راجعٌ إلى الفجّار و الکفّار، و الجمع المفهوم من اقتضاء الکافر و الفاجر النکرتین فی سیاق النفی للعموم. و تقدیم «الفاجر» على «الکافر» لعمومه الکافر و غیره؛ و للاقتداء بکتاب اللّه حیث قال ـ تعالى ـ: (وَ لاَیَلِدُوا إِلاَّ فَاجِراً کَفَّاراً)(126)
قوله – علیه السلام ـ: «بک و بخیار خلقک» ظرفٌ مستقرٌّ، أی: کائناً بک، و هو مفعول
ثانٍ لـ «اجعل».
و المراد بـ «خیار خلق اللّه»: الأنبیاء و الأولیاء و المؤمنین و الأخیار. و لمّا کان المعاشرة لازماً لجبلّة الإنسان – لقوله صلّى اللّه علیه و آله و سلّم: (قُلْ إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثلُکُمْ)(127) ـ
سأل – علیه السلام ـ أن یجعل ذلک بالخیار لا بالأشرار من الفسّاق و الکفّار.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْنِی لَهُمْ قَرِیناً، وَ اجْعَلْنِی لَهُمْ نَصِیراً، وَ امْنُنْ عَلَیَّ بِشَوْقٍ إِلَیْکَ، وَ بِالْعَمَلِ لَکَ بِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى، إِنَّکَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ، وَ ذَلِکَ عَلَیْکَ یَسِیرٌ.
قوله – علیه السلام ـ: «لهم» أی: لمحمّدٍ و آله – علیهم السلام ـ.
قوله: «و ذلک علیک یسیرٌ»: تعلیلٌ للدعاء و مزید استدعاء الإجابة؛ و لایحتاج إلى التفسیر.
—
و قد وفّقنی اللّه ـ تعالى ـ لإتمام هذه اللمعة فی عصر یوم الجمعة لعشرٍ خلون من شهر ربیع الأوّل سنة إحدى و ثلاثین و ألفٍ من الهجرة النبویّة.
1) کما حکاه المحدّث الجزائریّ، راجع: «نور الأنوار» ص 130.
2) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 445.
3) راجع: «الصحیفة الشریفة» الدعاء 16 القطعة 14 ص 78.
4) قارن: «نور الأنوار» ص 130.
5) کماحکاه العلّامة المدنیّ، راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 448.
6) قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 449.
7) راجع: «شرح الصحیفة» ص 219.
8) راجع: «التعلیقات» ص 51.
9) المصدر: موصوفها.
10) راجع: «نور الأنوار» ص 130.
11) راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 450.
12) کریمة 16 الزمر.
13) المصدر: الغناء.
14) راجع: «الکافی» ج 3 ص 324 الحدیث 12، «تهذیب الأحکام» ج 3 ص 185 الحدیث 1،«وسائل الشیعة» ج 8 ص 106 الحدیث 10182، «بحار الأنوار» ج 86 ص 367.
15) راجع: «نهج البلاغة» الخطبة 24 ص 66، «شرح ابن أبی الحدید» علیه ج 1 ص 331، «بحارالأنوار» ج 29 ص 464.
16) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 451.
17) کریمة 286 البقرة.
18) راجع: «الصحیفة الشریفة» الدعاء 29 القطعة 10 ص 168، «المصباح» ـ للکفعمیّ ـ ص 367.
19) کریمة 118 التوبة.
20) راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 1 ص 303 ذیل الحدیث 916، «مستدرک الوسائل» ج 4ص 140 الحدیث 4332، «بحار الأنوار» ج 81 ص 206.
21) کریمة 19 العلق.
22) راجع: «بحار الأنوار» ج 95 ص 408، «الإقبال» ص 695، «البلد الأمین» ص 173،«المصباح» ـ للکفعمیّ ـ ص 541، و انظر أیضاً: «الکافی» ج 3 ص 469 الحدیث 7.
23) کریمة 27 هود.
24) کریمة 88 المؤمنون.
25) راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 451.
26) راجع: «الصحیفة الشریفة» الدعاء 50 القطعة 4 ص 246.
27) المصدر: + و أمانه و جواره.
28) لم أعثر علیه فی مصادرنا، و قریبٌ منه ما یوجد فی «سنن ابن ماجة» ج 2 ص 895 الحدیث2685، «مسند أحمد» ج 4 ص 197، و انظر: «النهایة» ج 1 ص 313.
29) المصدر: أجار واحدٌ.
30) و هذا نصّ کلام محقّق الفیض، قارن: «التعلیقات» ص 51.
31) لنقد هذا القول راجع: «نور الأنوار» ص 130.
32) قارن: نفس المصدر.
33) راجع: «شرح الصحیفة» ص 220.
34) کما قال المحقّق الفیض: «لأنّ الطلب سبب التسلّط على المطلوب»، راجع: «التعلیقات» ص51. و قال المحدّث الجزائریّ: «لأنّ الطلب سبب الإعانة»، راجع: «نور الأنوار» ص 130.
35) لم أعثر علیه.
36) هذا قول معلّم الأوّل، راجع: «الحکمة المتعالیة» ج 9 ص 72.
37) لم أعثر علیه، نعم عن ابن منظور فی قوله ـ تعالى ـ: (أَینَ الْمَفَرّ): «و قرىء: (أَیْنَ الْمَفِرّ)أی: أین موضع الفرار، عن الزجّاج»، راجع: «لسان العرب» ج 5 ص 51 القائمة 1.
38) کریمة 12 الجن.
39) راجع: «القاموس المحیط» ص 235 القائمة 2.
40) راجع: «بحار الأنوار» ج 83 ص 318، «البلد الأمین» ص 385، «مهج الدعوات» ص 181.
41) الظاهر انّه إشارةٌ إلى قوله حیث قال: «لمّا کان الاستواء على العرش ـ و هو سریر الملک ـ ممّایردف الملک جعلوه کنایةً عن الملک، فقالوا: استوى فلانٌ على العرش…»، راجع: «تفسیرالکشّاف» ج 2 ص 530.
42) کریمة 64 المائدة.
43) کریمة 67 الزمر.
44) کریمة 5 طه.
45) راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 457.
46) کریمة 56 الذاریات.
47) کریمة 11 الضحى.
48) کریمة 11 المزمّل.
49) کریمة 20 الإسراء.
50) راجع: «النهایة» ج 1 ص 405.
51) صحاح اللغة: + الحجر، و.
52) راجع: «صحاح اللغة» ج 2 ص 634 القائمة 2.
53) هذا کلام محقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 221.
54) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 458.
55) هذا الضبط على ما حکاه المحقّق الداماد هو الشائع الذائع فی النسخ، راجع: «شرح الصحیفة»ص 221، و قال المحدّث الجزائری: «بل قیل: انّه المحفوظ المضبوط»، راجع: «نور الأنوار»ص 130.
56) کما نصّ علیه الجوهریّ، راجع: «صحاح اللغة» ج 1 ص 145 القائمة 2.
57) المصدر: و ذهب بعضهم إلى أنّ.
58) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 459.
59) کریمة 7 الفاتحة.
60) راجع: «شرح الأربعین حدیثاً» ـ للقونوی ـ ص 94، مع تغییرٍ کثیرٍ فی بعض الألفاظ.
61) قال: «و الناصیة قصاص الشعر، و أصله الاتّصال من قولهم: مفازةٌ تناصی مفازةً: إذا کانتالأخیرة متّصلةً بالأولى»، راجع: «مجمع البیان» ج 5 ص 288.
62) قال: «و الناصیة عند العرب منبت الشعر فی مقدّم الرأس، لا الشعر الّذی تسمّیه العامّةالناصیة»، راجع: «تهذیب اللغة» ج 12 ص 244 القائمة 2.
63) کما حکاه المحدّث الجزائری و العلّامة المدنیّ، راجع: «نور الأنوار» ص 131، «ریاض السالکین» ج 3 ص 461.
64) لم أعثر على العبارة فی «التجرید»، و فیه: «و مع الاجتماع یقع مراده ـ تعالى ـ»، راجع:«کشف المراد» ص 241.
65) راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 461.
66) راجع: «نهج البلاغة» الخطبة 1 ص 39، و انظر: «شرح ابن أبی الحدید» علیه ج 1 ص 78،«بحار الأنوار» ج 74 ص 302.
67) کریمة 7 المجادلة.
68) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 461.
69) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 462.
70) هذا قول محدّث الجزائری، راجع: «نور الأنوار» ص 131.
71) هذا قول الفاضل الخوانساری على ما حکاه عنه المحدّث الجزائری، راجع: نفس المصدر.
72) کریمة 103 آل عمران.
73) راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 463.
74) قال: «الدخور: الصغار و الذلّ، یقال: دخر الرجل ـ بالفتح ـ فهو داخرٌ»، راجع: «صحاحاللغة» ج 2 ص 655 القائمة 2.
75) کریمة 188 الأعراف.
76) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 465.
77) کریمة 34 الأعراف.
78) قال: «سکن المتحرّک و أسکنته و سکّنته»، راجع: «أساس البلاغة» ص 303 القائمة 2.
79) کریمة 146 آل عمران.
80) کما أورده القرطبیّ من غیر اسنادٍ إلى الفارسیّ، ثمّ أخذ فی تضییفه، راجع: «تفسیر القرطبیّ» ج4 ص 230.
81) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 467.
82) کذا فی النسختین.
83) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 469.
84) قارن: «نور الأنوار» ص 131.
85) هذا قول محدّث الجزائریّ، راجع: نفس المصدر.
86) کریمة 1 الأنبیاء.
87) لم أعثر علیه فی طرقنا، و راجع: «الترغیب و الترهیب» ج 2 ص 77، «کنز العمّال» الحدیث6436، «السلسلة الصحیحة» الرقم 618، و انظر: «النهایة» ج 1 ص 155.
88) قال: «أیس منه ـ کسمع ـ إیاساً: قنط»، راجع: «القاموس المحیط» ص 492 القائمة 1.
89) لم أعثر علیهما، لا فی دیوانه المطبوع فی سلسلة شعراؤنا و لا فی دیوانه المطبوع بمطبعة ناصریفی بمبئی.
90) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 471.
91) لتفصیل ذلک راجع: «شرح الصحیفة» ص 223.
92) قارن: «نور الأنوار» ص 131، مع تغییرٍ یسیر.
93) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 471، مع تغییرٍ فی بعض العبارات.
94) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 474.
95) هذا تلخیص و تحریر کلام محدّث الجزائریّ، و لتفصیله راجع: «نور الأنوار» ص 131.
96) کریمتان 23 / 22 الحدید.
97) قارن: «شرح الصحیفة» ص 224.
98) لم أعثر علیه، و یوجد: «یا أهل الکوفة! أنتم الشعار دون الدثار»، راجع: «الکافی» ج 6 ص497 الحدیث 8، «بحار الأنوار» ج 46 ص 141، «مکارم الأخلاق» ص 83، و انظر: «منلایحضره الفقیه» ج 1 ص 118 الحدیث 252، «شرح نهج البلاغة» ج 3 ص 186.
99) و انظر: «التعلیقات» ص 52.
100) هذا مختار محدّث الجزائریّ، راجع: «نور الأنوار» ص 131.
101) لبیان هذین الاشتقاقین انظر: «الرسالة القشیریّة» ص 447.
102) صحاح اللغة: + أی.
103) راجع: «صحاح اللغة» ج 3 ص 1244 القائمة 2.
104) راجع: «الرسالة القشیریّة» ص 450.
105) راجع: نفس المصدر ص 452.
106) کریمة 197 البقرة.
107) هذا قول العلّامة المدنیّ؛ راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 480.
108) کریمة 265 / 207 البقرة.
109) کریمة 54 الأعراف.
110) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 480.
111) راجع: «الکافی» ج 2 ص 375 الحدیث 3، نفس المصدر و المجلّد ص 624 الحدیث 10،«وسائل الشیعة» ج 12 ص 48 الحدیث 15610، «مجموعة ورّام» ج 2 ص 162.
112) راجع: «الکافی» ج 2 ص 638 الحدیث 3، «وسائل الشیعة» ج 12 ص 22 الحدیث15541.
113) راجع: «الکافی» ج 2 ص 640 الحدیث 4، «وسائل الشیعة» ج 12 ص 23 الحدیث15542، «بحار الأنوار» ج 71 ص 201.
114) لم أعثر علیه، و فی الحکم المنسوبة إلى أمیرالمؤمنین – علیه السلام ـ: «لاتؤاخین الفاجر فانّهیزیّن…»، راجع: «شرح نهج البلاغة» ج 20 ص 264 الحکمة 85.
115) راجع: «الکافی» ج 2 ص 375 الحدیث 3، «وسائل الشیعة» ج 16 ص 295 الحدیث21509، «بحار الأنوار» ج 71 ص 201.
116) هذا جزءٌ من حدیثٍ طویلٍ أورد المصنّف قطعاتٍ منه، راجع: «الکافی» ج 2 ص 641الحدیث 9، «وسائل الشیعة» ج 12 ص 31 الحدیث 15562، «مستدرک الوسائل» ج 12ص 308 الحدیث 14164، «بحار الأنوار» ج 13 ص 426، «القصص» ـ للراوندی ـ ص190 الحدیث 239.
117) راجع: «شرح نهج البلاغة» ج 10 ص 46، و قال المناویّ: «البیت لعدیّ»، راجع: «فیض القدیر» ج 3 ص 153.
118) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 482.
119) راجع: «بحار الأنوار» ج 71 ص 278، «الأمالی» ـ للطوسی ـ ص 454 الحدیث 1015،«مجموعة ورّام» ج 2 ص 175.
120) کریمة 18 الکهف.
121) راجع: «وسائل الشیعة» ج 12 ص 188 الحدیث 16044، «بحار الأنوار» ج 71 ص 189،«أعلام الدین» ص 293، «الأمالی» ـ للطوسی ـ ص 535 الحدیث 1162، و انظر: «مستدرک الوسائل» ج 12 ص 312 الحدیث 14175.
122) الفائق: + کما سمّی.
123) الفائق: + و فرقاً.
124) الفائق: ـ فاجر، لأنّه.
125) قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 484.
126) کریمة 27 نوح.
127) کریمتان 110 الکهف، 6 فصّلت.