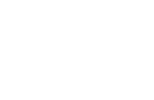بسم اللّه الرحمن الرحیم
و به نستعین
یا من اعترافنا بالذنب لدیه سببٌ لمغفرته و طلب التوبة منه موجبٌ لشمول رحمته، نحمدک على ما عرّفتنا سبیل ربوبیّتک و نشکرک على ما ألهمتنا طریق عبودیّتک؛ و الصلاة و السلام على نبیّک محمّدٍ ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ الّذی هو شفیع أمّته، و على آله الّذین هم أمناؤک فی خلقک من بعده.
و بعد؛ فیقول العبد المعترف لمعصیته طول عمره و المعترف بالسیّئة عند ربّه محمّد باقر بن السیّد محمّد ـ غفر اللّه ذنوبهما بمحمّدٍ و آله ـ: هذه اللمعة الثانیة عشرة من الشرح المسمّى بلوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة ـ علیه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ غیر متناهیةٍ ـ.
وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ ـ عَلَیْهِ السَّلاَمُ ـ فِی الاعْتِرَافِ وَ طَلَبِ التَّوْبَةِ إِلَى اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ.
«الاعتراف»: الاقرار؛ روى فی الکافی(1) بسنده عن أبی عبداللّه – علیه السلام ـ قال:
«و اللّه ما خرج عبدٌ من ذنبٍ باصرارٍ، و ما خرج(2) من ذنبٍ إلّا باقرارٍ»؛
و عن أبیجعفر – علیه السلام ـ قال: «لا و اللّه! ما أراد اللّه من الناس إلّا خصلتین: أن یعترفوا له بالنعم فیزیده بهم(3)، و بالذنوب فیغفرها لهم!»(4)؛
و عنه – علیه السلام ـ قال: «و اللّه ما ینجو من الذنوب(5) إلّا من أقرّ بها(6)»(7)
قال – علیه السلام ـ :
اللَّهُمَّ إِنَّهُ یَحْجُبُنِی عَنْ مَسْأَلَتِکَ خِلاَلٌ ثَلاَثٌ، وَ تَحْدُونِی عَلَیْهَا خَلَّةٌ وَاحِدَةٌ.
الضمیر فی «إنّه» للشأن.
و «یحجبنی» أی: یمنعنی، من: حَجَبه حَجْباً ـ من باب قتل ـ: منعه.
<و «المسألة» هنا مصدرٌ میمیٌّ؛ یقال: سألت اللّه العافیة سؤالاً و مسألةً أی: طلبتها.
و «الخِلال» ـ بالکسر ـ: جمع خلّة بمعنى الخصلة(8)، و هی الحالة>(9)؛ أی: خصالٌ ثلاثٌ.
و «تحدونی» أی: تبعثنی، من: حدوته على کذا أی: بعثته علیه. و أصله من: حدوت الإبل: إذا حثثتها على السیر بالحداء ـ و هو الغناء لها، لأنّه من أکبر الأشیاء على سوقها و بعثها ـ.
یَحْجُبُنِی أَمْرٌ أَمَرْتَ بِهِ فَأَبْطَأْتُ عَنْهُ، وَ نَهْیٌ نَهَیْتَنِی عَنْهُ فَأَسْرَعْتُ إِلَیْهِ، وَ نِعْمَةٌ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَیَّ فَقَصَّرْتُ فِی شُکْرِهَا.
«یحجبنی» استینافٌ، کأنّ قائلاً یقول: أیّ الخصال یحجبک و أیّها تحدوک؟؛ أجاب: بأنّه یحجبنی أمرٌ موصوفٌ بأنّک أمرت به ـ… إلى آخره – ؛ أو الجملة فی محلّ الرفع بدلٌ من الجملة الأولى ـ و هی قوله: «یحجبنی عن مسألتک» ـ، لکونها أوفى منها بتأدیة المعنى المراد لدلالتها على الخلال الحاجبة مفصّلةً، دون الأولى؛ مثل قوله ـ تعالى ـ: (وَ اتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّکُمْ بِمَا تَعمَلُونَ – أَمَدَّکُمْ بِأَنعَامٍ وَ بَنِینٍ – وَ جَنَّاتٍ وَ عُیُونٍ)(10)، فانّ دلالة الثانیة على نعم اللّه مفصّلةٌ، بخلاف الأولى.
و «الإبطاء»: خلاف الاسراع.
و «التقصیر فی» الأمر: التوانی فیه، و هو أن لایبادر إلى القیام به و لایهتمّ بشأنه.
وَ یَحْدُونِی عَلَى مَسْأَلَتِکَ تَفَضُّلُکَ عَلَى مَنْ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ إِلَیْکَ، وَ وَفَدَ بِحُسْنِ ظَنِّهِ إِلَیْکَ.
و «یحدونی» أی: یبعثنی.
و «التفضّل»: التطوّل.
«على من» أی: على کلّ شیءٍ «أقبل بوجهه إلیک»، على أنّ «من» هنا بمعنى: «ما».
اعلم! أنّ الممکن ـ کما عرفت سابقاً ـ زوجٌ ترکیبیٌّ من الوجود و المهیّة. و قد یعبّر عن «الوجود» بـ «الوجه»، لأنّ وجه الشیء هو ما یعرف منه و یشاهد و یواجه. و لاشکّ انّ ما یواجه من الممکن هو وجوده ـ لأنّه مبدء الآثار ـ، فوجه کلّ شیءٍ هو موجب بقائه و دوامه؛ و لذا قال اللّه ـ تعالى ـ: (کُلُّ شَیْءٍ هَالِکٌ إِلاَّ وَجْهَهُ)(11)
<قال بعض العرفاء: «انّ کلّ معلولٍ فهو مرکّبٌ فی طبعه من جهتین: جهةٌ بها یشابه الفاعل و یحاکیه؛
و جهةٌ بها یباینه و ینافیه، إذ لو کان بکلّه من نحو(12) الفاعل کان نفس الفاعل، لاصادراً منه، فکان نوراً محضاً؛ و(13) لو کان بکلّه من نحوٍ یباین نحو الفاعل استحال أیضاً أن یکون صادراً منه ـ لأنّ نقیض الشیء لایکون صادراً عنه ـ، فکان ظلمةً محضةً. فالجهة الأولى النورانیّة یسمّى: وجوداً، و الجهة الأخرى الظلمانیّة هی المسمّاة: ماهیّةً.
و هی غیر صادرةٍ عن الفاعل، لأنّها الجهة الّتی یثبت بها المباینة مع الفاعل، فهی جهةٌ مسلوبٌ نحوها عن الفاعل، و لاینبعث من الشیء ما لیس عنده. و لو کانت منبعثةً عن الفاعل کانت هی جهة الموافقة، فاحتاجت إلى جهةٍ أخرى للمباینة. فالمعلول من العلّة کالظلّ من النور، یشابهه من حیث ما فیه من النوریّة و یباینه من حیث ما فیه من شوب الظلمة، فکما انّ الجهة الظلمانیّة فی الظلّ لیست فائضةً من النور و لاهی من النور ـ لأنّها تضادّ النور و من أجل ذلک توقع المباینة، فکیف تکون منه!؟ ـ فکذلک الجهة المسمّاة مهیّةً فی المعلول. فثبت صحّة قول من قال: «المهیّة غیر مجعولةٍ و لافائضةٍ من العلّة»، فانّ المهیّة لیست إلّا ما کان به الشیء شیئاً فیما هو ممتازٌ عن غیره ـ: من الفاعل و من کلّ شیءٍ ـ ؛ و هو الجهة الظلمانیّة المشار إلیها ـ الّتی تنزل فی البسائط منزلة المادّة فی الأجسام ـ>(14)
<ثمّ لایختلجنّ فی وهمک انّهم لما أخرجوا المهیّة عن حیّز الجعل فقد ألحقوها بواجب الوجود و جمعوها إلیه فی الاستغناء عن العلّة، لأنّ المهیّة إنّما کانت غیر مجعولةٍ لأنّها دون الجعل ـ لأنّ الجعل یقتضی تحصّلاً(15) مّا و هی فی انّها مهیّةٌ لاتحصّل لها أصلا ـ. ألاَ ترى أنّها متى تحصّلت بوجهٍ من الوجوه ـ و لو بأنّها غیر محصّلةٍ(16) ـ کانت مربوطةً إلى العلّة حینئذٍ؟،
لأنّ الممکن متعلّقٌ بالعلّة وجوداً و عدماً؛ و واجب الوجود انّما کان غیر مجعولٍ لأنّه فوق الجعل من فرط التحصّل و الصمدیّة. فکیف یلحق ما هو غیر مجعولٍ ـ لأنّ الجعل فوقه ـ بما یکون غیر مجعولٍ ـ لأنّه فوق الجعل؟! ـ ؛ فافهم!».
و لقد أصاب الإمام الرازیّ حیث قال: «انّ القول بکون الماهیّات غیر مجعولةٍ من فروع المسألة المهیّة المطلقة، و انّها فی أنفسها غیر موجودةٍ و لامعدومةٍ»>(17)
فوجه کلّ شیءٍ هو الّذی یتوجّه به إلى اللّه؛ و قد مرّ سابقاً انّه ـ تعالى ـ هو الأوّل و الآخر والمبدء و الغایة لکلّ شیءٍ، فالأشیاء کلّها مخلوقةٌ لأن یتقرّبوا إلى اللّه و یتوجّهوا نحوه. فهم مسافرون إلیه سائرون فی سبیله متوجّهون نحوه؛ (وَ لِکُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَیرَاتِ)(18)
و قال الفاضل الشارح: «معنى «أقبل بوجهه إلیک»: أطاعک و أناب إلیک و أخلص نیّته لک، لأنّ من کان مطیعاً لغیره منقاداً له مخلصاً سریرته له فانّه یقبل بوجهه إلیه. فجعل «الإقبال بالوجه» کنایةً عن الطاعة و الانابة؛ أو معناه: أقبل بوجه قلبه و روحه فی المحبّة و العبادة و التوبة و الانابة لک»(19)؛ انتهى.
أقول: تمام ذلک: انّ کمال الإنسان منوطٌ بمعرفة الرحمن و عبادته و طاعته، و هی غایتها الّتی لأجلها خلق ـ کما فی قوله تعالى: (وَ مَا خَلَقتُ الْجِنَّ وَ الاْنسَ إِلاَّ لِیَعبُدُونِ)(20) ـ، و هی وجهه الّذی یوجب بقاءه الأخرویّ و سعادته السرمدیّة؛ و ترک الطاعة و الجهل بربّه یوجب هلاکه السرمدیّ. و تحصیل ذلک الکمال لایمکن لغیر الأنبیاء إلّا بمتابعتهم و انقیادهم، فان غیر النفوس القدسیّة لایمکنهم الأخذ من اللّه بلاواسطة معلّمٍ بشریٍّ، بل لابدّ لهم من متابعة الرسول و طاعته، فطاعتهم للرسول هی بالحقیقة طاعة اللّه؛ فلذلک الاتیان بالطاعة هو الوجه الّذی ینجو عن الهلاکة الأبدیّة و یصل إلى مقام الحیاة السرمدیّة.
قوله – علیه السلام ـ: «و وفد» أی: قدّم و ورد؛ یقال: وفد إلیه و علیه وفداً و وفوداً و وفادةً: قدّم و ورد.
قوله – علیه السلام ـ: «بحسن ظنّه»: قیدٌ یفید کمال حسن الرجاء له ـ سبحانه ـ، ففی الحدیث النبویّ: «و الّذی لا إله إلّا هو لایحسن ظنّ عبدٍ مؤمنٍ باللّه إلّا کان اللّه عند ظنّ عبده المؤمن، لأنّ اللّه کریمٌ بیده الخیرات یستحیی أن یکون عبده المؤمن قد أحسن به الظنّ ثمّ یخلف ظنّه و رجاءه، فأحسنوا باللّه الظنّ و ارغبوا إلیه»(21)
إِذْ جَمِیعُ إِحْسَانِکَ تَفَضُّلٌ، وَ إِذْ کُلُّ نِعَمِکَ ابْتِدَاءٌ.
<«إذ»: للتعلیل متعلّقٌ بـ «تفضّلک»؛ کأنّه قال: إنّ تفضّلک من غیر استحقاقٍ ثابتٌ متحقّقٌ، لأنّ جمیع احسانک تفضّلٌ من غیر استحقاقٍ ـ إذ کان ابتداءً بما لایلزم ـ>(22) لأنّ الممکن لیسٌ صرفٌ باطل الذات، لیس له شیءٌ إلّا النقص و القصور و الظلمة و الفتور، و لذا قال – علیه السلام ـ: «یامبتدءٌ بالنعم قبل استحقاقها».
و قال السیّد السند الداماد ـ رحمه اللّه ـ فی بیان هذه الفقرة: «إذ قاطبة ما سواک مستندٌ إلیک بالذات أبد الآباد مرّةً واحدةً دهریّةً خارجةً عن ادراک الأوهام، لا على شاکلة المرّات الزمانیّة المألوفة للقرائح الوهمانیّة. فطباع الإمکان الذاتیّ ملاک الافتقار إلى جدتک و مناط الاستناد إلى هباتک(23) فکما انّ النعم و المواهب فیوض جودک و رحمتک، فکذلک الاستحقاقات و الاستعدادات المترتّبة فی سلسلة الأسباب و المسبّبات مستندةٌ جمیعاً إلیک و(13) فائضةٌ بأسرها من تلقاء فیّاضیّتک»(24)؛ انتهى.
<و قال بعض الفضلاء: «الحکم بأنّ الاحسان و النعم کلّها تفضّلٌ إمّا بناءً على أنّ المراد
منهما ما یکون فی الدنیا ـ لأنّ بعض النعم الأخرویّة بالاستحقاق ـ؛ و إمّا بناءً على أنّ استحقاق بعض النعم و الاحسان کلّه تفضّلٌ»؛ انتهى.
و الظاهر من ممارسة الأخبار و الأدعیة المأثورة عن الأئمّة الأطهار: انّ الاحسان الدنیویّ و الأخرویّ و سائر المثوبات کلّها تفضّلٌ منه ـ تعالى ـ ؛ نعم! قد تفضّل ـ سبحانه ـ بأن جعل شیئاً من الثواب فی مقابلة الأعمال، و لو کافأنا حقیقةً لذهبت أعمالنا بالصغرى من أیادیه(25)>(26)
فَهَا أَنَا ذَا ـ یَا إِلَهِی! ـ. وَاقِفٌ بِبَابِ عِزِّکَ وُقُوفَ الْمُسْتَسْلِمِ الذَّلِیلِ وَ سَائِلُکَ عَلَى الْحَیَاءِ مِنِّی سُوَالَ الْبَائِسِ الْمُعِیلِ.
«الفاء» للسببیّة.
و «ها» حرف تنبیهٍ.
و «ذا» اسم إشارةٍ؛ و قد یخفّف بها نداءً بحذف الهمزة و اسقاط الألف فی الکتابة.
و «العزّ»: خلاف الذلّ. و «الوقوف بباب عزّه ـ تعالى ـ»: کنایةٌ عن الالتجاء به و الانقیاد له.
و «استسلم» أی: انقاد؛ یقال: أسلم للّه و سلّم و استسلم أی: انقاد لأمره و نهیه، کأنّه سلّم أن لاقدرة له على جلب نفعٍ أو دفع ضرٍّ.
و «على» ـ من قوله علیه السلام: «على الحیاء» ـ بمعنى: مع ـ کقوله تعالى: (وَ إِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ)(27) ـ.
و «الحیاء»: ملکةٌ نفسانیّةٌ توجب انقباض النفس و انزجارها من ارتکاب القبح العرفیّ أو العقلیّ أو الشرعیّ. و هو من الصفات المحمودة فی الإنسان لتوسّطه بین طرفین مذمومین ـ
و هما: الوقاحة الّتی هی الجرأة على القبائح؛ و الخجل الّذی هو قصور النفس و انحصارها عن الفعل الحسن ـ.
و اشتقاقه من «الحیاة»، لأنّه انکسارٌ للقوّة الحیوانیّة فیمنعها عن أفعالها، فیقال: حیی الرجل أی: انکسرت نفسه؛ کما یقال: حشى الحیوان: إذا اعتلّت حشاه.
و قیل: «هو من جودة الطبع و کرمه، و من فضائل الملکات و شرائف الصفات؛ و ما بعث اللّه نبیّاً إلّا حییئاً».
<و قال الزمخشریّ: «هو تغیّرٌ و انکسارٌ یعتری الإنسان من تخوّف ما یعاب به و یذمّ»؛ قال التفتازانیّ: «و هو تفسیرٌ للفظ الحیاء و نوع تنبیهٍ على معناه الوجدانیّ الغنیّ عن التعریف. و «تخوّف ما یعاب به» لیس یلزم أن یکون بصدور ذلک عنه، بل بمجرّد توهّمه، کما یستحیی الأرقّاء و ضعفاء القلوب فی حضور أهل الاحتشام»(28)؛ انتهى>(29) و التعریف الجامع ماذکرناه.
ثمّ اعلم! أنّ الحیاء على أقسامٍ:
بعضٌ منه من فضائل القوّة الشهویّة، و هو الممدوح منه؛
و بعضٌ آخر من رذائل الغضبیّه من طرف التفریط، و هو المذموم منه. و الأصحاب أطلقوا الکلام فی عدّةٍ من أنواع العفّة، و لعلّ مرادهم القسم الأوّل خاصّةً ـ کما یظهر من تفسیرهم ـ. فالاستحیاء من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مع تحقّق الشرائط ـ و عن أمثال ذلک ـ من ذمائم الصفات؛
فمنه ما هو محرّمٌ شرعاً ـ مثل ذلک -، و یدلّ علیه ما یدلّ على حرمة التهاون فیهما ـ کما هو مقرّرٌ فی محلّه ـ ؛
و منه ما هو مکروهٌ، مثل الاستحیاء عن بعض المستحبّات ـ کالامامة و الوعظ ـ فیما لایشمل على خطرٍ؛
و منه ما لیس کذلک، بل هو مباحٌ، إلّا انّه لترتّبه على ضعف النفس المذموم یستحسن ترکه و ان لم یکن بخصوصه مرجوحاً؛ فافهم!.
قال بعض العلماء: «الحیاء على وجوهٍ:
حیاء الجنایة، کحیاء آدم حیث نودی: «أ فرارٌ منّا؟
قال: بل حیاءٌ منک»(30)؛
و حیاء التقصیر، کالملائکة یقولون: سبحانک ما عبدناک حقّ عبادتک ـ قیل: عند رؤیة الآلآء و التقصیر یتولّد بینهما حالٌ للعبد یسمّى: الحیاء ـ ؛
و حیاء الاجلال، و ذلک حیاء إسرافیل. و قد قیل فی توجیه نسبة الحیاء إلى اللّه ـ تعالى، کما ورد فی الأحادیث، کما روی عن سلمان الفارسیّ رحمه اللّه عن النبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم: «إنّ اللّه حیییٌ کریمٌ یستحیی إذا رفع العبد إلیه یدیه أن یردّهما صفراً حتّى یضع فیها خیراً»(31)، و کما ورد فی الحدیث أیضاً: «إنّ اللّه یستحیی من ذی الشیبة المسلم أن یعذّبه» ـ وجهان:
أحدهما ـ و هو القانون فی أمثال ذلک، و هوـ: أن یراد بها نفی المقابلات لتلک الصفات و مبادیها، أو اثبات الغایات لها بدون تلک المبادی، فانّ کلّ صفةٍ محمودةٍ تثبت للنفس الإنسانیّة بمشارکة الجسم فله مبدءٌ انفعالیٌّ و غایةٌ فعلیّةٌ و أضداد قبیحة، فالحیاء مثلاً حالةٌ و صفةٌ عارضةٌ للانسان، و لکن لها مبدءً و منتهىً و ضدّاً؛
أمّا المبدء: فهو التغیّر النفسانی و الانفعال الجسمانیّ الّذی یعتریه من خوف أن ینسب إلى
القبیح؛
و أمّا النهایة: فهی أن یترک الفعل المنوط به؛
و أمّا الضدّ: فهو الوقاحة أو الخجل؛ فاذا ورد الحیاء فی حق اللّه فلیس المراد ذلک الخوف الّذی هو مبدء الحیاء و مقدّمته و معدّه، بل إمّا نفی ضدّه ـ الّذی هو الوقاحة ـ، أو ثبوت غایته ـ الّذی هو ترک الفعل المنوط به ـ ؛
و ثانیهما: إنّ للّه ـ تعالى ـ وسائط هم خلفاء اللّه إلى عباده و نوّابه فی سمائه و أرضه کالملائکة و الرسل من حیث إنّ فعلهم فعله و إطاعتهم إطاعته، من أطاعتهم فقد أطاع اللّه و من أبغضهم فقد أبعض اللّه ـ کما فی قوله سبحانه: (قُلْ إِنْ کُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبکُمُ آللَّهُ)(32)، و کما فی قوله صلّى اللّه علیه و آله و سلّم: «من أطاعنی فقد أطاع اللّه و من أبغضنی فقد أبغض اللّه»(33)، و کما روی عنه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم أیضاً انّه قال: «من رءانى فقد رأی الحقّ»(34) ـ. و هذا بابٌ شریفٌ ینتفع به فی معرفة کثیرٍ من الآیات القرآنیّة، و
به یصحّح کثیراً من المسائل الدینیّة، کاثبات الغضب و الانتقام و الحیاء و الرحمة، و کمسئلة البداء و اثبات الإرادة المتجدّدة و سنوح المسبّبات المتغیّرة فی قضاء الحاجات و اجابة الدعوات، إلى غیر ذلک من الحوادث المتجدّدة بالإرادات المتغیّرة ـ. فعلى هذا یکون معنى «غضب اللّه علیهم»: انّه غضب ملائکة اللّه علیهم؛ و معنى «فینتقم اللّه منهم»: انّه تنتقم ملائکة العذاب و سدنة الجحیم منهم؛ و هکذا قیاس غیرهما»؛ انتهى.
أقول: قد حقّقنا لک مراراً انّ حقیقةً واحدةً لها عوالم متعدّدة و أحکامٌ مختلفةٌ، بل لکلّ موجودٍ فی هذا العالم من الجواهر و الأعراض عوالم متعدّدة فوق هذا العالم، نسبة الأسفل إلى الأعلى نسبة الشهادة إلى الغیب و نسبة البدن إلى الروح و نسبة الظلّ إلى الشخص. مثاله
صورة المحسوس فی الخارج، فانّها کثیفٌ مادّیٌّ قابلٌ للانقسام، فإذا ارتسم فی القوّة الباصرة زال عنه کثیرٌ من النقائص و بقی الکثیر ـ کأصل المقداریّة و اللون و الحاجة إلى المحلّ المرکّب من الأضداد و شرائط المقابلة و الوضع إلى ما أخذ منه أو ما فی حکمه ـ ؛ و إذا ارتفع إلى عالم الخیال خلص عن بعض النقائص و العیوب و بقى البعض؛ ثمّ إذا جاء إلى عالم العقل تجرّد و تطهّر عن النقائص و العیوب کلّها إلّا الإمکان و الحدوث؛ فإذا رجع إلى ما فی عالم اللّه و عالم الأسماء الإلهیّة و صور الأعیان الثابتة الّتی غیر مجعولةٍ مقدّسةٍ عن جهات الکثرة و الإمکان کلّها ـ فانّ صورة علم اللّه من حیث هی صورةٌ علمیّةٌ واجبةٌ بوجوبه، و کذا الحال فی جمیع الذوات و الصفات؛ لأنّ العوالم المترتّبة فی الشرف و الدناءة کلّها صور ما فی علم اللّه و منازل صفاته و آیاته، و هذه النقائص و الشرور انّما لحقتها فی هذا العالم و فی المراتب النازلة لبُعدها عن منابع الخیرات. و بالجملة ما من شیءٍ فی هذا العالم إلّا و ینتهی أصله و سرّه إلى حقیقةٍ إلهیّةٍ و سرٍّ سبحانیٍّ و أصلٍ ربّانیٍّ و مطلعٍ أسمائیٍّ و شرفٍ قیّومیٍّ، و یکون نحو وجوده فی عالم الوحدة الجمعیّة الإلهیّة معرّاً عن کلّ کثرةٍ و شوبٍ مبرّاً عن کلّ نقصٍ و عیبٍ؛ و هکذا فی جمیع ما ینسب إلیه ـ تعالى ـ من الصفات التشبیهیّة ـ کالحیاء و الغضب و الانتقام و الرحمة و الرضا و الصبر و الشکر و القبض و البسط و السمع و البصر و الشوق و اللطف و ما أشبهها، و کذلک الید و الیمین و القلم و اللوح و الکتابة و الذهاب و المجیء و الجنب و القدم و الوجه و العین و ما یجری مجراها ـ. فمن عرف ما ذکرناه فتح على قلبه بابٌ عظیمٌ من علوم المکاشفة.
<و «البائس»: من بئس یبأس بؤساً ـ من باب علم ـ: الشدید الحاجة، و هو من البؤس بمعنى الضرّ؛ عن الصادق - علیه السلام ـ: «الفقیر: الّذی لایسأل الناس؛ و المسکین: أجهد منه؛ و البائس: أجهدهم»(35)
و «المعیل»: اسم فاعلٍ من أعال؛ إمّا بمعنى>(36): کثیر العیال ـ و فی الحدیث: «إنّ قلّة
العیال أحد الیسارین»(37)، کما انّ کثرة العیال أحد الفقرین ـ ؛ و إمّا بمعنى: افتقر، فقد حکى
صاحب القاموس: «عال ـ بالألف ـ بمعنى: افتقر»(38) شبّه سؤاله بسؤال البائس المعیل فی کمال الاحتیاج و الاضطرار؛ أو فی الالحاح.
مُقِرٌّ لَکَ بِأَنِّی لَمْ أَسْتَسْلِمْ وَقْتَ إِحْسَانِکَ إِلاَّ بِالإِقْلاَعِ عَنْ عِصْیَانِکَ.
«الاقلاع»: الکفّ، یقال: أقلع عمّا کان علیه: إذا کفّ عنه.
<عدّت هذه الفقرة من المشکلات، لأنّ دأبه - علیه السلام ـ الاعتراف بالمعصیة و الجرائم؛ و أیّدوه بما وجد فی نسخة ابنأشناس و الکفعمیّ و غیرهما هذه الکلمات هکذا: «مقرٌّ لک بأنّی لمأخل فی الحالات کلّها من احسانک، و لمأسلم مع وفور احسانک من عصیانک»؛ فصرفوا ما هنا عن ظاهره باحتمالاتٍ:
الأوّل: کون معناه: انّی مقرٌّ بانّ الاستسلام وقت الاحسان لایکون منّی إلّا بالاقلاع عن المعاصی و الکفّ عنها، و لمّا لمیحصل منّی لم یحصل الانقیاد أیضاً منّی لک؛
و الثانی: انّ الاقلاع کما یکون لازماً یکون متعدّیاً، و المعنى علیه: انّی لماستسلم لک إلّا باقلاعک لی عن المعاصی و کفّی عنها منک؛
و الثالث: انّ المستثنى منه محذوفٌ، و المعنى: انّی مقرٌّ لک بأنّی لمأستسلم لک فی شکر نعمةٍ من نعمک إلّا فی شکر اقلاعک عن المعاصی؛
و الرابع: انّ المراد بـ «العصیان»: بعض أفراده الّتی احترز عنها وقت الاحسان؛
و الخامس: انّ «إلّا» عاطفةٌ ـ مثلها فی قوله تعالى: (لِئَلاَّ یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَیکُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ
آلَّذِینَ ظَلَمُوا)(39) ـ>(26)؛
و السادس: ما هو الظاهر ـ على ما قیل ـ و هو أن یقول – علیه السلام ـ: یاربّ! أقرّ لک بأنّی لم أستسلم لک وقت الإحسان إلّا کفّی عن معاصیک مع أنّه ینبغی منّی استغراق ذلک الوقت بالشکر و الحمد؛
و السابع: انّ المراد: إنّی مقرٌّ بأنّی لم آت فیما مضى بطاعةٍ تدلّ على استسلامی إلّا إقلاعی الآن عن المعاصی و الندم علیها؛ و یؤیّده ما قرأت فی بعض کلامهم: «لست أعتذر إلیک من الذنب إلّا بالاقلاع عنه أو إقلاعی فی سابق الزمان عن المعاصی، أو لم أدع حقّ طاعتک و عبادتک و السعی فی مرضاتک إلّا انّی ترکت المعاصی ـ أی: الفواحش و القبائح ـ، أو لم أصرّ علیها ـ و هو العصیان الحقیقیّ ـ، بل کلّما عرضت معصیّةٌ رجعت إلیک بالتوبة و الاستغفار».
و لایخفى ما فی هذه الوجوه من التکلّف!.
و الظاهر انّ المراد: إنّی مقرٌّ بأنّی لا أعدّ مستسلماً و مطیعاً ـ أو لایتمّ منّی الانقیاد و الخضوع لاحسانک ـ إلّا بالکفّ عن المعصیة أصلا مع أنّی لم أخل فی حالٍ عن نعمةٍ منک علیَّ، فالواجب علیَّ أن لا أعصیک أبداً.
وَ لَمْ أَخْلُ فِی الْحَالاَتِ کُلِّهَا مِنِ امْتِنَانِکَ. فَهَلْ یَنْفَعُنِی ـ یَا إِلَهِی! ـ إِقْرَارِی عِنْدَکَ بِسُوءِ مَا اکْتَسَبْتُ؟ وَ هَلْ یُنْجِینِی مِنْکَ اعْتِرَافِی لَکَ بِقَبِیحِ مَا ارْتَکَبْتُ؟.
«الخلأ»: الفراغ.
<و «الحالات»: جمع حالة ـ بمعنى: الحال ـ، و هی ما یکون علیه الإنسان من الصفة.
و «الامتنان»: افتعالٌ من المنّة بمعنى: الانعام.
و «السوء»: القبیح، یقال: ساء الشیء یسوء سوءً: قبح؛ و قیل: «السوء ما یظهر مکروهه لصاحبه».
و «کسب» الإثم و اکتسبه: تحمّله. و قال الواحدیّ: «انّ الکسب و الاکتساب واحدٌ»(40)؛
و قیل: «الاکتساب أخصّ، لأنّ الکسب لنفسه و لغیره و الاکتساب ما یکتسب لنفسه خاصّةً»(41)؛ و قیل: «فی الاکتساب مزید أعمالٍ و تصرّفٍ، و لهذا خصّ بجانب الشرّ فی قوله ـ تعالى ـ: (لَهَا مَا کَسَبَتْ وَ عَلَیهَا مَا آکْتَسَبَتْ)(42) دلالةً على أنّ العبد لایؤاخذ من السیّئات إلّا بما عقد الهمّة علیه و ربط القلب به؛ بخلاف الخیر، فانّه یثاب علیه کیف ما صدر عنه»(43) قال الزمخشریّ: «فان قلت: لم خصّ الخیر بالکسب و الشرّ بالاکتساب؟
قلت: فی الاکتساب اعتمالٌ، فلمّا کان الشرّ ممّا تشتهیه النفس و هی منجذبةٌ إلیه و أمّارةٌ به کانت فی تحصیله أعمل و أجدّ، فجعلت لذلک مکتسبةً فیه؛ و لمّا لم تکن کذلک فی باب الخیر وصفت بما لادلالة فیه على الاعتمال»(44)؛ انتهى>(45).
و «القبیح»: ما لیس للقادر علیه أن یفعله. و قیل: «القبیح ما یکون متعلّق الذمّ فی العاجل و العقاب فی الآجل».
و الأصل فی «الرکوب» أن یکون فی الدابّة، ثمّ استعیر فی الإثم و الدین؛ فقیل: رکبت الإثم و ارتکبته: إذا أکثرت من فعله أو تحمّله.
و الاستفهام من باب تجاهل العارف و سوق المعلوم مساقّ غیره.
أَمْ أَوْجَبْتَ لِی فِی مَقَامِی هَذَا سُخْطَکَ؟، أَمْ لَزِمَنِی فِی وَقْتِ دُعَائِی
مَقْتُکَ؟. سُبْحَانَکَ، لاَ أَیْأَسُ مِنْکَ وَ قَدْ فَتَحْتَ لِی بَابَ التَّوْبَةِ إِلَیْکَ.
«الوجوب»: اللزوم و الثبوت، و «أوجبه»: ألزمه و أثبته.
<و «المَقام» ـ بالفتح ـ: موضع القیام. و یحتمل أن یکون المراد من «المَقام»: الحسّیّ و المعنویّ.
و «سَخَطک» بالفتح و التحریک بمعنى: الغضب؛ و بالضمّ و السکون ـ کقفل ـ اسمٌ منه>(46)
و «سبحانک» یجوز تعلّقه بما قبله و ما بعده؛ و معناه: أنزّهک عمّا لایلیق بجناب قدسک و عزّ جلالک. و هو مضافٌ إلى المفعول، و جوّز کونه مضافاً إلى الفاعل ـ بمعنى: التنزّه ـ.
و قال بعض الأعلام: «التنزیه المستفادّ من «سبحان اللّه» ثلاثة أنواعٍ:
تنزیه الذات عن نقص الإمکان ـ الّذی هو منبع الشرّ ـ ؛
و تنزیه الصفات عن وصمة الحدوث، بل عن کونها مغایرةً للذات المقدّسة و زائدةً علیها؛
و تنزیه الأفعال عن القبیح و العبث و عن کونها جالبةً إلیه ـ تعالى ـ نفعاً أو دافعةً عنه ـ سبحانه ـ ضرّاً ـ کأفعال العباد ـ.
و «یَئِس» من الشیء ییأس ـ من باب تعب ـ: قنط، فهو یائسٌ، و الشیء میؤوسٌ منه ـ على فاعلٍ و مفعولٍ ـ، و المصدر: الیأس ـ مثل فَلْس ـ. و یجوز قلب الفعل دون المصدر، فیقال: أیس یأساً؛ و فی القاموس: «أیس منه(47) إیاساً: قنط»(48)، فجعل إیاساً مصدر أیس.
لکن قال ابن سیدة فی محکم اللغة: «أمّا یئس و أیس فالأخیرة مقلوبةٌ عن الأولى، لأنّه لامصدر لأیس. و لایحتجّ بإیاسٍ ـ: اسم رجلٍ ـ، فانّه فِعَالٌ من الأوس، و هو العطاء ـ کما
یسمّى الرجل عطیّة وهبة اللّه»(49)؛ انتهى.
و فقره الدعاء وردت على الوجهین:
لا آیسٌ منک ـ على أنّه مستقبل أیس، و الأصل: أیأس بهمزتین، الأولى للمضارعة و الثانیة فاء الکلمة ـ، على ما هو فی النسخة المشهورة؛
و: لا أیأس منک ـ على أنّه مستقبل یئس ـ، على ما هو فی نسخة ابن ادریس(50)
و لمّا کان فی استفهامه – علیه السلام ـ السابق ما یشمّ رائحة الیأس و القنوط ـ لاظهار کمال الخوف و الخشیة الّذی غلب على الإمام فی هذه الحالة ـ نزّهه عن أن ییأس منه و یقنط من رحمته و الحال انّه قد فتح له باب التوبة، فجمع – علیه السلام ـ بین الخوف و الطمع؛ کما أمر اللّه ـسبحانه ـ به حیث قال: (ادْعُوهُ خَوفاً وَ طَمَعاً)(51) روى حرث بن المغیرة و أبوه عن الصادق – علیه السلام ـ قال: قلت له: ما کان فی وصیّة لقمان؟
قال: «فیها الأعاجیب، و کان أعجب ما فیها أن قال لابنه: خف اللّه – عزّ و جلّ ـ خیفةً لو جئته ببرّ الثقلین لعذّبک، و ارج اللّه رجاءً لو جئته بذنوب الثقلین لرحمک». ثمّ قال أبو عبداللّه: «کان أبی یقول: انّه لیس من عبدٍ مؤمنٍ إلّا فی قلبه نوران: نور خیفةٍ، و نور رجاءٍ، لو وزن هذا لم یزد على هذا !»(52)
ثمّ ترقّى – علیه السلام ـ فی مراتب الرجاء فقال:
بَلْ أَقُولُ مَقَالَ الْعَبْدِ الذَّلِیلِ الظَّالِمِ لِنَفْسِهِ الْمُسْتَخِفِّ بِحُرْمَةِ رَبِّهِ؛ الَّذِی
عَظُمَتْ ذُنُوبُهُ فَجَلَّتْ، وَ أَدْبَرَتْ أَیَّامُهُ فَوَلَّتْ.
قال الفاضل الشارح: «بل حرف اضرابٍ، فان تلاها جملةٌ کان معنى الاضراب إمّا الابطال لما قبلها ـ نحو: (وَ قَالُوا اتَّخَذَ آلرَّحمَنُ وَلَداً سُبحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُکْرَمُونَ)(53)، أی: بل هم عبادٌ، و نحو: (أَمْ یَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ)(54) ـ ؛ و إمّا الانتقال من غرضٍ إلى استیناف غرضٍ آخر ـ نحو: (قَدْ أفْلَحَ مَنْ تَزَکَّى – وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهُ فَصَلَّى – بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَیَاةَ آلدُّنیَا)(55) ـ. و نحوه عبارة الدعاء، إذ لیس الغرض من الإضراب فیها الانتقال من
الکلام الأوّل إلى معنىً آخر. و هی فی ذلک کلّه حرف ابتداءٍ، لا عاطفةٍ ـ على الصحیح ـ، و إن تلاها مفردٌ فهی عاطفةٌ»(56)؛ انتهى کلامه.
و هو کما ترى!. بل الظاهر ما ذکرناه من الترقّی، لا الاضراب.
و «الظلم»: النقص، قال اللّه ـ تعالى ـ : (کِلْتَا الْجَنَّتَینِ آتَتْ أُکُلَهَا وَ لَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَیْئاً)(57)، <أی: لم تنقص. و قیل: «وضع الشیء فی غیر موضعه».
و «استخفّ بحقّه»: استهانه، کأنّه عدّه خفیفاً فلم یعبأ به.
و «الحُرمة» ـ بالضمّ ـ: ما یجب القیام به و حرم التفریط فیه و لم یحلّ انتهاکه>(58) قال
بعض الأعلام: «قوله – علیه السلام ـ: «بحرمة ربّه»، ینبغی الوقف علیه حتّى یکون مابعده کلاماً مستأنفاً، و لذا یرقم: «ظ» أو «م» ـ أی: انّه وقفٌ مطلقٌ أو لازمٌ ـ»(59)
<و «الفاء» فی قوله - علیه السلام ـ: «فجلّت» للتعقیب. و العطف بها یدلّ على أنّ بین العظم و الجلالة فرقاً، لأنّهما لوکانا مترادفین ـ کما یظهر من کتب اللغة ـ لما جاز العطف بها، لأنّ عطف الشیء على مرادفه ممّا یختصّ به الواو و لایشارکها فیه غیرها من حروف العطف. و یمکن أن یعتبر العظم بحسب الکمّیّة ـ کما یقال: جیشٌ عظیمٌ: إذا کان کثیر العدد ـ،
و الجلالة بحسب الکیفیّة، فانّ الذنوب إذا کثرت و ترادفت عظم خطرها فصارت جلیلةً!؛ و عن أبی عبداللّه – علیه السلام ـ: «إنّ رسول اللّه نزل بأرضٍ قرعاء، فقال لأصحابه: ایتونی(60) بحطبٍ،
فقالوا: یا رسول اللّه! نحن بارضٍ قرعاء ما بها من حطبٍ!
قال: فلیأت کلّ إنسانٍ بما قدر علیه. فجاؤوا به حتّى رموه(61) بین یدیه بعضه على بعضٍ، فقال رسول اللّه: هکذا تجتمع الذنوب!»(62)>(58)
و «الإدبار»: خلاف الإقبال.
و «ولّى» و «تولّى» أی: ذهب و اعرض، فالتولّی بعد الإدبار؛ فصحّ العطف بالفاء التعقیبیّة.
حَتَّى إِذَا رَأَى مُدَّةَ الْعَمَلِ قَدِ انْقَضَتْ وَ غَایَةَ الْعُمُرِ قَدِ انْتَهَتْ، وَ أَیْقَنَ أَنَّهُ لاَ مَحِیصَ لَهُ مِنْکَ وَ لاَ مَهْرَبَ لَهُ عَنْکَ.
«حتّى» عند الجمهور هی الابتدائیّة دخلت على الجملة الشرطیّة، و هی على ذلک غایةٌ لما قبلها ـ و هو الظلم لنفسه … إلى آخره ـ. <و استشکل بعضهم هذا و قال: «کیف تکون غایةً لما قبلها و بعدها جملة الشرط؟»؛
و أجیب: «بأنّ الغایة فی الحقیقة هو ما ینسبک من الجواب مرتّباً على فعل الشرط؛ فالتقدیر: بل أقول مقال من لم یزل ظالماً لنفسه مستخفّاً بحرمة ربّه إلى أن تلقاک بالأنابة و أخلص لک التوبة وقت رؤیته: مدّة العمل قد انقضت و غایة العمر قد انتهت ـ… إلى آخره ـ».
و قیل: «هی فی مثل ذلک غایةٌ لجواب الشرط، على معنى: انّه لمّا رأى مدّة العمل قد انقضت و غایة العمر قد انتهت تلقاک بالإنابة».
و زعم الأخفش و ابن مالک أنّها الجارّة، و انّ «إذا» فی موضع الجرّ بها، و على هذا فیکون تقدیر الغایة: «لم یزل ظالماً لنفسه مستخفّاً بحرمة ربّه إلى وقت رؤیته مدّة العمل قد انقضت»؛ و هی على هذا لاجواب لها ـ لأنّها معمولةٌ لما قبلها ـ. فیکون قوله: «تلقاک بالأنابة» استینافاً و جواب سؤالٍ، کأنّه سئل: فما کان منه إذ ذاک؟، فقال: تلقاک بالأنابة.
و «العمل»: فعل الإنسان الصادر عن قصدٍ و علمٍ. و المراد به هنا: ما یستحقّ به الثواب و ینجی من العقاب.
قوله: «و غایة العمر».
«الغایة»: النهایة.
و «العمر»: الحیاة.
و قوله: «انقضت و انتهت» من باب التعبیر بالفعل عن مشارفته؛ أی: رأى مدّة العمل قد شارفت الانقضاء و غایة العمر قد شارفت الانتهاء ـ کقوله تعالى: (وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ)(63)، أی: فشارفن انقضاء العدّة ـ>(64) ؛ فعلى هذا فالجملتان مفعولتان لـ «رأى» بمعنى: علم، کما تقول: رأیت زیداً قد استغنى و طغى.
قوله: «و أیقن انّه».
«الیقین»: فعیلٌ بمعنى فاعلٍ، یقال: یَقِنَ الأمر یَیقَنُ یقیناً ـ من باب تعب ـ: إذا ثبت و وضح، فهو یقینٌ. و یستعمل متعدّیاً بنفسه، و بالباء، و بالهمزة و الباء؛ فیقال: یقّنته، و یقّنت به، و أیقنت به، و تیقّنته، و استیقنته إذا علمته. و الأصل و أیقن بأنّه فحذف الباء لأنّ حذف حرف الجرّ مطّردٌ مع انّ. و انّه ضمیر الشأن.
و للـ «یقین» معنیان:
أحدهما ـ و هو الشائع ـ: الاعتقاد الثابت الجازم المطابق للواقع الّذی لایتصوّر فیه شکٌّ و لایزول بشبهةٍ ـ سواءٌ کان بدیهیّاً أو نظریّاً ـ، فخرج الجهل المرکّب و البسیط و الشکّ. فإن اعتبرنا الأخیر فی العلم کانا مترادفین، و إلّا کان نوعاً منه. و على هذا التفسیر لایوصف بالضعف و القوّة ـ إذ لاتفاوت فی نفی الشکّ ـ ؛
و ثانیهما: للعرفاء و الصوفیّة، و هو: میل النفس إلى التصدیق بشیءٍ و استیلائه على القلب بحیث یصیر هو الحاکم المتصرّف فیه بالأمر و النهی و المنع و التحریص. و لاشکّ فی أنّ الناس یشترکون فی القطع بالموت و عدم الشکّ فیه، لکن أکثرهم لایلتفتون إلیه، فکأنّهم لم یؤمنوا به. و فیهم من استغرق همّه فیه بالاستعداد له؛ و هو بهذا التعبیر یوصف بالقوّة و الضعف. و مراتبه لایتناهى بحسب استعداد الناس للوصول إلیه ـ بحسب استعداد المدرک و صفائه و نقائه عن الحجب الحسّیّة و کدورة الظلمات الطبیعیّة ـ.
و هو منقسمٌ إلى أقسامٍ ثلاثةٍ: علم الیقین؛ و عین الیقین؛ و حقّ الیقین؛
و الأوّل هو الانتقال من الملزوم إلى اللازم و بالعکس، کالعلم بوجود النار من مشاهدة الدخّان. و لایترتّب علیه کثیر أثرٍ من استیلائها على القلب و تصرّفها فیه بالأمر و النهی و القبض و البسط، کما لایترتّب على العلم بالتواتر بکون(65) الأسد فی الطریق من الدهشة و الاضطراب و تغیّر اللون و رجف الأعضاء إلّا قلیلٌ لایکمل به المطلوب. و قال صدرالحکماء و المحقّقین: «فالأوّل هو التصدیق بالأمور النظریّة الکلّیّة مستفادّاً من البرهان ـ کالعلم بوجود الشمس للأعمى ـ»(66)؛
و الثانی: مشاهدة المطلوب بالبصیرة الباطنة الحاصلة من التصفیة و تجرّد النفس و صفائها من عالم الطبیعة ـ کالیقین الحاصل بوجود النار من مشاهدتها بهذا البصر الحسّیّ ـ ؛ و قد أشار ـ سبحانه ـ إلیه بقوله: (ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِینِ)(67)، و قال أمیرالمؤمنین – علیه
السلام ـ لمّا سأل عنه ذعلب الیمانی: «هل رأیت ربّک؟
قال: لم أعبد ربّاً لم أره!»(68)؛
و الثالث: هو مشاهدة الآثار و الأنوار بسبب الدخول فی النار. و قال صدرالحکماء و المحقّقین أیضاً: «و الثالث صیرورة النفس متّحدةً بالمفارق العقلیّ ـ الّذی هو کلّ المعقولات ـ. و لایوجد له مثالٌ فی عالم الحسّ ـ لعدم امکان الإتّحاد بین شیئین فی الجسمانیّات ـ»(66)
و هذان القسمان الأخیران لایحصلان للإنسان إلّا بعد مجاهداتٍ عظیمةٍ ـ بهجر الرسوم و العادات و ترک العلائق و الشهوات و قطع الوساوس النفسانیّة و قلع الهواجس الشیطانیّة و قصر النظر فی ملاحظة أنوارها الجمالیّة و مشاهدة سطواته الجلالیّة و الاستغراق فی بحر معرفته و أنسه و الفناء فی الحضرة الأحدیّة ـ حتّى یحصل للنفس صفاءٌ و تجرّدٌ تامٌّ و وضعٌ و محاذاةٌ للمبادی العالیة، فانّها کمرآةٍ متحاذیةٍ ینعکس إلیها صور الموجودات المرتسمة. فلابدّ لها من خمسة أشیاء:
عدم نقصان جوهرها، فلایکون کالصبیّ الغیر القابل لتجلّی المعلومات؛
و صفائها عن أخباث الشهوات، و نقائها عن الرسوم و العادات، کما یعتبر فی المرآة صقالتها عن الخبث؛
و الصداء من التوجّه التامّ إلى المطلوب، فلایکون له ما یشوّش الخاطر من أسباب التعیّش و العلائق الدنیویّة، کما یعتبر فی المرآة محاذاتها لذات الصورة؛
و من تخلّیها من التعصّب و التقلید، کما یعتبر فیها ارتفاع الحاجب بینها و بین ذات الصورة؛
و من استحصال المطلوب من ترتیبٍ مخصوصٍ للمقدّمات المناسبة له بشرائطها، کما یعتبر فیها العثور على الجهة الّتی فیها الصورة. فبعد حصول الشرائط المذکورة ینتقش فیها عالم الملک و الشهادة لتناهیه، فیمکن الاحاطة به؛ و عالم الملکوت و الجبروت بقدر ما یمکنه بحسب مرتبته ـ لکونها من الأسرار الّتی لاتدرک بالأبصار ـ، بل بعین البصیرة و الاعتبار. و ما یلوح منها للنفس أیضاً متناهٍ و إن کانت فی نفسها و بالاضافة إلى علمه ـ تعالى ـ غیر متناهیةٍ. و مجموع ما ذکر من العوالم هو العالم الربوبیّ ـ لانتساب الموجودات بأسرها إلیه تعالى ـ. و هو العالم المحیط بکلّها، فلاتحیط به النفس لعدم تناهیه؛ بل تحصل لها السعادة و اللذّة بقدر استعدادها و قوّتها و ما یحصل لها من التصفیة و التزکیة و تجلّی الحقائق و الأسرار و معرفة صفاته و عظمته و سعة مملکته بقدر المعرفة الحاصلة لها بذلک.
و لعدم تناهیه لاتستقرّ النفس فی مقامٍ یکون غایةً لطلبها من الکمال و المعرفة أبداً.
و اعلم! أنّ العرفاء قرّروا فوق الأقسام الثلاثة للیقین قسماً رابعاً، و سمّوها بـ «حقیقة حقّ الیقین»(69) و «مرتبة الفناء»(70)؛ و هو أن یرى العارف ذاته فیضمحلّه فی أنوار اللّه ـ تعالى ـ محترقةً من سبحات وجهه بحیث لایرى لها تحصّلاً أصلاً ـ کالدخول فی النار و احتراقه بها!ـ.
قال بعض العارفین ـ رحمهم اللّه ـ: «إنّ هذه المراتب من أقسام السعادة؛
فالأولى یتوقّف على السعادة البدنیّة حال کون الإنسان ملابساً بالمادّة الهیولانیّة مقارناً للجواهر السفلانیّة متوغّلاً فی المعارف الإلهیّة؛
و الثانیة غیر متوقّفةٍ علیها، و هی عند التجرّد عن الملابس الحسّیّة و المفارقة عن الکدورات الإنسیّة مخالطاً بالملأ الأعلى القدسیّة؛ قال اللّه ـ تعالى ـ: (کَلاَّ لَو تَعلَمُونَ عِلْمَ
الْیَقِینِ – لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ – ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ آلْیَقِینِ)(71)؛
و کذا الثالثة و الرابعة، لکنّهما عند انقطاع العارف عن ذاته و صفاته و انغماسه فی بحار الألوهیّة و غمراته و انتفاء أنّیّته و نعته.
و أهل المرتبة الأولى هم الحکماء و العلماء المحقّقون؛
و أهل المرتبة الثانیة قسمان:
قسمٌ غلبت علیهم الروحانیّة و استولت السلطنة العقلیّة، فهم غافلون عن عالم الحسّ متوجّهون إلى عالم القدس فلم یتفرّغوا لتدبیر المعاش و حفظ النظام. و هو صنفٌ من المتصوّفة و الحکماء، و منهم المجانین العقلاء ـ کلقمان السرخسی و غیرهم ـ. فهم ناقصون عن رتبة الهدایة و إن کانوا واصلین إلى مطلوبهم الأصلیّة؛
و قسمٌ تمکّنوا فی هذا المقام من استعمال القوّة البشریّة و استقاموا إلى اللّه فی جمیع الأحوال النظریّة و العملیّة، و وقفت قوّتهم ـ لفرط طمأنینتهم و سکینتهم ـ لضبط الأمور الکلّیّة و الجزئیّة، فشرعوا فی تکمیل الناقصین المستعدّین و تنکیل الطاغین المتمرّدین و تنظیم قواعد العدالة و الحفظ لبنی نوع الإنسان؛ فهم الأنبیاء و المرسلون و الأوصیاء المعصومون.
و أهل المرتبة الثالثة و الرابعة هم أهل الوحدة و أهل اللّه ـ: الّذین تصفوا عن شوائب التعدّد و الإثنینیّة و تخلّوا عن عوائق التحیّز و الإثنینیّة ـ. فهم و إن کانوا من الواصلین و أهل القرب و التمکین إلّا أنّهم ناقصون أیضاً عن مرتبة أهل الصفوة من الأنبیاء و المرسلین، لأنّهم محجوبون عن رؤیة جمال الوحدة و کماله فی النشأتین. بل مرتبتهم مرتبة الجمع لا مرتبة جمع الجمع ـ الّتی هی أکمل مراتب الإنسان -. و بالجملة هو أشرف الفضائل و الکمالات، و هو الکبریت الأحمر الّذی لایظفر به إلّا الخلّص من ذوی السعادات و لایصل إلیه إلّا شرذمةٌ من العرفاء و قلیلٌ من کمّل الاولیاء. قال النبیّ ـ صلّى اللّه علیه و آله و
سلّم ـ: «الیقین کلّ الإیمان!»(72)؛ و قال: «من أقل ما أوتیتم الیقین و عزیمة الصبر، و من أوتی(73) حظّه منهما لم یبال ما فاته من صیام النهار و قیام اللیل(74)»(75)؛ هذا.
ثمّ اعلم! أنّ من علامات الیقین أن یعلم صاحبه أن لامؤثّر فی الوجود إلّا هو، و لا اثر إلّا هو أثره، و لایلتفت إلّا إلیه و لایتّکل إلّا علیه؛ و یستوی حالتا الفقر و الغنى و الصحّة و المرض لدیه، لأنّه یرى جمیع الأشیاء بعینٍ واحدةٍ و الوسائط مسخّرةً تحت حکمه؛ قال الصادق – علیه السلام ـ: «مَن ضعف یقینه تعلّق بالأسباب و رخّص لنفسه بذلک و اتّبع العادات و أقاویل الناس بغیر حقیقةٍ، و السعی فی أمور الدنیا و جمعها و امساکها مقرّاً باللسان انّه لامانع و لامعطی إلّا اللّه، و انّ العبد لایصیب إلّا ما رزق و قسم له و الجهد لایزید فی الرزق، و ینکر ذلک بفعله و قلبه!؛ قال اللّه ـ تعالى ـ: (یَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَیسَ فِی قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعلَمُ بِمَا یَکتُمُونَ)(76)»(77)
و فی حدیثٍ آخر: «حدّ الیقین أن لاتخاف مع اللّه شیئاً»(78)
و من علاماته أیضاً خضوع صاحبه للّه ـ تعالى ـ، و قیامه بوظائف العبادات مع المواظبة على امتثال الطاعات فارغاً قلبه عمّا سواه مصروفاً فکره فیما یوجب رضاه، لأنّه یدری قدرته و عظمته و اطّلاعه على خفایا ضمیره و علمه بأفعاله و أعماله فیکون فی مقام
الشهود أبداً و الاشتغال بوظائف الأدب دائماً. کیف لا!؟ و قد یرى انّ کلّ من یحضر عند ذوی الشوکة و الأقدار ـ من الملوک و أرباب الدول و الاعتبار مع خساستهم و رذالتهم و مجازیّة دولتهم و نعمتهم ـ یبالغ فی أقصى وظائف الأدب و الخدمة و یحصل له أعلى مراتب الخوف و الدهشة ـ سیّما إذا علم اطّلاعه على أفعاله بمخالفته لأمره و رضاه ـ ؛ فکیف و هو ملک الملوک و جبّار الجبابرة و المنعم الحقیقیّ العالم بما تخفیه الصدور!؟.
فمن تیقّن بأنّه یشاهد أعماله یجتهد أبداً فی الامتثال و الاطاعة و الدعاء و الاستکانة؛ و من أیقن باحسانه و حقوقه المتواترة یکون دائماً فی مقام الشکر و الحیاء؛ و من أیقن بما هیّأه لمحبّیه و مخلصیه فی دار الجزاء یکون دائماً فی مقام الاخلاص و الرجاء؛ و من أیقن باستناد کلّ الأشیاء إلیه على نظامٍ تقتضیه الحکمة و المصلحة یکون دائماً فی مقام التسلیم و الرضا؛ و من أیقن بالموت و مابعده من المعقّبات الهائلة یکون دائماً فی مقام البکاء؛ و من أیقن بخساسة الدنیا و فنائها لمیرکن إلیها، لما یشاهد منها عدم الوفاء ـ ففی الخبر: إنّ الکنز الّذی حکى اللّه ـ تعالى ـ للیتیمین کان مکتوباً فیه: «عجبت لمن أیقن بالموت کیف یفرح؟!، و عجبت لمن أیقن بالقدر کیف یحزن؟!، و عجبت لمن أیقن بالدنیا(79) و تقلّبها بأهلها کیف یرکن إلیها؟!»(80) ـ ؛ و من أیقن بعظمته و کمال قدرته کان فی مقام الخوف و الدهشة والخشوع ـ کما انّ رسول اللّه صلىّ اللّه علیه و آله و سلّم من شدّة خضوعه للّه تعالى إذا مشى یظنّ انّه یسقط على الأرض(81) ! ـ ؛ و من أیقن بکمالاته الغیر المتناهیة و کونه فوق التمام بمالایتناهى یکون دائماً فی مقام الشوق و الوله و الاستغراق و الغشیان فی الخلوات و غیرها
ـ کما روی عن أمیرالمؤمنین(82) علیه السلام ـ.
و من آثاره أیضاً القدرة على انحاء التصرّفات فی الکائنات على حسب مشیّتهم، فکلّما ازدادت ملکة الیقین زادت القدرة المزبورة ـ لزیادة تجرّد النفس و تشبّهها بالمبادی العالیة فی تصرّفها فی موادّ الموجودات ـ ؛ و فی الخبر عن الصادق – علیه السلام ـ: «إنّ(83) الیقین یوصل العبد إلى کلّ حالٍ سنیٍّ و مقامٍ عجیبٍ»(84)، کما أخبر رسول اللّه ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ من عظم شأن الیقین حین ذکر عنده: «انّ عیسى بن مریم کان یمشی على الماء!»، فقال – صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ: «لو زاد یقینه لمشى على الهواء کما مشى على الماء!!»(84)
و منه یظهر شدّة اختلاف مراتبه حتّى فی الأنبیاء.
قوله – علیه السلام ـ: «لامحیص له منک».
«المحیص»: الملجأ و المنجا، من: حاص یحیص حیصاً: إذا عدل و حاد؛ و قیل: «هو من حاص الحمار: إذا عدل بالفرار». و هو إمّا اسم مکانٍ ـ کالمبیت و المضیف ـ، أو مصدرٌ ـ کالمغیث و المشیب ـ ؛ أی: لامفرّ و لامخلص له منک، لأنّ الکلّ مقهورٌ تحت سطوته.
و قیل: «منک، أی: من عذابک»؛
و قیل: «أی: من أمرک، و مثل المحیص: المهرب»؛
و قیل: «عنک، أی: عن سخطک»؛
و قیل: «عن أمرک، أی: الموت».
تَلَقَّاکَ بِالإِنَابَةِ وَ أَخْلَصَ لَکَ التَّوْبَةَ، فَقَامَ إِلَیْکَ بِقَلْبٍ طَاهِرٍ نَقِیٍّ، ثُمَّ دَعَاکَ
بِصَوْتٍ حَائِلٍ خَفِیٍّ.
«تلقّاک» جزاء الشرط، أی: استقبلک متلبّساً بالانابة ـ أی: الإقبال علیک ـ، من: أناب: إذا أقبل و رجع.
و «أخلص» للّه العمل: لم یراء فیه، من: خلص الماء من الکدر: إذا صفا. و «اخلاص التوبة»: أن یأتی بها على طریقها لتصفو و تسلم ممّا ینافیها. عن أمیرالمؤمنین – علیه السلام ـ: «إنّ التوبة یجمعها ستّة أشیاء: على الماضی من الذنوب الندامة؛ و للفرائض الإعادة؛ و ردّ المظالم و استحلال الخصوم؛ و أن تعزم أن لاتعود؛ و أن تذیب نفسک فی طاعة اللّه ـ تعالى ـ کما ربّیتها فی المعصیة؛ و أن تذیقها مرارة الطاعة کما أذقتها حلاوة المعاصی»(85)
<و فرّق بعضهم بین «الإنابة» و «التوبة»؛ فقال: «الإنابة أن یتوب العبد خوفاً من عقوبته، و التوبة حیاءً من کرمه؛ فالأولى توبة إنابةٍ و الثانیة توبة استجابةٍ»>(86)
و قیل: «أخلص عطفٌ على تلقاک، أی: جعل نفسه خالصاً عن الذنوب بسبب التوبة لطلب مرضاتک، فالاسناد التعلّقیّ مجازیٌّ، کما فی قوله ـ تعالى ـ: (تَوبَةً نَصُوحاً)(87)، «النصوح» صفة التائب فجعله صفةً للتوبة».
أقول: لا داعی إلى ذلک ـ کما ذکرناه لک ـ ؛ و کقوله ـ تعالى ـ: (مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ)(88)، فکما أخلص دینه للّه فقد أخلص توبته، فلیس الإسناد مجازیّاً.
قوله – علیه السلام ـ: «فقام إلیک».
«الفاء» للسببیّة، أی: بسبب الإنابة و الإخلاص فی التوبة قام ذلک العبد متوجّهاً إلیک. عدّى «القیام» بـ «الى» لتضمینه معنى التوجّه.
و «الباء» فی «بقلبٍ»: للملابسة، أی: متلبّساً.
و «الطُهر» ـ بالضمّ ـ: اسمٌ من طَهَرَ الشیء طهارةً من باب قتل ـ. و هو لغةً: النقاء من الدنس و النجس، و یخصّ شرعاً بالثانی.
و «النقاوة»: النظافة من الوسخ و الدنس؛ و المراد بطهارة القلب و نقاوته: نقاوته من الأنجاس و الأدناس الروحانیّة ـ کالشرک و الجهل و سائر الاعتقادات الردیئة ـ و الأخلاق الذمیمة و الصفات الطبیعیّة الظلمانیّة؛ بل من الأرجاس و الأنجاس الأنانیّة الّتی یندرج فیها الجمیع.
«ثمّ دعاک» أی: بعد القیام. إنّما عطف بـ «ثمّ لتراخی الدعاء عن القیام.
و «الدعاء»: الابتهال إلى اللّه ـ تعالى ـ بالسؤال و الرغبة فیما عنده من الخیر.
قوله: «بصوتٍ حائلٍ» أی: ضعیفٍ.
و «الصوت» کیفیّةٌ قائمةٌ بالهواء یحملها إلى الصماخ.
و «حال» الشیء یحول حولاً: إذا تغیّر عن طبعه و وصفه. و فی نسخة ابن ادریس: «حامل»، أی: خفیّ.
و إنّما وصف «الصوت» بـ «الضعف و الخفاء» لما اعتراه من الخوف أو الحیاء، کما هو شأن الخائف أو المستحیی، و ربّما بلغ إلى انقطاع الصوت و الکلام.
قَدْ تَطَأْطَأَ لَکَ فَانْحَنَى وَ نَکَّسَ رَأْسَهُ فَانْثَنَى، قَدْ أَرْعَشَتْ خَشْیَتُهُ رِجْلَیْهِ وَ غَرَّقَتْ دُمُوعُهُ خَدَّیْهِ.
«تطأطأ»: خفض رأسه و تواضع.
و «انحنى» أی: انعطف.
و «نَکَسَ رأسه» ـ من باب قتل ـ و نکّسه ـ بالتثقیل ـ: خفضه و طأطأه.
و «انثنى» أی: انعطف و انحنى، من: ثَنَاه یَثنِیه ثَنْیاً ـ من باب رمى ـ: إذا عطف. و الجملة فی محلّ النصب على الحال، أی: حالکونه قد تطأطأ؛ و یحتمل الاستیناف، کأنّه سئل: ثمّ ماکان منه بعد ذلک؟ فقال: قد تطأطأ ـ… إلى آخره ـ.
<و «الرعشة»: الاضطراب، یقال: رَعِشَ رَعَشاً و رَعْشاً ـ من باب تعب و منع ـ : أخذته الرعدة. و یتعدّی بالهمزة، فیقال: أرعشه اللّه؛ و «ارتعش»: ارتعد.
و «الخشیة»: الخوف>(89) <قال المحقّق الطوسیّ ـ قدّس سرّه القدّوسی ـ فی بعض
مؤلّفاته ما حاصله: «إنّ الخوف و الخشیة و إن کانا فی اللغة بمعنىً واحدٍ إلّا أنّ بین خوف اللّه ـ تعالى ـ و خشیته فی عرف أرباب القلوب فرقاً، هو: انّ «الخوف» تألّم النفس من العقاب المتوقّع بسبب ارتکاب المنهیّات و التقصیر فی الطاعات. و هو یحصل لأکثر الخلق و إن کانت مراتبه متفاوتةً جدّاً، و المرتبة العلیا منه لاتحصل إلّا للقلیل؛
و «الخشیة»: حالةٌ تحصل عند الشعور بعظمة الحقّ و هیبته و خوف الحجب عنه. و هذه الحالة لاتحصل إلّا إن اطّلع على جلال الکبریاء و زاق حلاوة القرب؛ و لذلک قال ـ سبحانه ـ: (إِنَّمَا یَخشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)(90)؛ فالخشیة خوفٌ خاصٌّ. و قد یطلقون علیها الخوف أیضاً»(91)؛ انتهى کلامه>(92)
قال بعض العارفین: «إذا احترقت جمیع الشهوات بنار الخوف ظهر فی القلب الذبول و الخشوع و الانکسار و زال عنه الحقد و الکبر و الحسد. و صار کلّ همّه النظر فی خطر العاقبة، فلایتفرّغ لغیره، و لا یصیر له شغلٌ إلّا المراقبة و المحاسبة و المجاهدة و الاحتراز من تضییع الأنفاس و الأوقات و مؤاخذة النفس فی الخطوات و الخطرات. و أمّا الخوف الّذی لایترتّب علیه شیءٌ من هذه الآثار فلایستحقّ أن یطلق علیه اسم الخوف، و إنّما هو «حدیث النفس»؛ و لهذا قال بعض أرباب القلوب: إذا قیل لک: هل تخاف اللّه؟ فاسکت عن الجواب!، فانّک إن قلت: لا، کفرت!، و إن قلت: نعم، کذبت!»(93)؛ انتهى.
و «الخشیة»: فاعل «أرعشت».
و «رجلیه»: مفعوله؛ أی: جعل خوفه و خشیته رجلیه مرتعشاً مضطرباً. و تخصیص «الرجلین» بالذکر: للاشعار بشدّة الخشیة و قوّتها، لأنّ الرعشة فیهما لاتحدث إلّا عن سببٍ قویٍّ کأنّه لایمکنه أن یستقرّ على وجه الأرض!. و ذلک لأنّ احتیاج أسافل البدن إلى الروح المحرّک لها أشدٌّ من أعالیه ـ لبُعدها عن ینبوع الحیاة ـ، فلاتفعل إلّا بسببٍ قویٍّ.
و «غَرِقَ» الشیء فی الماء ـ من باب تعب ـ: رسب فیه. و فی هذا اشارةٌ إلى کثرة الدموع بحیث تغطّى و تستر الخدّین ـ کما انّ الماء الکثیر تستر الغریق ـ. و الجملة فی محلّ النصب على الحال من فاعل «دعاک»؛ أو من الضمیر فی «تطأطأ» عند من منع تعدّد الحال. و تحتمل الاستیناف ـ کالّتی قبلها ـ.
یَدْعُوکَ بِیَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.
قال الفاضل الشارح: «یدعوک أی: ینادیک، من: دعوت زیداً أی: نادیته و طلبت إقباله. و مدخول الیاء محذوفٌ، و التقدیر: یدعوک بقوله: یا أرحم الراحمین.
و «یا» حرفٌ موضوعٌ لنداء البعید، حقیقةً أو حکماً، و قد ینادى بها القریب توکیداً. و قیل: «(94) مشترکةٌ بین البعید و القریب»؛ و قیل: «بینهما و بین المتوسّط»، قاله ابنهشامٍ فی المغنی(95) و قال ابن المنیر: «و أصله صوتٌ یهتف به لمن کان بعیداً منک، ثمّ استعمل فی کلّ نداءٍ و إن قرب المنادى، کأنّک تقدّر المخاطب ساهیاً عنک ـ و کفى بالغفلة بُعداً ـ فتوقظه بذلک الصوت من سنة السهو، ثمّ تؤذنه بخطابک و إن کان مصغیاً بأنّ الأمر الّذی بعده مهمٌّ عندک و انّک فی غفلةٍ عنه، فتزیده یقظةً إلى یقظةٍ بالتصویت.
فان قلت: فقد استعمل هذا الحرف فی الدعاء، و قد علم انّ اللّه ـ تعالى ـ لایجوز علیه السهو و الغفلة و لا البعد، فانّه أقرب إلى الداعی من حبل الورید؟!
قلت: قد استقرّ انّها بالاتّساع صارت مؤدّیةً باهتمام المتکلّم بالمقصود، و الّذی یأتی بعدها أعمّ من کون الساهی غافلاً أو حاضراً؛ و اظهار الاهتمام بالحاجة من قبیل الضراعة و الالحاح المطلوب فی الدعاء».
و قال الزمخشریّ: «و قول الداعی فی جواره: یا ربّ و یا اللّه مع کونه أقرب إلیه من حبل الورید استقصاءرٌ منه لنفسه و استبعادٌ لها من مظانّ الزلفى»(96)، و هو اقناعیٌّ لأنّ الداعی یقول فی دعائه: یا قریباً غیر بعیدٍ، و ربّما قال: یا من هو أقرب إلیَّ من حبل الورید، فأین هذا من الانتصاب فی مقام البعد؟!»؛ انتهى کلام ابن المنیر.
و أجیب عن تعقیبه کلام الزمخشریّ بأنّ هذا الکلام من الداعی غیر منافٍ لانتصابه فی مقام البعد و لابعید منه، لأنّ المراد استقصار نفسه و استبعادها ممّا یقرّبه إلى رضوان اللّه ـ تعالى ـ»؛ انتهى.
و الجملة فی محلّ النصب على الحال من الضمیر فی قوله: «فقام إلیک»؛ کأنّه قال: فقام إلیک ثمّ دعاک منادیاً لک بقول: یا أرحم الراحمین.
و تقدیمه النداء بهذا الوصف لأنّه الأهمّ بالمقام، لاشتماله على صفة «الرحمة» الّتی لاتساویها رحمةٌ و لاتکون توبةٌ و لاعفوٌ و لاغفرانٌ و لافضلٌ و منٌّ و احسانٌ إلّا بعدها!. و فی الحدیث: «إنّ للّه ملکآ موکّلاً بمن یقول: یا أرحم الراحمین، فمن قالها ثلاثاً قال له الملک: انّ أرحم الراحمین قد أقبل علیک، فسل!»(97) و مرّ رسول اللّه – صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ برجلٍ و هو یقول: یا أرحم الراحمین، فقال له: «سل، فقد نظر اللّه إلیک»(98)؛(99) انتهى کلام الشارح الفاضل.
أقول: التحقیق الحقیق بالمقام ما مرّ من أنّ الممکن له جهةٌ إلى ربّه و جهةٌ إلى نفسه، فاذا
التفت إلى جهة نفسه و استشعر لاشیئیّته و بطلانه و فقره استولى علیه الخوف و الخشیة، فیقول: یا أرحم الراحمین؛ فکأنّه لامناسبة بینه و بین خالقه ـ کما قیل: «ما للتراب و ربّ الأباب»؛
چه نسبت خاک را با عالم پاک!
فهو من هذه الحیثیّة فی نهایة البُعد، فیصحّ أن یستعمل حرفاً موضوعاً لنداء البعید.
وَ یَا أَرْحَمَ مَنِ انْتَابَهُ الْمُسْتَرْحِمُونَ، وَ یَا أَعْطَفَ مَنْ أَطَافَ بِهِ الْمُسْتَغْفِرُونَ.
«انتابه»: افتعالٌ من النوبة ـ بالنون ـ، أی: قصدوه على التناوب مرّةً بعد أخرى؛ قال ابن الأثیر فی النهایة: «انتابه: إذا قصده مرّةً بعد أخرى(100)، و منه حدیث الدعاء: یا أرحم من انتابه المسترحمون»(101)؛(102) انتهى. و قال فی القاموس: «النوبة: الفرصة و الدولة و الجماعة من
الناس،(103) واحده النوب(104) و ناب عنه نوباً و مناباً: قام مقامه»(105)
قال السیّد السند الداماد: «و من أعاجیب الأغلاط ما وقع هیهنا لغیر واحدٍ من(106) القاصرین، و هو حسبان ذلک انفعالاً من التوبة ـ أی: الرجوع من الذنب و الندم علیهاـ»(107)
و «أعطف» أی: أشفق و تحنّن.
و «أطاف» أی: استدار بجوانبه؛ أی: أرءف من دار حول سرادق کبریائه طالبوا المغفرة.
یعنى: کلّ من یطوف حوله المستغفرون أنت أرءف من ذلک المطاف علیه.
وَ یَا مَنْ عَفْوُهُ أَکْثَرُ مِنْ نَقِمَتِهِ، وَ یَا مَنْ رِضَاهُ أَوْفَرُ مِنْ سَخَطِهِ.
«وَفَُرَ» المال ـ من باب کرم و وعد ـ وفراً و وفوراً: کثر و اتّسع، فهو وفرٌ؛ أی: یامن رضاه أکثر و أوسع من سخطه، لأنّه یشکر بالقلیل و یجازی بالجلیل ـ کما وقع فی أدعیة یوم الجمعة(108) ـ.
و زیادة العفو من النقمة ـ فی الفقرة السابقة ـ، لأنّه «سبقت رحمته غضبه»(109)
و تقدیم «العفو» على «الرضاء» من باب الترقّی من الأدنى إلى الأعلى، فلایحتاج إلى التعویل الّذی ذکره بعضٌ فی هذا المقام. و التقدیم فی محلّه، کما مرّ تحقیق ذلک فی اللمعة الأولى فی شرح قوله – علیه السلام ـ: «و تسبق به من سبق إلى رضاه و عفوه»؛ فانّ العفو فی بعض المراتب مقدّمٌ على الرضا.
وَ یَا مَنْ تَحَمَّدَ إِلَى خَلْقِهِ بِحُسْنِ التَّجَاوُزِ، وَ یَا مَنْ عَوَّدَ عِبَادَهُ قَبُولَ آلإِنَابَةِ.
قال الفاضل الشارح: «تحمّد هنا بمعنى: استحمد؛ یدلّ على ذلک قول الزمخشریّ فی الأساس: «استحمد اللّه إلى خلقه باحسانه إلیهم و انعامه علیهم»(110)؛ انتهى. و «تفعّل» ترد بمعنى «استفعل» فی معنى الطلب ـ نحو تنجّزته أی: استنجزته إذا طلبت نجازه ـ. فـ «تحمد إلى خلقه» و استحمد بمعنى: طلب إلیهم أن یحمدوه، کما قال ـتعالى ـ: (وَ قُلِ الْحَمدُ
لِلَّهِ)(111) و (اشْکُرُوا لِی وَ لاَتَکفُرُونِ)(112) و إنّما عدّاه بـ «الى» ـ و الأصل أن یتعدّى بنفسه ـ لتضمینه معنى «خطب»، أی: تحمدهم خاطباً إلیهم حمده.
و أمّا تفسیره بمعنى «امتنّ» ـ کما فعله کثیرٌ من المحشّین و المسترجمین، أخذاً من قول الجوهریّ فی الصحاح: «فلانٌ یتحمّد علیَّ أی: یمتنّ علیَّ(113)، یقال: من أنفق ماله على نفسه فلایتحمّد به على الناس»(114)؛ انتهى ـ فلیس بصوابٍ!؛ و ذلک لوجهین:
أحدهما: انّ التحمّد بمعنى الامتنان إنّما یتعدّی بـ «على» ـ کما هو صریح عبارة الجوهریّ – و التحمّد فی الدعاء معدّىً بـ «إلى»، فاختلف المعنى. و یدلّ على ذلک قول الإمام أبی الفضل المیدانی فی مجمع الأمثال: «قولهم(115): من أنفق ماله على نفسه فلایتحمّد به
على الناس، و یروى: إلى الناس؛ فمن وصله بـ «على» أراد فلایمتنّ به على الناس، و من وصله بـ «إلى» أراد فلایخطبن إلیهم حمده»(116)؛ انتهى؛
و الثانی: إنّه قد ورد فی دعائهم – علیهم السلام ـ تنزیهه ـ تعالى ـ عن الامتنان ـ کما یأتی فی دعاء وداع شهر رمضان: «و لمتشب عطاؤک بمنٍّ»، فلایصحّ حمل التحمّد هیهنا على معنى الامتنان.
و لاحاجة إلى التکلّف فی الجواب: انّ معنى امتنانه کون نعمه جدیرةً بأن یمتنّ بها و إلّا فهو مبرءٌ عن ذلک!.
فان قلت: فقد ورد الامتنان فی القرآن المجید کثیراً، کقوله ـ تعالى ـ: (یَا بَنِی إِسرَائِیلَ اذْکُرُوا نِعمَتِیَ الَّتِی أَنعَمْتُ عَلَیکُمْ)(117)، و قوله ـ تعالى ـ: (وَ اْکُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ
مُسْتَضْعَفُونَ فِی الاَرضِ)(118) ـ… الآیة ـ، إلى غیر ذلک ؛
قلت: هذا و نحوه من قبیل التنبیه على شکرالنعمة و النهی عن کفرها، و لیس الغرض منه اعتداد النعمة کما یفعله المعتدّ بنعمه و المتطوّل بها على المنعَم علیه»(119)؛ انتهى کلام الفاضل الشارح.
أقول: هذا تطویلٌ بلاطائلٍ!. و التحقیق: انّ کلّاً من «المنّ» و «الامتنان» یستعمل على وجهین:
أحدهما: بمعنى العتائق، منّ و امتنّ علیه بالعتق و العفو و غیرهما أی: أنعم علیه بها؛
و ثانیهما: أن یصدر من المعطی ما ینکر منه قلب المعطى ـ من تعییرٍ له به و تعدید نعمه علیه أو استخفافٍ بحرمته ـ، و مثل ذلک ممّا یکدّر العطا و یکسّر قلب المعطى. و ربّما یکون بأمرٍ أضمره فی باطنه ـ بأن یرى ما أعطاه کثیراً و یرى له فی نفسه على المعطى فضلاً و تفوّقاً! ـ. و المنّ بهذا المعنى هو الّذی نهاه اللّه ـ تعالى ـ، لأنّه لیس من خصال الکریم، فهو أولى بأن یتبرّء منه؛ قال: (لاَتُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الاَْذَى)(120) و لکنّه أطلق اللّه ـ تعالى ـ هذا الاسم على نفسه و اختصّ به کاسم الجبّار و المتکبّر، مثل قوله ـ تعالى ـ: (یَمُنُّ عَلَى مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ)(121)، (اللَّهُ یَمُنُّ عَلَیکُمْ أَنْ هَدَاکُمْ)(122)، و فی دعاء الجوشن الکبیر: «یا منّان»(123)
و بالجملة الامتنان الّذی یکدّر العطاء و یکسر منه قلب المعطى لایلیق بالعبد الّذی هذّب نفسه و أصلح دینه، فکیف باللّه ـ تعالى ـ؟!.
و من لاحظ لیسیّة الممکن و لاشیئیّته و بطلانه تحقّق عنده ما قلناه من أنّ المنّة مختصّةٌ بالحضرة الأحدیّة.
و أبعد ممّا ذکره فی «الامتنان»، ما ذکره من: «انّ تحمّد بمعنى: استحمد». فمعنى «تحمّد»: حمده ـ تعالى ـ خلقه أوّلاً فی مرتبة الألوهیّة و ثانیاً فی المعلولات الأمریّة و الخلقیّة ـ کما مرّ فی اللمعة الأولى ـ. و قد ورد فی دعاء الجوشن أیضاً: «یا حامد»(124)؛ فتأمّل تفهم!.
و «التجاوز»: الصفح عن الذنب.
و «حسنه»: الصفح الجمیل؛ و عن علیٍّ – علیه السلام ـ: «إنّ الصفح الجمیل هو العفو من غیر عقابٍ»(125)
و «عوّده» کذا فاعتاده و تعوّده أی: صیّره له عادةً؛ أی: یامن جعل قبول التوبة منهم عادةً لهم یعتادونه، لأنّهم کلّما تابوا و أنابوا قبل توبتهم، قال اللّه ـ تعالى ـ: (وَ مَنْ یَعْمَلْ سُوءً وَ یَظْلِمْ نَفسَهُ ثُمَّ یَسْتَغفِرِ اللَّهَ یَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِیماً)(126)، و عن أبی جعفرٍ- علیه
السلام ـ: «کلمّا عاد المؤمن بالاستغفار و التوبة عاد اللّه إلیه بالمغفرة، و انّ اللّه غفورٌ رحیمٌ یقبل التوبة و یعفو عن السیّئة(127)»(128) و الأخبار فی هذا المعنى لاتکاد تحصى!.
وَ یَا مَنِ اسْتَصْلَحَ فَاسِدَهُمْ بِالتَّوْبَةِ، وَ یَا مَنْ رَضِیَ مِنْ فِعْلِهِمْ بِالْیَسِیرِ، وَ یَا مَنْ کَافَى قَلِیلَهُمْ بِالْکَثِیرِ.
«استصلح» الشیء أی: طلب صلاحه.
و «رضی» بالشیء أی: قنع به و لم یطلب معه غیره.
و «الیسیر»: القلیل.
و «کافى» ـ بالمقصورة و الهمزة ـ من المکافات، أی: المجازات، لأنّ عطاء العظیم عظیمٌ. و الأحادیث الّتی وقعت فی الجزاء الجلیل و الأجر الجزیل للفعل القلیل أکثر من أن تحصى!.
وَ یَا مَنْ ضَمِنَ لَهُمْ إِجَابَةَ الدُّعَاءِ، وَ یَا مَنْ وَعَدَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِتَفَضُّلِهِ حُسْنَ الْجَزَاءِ.
«ضَمِن» ـ من باب علم ـ: تکفّل؛ و ضمنت المال ضماناً: التزمته.
و «الإجابة»: القبول؛ و ذلک لقوله ـ تعالى ـ: (أُدْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ)(129)، و قوله: (إِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ)(130)
و «الوعد»: هو الخبر عن ایصال نفعٍ إلى الغیر، أو دفع ضررٍ فی المستقبل ـ سواءٌ کان النفع مستحقّاً أو لا ـ. و عدّاه بـ «على» لتضمینه معنى: الایجاب، أی: وعدهم موجباً على ذاته المقدّسة التفضّل بحسن الجزاء.
و المراد بـ «حسن الجزاء»: هو حسن الثواب، کما قال ـ تعالى ـ: (وَ اللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ)(131)<قیل: «هو ما لایبلغه وصف واصفٍ ولایدرکه نعت ناعتٍ ممّا لاعینٌ رأت و لاأذنٌ سمعت و لاخطر على قلب بشرٍ!»؛
و قیل: «حسنه فی دوامه و سلامته من کلّ شوبٍ و من النقصان، ألاَ ترى إلى قوله ـ تعالى ـ: (فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنیَا وَ حُسْنَ ثَوَابِ الاْخِرَةِ)(132) کیف وصف ثواب الآخرة بالحسن و لم یصف به ثواب الدنیا؟! ـ لامتزاجه بالمضارّ و کدر صفوه بالانقطاع و الزوال،
بخلاف ثواب الآخرة ـ»>(133)؛
و قیل: «حسن الجزاء مفعول «وعد»، أی: الجزاء الحسن، و هو عشرة الأمثال لا أقلّ!».
مَا أَنَا بِأَعْصَى مَنْ عَصَاکَ فَغَفَرْتَ لَهُ، وَ مَا أَنَا بِأَلْوَمِ مَنِ اعْتَذَرَ إِلَیْکَ فَقَبِلْتَ مِنْهُ، وَ مَا أَنَا بِأَظْلَمِ مَنْ تَابَ إِلَیْکَ فَعُدْتَ عَلَیْهِ.
الجملة الأولى هی منادى لها بقوله: «یدعوک یا أرحم الراحمین»، أی: یقول:… .
قال الفاضل الشارح: «الجملة الأولى فی محلّ النصب بـ «القول» المقدّر المجرور بـ «الباء» من قوله فیما تقدّم: «یدعوک» ـ… إلى آخره، أی بقوله: «یا أرحم الراحمین! ما أنا بأعصى من عصاک» ـ، و ما بعدها معطوفٌ علیها.
و «الفاء» من قوله: «فغفرت له» عاطفةٌ مفیدةٌ للتعقیب»(134)
و قیل: «هذه الفقرة من باب «ما أنا قلت»، و کذا الفقرتان بعدها؛ یعنى: إنّ من کان أکثر عصیاناً منّی غفرته فکیف لاتغفر لی!، فلست آئساً من رحمتک قطّ و إن کثر ذنوبی!. و روی انّ أمیرالمؤمنین – علیه السلام ـ کان یقول فی المناجاة:
ذُنُوبِی إِذَا(135) فَکَّرتُ فِیهَا کَثِیرَةٌ++
وَ رَحْمَةُ رَبِّی مِن ذُنُوبِیَ أَوسَعُ
فَمَا طَمَعِی فِی صَالِحٍ قَدْ فَعَلتُهُ(136)++
وَ لَکِنَّنِی فِی رَحمَةِ آللَّهِ أَطمَعُ(137)
و «ألوم»: أفعل تفضیلٍ من لامه یلومه لوماً ـ مبنیٌّ للمفعول ـ، أی: لست أکثر ملوماً من جماعةٍ اعتذروا إلیک فقبلت منهم عذرهم؛ یعنى: هم أکثر ملامةً منّی، فاذا قبلت عذرهم فقبول عذری یکون بطریقٍ أولى.
و «ما أنا بأظلم ـ… إلى آخره ـ» یعنى: قد رأیت انّک التفتت بنظر رحمتک إلى من هو
أکثر ظلماً على نفسه منّی، فکیف أکون آئساً من روحک و التفاتک و عودک إلیَّ بالمغفرة و حسن التجاوز عن السیّئة.
و قیل: «فعدت علیه: من العائدة ـ و هی الصلة و الفضل و المعروف و العطف و الاحسان ـ و لیس من العود»(138)
أقول: و ظنّی انّ أصل «العائدة» أیضاً من «العود»، کما یظهر من کلام أهل اللغة(139)
و قیل: «إنّ العفو من اللّه ـسبحانه ـ :
إمّا أن یکون ابتداءً منه ـ تعالى ـ و هو العفو مع الاصرار ـ کما قال تعالى: (وَ إِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ)(27) ـ. و قد سمع رجلٌ حکیماً یقول: «ذنب الإصرار أولى بالاعتذار!»، فقال: «صدّق، لیس فضل من یعفو عن السهو القلیل کمن عفا عن العمد الجلیل!»، و إلى هذا القسم وقعت الإشارة بالفقرة الأولى ـ و هی قوله علیه السلام: «ما أنا بأعصى من عصاک فغفرت له» ـ؛
و إمّا أن یکون عن اعتذارٍ و اقرارٍ، و إلیه الإشارة بالفقرة الثانیة؛
و إمّا أن یکون عن توبةٍ و استغفارٍ، و إلیه الاشارة بالفقرة الثالثة»؛ و اللّه أعلم.
أَتُوبُ إِلَیْکَ فِی مَقَامِی هَذَا تَوْبَةَ نَادِمٍ عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُ، مُشْفِقٍ مِمَّا اجْتَمَعَ عَلَیْهِ، خَالِصِ الْحَیَاءِ مِمَّا وَقَعَ فِیهِ.
«أتوب إلیک» بدلٌ من قوله: «أقول مقام العبد الذلیل».
و قال الفاضل الشارح: «الجملة فی محلّ النصب على أنّها مفعولٌ للقول ـ من قوله علیه السلام فیما سبق: «بل أقول مقام العبد الذلیل» ـ. و یحتمل أن تکون مفسّرةً للمقال، فلامحلّ
لها من الإعراب. و صحّ وقوعها مفسّرةً ـ مع کونها انشائیّةً ـ لکون المفسّر مفرداً مؤدّیا عن جملةٍ ـ کقوله تعالى: (وَ أَسَرَّوا النَّجوَى الَّذِینَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُکُم)(140)، فانّ جملة الاستفهام مفسّرةٌ للـ «نجوى» لکونه مفرداً مؤدّیاً عن جملةٍ ـ»(141)؛ انتهى کلامه.
و لایخفى بعده!.
و «الندم»: تمنّی الإنسان انّ ما وقع منه لم یقع.
و «فَرَطَ» یَفرُطُ ـ من باب قتل ـ أی: سبق و تقدّم، أی: راجعت فی موقفی هذا إلى جنابک مثل رجوع من ندم على ما سبق منه من الذنب.
«مشفق» أی: خائف، و هو بدلٌ من «نادم»؛ أو عطفٌ علیه، أی: خائف ممّا اهتجم علیه من الذنوب؛ یقال: أشفقت من کذا: حذرت، فأنا مشفقٌ. و حکى ابن درید: «شَفَقتُ»(142) أیضاً ـ من باب ضرب ـ، و هو غیر مرضیٍّ عند جمهور أهل اللغة؛ و قالوا: «لایقال إلّا أشفقت»(143) ـ بالألف ـ.
و «الحیاء» قد مرّ تفسیره.
و المراد بـ «خالصه»: کونه غیر مشوبٍ بشیءٍ، أی: له حیاءٌ خالصٌ تامٌّ ممّا وقع فیه من الذنوب.
عَالِمٍ بِأَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الذَّنْبِ الْعَظِیمِ لاَ یَتَعَاظَمُکَ، وَ أَنَّ التَّجَاوُزَ عَنِ الإِثْمِ الْجَلِیلِ لاَ یَسْتَصْعِبُکَ، وَ أَنَّ احْتِمالَ الْجِنَایَاتِ الْفَاحِشَةِ لاَیَتَکَأَّدُکَ.
«تعاظمه» الأمر: عظم علیه، و المعنى: انّ التجاوز عن الذنب العظیم لیس عندک بعظیمٍ.
و «استصعب» علیه الأمر: صعب، و «الصعب»: نقیض الذلول، و «الذلول» من الذِلّ ـ بالکسر ـ، و هو: اللین، و یجمع على ذلل؛ و فی الحدیث: «اللّهمّ اسقنا ذلل السحاب»(144) أی: غیر صعابها؛ و فی القرآن: (فَاسْلُکِی سُبُلَ رَبِّکِ ذُلُلاً)(145)
و «الجِنَایات» ـ بکسر الجیم و فتحها ـ: الجرائم، یقال: جنى جنایةً أی: أذنب ذنباً و جرماً یؤاخذ علیه. و عرّفوا «الجنایة» بـ: انّها کلّ فعلٍ محظورٍ یتضمّن ضرراً على النفس أو غیرها. و غلبت فی ألسنة الفقهاء على الجرح و القطع.
و «فُحْش»: مثل قُبْح وزناً و معنىً(146)، و فی لغةٍ من باب قتل(147) و کلّ شیءٍ جاوز الحدّ فهوفاحشٌ، و منها: غبنٌ فاحشٌ؛ و کلا المعنیین هنا محتمل، أی: الجنایات القبیحة، أو المجاوزة للحدّ.
و «تکادّه» الشیء ـ على تفاعله ـ و تکأّده ـ على تفعّله ـ: صعب علیه و شقّ، و وردت الروایة فی الدعاء بالوجهین.
قال الفاضل الشارح: «و هذه الفقرات الثلاث بمعنىً واحد، و إنّما أورده بعباراتٍ شتّى بسطاً للکلام ـ حیث الاصغاء مطلوبٌ ـ و اهتماماً بالغرض ـ الّذی هو وصف عظمة عفوه و اتّساع مغفرته ـ. فانّ جرائم العباد و آثام أهل العناد فی جنب عظمة عفوه و غفرانه کقطرةٍ فی جنب بحرٍ، بل أقلّ منها!. و فی الحدیث المشهور عن أنس قال: سمعت رسول اللّه ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ یقول: «قال اللّه ـ تعالى ـ: یا بن آدم! انّک ما دعوتنی و رجوتنی غفرت لک على ما کان منک و لا أبالی، یا بن آدم! لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثمّ استغفرتنی غفرت لک!، یا بن آدم! لو أتیتنی بقراب الأرض خطایا ثمّ لقیتنی لاتشرک بی شیئاً لآتیتک
بقرابها!»(148)؛ و ما أحسن قول القائل فی هذا المعنى:
وَ لَمَّا قَسَا قَلبِی وَ ضَاقَتْ مَذَاهِبِی++
جَعَلتُ رَجَائِی نَحوَ عَفوِکَ سُلَّمَا
تَعَاظَمَنِی ذَنبِی فَلَمَّا قَرَنتُهُ++
بِعَفْوِکَ ـ رَبّی! ـ کَانَ عَفوُکَ أَعظَمَا(149)
»(150)؛انتهى کلامه.
أقول: و یحتمل أن یکون فى هذه الفقرات الثلاث إشارةٌ إلى جرم الذات و الصفات و الأفعال، لئلّا یخلو کلام المعصوم عن الفائدة المعنویّة.
وَ أَنَّ أَحَبَّ عِبَادِکَ إِلَیْکَ مَنْ تَرَکَ الاِسْتِکْبَارَ عَلَیْکَ، وَ جَانَبَ آلإِصْرَارَ وَ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ.
قد تقدّم الکلام فی «المحبّة» بما لامزید علیه فی اللمعة الأولى؛ فلیرجع إلیها.
و «تکبّر» و «استکبر»: اعتقد فی نفسه أنّها کبیرةٌ؛ و «استکبر علیه» و «تکبّر»: رأى انّه أکبر منه.
اعلم! أنّ الاستکبار ینشأ من الکبر، و الکبر من نتائج العُجب؛ و ما یترتّب علیه من التحقیر للغیر ـ کالاستنکاف عن مؤاکلته و مصاحبته و توقّع التقدیم فیما یدلّ عرفاً على التعظیم علیه و عدم الالتفات فی المحاورات و غیرها إلیه ـ یسمّى تکبّراً. و هو من الآفات العظیمة الّتی هلک بها خواصّ الأنام فضلاً عن العوامّ؛ و قد سبق تحقیقه فیما سبق من الکلام.
و العلاج العملیّ له: المواظبة على ضدّه و لو تکلّفاً إلى أن یعتاد علیه و یصیر ملکةً له و تنقلع عن قلبه شجرته الراسخة فیه بأصولها و أغصانها. و له علاماتٌ کحصول السرور
القلبیّ له من ظهور الخطأ فی رأیه و حقیّة رأی خصمه فی مناظرته له و شکره الظاهریّ له على تنبیهه علیه من دون ثقلٍ علیه ـ لا فی الخلأ و لا فی الملأ ـ، و اللبس من دون ذیّ أقرانه ـ کلبس الصوف و غیره من الخشن ـ، و الأکل مع الفقراء و المعلولین و الخدم و الغلمان من دون ثقلٍ علیه فی الخلأ و الملأ. و إن ثقل علیه أحد ما ذکر فی الملأ دون الخلأ فهو و إن لم یکن متکبّراً إلّا انّه مراءٌ ینبغی له إعمال معالجات الریاء؛ و فی الخبر: «إنّ رسول اللّه ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ کان یعلف الناضح و یعقل البعیر و یقم البیت و یحلب الشاة و یخصف النعل و یرقّع الثوب و یأکل مع الخادم و یطحن عنه إذا أعیا، و یشتری الشیء من السوق و یعلّقه بیده أو یجعله فی طرف ثوبه و یصافح الغنیّ و الفقیر و الصغیر و الکبیر و یسلّم مبتدءً على کلّ مستقبلٍ من صغیرٍ و کبیرٍ و أحمر و أسود ـ حرٍّ أو عبدٍ ـ من أهل الصلاة، و کان أشعث أغبر، و لایحقّر ما دُعی إلیه ـ… الحدیث ـ»(151)
و اعلم! أنّ مِن أظهر أنواع الکبر: الافتخار، و قد ورد فی ذمّه بخصوصه أیضاً کثیرٌ من الأخبار، و علاجه بعلاجه أیضاً.
قوله – علیه السلام ـ: «و جانب الإصرار» أی: ترک الإصرار على الذنب و باعد منها؛ یقال: جانب الشیء مجانبةً: باعده و ترکه. و أصل المجانبة کون کلٍّ من الشیئین فی جانبٍ، و استعملت فی الترک لأنّه إذا ترک الشیء فکأنّه صار فی جانبٍ و ذلک الشیء فی جانبٍ آخر.
و «الإصرار»: ملازمة الأمر.
و «لازمه» و «لزمه» ـ أیضاً ـ: تعلّق به.
و «الاستغفار»: طلب غفران الذنوب؛ و المعنى ظاهرٌ.
وَ أَنَا أَبْرَأُ إِلَیْکَ مِنْ أَنْ أَسْتَکْبِرَ، وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ أَنْ أُصِرَّ، وَ أَسْتَغْفِرُکَ لِمَا قَصَّرْتُ فِیهِ وَ أَسْتَعِینُ بِکَ عَلَى مَا عَجَزْتُ عَنْهُ.
«و أنا أبرأ» لما ذکر من مذمّة الاستکبار، و لقوله ـ تعالى ـ: (إِنَّ الَّذِینَ یَستَکْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِینَ)(129)، و لأنّ الشیطان (أَبَى وَ اسْتَکبَرَ)(152) فصار رجیماً ملعوناً مطروداً.
و «البراءة»: التباعد؛ قال الزمخشریّ فی الفائق: «برىء من المرض و برأ، فهو بارىء، و معناه: مزایلة المرض، أی: مفارقته(153) و التباعد منه؛ و منه: برىء من کذا براءةً»(154)؛ انتهى. وتعدیته بـ «إلى» لتضمینه معنى التوجّه و الالتجاء.
و «التقصیر» فی الأمر: التوانی و عدم الاهتمام به.
و «الاستعانة»: طلب المعونة.
و «عَجَز» عن الشیء ـ من باب ضرب ـ: ضعف عنه.
و أمثال هذه الأقوال من المعصومین – علیهم السلام ـ للتعلیم.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ هَبْ لِی مَا یَجِبُ عَلَیَّ لَکَ، وَ عَافِنِی مِمَّا أَسْتَوْجِبُهُ مِنْکَ، وَ أَجِرْنِی مِمَّا یَخَافُهُ أَهْلُ الإِسَاءَةِ.
«وَهَبَ» له شیئاً: أعطاه، ثمّ توسّعوا فی الهبة و استعملوها بمعنى المغفرة ؛ یقال: أللّهمّ هبْ لی ذنوبی أی: اغفرها لی.
و «وجب» الحقّ یجب وجوباً: لزم و ثبت؛ و استوجب الشیء: استحقّه.
و «عافاه» اللّه: محا عنه الأسقام؛ أی: و هبْ لی ما یجب علیَّ من معرفتک و طاعتک بقدر استعدادی و نحو وجودی.
و «أجره» ممّا یخاف منه: أمنه.
و «أهل الإساءة»: هم الّذین یعملون السیّئات و یرتکبون القبائح؛ و المعنى واضحٌ.
فَإِنَّکَ مَلِیءٌ بِالْعَفْوِ.
«الفاء» للتعلیل.
و «الملیء» إمّا بهمزةٍ بعد الیاء؛ أو بتشدید الیاء ـ بالقلب و الإدغام، کما فی نسخة الکفعمیّ(155) ـ، فعیلٌ <من ملأ الإناء یملأه؛ و مالأه فلاناً: عاونه؛ و تمالؤا: تعاونوا. و قال المطرّزی فی المغرب: «و أصل ذلک العون فی الملأ، ثمّ عمّ، و قد ملأ و أملأه و هو أملاءٌ منه ـ على أفعل التفضیل ـ، و منه قولهم: اختر املأهم أی: أقدرهم». و قال فی غریب القرآن: «ملأ ـ من بنی اسرائیل ـ: أشرافهم و وجوههم»(156)؛ و قال ابن الأثیر: «الملیء ـ بالهمزة(157) ـ: الثقة الغنیّ، و یقال: هو(158) ملیءٌ بیّن(159) الملاءة ـ بالمدّ ـ، و قد أولع الناس فیه ـ بترک الهمزة والتشدیدـ»(160)
أقول: قد ظهر من هذا انّ ملیّئاً بهذا المعنى أصله الهمزة، على خلاف «ملیّ» فی قوله ـ تعالى ـ: (وَ اهْجُرنِی مَلِیّاً)(161) ـ أی: زماناً طویلاً ـ، فانّه من الملاوة>(162)
مَرْجُوٌّ لِلْمَغْفِرَةِ، مَعْرُوفٌ بِالتَّجَاوُزِ
عن السیّئات و عدم المؤاخذة بالجریرة. قیل: «الفرق بین «العفو» و «المغفرة»: انّ العفو اسقاط العذاب، و المغفرة أن یستر علیه بعد ذلک جرمه صوناً له من عذاب الخزی والفضیحة ـ فانّ الخلاص من عذاب النار إنّما یطیب إذا حصل عقیبه الخلاص من عذاب الفضیحة ـ ؛ فالعفو اسقاط العذاب الجسمانیّ، و المغفرة اسقاط العذاب الروحانی؛ و «التجاوز» یعمّهما».
لَیْسَ لِحَاجَتِی مَطْلَبٌ سِوَاکَ وَ لاَ لِذَنْبِی غَافِرٌ غَیْرُکَ، حَاشَاکَ. وَ لاَ أَخَافُ عَلَى نَفْسِی إِلاَّ إِیَّاکَ.
«المطلب» إمّا مصدرٌ، أو اسم مکانٍ بمعنى موضع الطلب.
و «سِوى» ـ بالکسر و القصر على أشهر لغاتها ـ کالغیر معنىً و تصرّفاً فی وجوه الإعراب عند الزجّاج و ابن مالک، و ذهب سیبویه و البصریّون إلى أنّها منصوبةٌ أبداً على الظرفیّة المکانیّة و لاتخرج عن ذلک إلّا فی الشعر؛ فإذا قلت: جاءنی القوم سِوى زیدٍ، کان فی قوّة قولک: جاءنی القوم مکان زیدٍ ـ أی: بدله ـ، فیفید انّ زیدآ لمیأتک. فجرّد عن معنى البدلیّة لمطلق الاستثناء، فلزم نصبه على کونه ظرفاً فی الأصل و إن لمیکن فیه الآن معنى الظرفیّة(163) و قال بعضهم: «تستعمل ظرفاً غالباً، و کغیر قلیلاً»(164)
و إنّما قصّر – علیه السلام ـ موضع طلب حاجته علیه ـ سبحانه ـ، لما مرّ من أنّه ـ تعالى ـ مطلوب کلٍّ من الموجودات و لا قاضٍ لحوائجهم إلّا هو، لأنّ الکلّ مفتقرٌ إلیه ـ سبحانه ـ فی الوجود، فکیف فیما سوى الوجود من متفرّعاته!.
ثمّ قصّر مغفرة الذنب علیه ـ تعالى ـ، لاستحالة مغفرة الذنوب الوجودیّة و غیر
الوجودیّة من غیر الحضرة الأحدیّة ـ کما قال تعالى: (وَ مَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ آللَّهُ)(165)؟ـ.
فقوله – علیه السلام ـ: «حاشاک» بمعنى: سبحانک، تنزیهٌ له ـ سبحانه ـ أن یتصوّر للذنوب غافرٌ غیره. <و یجوز کونه بمعنى: سواک ـ تأکیداً لـ «غیرک» ـ ؛ و حینئذٍ فینبغی الوقف فیه، و لذا لم یرقم علیه «ط». و أمّا تعلّقه بما بعده و الوقف على «غیرک» ـ کما توهّم ـ فبعیدٌ>(166)
و قوله – علیه السلام ـ: «و لا أخاف على نفسی إلّا إیّاک» هذا القصر أیضاً لما مرّ من أنّ کلّ شخصٍ من الممکنات ذو وجهین: وجهٌ إلى ربّه؛ و وجهٌ إلى نفسه ـ الّذی هو الإمکان و الفقر و الفاقة و النقص و الآفة ـ ؛ فکلّما ازداد معرفة نفسه ازداد معرفة ربّه، و کلّما ازداد معرفة ربّه ازداد خوفه و خشیته، کما قال ـ سبحانه ـ: (إِنَّمَا یَخشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ)(90)
ثمّ إذا تأمّل طبقة الموجودات وجدها کنفسه عین البطلان و الاحتیاج، فلم یر فی دائرة الوجود إلّا هو، فلایخاف على نفسه إلّا إیّاه!.
و قال الفاضل الشارح: «و «إیّاک» على المختار ضمیرٌ بارزٌ منفصلٌ مرادفٌ بحرف الخطاب. و الکلام إمّا على حذف مضافٍ ـ أی: لا أخاف على نفسی إلّا عذابک ـ فحذف المضاف و أقام المضاف إلیه مقامه ـ کما قالوه فی قوله تعالى: (یَخَافُونَ رَبَّهُمْ)(167) أی: عذابه،
بدلیل قوله سبحانه: (وَ یَخَافُونَ عَذَابَهُ)(168) ـ ؛ أو هو من باب الترقّی عن مقام مشاهدة الأفعال و الصفات إلى ملاحظة الذات. و هی الاقبال على اللّه ـ تعالى ـ و توجیه وجه النفس إلى قبلة ذاته المقدّسة مع قطع النظر عن الأفعال و الصفات. و هو أوّل مقام الوصول
إلى ساحل العزّة، فهو من قبیل ما وقع فی الدعاء النبویّ: «و أعوذ بک منک»(169)؛ و قد سبق الکلام على ذلک»(170)
و هذه الفقرة مع الفقرة السابقة ـ و هو قوله علیه السلام: «مرجوٌّ للمغفرة» یدلّان دلالةً لطیفةً على أن الخوف و الرجاء لابدّ أن یکونا متساویین؛ و لکن لابدّ من تصحیح ذلک، لأنّ من درجات العرفان أن لایخشى العارف إلّا ربّه.
و قول المتوهّم: «إنّ حاشاک متعلّقٌ بما بعده» یفید خلاف ذلک؛ فالتصحیح ـ کما قیل ـ من ثلاثة وجوهٍ:
<الأوّل: إنّ انتقامه ـ تعالى ـ من تمام الحکمة و عقابه من سعة الرحمة ـ کما قال علیه السلام فی دعائه إذا استقال من ذنوبه: «أنت الّذی تسعى رحمته»(171) ـ، أمّا غضبه فالعقوبات الإلهیّة کتأدیبٍ یتولّاها المؤدّب الرؤوف الرحیم و إیلاماتٍ یأمر بها المعالج العطوف الحکیم؛ و إنّما الأسماء الحسنى القهریّة للرحمن ـ سبحانه، کالقابض و المضلّ و الضارّ ـ فی مقابلة أسمائه الحسنى اللطیف ـ کالباسط و الرافع و المعزّ و النافع ـ. و إلى هذا نظر من قال من أهل التحصیل: «و التحقیق انّه لا یسوغ لذاکرین اللّه ـ سبحانه ـ أن یفردوا شیئاً من أسمائه القهریّة من مقابلة أسماء الرحمة، دون العکس»؛
و الثانی: انهّ لمّا کانت غایة شدةّ الکمال مستوجبةً توافق الأسماء المتقابلة الکمالیّة علی الوجه الأتمّ الأکمل کان کلٌّ من الأسماء الحسنی المتقابلة الإلهیّة مقتضاه فی شدّة الکمالیّة أن یکون بحیث کانّه لا یصحّ انطلاق مقابله أصلاً، فملاحظة «الغفور الرحیم» مقام طلب المغفرة والرحمة کأنّها تصورّ العبد بحیث یستوجبه شدّة کمالیّة الاسم من استشعار ما یقابله من الأسماء المقدّسة – و هو «شدید العقاب» -. وقد لاحظ ذلک من ذهب من الأصحاب انّه
لا یسوغ للذاکرین إفراد شیءٍ من الأسماء المتقابلة من مقابله، بل الحقیق بحسن الأدب القِران بین کلّ متقابلین من الأسماء المقدسة؛
و الثالث: انّه درجة العارف فی مقام الرجاء بحیث أن یصدّه عن استشعار الخوف رأساً، کما یجب أن لاتصدّه درجته فی مقام الخوف عن احتمال الرجاء أصلا؛ و لذلک قد وجب أن تکون درجات الرجاء و الخوف على التکافؤ و التقاوم أبدآ إلى حین الموت. روى شیخنا الأقدم محمّد بن یعقوب ـ رحمه اللّه ـ فی کتاب الکافی(172) عن الحارث بن المغیرة ـ أو أبیه ـ قال: قلت لأبی عبداللّه – علیه السلام ـ: ما کان فی وصیّة لقمان لابنه؟
قال: کان فیها الأعاجیب!، و کأنّ أعجب ما کان فیها أن قال لابنه: خف اللّه ـ عزّ و جلّ ـ خیفةً لوجئته ببرّ الثقلین لعذّبک، و ارج اللّه رجاءً لوجئته بذنوب الثقلین لرحمک!». ثمّ قال: «کان أبی یقول(173) : لیس من عبدٍ مؤمنٍ إلّا و فی قلبه نوران: نور خیفةٍ و نور رجاءٍ لووزن هذا لمیزد على هذا!»>(174)
و قال السیّد السند الداماد: «و(175) لعلّ فی تأخیر الرجاء عن الخوف إیماءً لطیفآ إلى أنّه ینبغی أن یکون خاتمة الحیاء على مقام الرجاء، و رجحان درجته. و اللّه ـ سبحانه ـ أعلم بأسرار أوصیاء رسوله ـ علیه و علیهم أفضل الصلاة و أزکى التحیّات ـ»(176)
و قیل: «لابدّ أن ترجو من اللّه بحیث لو أُخبرت أنّه لایدخل الجنّة إلّا واحدٌ لترجو انّک هذا الواحد!، و لوسمعت انّه لایدخل النار إلّا واحدٌ خفت انّک هذا الواحد!».
إِنَّکَ أَهْلُ التَّقْوَى وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ.
هذا تعلیلٌ أو تقریرٌ لما سبق. أی: انّک حقیقٌ بأن یُتّقى ـ أی: یخشى ـ منک و جدیرٌ بأن یرجى الغفران منک.
و هذه الفقرة أیضاً تدلّ على أنّه ینبغی استواء الخوف و الرجاء. و عن أبی عبداللّه – علیه السلام ـ فی قول اللّه ـ عزّ و جلّ ـ: (هُوَ أَهلُ التَّقوَى وَ أَهلُ الْمَغْفِرَةِ)(177) : «قال اللّه ـ تبارک وتعالى ـ: أنا أهل أن أتّقى و لایشرک بی عبدی شیئاً، و أنا أهلٌ إن لم یشرک بی عبدی شیئاً أن أدخله الجنّة»(178)؛ و فی التفسیر الکبیر فی تفسیر هذه الآیة: «قال رسول اللّه ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ: اللّهمّ اجعلنی من أهل التقوى و أهل المغفرة. الأوّل من الأوّل و الثانی من الثانی من المجهول، و الثانی من الأوّل و الأوّل من الثانی من المعلوم»(179)
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ اقْضِ حَاجَتِی وَ أَنْجِحْ طَلِبَتِی، وَ اغْفِرْ ذَنْبِی، وَ آمِنْ خَوْفَ نَفْسِی.
<و «انجح» حاجته انجاحاً: قضاها له و أظفره بها.
و «الطَلِبة» ـ بفتح الطاء المهملة و کسر اللام، على وزن کَلِمَة ـ: ما یطلبه الإنسان من غیره. و کأنّ «الحاجة» أخصّ من «الطلبة»، لأنّها من الحوج – بالضمّ، بمعنى: الفقر ـ، فیکون المراد بها المطلوب الّذی لابدّ له منه و لاغناء به عنه ـ کالفوز بالجنّة و النجاة من النار ـ و الطلبة أعمّ منها ـ کرفع الدرجات و إضعاف المثوبات ـ. فیکون قوله: «و أنجح طلبتی» تأسیساً لا تأکیداً.
و «الأمن»: سکون القلب و اطمینانه؛ و أَمِنَ یَأمَنُ من باب تَعِب، و یعدّی بالهمزة،
فیقال: أمنته.
و اعلم! أنّ الأمن لایکون للخوف، بل للخائف؛ لکن لمّا کان الخوف سبباً موجباً لاضطراب الخائف نسب الأمن إلیه>(180)؛ و فی الحدیث القدسیّ: «و عزّتی و جلالی لا أجمع على عبدی خوفین، و لا أجمع له أمنین؛ فاذا أمننی فی الدنیا أخفته یوم القیامة!، و إذا خافنی فی الدنیا(181) آمنته یوم القیامة»(182)
إِنَّکَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ وَ ذَلِکَ عَلَیْکَ یَسِیرٌ.
تعلیلٌ لما سبق، کأنّه قال: إنّ قدرتک التامّة متحقّقةٌ و شمولها لجمیع الأشیاء ثابتٌ، فما سألتک علیک سهلٌ یسیرٌ.
و «الواو» من قوله: «و ذلک» یحتمل أن تکون للحال، فالجملة حالیّةٌ؛ و یحتمل أن تکون عاطفةً لاسم الإشارة على الضمیر المتّصل المنصوب بأن، و التقدیر: و إنّ ذلک علیک یسیرٌ. و تقدیم الظرف للاختصاص.
آمِینَ رَبَّ الْعَالَمِینَ.
<«آمین» ـ بالمدّ و القصر و تخفیف المیم ـ: اسم فعلٍ بمعنى: استجب؛ و فی الخبر انّه قال ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ: «علّمنی جبرئیل آمین و قال: انّه کالختم على الکتاب»؛ و فی خبرٍ آخر: «إنّه خاتم ربّ العالمین ختم به دعاء عبده» أی: به یصونه عن الآفات؛ و فی خبرٍ آخر: «انّه درجته فی الجنّة» أی: لقائلها>(183)
و قال الفاضل الشارح: «آمین اسم فعلٍ مبنیٍّ على الفتح ـ لالتقاء الساکنین ـ. و بنی علیه لأنّه أخفّ الحرکات، و لیکون مستعقباً للفتح تفاؤلاً.
و فیه أربع لغات:
إحداها: آمین ـ بالمدّ بعد الهمزة من غیر إمالةٍ ـ، و هذه اللغة أکثر اللغات استعمالاً. و لکن فیها بعدٌ فی القیاس، إذ لیس فی العربیّة «فاعیل» و إنّما ذلک فی الأسماء الأعجمیّة ـ کقابیل و هابیل ـ. و من ثَمّ زعم بعضهم انّه أعجمیٌّ؛ و على هذه اللغة قوله:
وَ یَرحَمُ اللَّهُ عَبْداً قَالَ آمِینَا(184)
قیل: «و الوجه فیها أن تکون أشبعت الفتحة فنشأت الألف، فلایکون خارجاً عن الأوزان العربیّة». قال ابن هشامٍ: «و فیه نظرٌ!، لأنّ الاشباع بابه الفتح». و نوقش بما قاله ابن مالک فی التوضیح من: «انّ الاشباع فی الحرکات الثلاث لغةٌ معروفةٌ»(185)، و جعل منه قولهم: بینا زیدٌ قام جاء عمروٌ، أی: بینا وقت قیام زیدٍ؛
و الثانیة: کالاولى، إلّا انّ الألف ممالةٌ للکسرة بعدها، رویت عن حمزة و الکسائی؛
و الثالثة: أمین ـ بقصر الألف، على وزن قدیر ـ، قال:
أَمِینَ فَزَادَ اللَّهُ مَا بَینَنَا بُعْداً(186)
و هذه اللغة أفصح فی القیاس و أقلّ فی الاستعمال حتّى أنّ بعضهم أنکرها. قال صاحب الإکمال: «حکى ثعلب القصر، و انکره غیره و قال: إنّما جاء مقصوراً فی الشعر»؛انتهى. و
انعکس النقل عن ثعلب علیّ بن فرقول فقال: «أنکر ثعلب القصر إلّا فی الشعر، و صحّحه غیره»؛ و قال صاحب التحریر: «و قال جماعةٌ انّ القصر لم یجیء عن العرب، و انّ البیت إنّما هو:
فَآمِینَ زَادَ اللَّهُ مَا بَینَنَا بُعداً
و الرابعة: «آمّین» ـ بالمدّ و تشدید المیم ـ. قال صاحب الإکمال: «حکى الداودی تشدید المیم مع المدّ و قال: هی لغةٌ شاذّةٌ، ولم یعرفها غیره»(187)؛ انتهى.
و أنکر ثعلب(188) و الجوهریّ(189) أن یکون ذلک لغةً و قال: «لانعرف آمّین جمعاً بمعنى قاصدین کقوله ـ تعالى ـ: (آمِّینَ الْبَیتَ الْحَرَامَ)(190)».
و قال بعضهم: «القول بأنّ التشدید لغةٌ، وهمٌ قدیمٌ؛ و ذلک انّ أباالعباس أحمد بن یحیى ثعلب قال: آمّین مثل عاصّین لغةٌ، فتوهّم انّ المراد صیغة الجمع، لأنّه قابله بالجمع؛
و هو مردودٌ بقول ابن جنیّ و غیره: انّ موازنه اللفظ لا غیر»(191)
و یؤیّده قول صاحب التمثیل: «و التشدید خطأٌ».
و اختلفوا فی معناها؛ فقال الجمهور: «معناها: استجب»(192)؛
و عن ابن عبّاس قال: سألت النبیّ ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ عن معنى آمّین، فقال: «إفعل»(91)؛
و قال أبوحاتم: «معناه: یکون کذلک»(193)؛
و قیل: «کذلک مثله فلیکن»(192)؛
و قیل: «کذلک فافعل»(194)
و قیل: «انّه اسمٌ من أسماء اللّه(195) ـ تعالى ـ بمعنى المؤمّن، و معناه: یا امین استجب»؛ قال صاحب المطالع: «و هذا لایصحّ، إذ لیس فی أسماء اللّه ـ تعالى ـ اسمٌ مبنیٌّ و لاغیر معربٍ. مع انّ أسماء اللّه ـ تعالى ـ لاتثبت إلّا بقرآنٍ أو سنّةٍ، و قد عدم الطریقان فی آمّین»؛ انتهى؛ و عن أبی علیٍّ الفارسی: «انّه تأوّل هذا القول على أنّ فی آمّین ضمیر اللّه»؛
و هو حسنٌ لو لم یصرّح صاحبه بأنّه بمعنى: المؤمّن.
و قال الواحدیّ: روی عن أبی جعفر الصادق – علیه السلام ـ انّه قال: «تأویله: قاصدین نحوک و أنت أکرم من أن تخیّب قاصداً»(91)؛
و هذا تحقیق لغة التشدید مع المدّ.
و قال الترمذی: «معناه: لاتخیّب رجاءنا»؛
و قال سهلٌ: «معناه: لایقدر أحدٌ على هذا سواک».
و قیل: «هی کلمةٌ عبرانیّةٌ عرّبت مبنیّةً على الفتح»؛ و اللّه اعلم!»(196)؛ انتهى کلامه.
قوله – علیه السلام ـ «ربّ العالمین». أی: یا ربّ العالمین، حذف حرف النداء استغناءً عنه، لاستشعاره بکون المنادى مقبلاً علیه سامعاً لما یقول.
و «الربّ» قد مرّ معناه لغةً و اصطلاحاً.
و «العالمون»: جمع عالَم، و هو جمعٌ لا واحد له من جنسه ـ کالنفر و الرهط ـ. و اشتقاقه
إمّا من «العلامة»، فهو اسمٌ لما یعلم به ـ کالخاتم لما یختم به، و القالب لما یقلب به ـ غلب فیما یعلم به صانعه؛ و إمّا من العلم، لأنّه یقع على ما یعلم. و هو فی عرف اللغة عبارةٌ عن جماعةٍ من العلماء من الملائکة و الثقلین. و إنّما جمع لیشتمل کلّ جنسٍ من مسمّاه؛ و غلب العقلاء
فیهم فجمع ـ لمعنى وصفهم فیه ـ بالواو و النون.
و قیل: «العالَم لنوع مایعقل، و هم: الملائکة و الجنّ و الإنس»؛
و قیل: «هم الثقلان خاصّةً، لقوله ـ تعالى ـ: (لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیراً)(197)؛
و قیل: «هم الإنس، لقوله: (أَ تَأْتُونَ الذُّکرَانَ مِنَ العَالَمِینَ)(198) ؟»(199)
و فی المتعارف بین الناس هو عبارةٌ عن جمیع المخلوقات ـ من الجواهر و الأعراض ـ ؛ و قد دلّت علیه الآیة، قال: (وَ مَا رَبُّ الْعَالَمِینَ – قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الاَرْضِ)(200) -(201) و فی تفسیر البیضاویّ: «و قیل: عنی به الناس هیهنا، فانّ کلّ واحدٍ منهم عالمٌ من حیث انّه یشتمل على نظائر ما فی العالَم الکبیر(202)، و لذلک سوّى بین النظر فیهما و قال ـ تعالى ـ: (وَ فِی أَنْفُسِکُمْ أَفَلاَتُبصِرُونَ)(203)»(204)؛ انتهى.
أقول: کون کلّ واحدٍ من أفراد الناس أو أکثرهم مشتملاً على نظائر ما فی العالم الکبیر ـ کلّاً أو جلّاً ـ محلّ نظرٍ!، فربّ انسانٍ لمیتجاوز عن حدود البهیمة إلى درجة العقل ـ کما مرّ تحقیق ذلک ـ ؛ و اشتماله على بعض نظائره غیر مختصٍّ بالإنسان.
و یمکن أن یراد بـ «العالمین» هیهنا: العلماء من الإنسان، أمّا على عرف أهل اللغة فظاهرٌ؛ و أمّا على المتعارف بین الناس فلأنّ کلّ عالِمٍ ـ بالکسر ـ عالَمٌ ـ بالفتح ـ،
إمّا باعتبار انّ فیه من کلّ ما فی العالم الکبیر شیءٌ ـ لأنّ نشأته الکاملة مظهر جمیع الأسماء و الصفات الإلهیّة و مجمع کلّ الحقائق الکونیّة، کما یعرفه متتبّعوا آیات الآفاق و الأنفس، فیکون أنموذجاً لجمیع ما فی العالَم؛ و کما یقال للعالَم: الإنسان الکبیر، کذلک یقال للإنسان العالَم الصغیر، و کلٌّ من هذین القولین انّما یصحّ بحسب الصورة لإجمال أحدهما و تفصیل الآخر ـ؛
و إمّا بحسب المرتبة. فالعالَم هو الإنسان الصغیر و الإنسان هو العالم الکبیر، إذ للخلیفة الاستعلاء على المتسخلَف علیه. و لظهور کلّ شأنٍ فیه بصورة الجمع و وصفه لجامعیّته بین إجمال الجمعیّة الإلهیّة و قوّتها و بین تفصیل العالم و فعلیّة أحدهما فیه دفعةً و الآخر بالتدریج ـ کما قال أمیرالمؤمنین علیه السلام:
أَ تَزعَمُ(205) أَنَّکَ جِرمٌ صَغِیر++
وَ فِیکَ انْطَوَى اْعَالَمُ الاَکبَرُ
وَ أَنتَ الْکِتَابُ الْمُبِینُ الَّذِی++
بِأَحرُفِهِ یَظهَرُ الْمُضمَرُ(206) ـ
و قال صدر الحکماء و المحقّقین: «تسمیته بالعالم الصغیر باعتبار هذه النشأة الدنیاویّة و مظهریّته لجمیع الأسماء و الصفات الإلهیّة، فکأنّه کتابٌ مختصرٌ منتخبٌ من جمیع العالَم، (لاَیُغَادِرُ صَغِیرَةً وَ لاَ کَبِیرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا)(207)؛ کما انّ القرآن مع وجازته مشتملٌ على ما فی جمیع الکتب السماویّة.
و أمّا باعتبار انّه إذا برز باطنه إلى عالم الآخرة و حشر إلى ربّه یصیر علمه عیناً و غیبه شهادةً، فکلّ ما یخطر بباله من الأفلاک و العناصر و الجنّات و الأنهار و الحور و القصور و غیر ذلک یکون موجوداً فی الخارج من غیر مضایقةٍ و مزاحمةٍ، فله من کلّ ما یریده و یشتهیه و لو کان أعظم من هذا العالم بکثیرٍ. فهو بهذا الاعتبار عالمٌ کبیرٌ برأسه لیس جزءً من أجزاء هذا العالم. و لهذا سمّی بالعالم الکبیر، بل بالأکبر أیضاً! نظرآ إلى هذا.
و تسمیته بالعالم الصغیر إنّما وقع نظراً إلى الاعتبار الأوّل».
ثمّ قال: «فعلى ما بینّا زال الاشکال الّذی ورد هیهنا من: أنّ الإنسان جزءٌ من العالم، فکیف یزید على الکلّ؟!
و قد تکلّف بعض أهل النظر ممّن یرید أن یطیر مع الطیور السماویّة بأجنحةٍ علیلة(208)
صنعها بیدیه و ألصقها بجنبیه فی دفع هذا الاشکال بهذا المقال، و هو: انّ أهل الذوق یجعلونه من حیث الوجود الخارجیّ و ما یشتمل علیه من الأجزاء و الأحوال جزءً من العالم حتّى یکون العالم الصغیر ـ الّذی یکون الإنسان کبیراً بالنسبة إلیه ـ هو الموجودات الخارجیّة و العالم الکبیر هو الإنسان بجمیع ما یشتمل علیه من الموجودات الخارجیّة و الذهنیّة، فیزید على العالم بالموجودات الذهنیّة؛ إذ العقول و النفوس الفلکیّة ناطقةٌ مدرکةٌ للأشیاء ـ کما هو المشهور بین الفلاسفة ـ ؛
فأجاب عنه بقوله: قلت: أمّا العقول فلااحساس لها مطلقاً، و أمّا النفوس الفلکیّة فلااحساس لها بالحواسّ الظاهرة»؛ انتهى.
قال الصدر المذکور: «أقول: و لایخفى ما فیه من الرکاکة!، فانّه على تقدیر صحّته لایثبت إلّا کونه کبیراً بالنسبة إلى العقول و النفوس، لابالنسبة إلى مجموع العالم المشتمل على العقول و النفوس الکلّیّة المدرکة للکلّیّات و على النفوس الجزئیّة الحیوانیّة المدرکة للجزئیّات. فالحقّ ما ذکرنا من أنّ الإنسان الکامل عند خروج روحه عن مشیمة هذا العالم و نشر صحیفة ذاته یکون کما أشار إلیه أبویزید البسطامیّ بقوله: «لو أنّ العرش و ما حواه ألف مرّةً وقع فی زاویة قلب العارف لما ملأه(209)»(210)؛ انتهى کلامه.
أقول: ما أورده على بعض أهل النظر واردٌ. و ما ذکره من توجیه کون الإنسان عالماً کبیراً یرجع عند التحقیق إلى ما ذکرناه لک آنفاً؛ فتبصّر.
—
قد و قع الفراغ من إتمام هذه اللمعة الثانیة عشرة فی لیلة الاثنین من العشر الأوسط من شوّال المکرّم سنة 1230.
1) راجع: «الکافی» ج 2 ص 426 الحدیث 4. و انظر: «وسائل الشیعة» ج 16 ص 59 الحدیث20976، «فلاح السائل» ص 35.
2) المصدر: + عبدٌ.
3) المصدر: أن یقرّوا له بالنعم فیزیدهم.
4) راجع: «الکافی» ج 2 ص 426 الحدیث 2، «بحار الأنوار» ج 6 ص 36، «مجموعة ورّام» ج 1ص 18، «مشکاة الأنوار» ص 110.
5) المصدر: الذنب.
6) المصدر: به.
7) راجع: «الکافی» ج 2 ص 426 الحدیث 1، «وسائل الشیعة» ج 16 ص 58 الحدیث20974، «بحار الأنوار» ج 6 ص 38، «مجموعة ورّام» ج 1 ص 18.
8) و انظر: «نور الأنوار» ص 98.
9) قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 470.
10) کریمات 132 / 133 / 134 الشعراء.
11) کریمة 88 القصص.
12) المصدر: + یشابه نحو.
13) المصدر: ـ و.
14) قارن: «الحکمة المتعالیة» ج 1 ص 420.
15) المصدر: تحصیلاً.
16) المصدر: متحصّلةٍ.
17) قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 421.
18) کریمة 148 البقرة.
19) راجع: «ریاض السالکین» ج 2 ص 474.
20) کریمة 56 الذاریات.
21) راجع: «الکافی» ج 2 ص 71 الحدیث 2، «مستدرک الوسائل» ج 11 ص 250 الحدیث12904، «بحار الأنوار» ج 67 ص 394، «جامع الأنوار» ص 98.
22) قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 475.
23) المصدر: هبتک.
24) راجع: «شرح الصحیفة» ص 152.
25) هکذا العبارة فی النسختین، تبعاً لما فی المصدر.
26) قارن: «نور الأنوار» ص 99.
27) کریمة 6 الرعد.
28) لم أعثر علیهما. و الظاهر من تعقیب التفتازانیّ کلامه انّ العبارتین مأخوذتان من «الکشّاف» و«حاشیة» التفتازانی علیه. و لکن لما اهتد إلى موضع کلام الزمخشریّ فی «الکشّاف»، و«حاشیة» التفتازانی علیه لمیطبع بعد.
29) قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 477.
30) لم أعثر على مصدره.
31) لم أعثر علیه بألفاظه، و انظر: «مستدرک الوسائل» ج 5 ص 186 الحدیث 5642، «شرح ابن أبی الحدید» ج 6 ص 196.
32) کریمة 31 آلعمران.
33) لم أعثر علیه، و انظر: «بشارة المصطفى» ص 274.
34) راجع: «بحار الأنوار» ج 58 ص 234.
35) راجع: «الکافی» ج 3 ص 501 الحدیث 16، «التهذیب» ج 4 ص 104 الحدیث 31. و انظر:«بحار الأنوار» ج 93 ص 70.
36) قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 478.
37) راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 4 ص 416 الحدیث 5904، «بحار الأنوار» ج 10 ص 98،«تحف العقول» ص 110، «دعائم الإسلام» ج 2 ص 255 الحدیث 970.
38) قال: «عال یعیل عَیلاً و عُیولاً و معیلاً: افتقر»، راجع: «القاموس المحیط» ص 955 القائمة 2.
39) کریمة 150 البقرة. و قد صحّحنا الآیة الکریمة، و هی فی المتن خطأٌ کما جاءت فی المصدر.
40) کما حکاه الرازیّ، راجع: «التفسیر الکبیر» ج 7 ص 152.
41) راجع: نفس المصدر المتقدّم ذکره.
42) کریمة 286 البقرة.
43) راجع: «تفسیر القرطبی» ج 3 ص 431.
44) راجع: «تفسیر الکشّاف» ج 1 ص 408.
45) قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 481.
46) قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 483.
47) المصدر: + کسمع.
48) راجع: «القاموس المحیط» ص 492 القائمة 1.
49) لم أعثر علیه فی مادّته فی «المحکم»، و نقله الزبیدیّ عن خطبته، راجع: «تاج العروس» ج 8ص 194 القائمة 1.
50) کما حکاه المحدّث الجزائری، انظر: «نور الأنوار» ص 99.
51) کریمة 56 الأعراف.
52) راجع: «الکافی» ج 2 ص 67 الحدیث 1، «وسائل الشیعة» ج 15 ص 216 الحدیث20311، «بحار الأنوار» ج 75 ص 259، «القصص» ـ للراوندی ـ ص 191.
53) کریمة 26 الأنبیاء.
54) کریمة 70 المؤمنون.
55) کریمات 14 / 15 / 16 الأعلى.
56) راجع: «ریاض السالکین» ج 2 ص 485.
57) کریمة 33 الکهف.
58) قارن: «ریاض السالکین» ج 2 486.
59) هذا قول المحدّث الجزائری، انظر: «نور الأنوار» ص 99.
60) المصدر: ائتو.
61) المصدر: رموا.
62) راجع: «الکافی» ج 2 ص 288 الحدیث 3. و انظر: «وسائل الشیعة» ج 15 ص 310 الحدیث20605، «بحار الأنوار» ج 70 ص 346.
63) کریمة 231 البقرة.
64) قارن: «ریاض السالکین» ج 2 487.
65) فی النسختین: على العالم بالتواتر کون.
66) راجع: «الحکمة المتعالیة» ج 3 ص 518.
67) کریمة 7 التکاثر.
68) راجع: «الکافی» ج 1 ص 97 الحدیث 6. و انظر أیضاً: «بحار الأنوار» ج 10 ص 117،«ارشاد القلوب» ج 2 ص 374، «التوحید» ص 304 الحدیث 1، «روضة الواعظین» ج 1ص 32.
69) و انظر: «لطائف الأعلام» ص 250.
70) و انظر أیضاً: نفس المصدر صص 463 / 464.
71) کریمات 5 / 6 / 7 التکاثر.
72) لم أعثر علیه. و روی عنه ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ـ: «الیقین الإیمان کلّه»، راجع: «اتحاف السادة المتّقین» ج 4 ص 187، «المغنی عن حمل الأسفار» ج 1 ص 72، «کشف الخفاء» ج 2ص 555.
73) المصدر: أعطى.
74) المصدر: قیام اللیل و صیام النهار.
75) راجع: «مستدرک الوسائل» ج 2 ص 425 الحدیث 2360، «بحار الأنوار» ج 79 ص 137،«مسکّن الفؤاد» ص 41.
76) کریمة 167 آلعمران.
77) راجع: «مستدرک الوسائل» ج 11 ص 198 الحدیث 12737، «بحار الأنوار» ج 67ص 196.
78) راجع: «الکافی» ج 2 ص 57 الحدیث 1، «وسائل الشیعة» ج 15 ص 202 الحدیث20279، «بحار الأنوار» ج 67 ص 142، «مجموعة ورّام» ج 2 ص 184.
79) المصدر: رأى الدنیا.
80) راجع: «الکافی» ج 2 ص 59 الحدیث 9. و انظر أیضاً: «التهذیب» ج 9 ص 276 الحدیث11، «بحار الأنوار» ج 67 ص 156، «ارشاد القلوب» ج 1 ص 113.
81) کما فی الخبر: «کان إذا مشى کأنّما ینحطّ من صببٍ»، راجع: «مستدرک الوسائل» ج 8 ص237 الحدیث 9341، «عیون أخبار الرضا» ج 1 ص 315، «معانی الأخبار» ص 79الحدیث 1.
82) ما اهتدیت إلى مراد المصنّف.
83) المصدر: ـ انّ.
84) راجع: «مستدرک الوسائل» ج 11 ص 198 الحدیث 12737، «بحار الأنوار» ج 67ص 179.
85) لم أعثر علیه بألفاظه، و انظر: «نهج البلاغة» الحکمة 417 ص 549، «شرح ابن أبی الحدید»علیه ج 20 ص 56.
86) قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 490.
87) کریمة 8 التحریم.
88) تکرّرت هذه الکریمة فی القرآن الکریم 7 مرّات، فانظر ـ کنموزجٍ ـ 29 الأعراف.
89) قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 492.
90) کریمة 28 فاطر.
91) لم أعثر علیه.
92) قارن: «الأربعون حدیثاً» ص 308.
93) هذاکلام العلّامة البهائی، راجع: «الأربعون حدیثاً» ص 308. و قوله: «و لهذا قال بعض أرباب القلوب» اشارةٌ إلى قول فیض بن عیاض، انظر: «عوارف المعارف» ص 498، «احیاء علوم الدین» ج 4 ص 332.
94) المصدر: + هی.
95) راجع: «مغنی اللبیب» ج 1 ص 488.
96) راجع: «المفصّل فی علم العربیّة» ص 309.
97) لم أعثر علیه، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة.
98) راجع: «مستدرک الوسائل» ج 5 ص 219 الحدیث 5734، «بحار الأنوار» ج 90 ص 235،«الدعوات» ص 45 الحدیث 108.
99) راجع: «ریاض السالکین» ج 2 ص 494.
100) المصدر: مرّةٍ.
101) راجع: «الصحیفة» المبارکة الدعاء 12 الفقرة 9 ص 66، «المصباح» ـ للکفعمی ـ ص 385،«بحار الأنوار» ج 69 ص 114.
102) راجع: «النهایة» ج 5 ص 123.
103) المصدر: + و.
104) هیهنا حذف المصنّف قطعةً من المصدر.
105) راجع: «القاموس المحیط» ص 142 القائمة 1.
106) المصدر: + الطغام.
107) راجع: «شرح الصحیفة» ص 154.
108) قال فی ابن طاوس: «و إذا فرغ من الصلاة یوم الجمعة قال:… یا من شکر على القلیل و یجازیبالجلیل»، راجع: «جمال الأسبوع» ص 423، و انظر: «المصباح» ـ للکفعمی ـ ص 433.
109) انظر: «بحار الأنوار» ج 87 ص 157، «الاقبال» ص 362.
110) راجع: «أساس البلاغة» ص 140 القائمة 2.
111) کریمات 111 الإسراء، 59 النمل….
112) کریمة 152 البقرة.
113) الصحاح: أی: یمنّ.
114) راجع: «صحاح اللغة» ج 1 ص 464 القائمة 1.
115) مجمع الأمثال: ـ قولهم.
116) راجع: «مجمع الأمثال» ج 2 ص 317 القائمة 1 الرقم 4112.
117) کریمات 40 / 47 / 122 البقرة.
118) کریمة 26 الأنفال.
119) راجع: «ریاض السالکین» ج 2 ص 499.
120) کریمة 264 البقرة.
121) کریمة 11 إبراهیم.
122) کریمة 17 الحجرات.
123) راجع: «المصباح» ـ للکفعمی ـ ص 247.
124) راجع: نفس المصدر ص 251.
125) لم أعثر علیه. و عن سیّدنا علیّ بن الحسین ـ علیهما السلام ـ فی قوله ـ تعالى ـ: (فَافْصَحِ الصَّفْحَ الْجَمِیل) قال: «العفو من غیر عتابٍ»، راجع: «وسائل الشیعة» ج 12 ص 171الحدیث 15989. و انظر أیضاً: «بحار الأنوار» ج 68 ص 421، «الأمالی» ـ للصدوق ـ ص336 الحدیث 14.
126) کریمة 110 النساء.
127) المصدر: السیّئات.
128) راجع: «الکافی» ج 2 ص 434 الحدیث 6، «بحار الأنوار» ج 6 ص 40، «ارشاد القلوب» ج1 ص 180.
129) کریمة 60 غافر.
130) کریمة 186 البقرة.
131) کریمة 195 آلعمران.
132) کریمة 148 آلعمران.
133) قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 503.
134) راجع: «ریاض السالکین» ج 2 ص 505.
135) المصدر: إن.
136) المصدر: عملته.
137) راجع: «أنوار العقول» القطعة 253 ص 271. و انظر أیضاً: «بحار الأنوار» ج 34 ص 423.
138) هذا قول المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 155.
139) کما انّ الفیروزابادیّ ذکر لفظة «العائدة» فی مادّة «العود»، راجع: «القاموس المحیط» ص 288القائمة 1.
140) کریمة 3 الأنبیاء.
141) راجع: «ریاض السالکین» ج 2 ص 508.
142) قال: «شفقت و أشفقت إذا حاذرت بمعنىً واحد، زعم ذلک قومٌ و أنکره جلّ أهل اللغة، و قالوا:لایقال إلّا أشفقت»، راجع: «جمهرة اللغة» ج 3 ص 65 القائمة 1.
143) انظر ما حکیناه عن ابن درید فی التعلیقة السالفة. و قال الفیروزابادی: «و شفق و أشفق:حاذَر، أو لایقال إلّا أشفق»، راجع: «القاموس المحیط» ص 827 القائمة 1. و قال الزبیدیّ: «وهی اللغة العالیة»، راجع: «تاج العروس» ج 13 ص 244 القائمة 2.
144) راجع: «نهج البلاغة» الحکمة 472 ص 558، «خصائص الأئمّة» ص 125.
145) کریمة 69 النحل.
146) کما قال الفیروزابادی: «فحش ککَرُمَ»، راجع: «القاموس المحیط» ص 555 القائمة 2.
147) کما حکاه الزبیدیّ عن «خلاصة المحکم»، راجع: «تاج العروس» ج 9 ص 157 القائمة 2.
148) لم أعثر علیه، و انظر: «بحار الأنوار» ج 90 ص 283، «الدعوات» ص 31 الحدیث 66.
149) لم أعثر على قائله. و لمولانا أمیرالمؤمنین – علیه السلام ـ:یَا رَبِّ إنْ عَظُمَت ذُنُوبٌ کَثِیرَةٌ++فَلَقَد عَلِمتُ بِأَنَّ عَفَوَکَ أَعظَمُراجع: «أنوار العقول» القطعة 423 ص 401. و البیت منسوبٌ إلى أبی نواس أیضاً.
150) راجع: «ریاض السالکین» ج 2 ص 511.
151) راجع: «بحار الأنوار» ج 70 ص 208، مع تغییرٍ فی بعض الألفاظ.
152) کریمة 34 البقرة.
153) المصدر: ـ أی: مفارقته.
154) راجع: «الفائق» ج 1 ص 100.
155) کما حکاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 156.
156) لم أهتد إلى مراده. و لم أعثر على العبارة فیما عندی من مصادر غریب القرآن، کـ «تفسیرغریب القرآن الکریم» للطریحی، و «غریب القرآن» المنسوب إلى زید الشهید، و لم توجد فی«مسائل الرازی من غرائب آی التنزیل».
157) النهایة: بالهمز.
158) النهایة: و قد ملؤ فهو.
159) النهایة: + الملاء و.
160) راجع: «النهایة» ج 4 ص 352.
161) کریمة 46 مریم.
162) قارن: «شرح الصحیفة» ص 157.
163) المسألة من الخلافیّات بین البصرییّن و الکوفییّن، و لتفصیل المقال راجع: «الإنصاف فیمسائل الخلاف» ج 1 ص 294 المسألة 39.
164) هذا قول الرمّانى و العکبرى، انظر: «ریاض السالکین» ج 2 ص 517.
165) کریمة 135 آلعمران.
166) قارن: مع تغییرٍ فی بعض الألفاظ «نور الأنوار» ص 104.
167) کریمة 50 النحل.
168) کریمة 57 الإسراء.
169) راجع: «الکافی» ج 3 ص 324 الحدیث 12، «وسائل الشیعة» ج 8 ص 106 الحدیث10182، «الأمالی» ـ للطوسی ـ ص 158 الحدیث 265.
170) راجع: «ریاض السالکین» ج 2 ص 517.
171) راجع: «الصحیفة» المبارکة، الدعاء 16 الفقرة 8 ص 79.
172) راجع: «الکافی» ج 2 ص 67 الحدیث 1. و انظر أیضاً: «وسائل الشیعة» ج 15 ص 216الحدیث 20311، «بحار الأنوار» ج 67 ص 352، «القصص» ـ للراوندی ـ ص 191الحدیث 240.
173) المصدر: + انّه.
174) قارن: «نور الأنوار» ص 104. و العبارات تفصیلٌ لما أجمله المحقّق الداماد، راجع: «شرحالصحیفة» ص 157.
175) المصدر: انّه.
176) راجع: «شرح الصحیفة» ص 159.
177) کریمة 56 المدّثر.
178) راجع: «بحار الأنوار» ج 3 ص 4، «التوحید» ص 19 الحدیث 6.
179) قوله: «التفسیر الکبیر» اشارةٌ إلى «مجمع البیان» لا «التفسیر الکبیر» للرازی ـ کما هوالمشهور فی عصرنا ـ، راجع: «مجمع البیان» ج 10 ص 189.
180) قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 518.
181) المصدر: ـ فی الدنیا.
182) راجع: «مستدرک الوسائل» ج 11 ص 228 الحدیث 12818، «بحار الأنوار» ج 67 ص379، «أعلام الدین» ص 192، «جامع الأخبار» ص 97.
183) قارن: «نور الأنوار» ص 105. و الروایات المرویّة فی هذه القطعة لم أعثر علیها فی مصادرناالروائیّة.
184) صدره:یَا رَبِّ لاَتَسلُبَنِّی حُبَّهَا أَبَداًراجع: «صحاح اللغة» ج 5 ص 2072 القائمة 2.
185) لم أعثر علیهما.
186) صدره: تَبَاعَدَ مِنِّی فَطحُلٌ إِذْ رَأَیتُهُ راجع: نفس المصدر.
187) کما حکاه عنه الزبیدیّ، راجع: «تاج العروس» ج 18 ص 26 القائمة 1.
188) قال: «و إذا دعا الرجل قلت: أمین بقصر الألف»، راجع: «شرح الفصیح» ـ لابن هشام اللخمی ـ ص 244.
189) قال: «و تشدید المیم خطأٌ»، راجع: «صحاح اللغة» ج 5 ص 2072 القائمة 2.
190) کریمة 2 المائدة.
191) هذا قول الفیّومی، راجع: «المصباح المنیر» ص 34.
192) راجع: «النهایة» ج 1 ص 72.
193) انظر: «المصباح المنیر» ص 34.
194) انظر: «تاج العروس» ج 18 ص 26 القائمة 2.
195) هذا قول الحسن البصریّ، راجع: «المصباح المنیر» ص 34، «تاج العروس» ج 18 ص 26القائمة 2، و انظر أیضاً: «بحار الأنوار» ج 90 ص 393.
196) راجع: «ریاض السالکین» ج 2 ص 520.
197) کریمة 1 الفرقان.
198) کریمة 165 الشعراء.
199) لجمیع ذلک راجع: «تفسیر البیضاوی» ص 3.
200) کریمتان 23 / 24 الشعراء.
201) و انظر: «تاج العروس» ج 17 ص 449 القائمة 1.
202) هیهنا حذف المصنّف قطعةً من کلام البیضاوی.
203) کریمة 21 الذاریات.
204) راجع: «تفسیر البیضاوی» ص 4.
205) المصدر: و تحسب.
206) راجع: «أنوار العقول»، القطعة 219 ص 249.
207) کریمة 49 الکهف.
208) فی النسختین: «عملیّة»، و التصحیح قیاسیٌّ.
209) کما حکاه الشیخ بقوله: «یقول أبویزید: لو انّ العرش و ما حواه مأة ألف ألف مرّةٍ فی زاویةٍ من زوایا قلب العارف ما أحسّ بها»، راجع: «الفتوحات المکّیة» ج 2 ص 361 السطر 6.
210) لم أعثر على العبارات فی ما فحصت من آثاره للعثور علیها، کـ «الحکمة المتعالیة» و «الشواهدالربوبیّة» و «مجموعه رسائل فلسفى صدرالمتألّهین» و «ثلاث رسائل» و «شرح الأصول من الکافی» و «الواردات القلبیّة»، و غیرها مما راجعت إلیها.